التحكيم الالكتروني كآلية لفض منازعات التجارة الالكترونية الدكتور : يوسف كبيطي
[]
التحكيم الالكتروني كآلية لفض منازعات التجارة الالكترونية
Electronic arbitration as a mechanism for resolving e-commerce disputes
الدكتور : يوسف كبيطي
استاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة- جامعة شعيب الدكالي
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
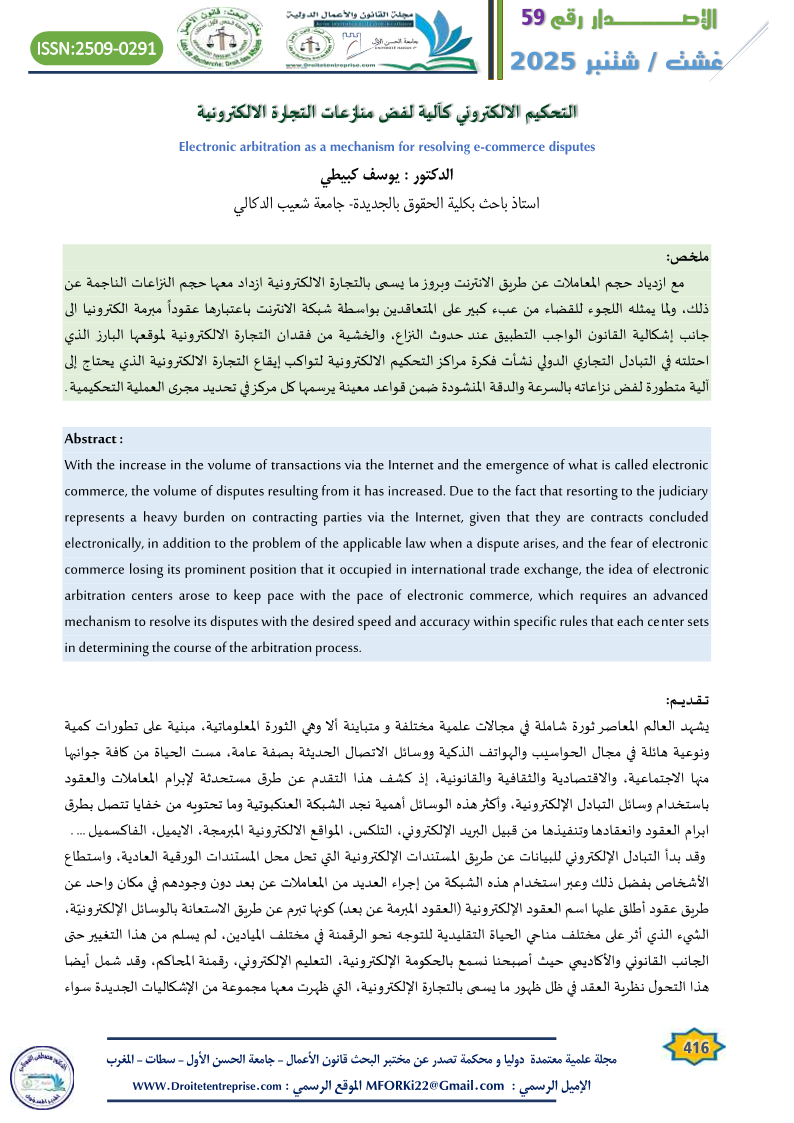
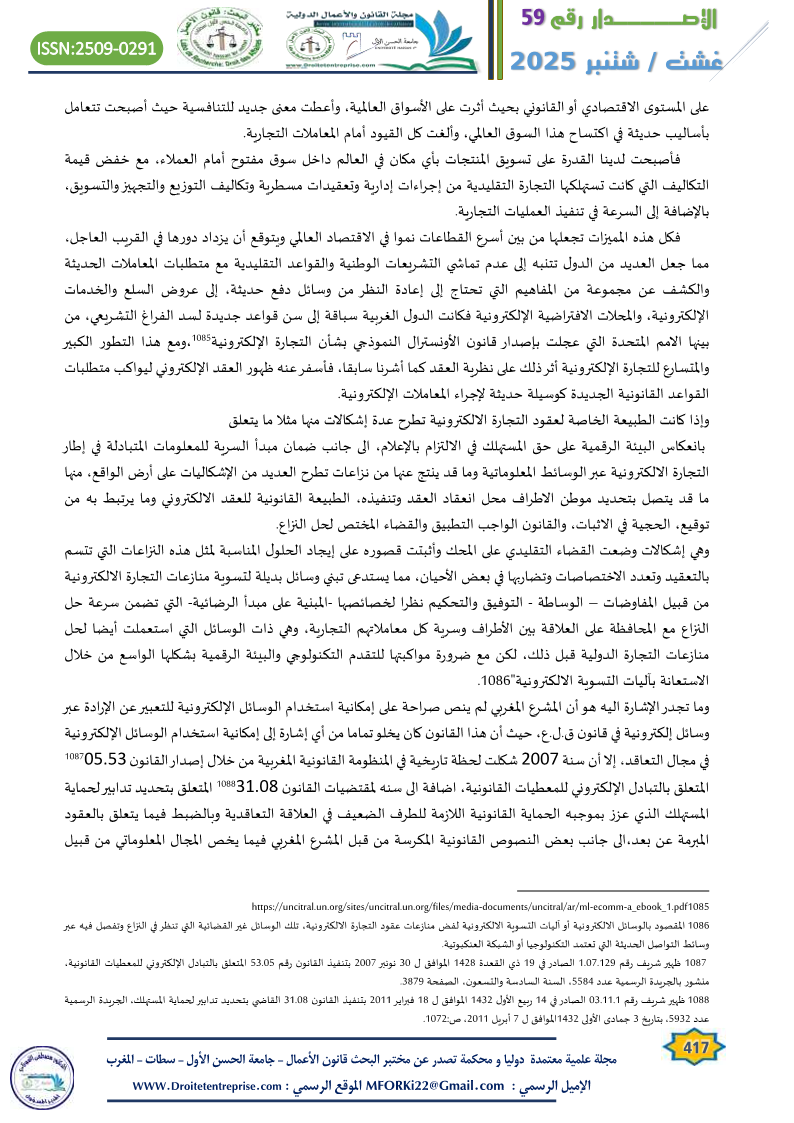
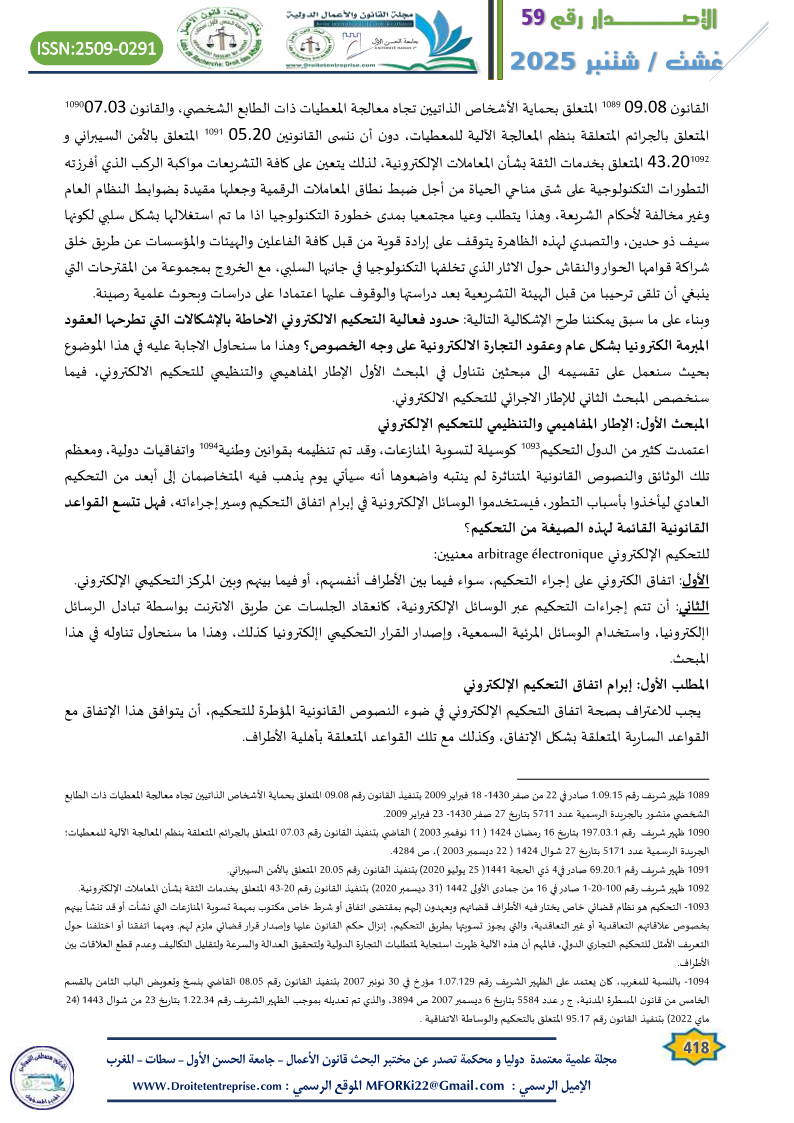
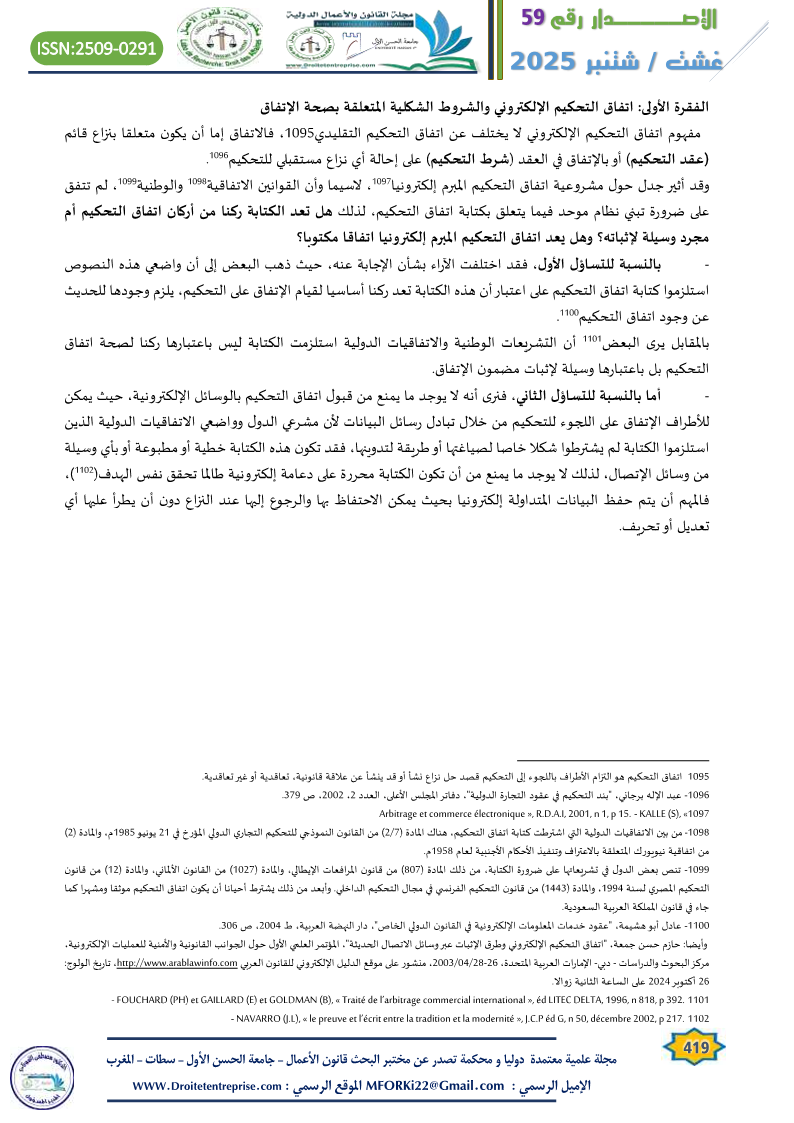
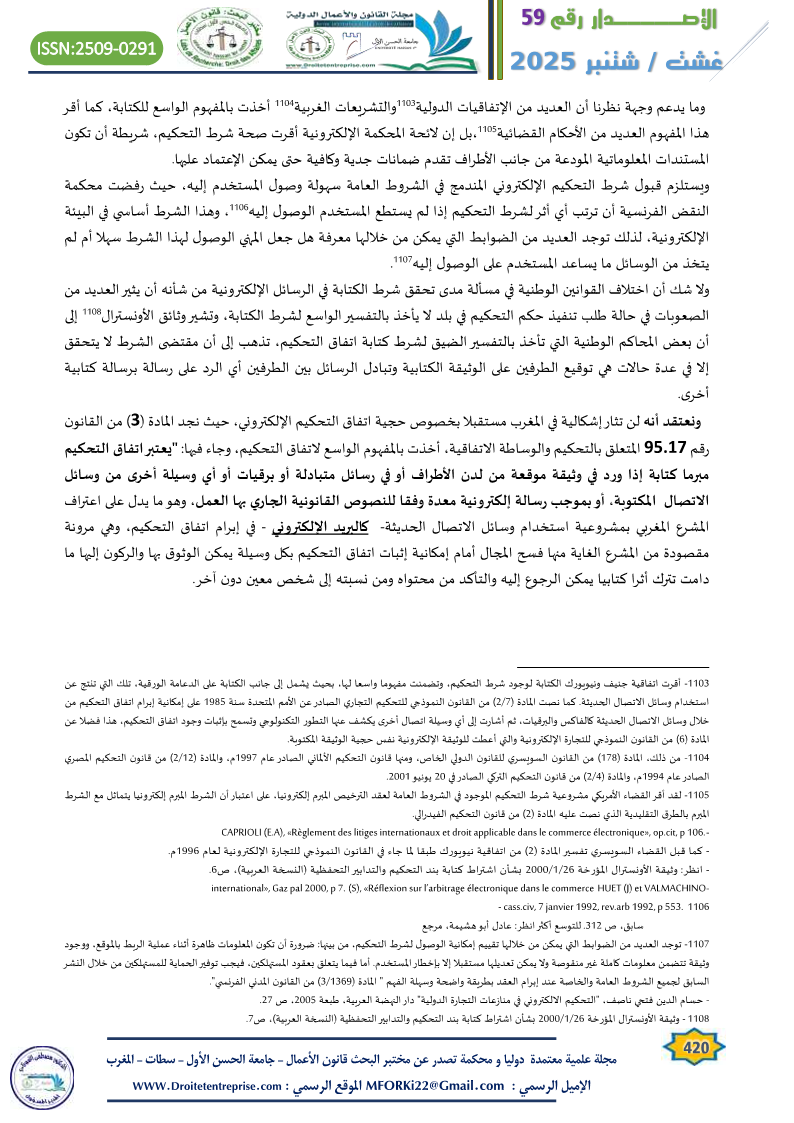
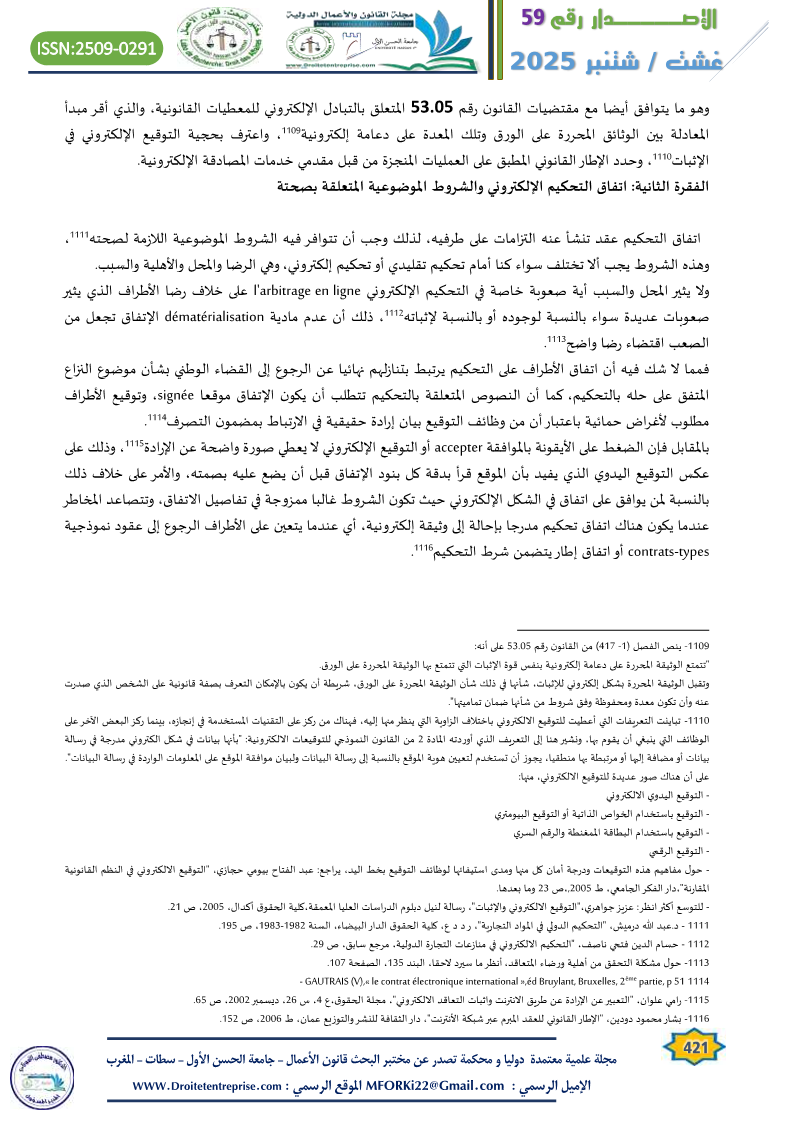
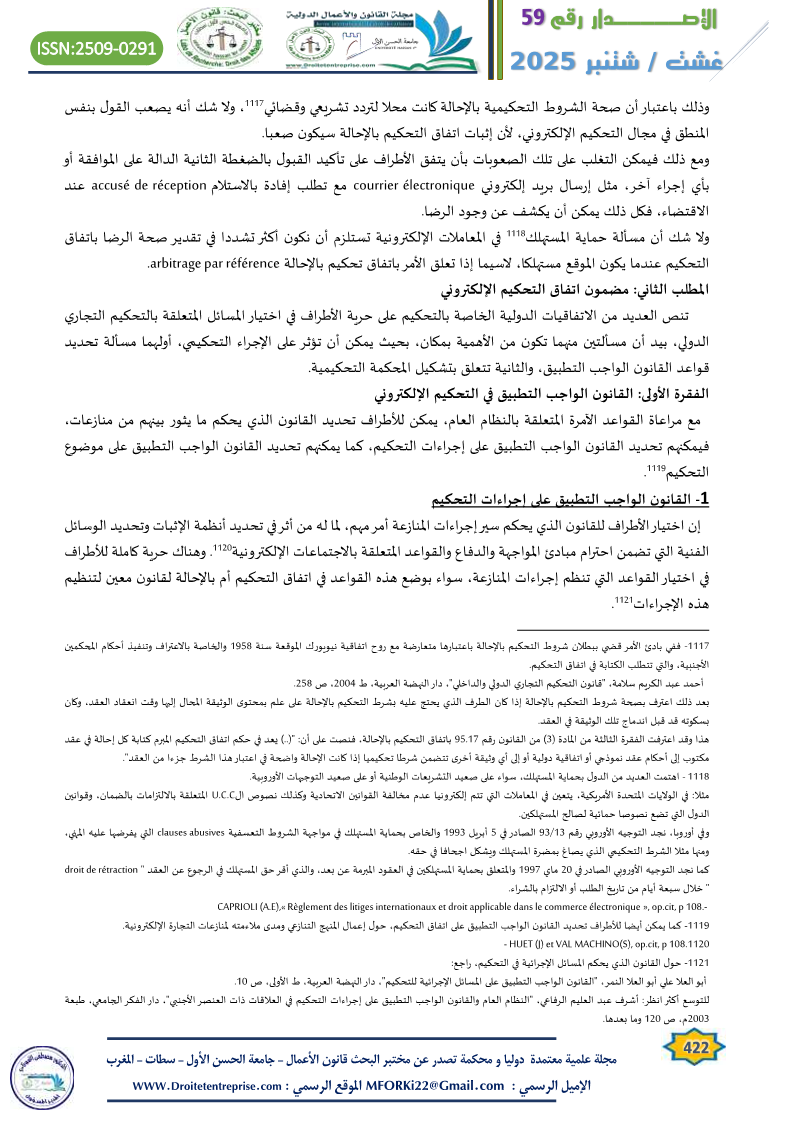
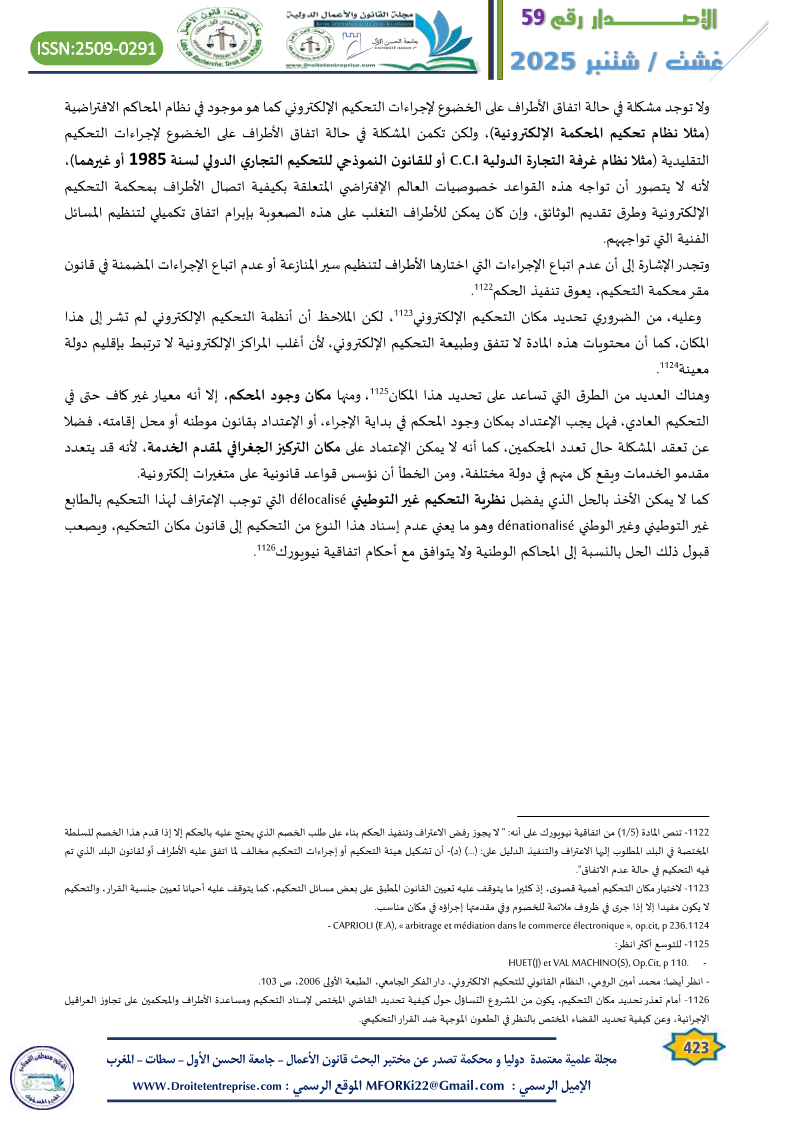
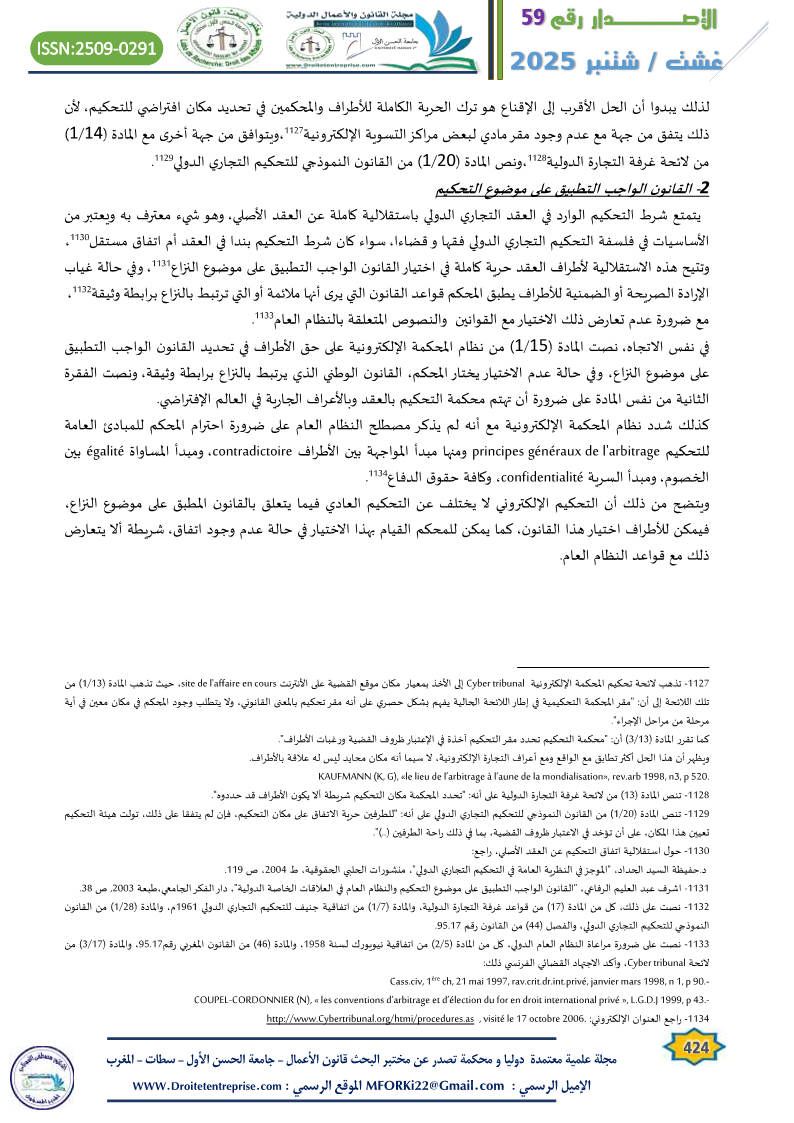
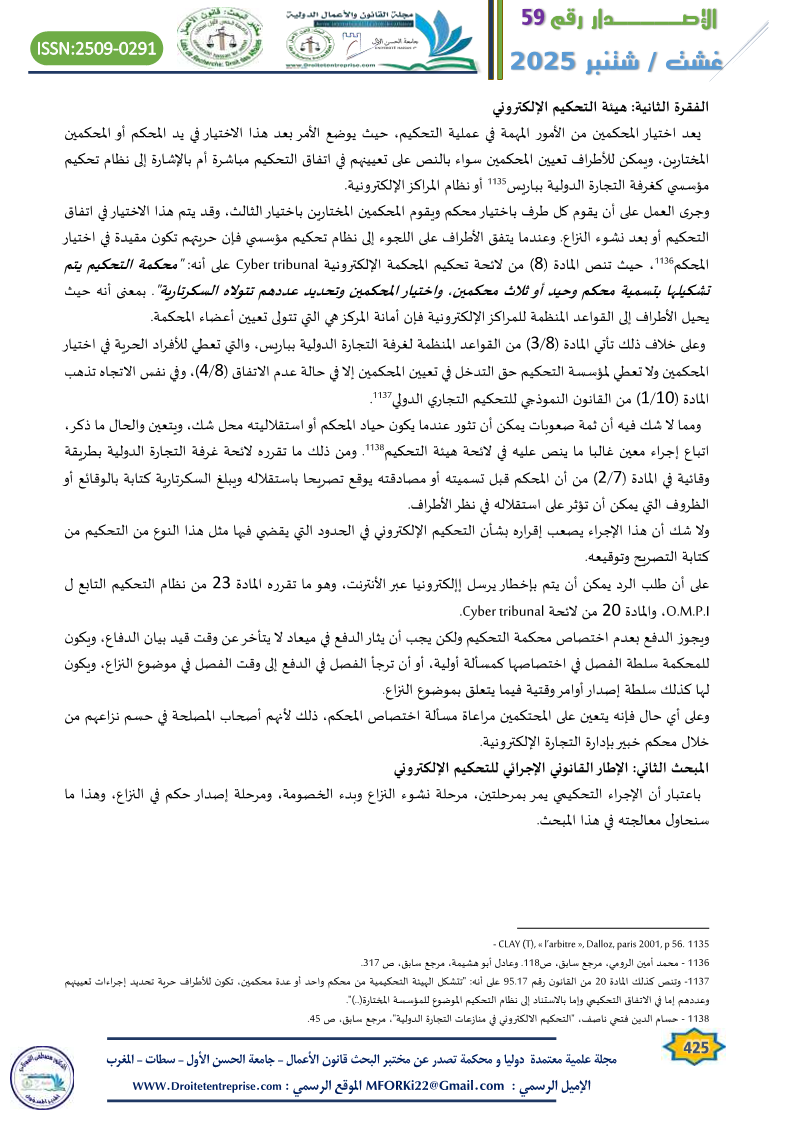
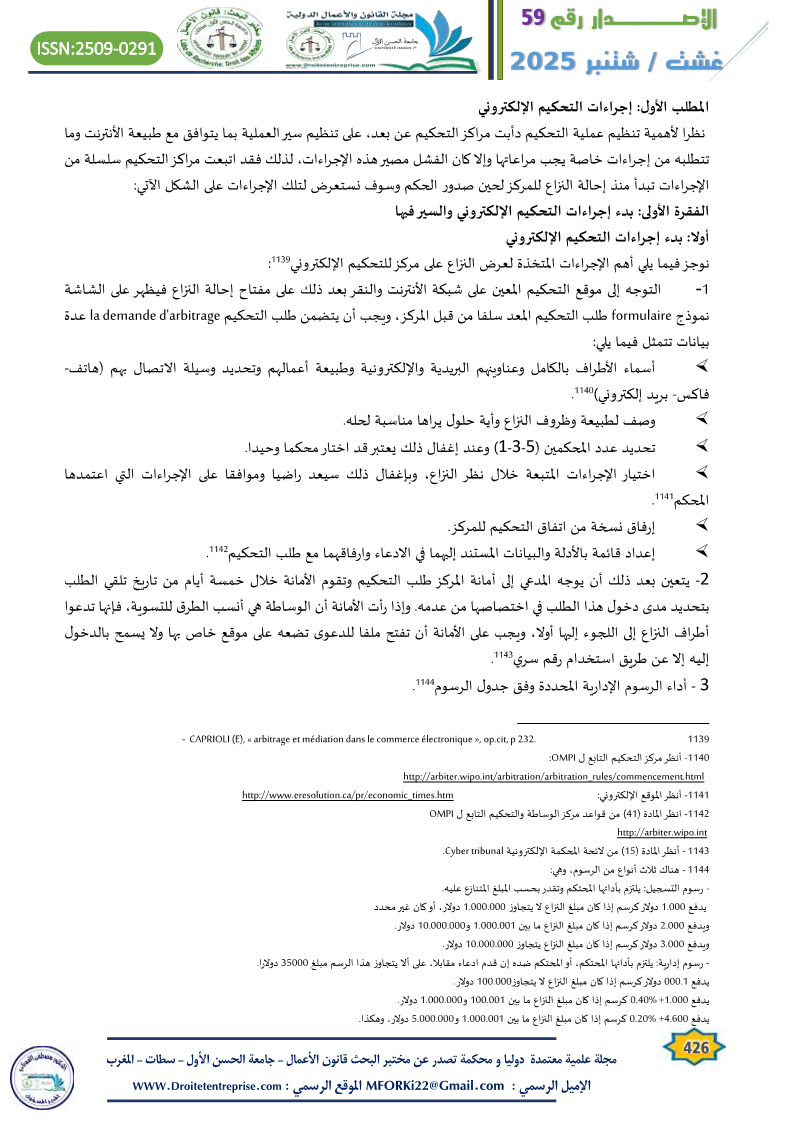
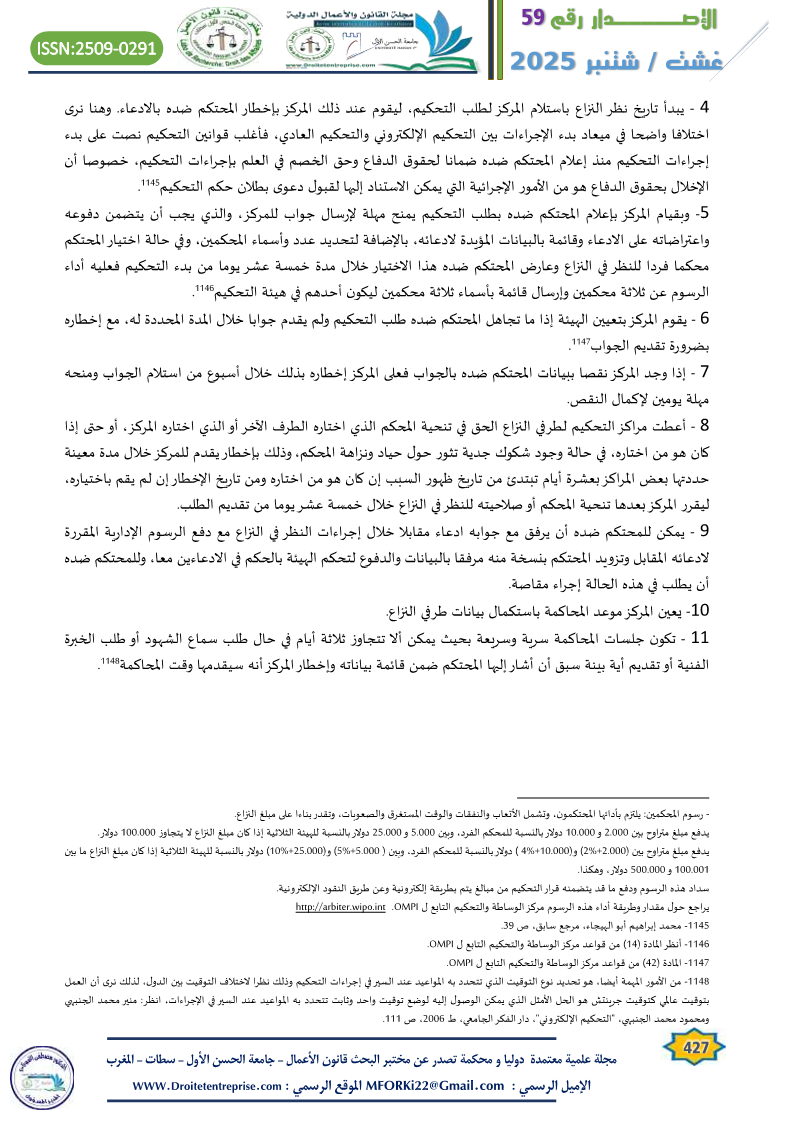
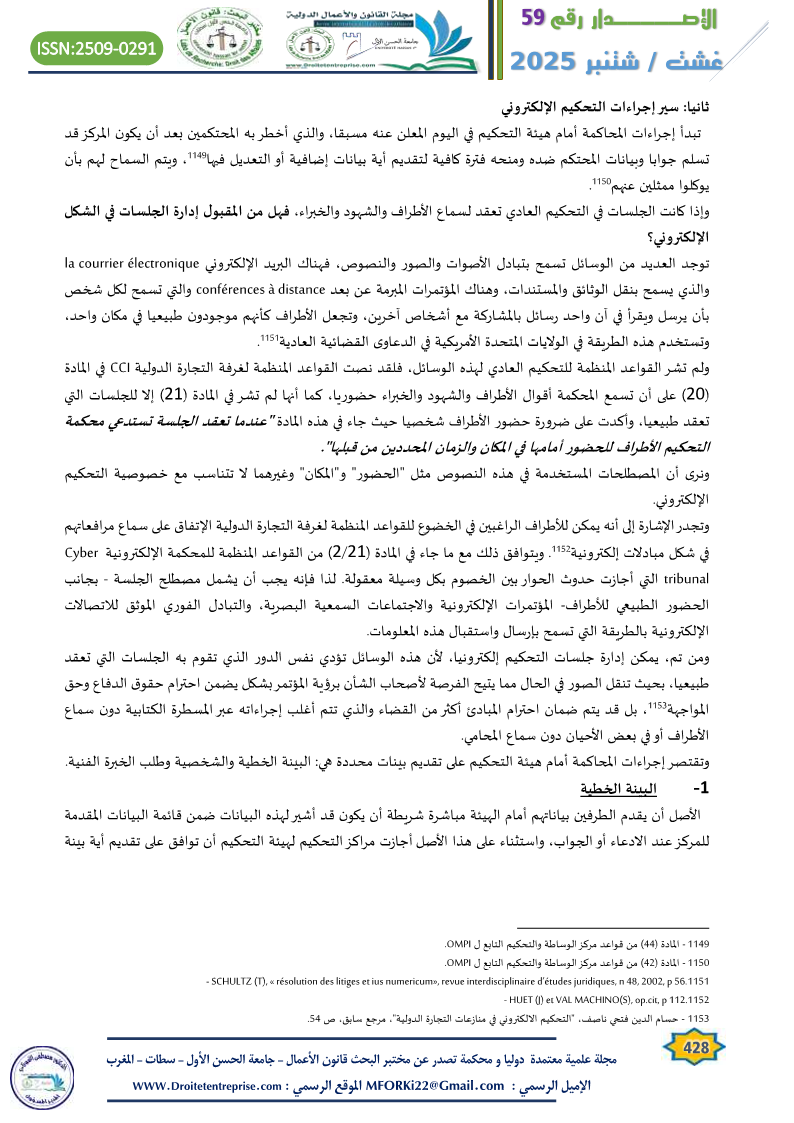
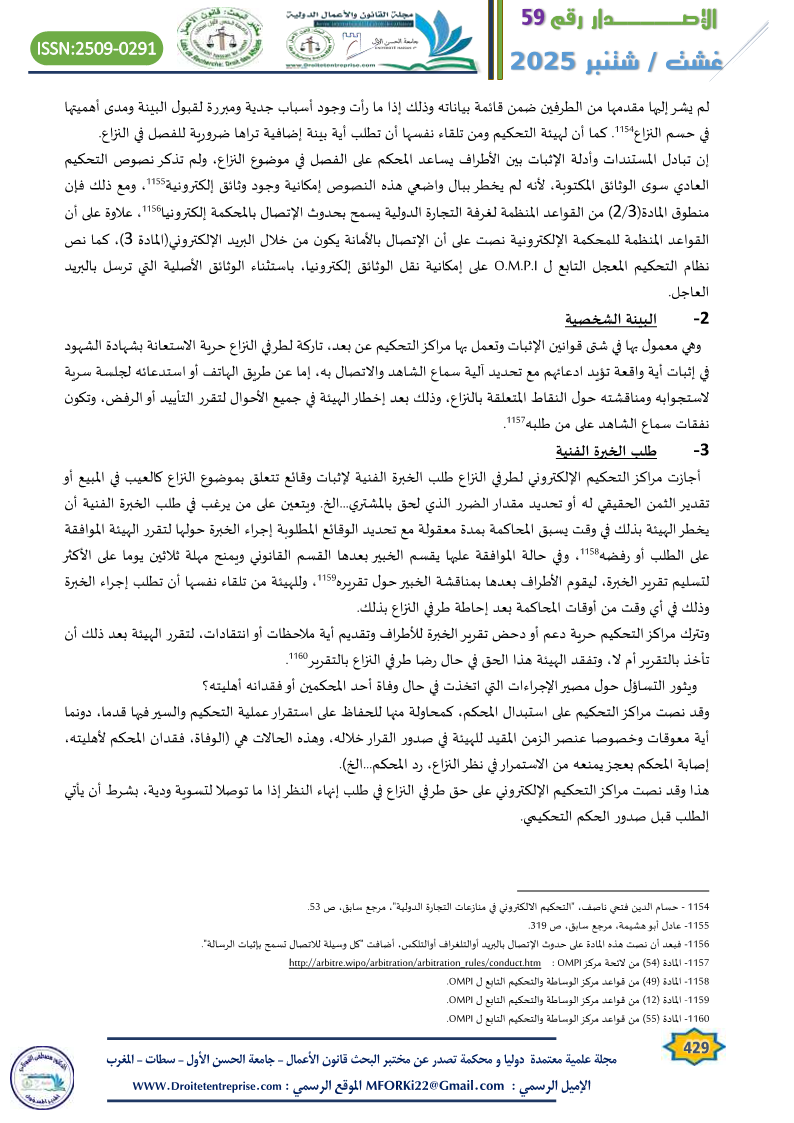
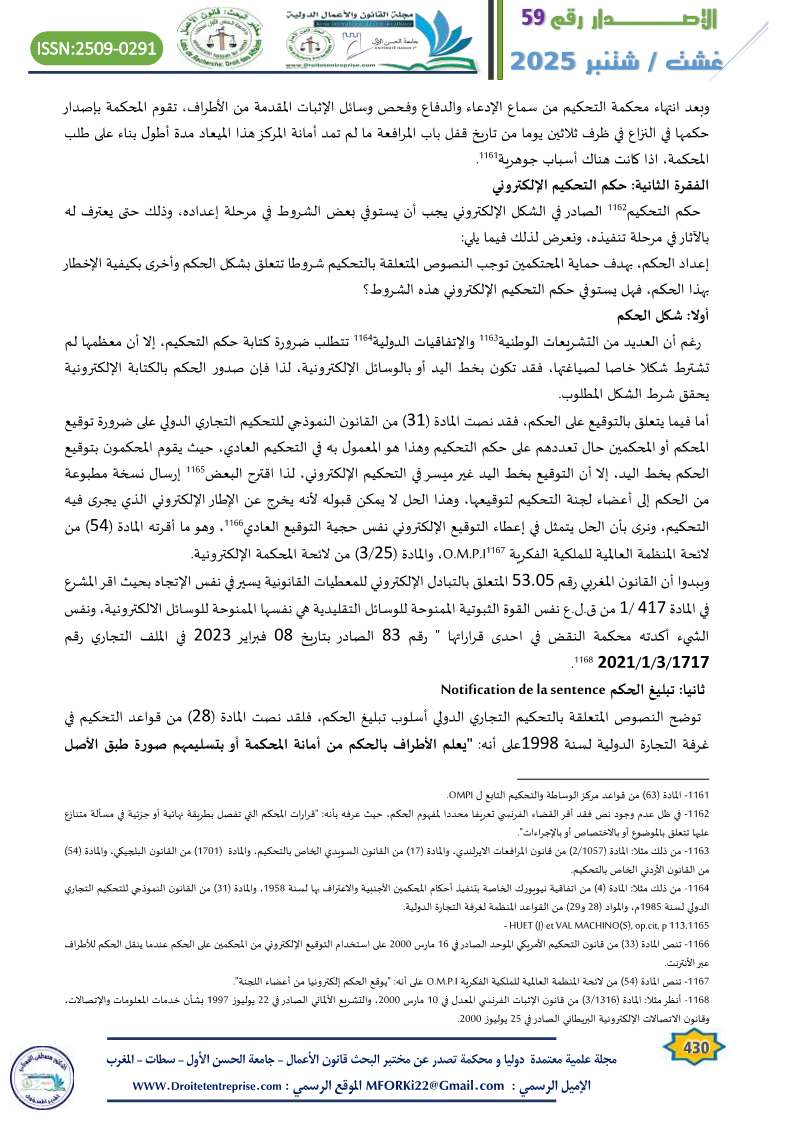
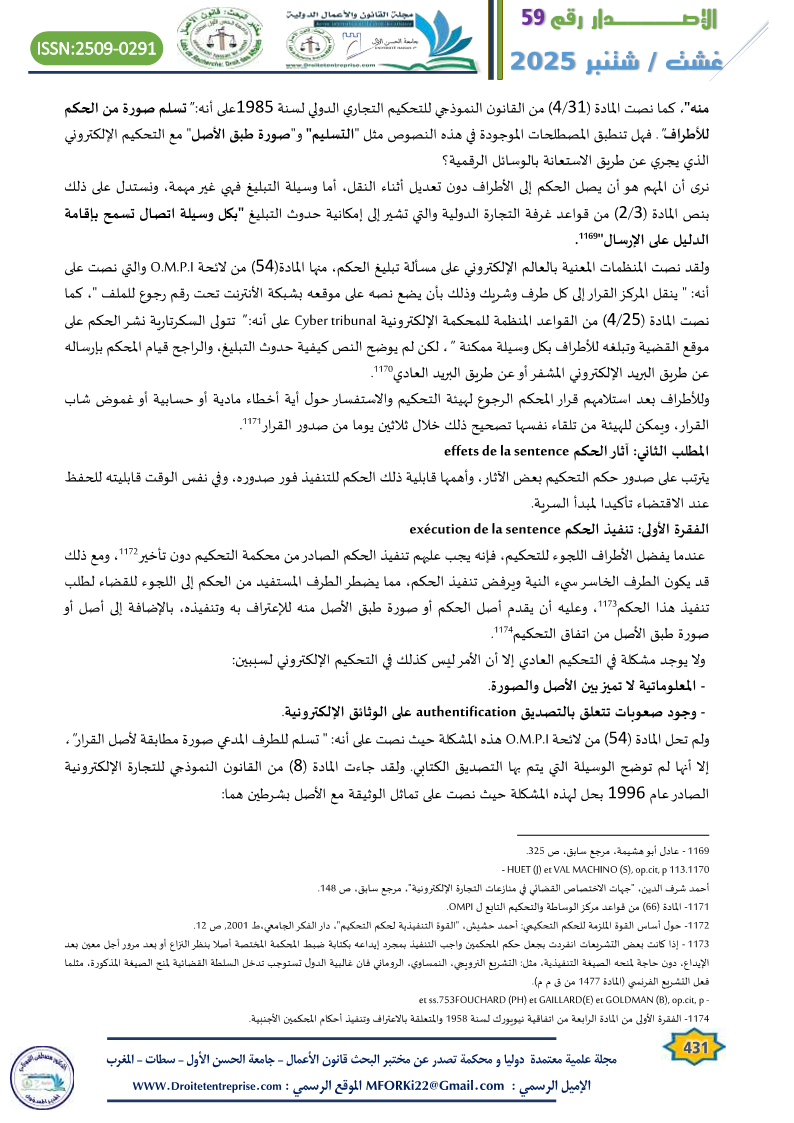
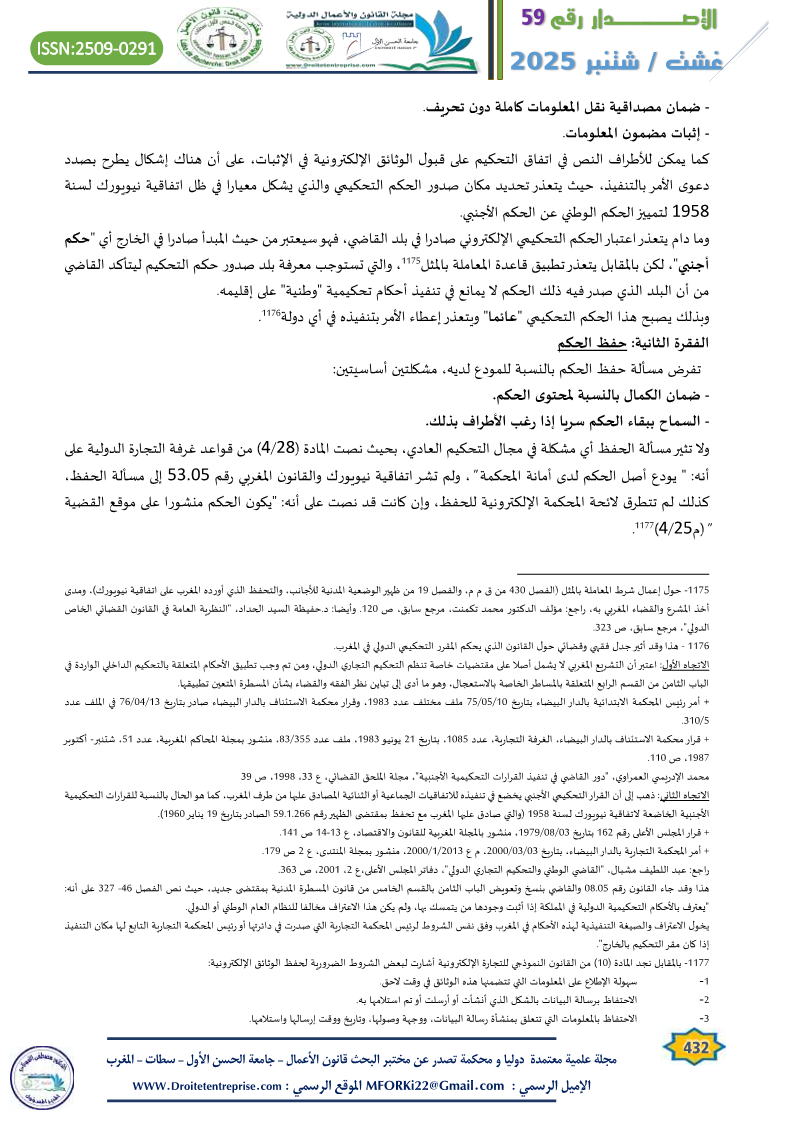
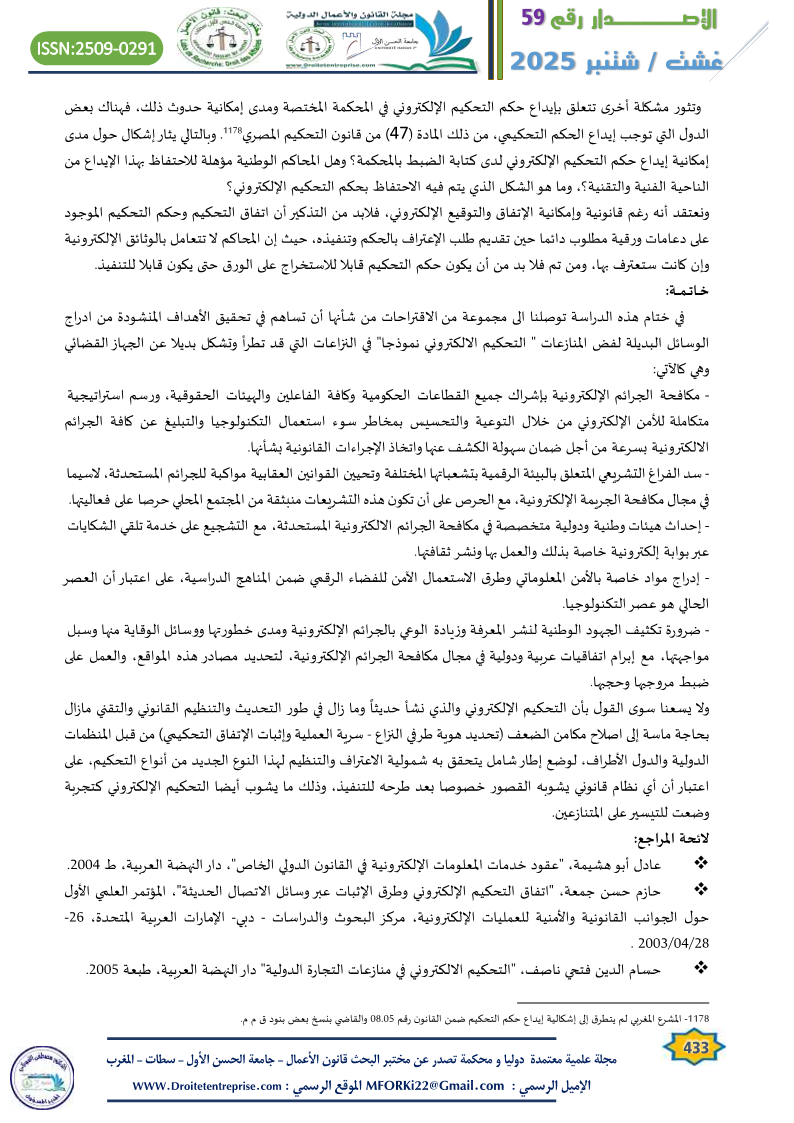
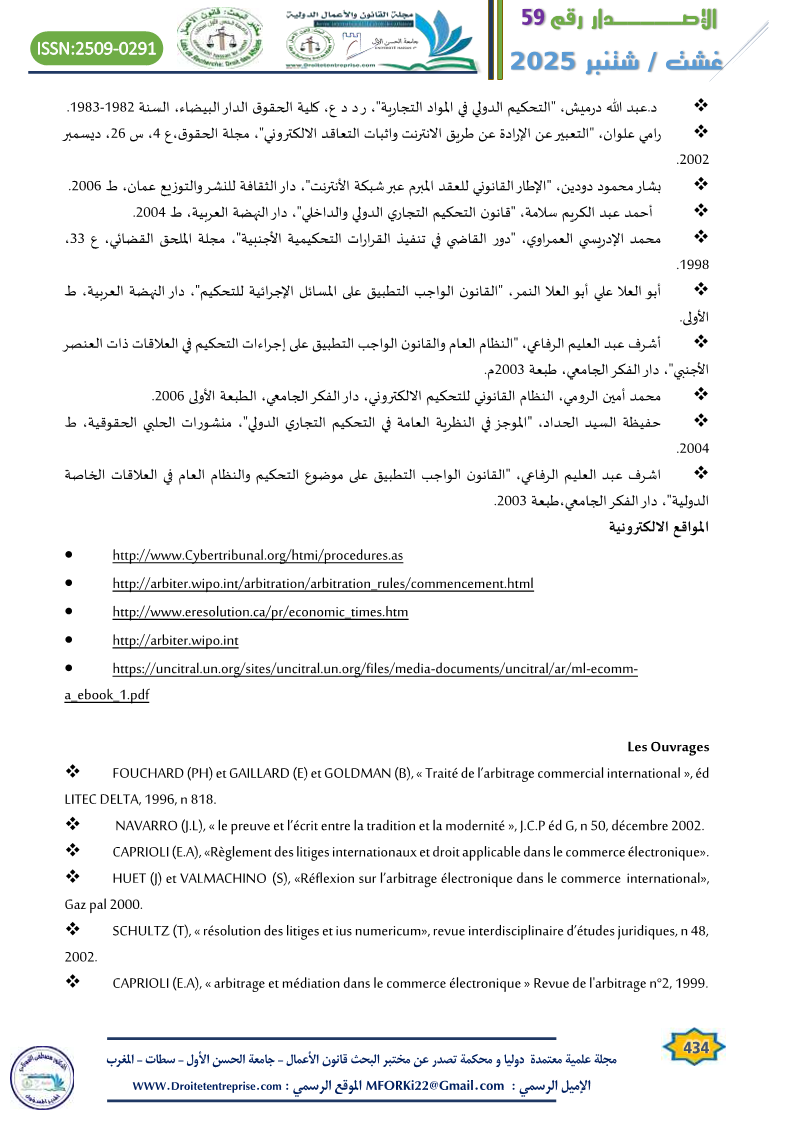
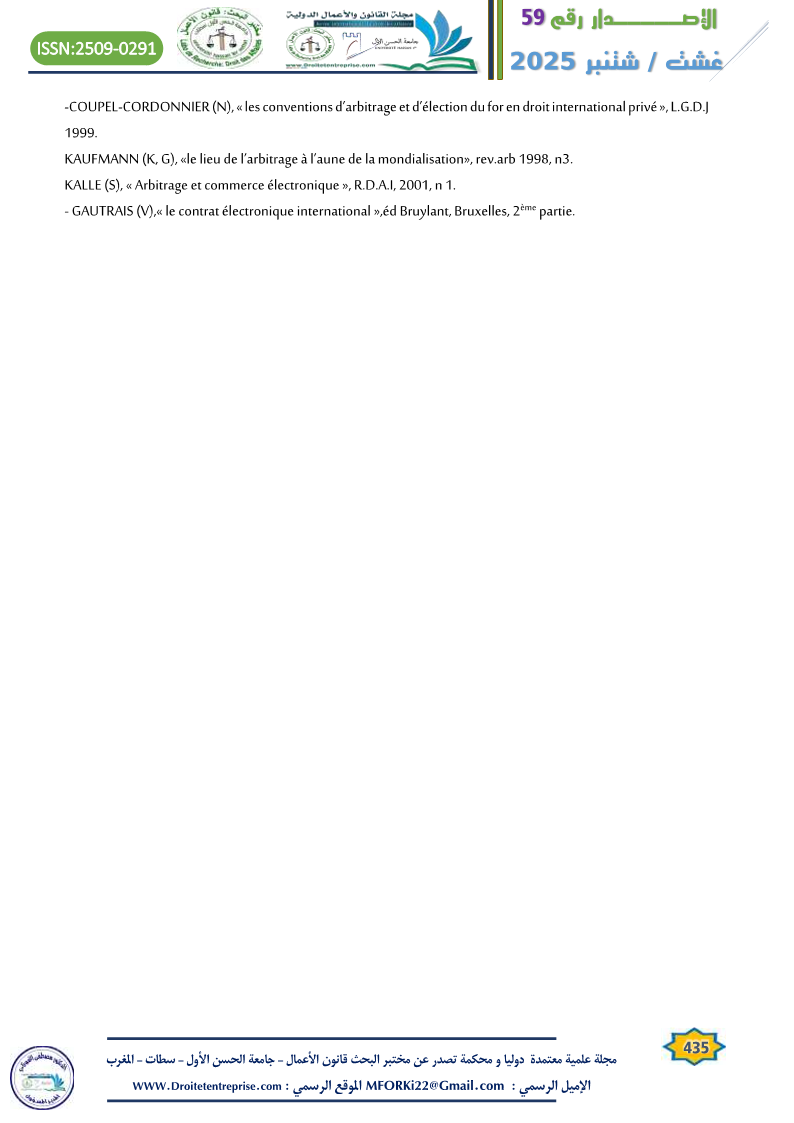
التحكيم الالكتروني كآلية لفض منازعات التجارة الالكترونية
Electronic arbitration as a mechanism for resolving e-commerce disputes
الدكتور : يوسف كبيطي
استاذ باحث بكلية الحقوق بالجديدة- جامعة شعيب الدكالي
ملخص:
مع ازدياد حجم المعاملات عن طريق الانترنت وبروز ما يسمى بالتجارة الالكترونية ازداد معها حجم النزاعات الناجمة عن ذلك، ولما يمثله اللجوء للقضاء من عبء كبير على المتعاقدين بواسطة شبكة الانترنت باعتبارها عقوداً مبرمة الكترونيا الى جانب إشكالية القانون الواجب التطبيق عند حدوث النزاع، والخشية من فقدان التجارة الالكترونية لموقعها البارز الذي احتلته في التبادل التجاري الدولي نشأت فكرة مراكز التحكيم الالكترونية لتواكب إيقاع التجارة الالكترونية الذي يحتاج إلى آلية متطورة لفض نزاعاته بالسرعة والدقة المنشودة ضمن قواعد معينة يرسمها كل مركز في تحديد مجرى العملية التحكيمية.
Abstract :
With the increase in the volume of transactions via the Internet and the emergence of what is called electronic commerce, the volume of disputes resulting from it has increased. Due to the fact that resorting to the judiciary represents a heavy burden on contracting parties via the Internet, given that they are contracts concluded electronically, in addition to the problem of the applicable law when a dispute arises, and the fear of electronic commerce losing its prominent position that it occupied in international trade exchange, the idea of electronic arbitration centers arose to keep pace with the pace of electronic commerce, which requires an advanced mechanism to resolve its disputes with the desired speed and accuracy within specific rules that each center sets in determining the course of the arbitration process.
تـــقــديـــــم:
يشهد العالم المعاصر ثورة شاملة في مجالات علمية مختلفة و متباينة ألا وهي الثورة المعلوماتية، مبنية على تطورات كمية ونوعية هائلة في مجال الحواسيب والهواتف الذكية ووسائل الاتصال الحديثة بصفة عامة، مست الحياة من كافة جوانبها منها الاجتماعية، والاقتصادية والثقافية والقانونية، إذ كشف هذا التقدم عن طرق مستحدثة لإبرام المعاملات والعقود باستخدام وسائل التبادل الإلكترونية، وأكثر هذه الوسائل أهمية نجد الشبكة العنكبوتية وما تحتويه من خفايا تتصل بطرق ابرام العقود وانعقادها وتنفيذها من قبيل البريد الإلكتروني، التلكس، المواقع الالكترونية المبرمجة، الايميل، الفاكسميل … .
وقد بدأ التبادل الإلكتروني للبيانات عن طريق المستندات الإلكترونية التي تحل محل المستندات الورقية العادية، واستطاع الأشخاص بفضل ذلك وعبر استخدام هذه الشبكة من إجراء العديد من المعاملات عن بعد دون وجودهم في مكان واحد عن طريق عقود أطلق عليها اسم العقود الإلكترونية (العقود المبرمة عن بعد) كونها تبرم عن طريق الاستعانة بالوسائل الإلكترونيّة، الشيء الذي أثر على مختلف مناحي الحياة التقليدية للتوجه نحو الرقمنة في مختلف الميادين، لم يسلم من هذا التغيير حتى الجانب القانوني والأكاديمي حيث أصبحنا نسمع بالحكومة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني، رقمنة المحاكم، وقد شمل أيضا هذا التحول نظرية العقد في ظل ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، التي ظهرت معها مجموعة من الإشكاليات الجديدة سواء على المستوى الاقتصادي أو القانوني بحيث أثرت على الأسواق العالمية، وأعطت معنى جديد للتنافسية حيث أصبحت تتعامل بأساليب حديثة في اكتساح هذا السوق العالمي، وألغت كل القيود أمام المعاملات التجارية.
فأصبحت لدينا القدرة على تسويق المنتجات بأي مكان في العالم داخل سوق مفتوح أمام العملاء، مع خفض قيمة التكاليف التي كانت تستهلكها التجارة التقليدية من إجراءات إدارية وتعقيدات مسطرية وتكاليف التوزيع والتجهيز والتسويق، بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ العمليات التجارية.
فكل هذه المميزات تجعلها من بين أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد العالمي ويتوقع أن يزداد دورها في القريب العاجل، مما جعل العديد من الدول تتنبه إلى عدم تماشي التشريعات الوطنية والقواعد التقليدية مع متطلبات المعاملات الحديثة والكشف عن مجموعة من المفاهيم التي تحتاج إلى إعادة النظر من وسائل دفع حديثة، إلى عروض السلع والخدمات الإلكترونية، والمحلات الافتراضية الإلكترونية فكانت الدول الغربية سباقة إلى سن قواعد جديدة لسد الفراغ التشريعي، من بينها الامم المتحدة التي عجلت بإصدار قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،ومع هذا التطور الكبير والمتسارع للتجارة الإلكترونية أثر ذلك على نظرية العقد كما أشرنا سابقا، فأسفر عنه ظهور العقد الإلكتروني ليواكب متطلبات القواعد القانونية الجديدة كوسيلة حديثة لإجراء المعاملات الإلكترونية.
وإذا كانت الطبيعة الخاصة لعقود التجارة الالكترونية تطرح عدة إشكالات منها مثلا ما يتعلق
بانعكاس البيئة الرقمية على حق المستهلك في الالتزام بالإعلام، الى جانب ضمان مبدأ السرية للمعلومات المتبادلة في إطار التجارة الالكترونية عبر الوسائط المعلوماتية وما قد ينتج عنها من نزاعات تطرح العديد من الإشكاليات على أرض الواقع، منها ما قد يتصل بتحديد موطن الاطراف محل انعقاد العقد وتنفيذه، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني وما يرتبط به من توقيع، الحجية في الاثبات، والقانون الواجب التطبيق والقضاء المختص لحل النزاع.
وهي إشكالات وضعت القضاء التقليدي على المحك وأثبتت قصوره على إيجاد الحلول المناسبة لمثل هذه النزاعات التي تتسم بالتعقيد وتعدد الاختصاصات وتضاربها في بعض الأحيان، مما يستدعى تبني وسائل بديلة لتسوية منازعات التجارة الالكترونية من قبيل المفاوضات – الوساطة – التوفيق والتحكيم نظرا لخصائصها -المبنية على مبدأ الرضائية- التي تضمن سرعة حل النزاع مع المحافظة على العلاقة بين الأطراف وسرية كل معاملاتهم التجارية، وهي ذات الوسائل التي استعملت أيضا لحل منازعات التجارة الدولية قبل ذلك، لكن مع ضرورة مواكبتها للتقدم التكنولوجي والبيئة الرقمية بشكلها الواسع من خلال الاستعانة بآليات التسوية الالكترونية”.
وما تجدر الإشارة اليه هو أن المشرع المغربي لم ينص صراحة على إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية للتعبير عن الإرادة عبر وسائل إلكترونية في قانون ق.ل.ع، حيث أن هذا القانون كان يخلو تماما من أي إشارة إلى إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية في مجال التعاقد، إلا أن سنة 2007 شكلت لحظة تاريخية في المنظومة القانونية المغربية من خلال إصدار القانون 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، اضافة الى سنه لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي عزز بموجبه الحماية القانونية اللازمة للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية وبالضبط فيما يتعلق بالعقود المبرمة عن بعد،الى جانب بعض النصوص القانونية المكرسة من قبل المشرع المغربي فيما يخص المجال المعلوماتي من قبيل القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون 07.03 المتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، دون أن ننسى القانونين 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني و 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، لذلك يتعين على كافة التشريعات مواكبة الركب الذي أفرزته التطورات التكنولوجية على شتى مناحي الحياة من أجل ضبط نطاق المعاملات الرقمية وجعلها مقيدة بضوابط النظام العام وغير مخالفة لأحكام الشريعة، وهذا يتطلب وعيا مجتمعيا بمدى خطورة التكنولوجيا اذا ما تم استغلالها بشكل سلبي لكونها سيف ذو حدين، والتصدي لهذه الظاهرة يتوقف على إرادة قوية من قبل كافة الفاعلين والهيئات والمؤسسات عن طريق خلق شراكة قوامها الحوار والنقاش حول الاثار الذي تخلفها التكنولوجيا في جانبها السلبي، مع الخروج بمجموعة من المقترحات التي ينبغي أن تلقى ترحيبا من قبل الهيئة التشريعية بعد دراستها والوقوف عليها اعتمادا على دراسات وبحوث علمية رصينة.
وبناء على ما سبق يمكننا طرح الإشكالية التالية: حدود فعالية التحكيم الالكتروني الاحاطة بالإشكالات التي تطرحها العقود المبرمة الكترونيا بشكل عام وعقود التجارة الالكترونية على وجه الخصوص؟ وهذا ما سنحاول الاجابة عليه في هذا الموضوع بحيث سنعمل على تقسيمه الى مبحثين نتناول في المبحث الأول الإطار المفاهيمي والتنظيمي للتحكيم الالكتروني، فيما سنخصص المبحث الثاني للإطار الاجرائي للتحكيم الالكتروني.
اعتمدت كثير من الدول التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات، وقد تم تنظيمه بقوانين وطنية واتفاقيات دولية، ومعظم تلك الوثائق والنصوص القانونية المتناثرة لم ينتبه واضعوها أنه سيأتي يوم يذهب فيه المتخاصمان إلى أبعد من التحكيم العادي ليأخذوا بأسباب التطور، فيستخدموا الوسائل الإلكترونية في إبرام اتفاق التحكيم وسير إجراءاته، فهل تتسع القواعد القانونية القائمة لهذه الصيغة من التحكيم؟
للتحكيم الإلكتروني arbitrage électronique معنيين:
الأول: اتفاق الكتروني على إجراء التحكيم، سواء فيما بين الأطراف أنفسهم، أو فيما بينهم وبين المركز التحكيمي الإلكتروني.
الثاني: أن تتم إجراءات التحكيم عبر الوسائل الإلكترونية، كانعقاد الجلسات عن طريق الانترنت بواسطة تبادل الرسائل اإلكترونيا، واستخدام الوسائل المرئية السمعية، وإصدار القرار التحكيمي اإلكترونيا كذلك، وهذا ما سنحاول تناوله في هذا المبحث.
المطلب الأول: إبرام اتفاق التحكيم الإلكتروني
يجب للاعتراف بصحة اتفاق التحكيم الإلكتروني في ضوء النصوص القانونية المؤطرة للتحكيم، أن يتوافق هذا الإتفاق مع القواعد السارية المتعلقة بشكل الإتفاق، وكذلك مع تلك القواعد المتعلقة بأهلية الأطراف.
الفقرة الأولى: اتفاق التحكيم الإلكتروني والشروط الشكلية المتعلقة بصحة الإتفاق
مفهوم اتفاق التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن اتفاق التحكيم التقليدي، فالاتفاق إما أن يكون متعلقا بنزاع قائم (عقد التحكيم) أو بالإتفاق في العقد (شرط التحكيم) على إحالة أي نزاع مستقبلي للتحكيم.
وقد أثير جدل حول مشروعية اتفاق التحكيم المبرم إلكترونيا، لاسيما وأن القوانين الاتفاقية والوطنية، لم تتفق على ضرورة تبني نظام موحد فيما يتعلق بكتابة اتفاق التحكيم، لذلك هل تعد الكتابة ركنا من أركان اتفاق التحكيم أم مجرد وسيلة لإثباته؟ وهل يعد اتفاق التحكيم المبرم إلكترونيا اتفاقا مكتوبا؟
- بالنسبة للتساؤل الأول، فقد اختلفت الآراء بشأن الإجابة عنه، حيث ذهب البعض إلى أن واضعي هذه النصوص استلزموا كتابة اتفاق التحكيم على اعتبار أن هذه الكتابة تعد ركنا أساسيا لقيام الإتفاق على التحكيم، يلزم وجودها للحديث عن وجود اتفاق التحكيم.
بالمقابل يرى البعض أن التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية استلزمت الكتابة ليس باعتبارها ركنا لصحة اتفاق التحكيم بل باعتبارها وسيلة لإثبات مضمون الإتفاق.
- أما بالنسبة للتساؤل الثاني، فنرى أنه لا يوجد ما يمنع من قبول اتفاق التحكيم بالوسائل الإلكترونية، حيث يمكن للأطراف الإتفاق على اللجوء للتحكيم من خلال تبادل رسائل البيانات لأن مشرعي الدول وواضعي الاتفاقيات الدولية الذين استلزموا الكتابة لم يشترطوا شكلا خاصا لصياغتها أو طريقة لتدوينها، فقد تكون هذه الكتابة خطية أو مطبوعة أو بأي وسيلة من وسائل الإتصال، لذلك لا يوجد ما يمنع من أن تكون الكتابة محررة على دعامة إلكترونية طالما تحقق نفس الهدف()، فالمهم أن يتم حفظ البيانات المتداولة إلكترونيا بحيث يمكن الاحتفاظ بها والرجوع إليها عند النزاع دون أن يطرأ عليها أي تعديل أو تحريف.
وما يدعم وجهة نظرنا أن العديد من الإتفاقيات الدوليةوالتشريعات الغربية أخذت بالمفهوم الواسع للكتابة، كما أقر هذا المفهوم العديد من الأحكام القضائية،بل إن لائحة المحكمة الإلكترونية أقرت صحة شرط التحكيم، شريطة أن تكون المستندات المعلوماتية المودعة من جانب الأطراف تقدم ضمانات جدية وكافية حتى يمكن الإعتماد عليها.
ويستلزم قبول شرط التحكيم الإلكتروني المندمج في الشروط العامة سهولة وصول المستخدم إليه، حيث رفضت محكمة النقض الفرنسية أن ترتب أي أثر لشرط التحكيم إذا لم يستطع المستخدم الوصول إليه، وهذا الشرط أساسي في البيئة الإلكترونية، لذلك توجد العديد من الضوابط التي يمكن من خلالها معرفة هل جعل المهني الوصول لهذا الشرط سهلا أم لم يتخذ من الوسائل ما يساعد المستخدم على الوصول إليه.
ولا شك أن اختلاف القوانين الوطنية في مسألة مدى تحقق شرط الكتابة في الرسائل الإلكترونية من شأنه أن يثير العديد من الصعوبات في حالة طلب تنفيذ حكم التحكيم في بلد لا يأخذ بالتفسير الواسع لشرط الكتابة، وتشير وثائق الأونسترال إلى أن بعض المحاكم الوطنية التي تأخذ بالتفسير الضيق لشرط كتابة اتفاق التحكيم، تذهب إلى أن مقتضى الشرط لا يتحقق إلا في عدة حالات هي توقيع الطرفين على الوثيقة الكتابية وتبادل الرسائل بين الطرفين أي الرد على رسالة برسالة كتابية أخرى.
ونعتقد أنه لن تثار إشكالية في المغرب مستقبلا بخصوص حجية اتفاق التحكيم الإلكتروني، حيث نجد المادة (3) من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، أخذت بالمفهوم الواسع لاتفاق التحكيم، وجاء فيها: “يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وهو ما يدل على اعتراف المشرع المغربي بمشروعية استخدام وسائل الاتصال الحديثة- كالبريد الإلكتروني – في إبرام اتفاق التحكيم، وهي مرونة مقصودة من المشرع الغاية منها فسح المجال أمام إمكانية إثبات اتفاق التحكيم بكل وسيلة يمكن الوثوق بها والركون إليها ما دامت تترك أثرا كتابيا يمكن الرجوع إليه والتأكد من محتواه ومن نسبته إلى شخص معين دون آخر.
وهو ما يتوافق أيضا مع مقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي أقر مبدأ المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، واعترف بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، وحدد الإطار القانوني المطبق على العمليات المنجزة من قبل مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية.
الفقرة الثانية: اتفاق التحكيم الإلكتروني والشروط الموضوعية المتعلقة بصحتة
اتفاق التحكيم عقد تنشأ عنه التزامات على طرفيه، لذلك وجب أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية اللازمة لصحته، وهذه الشروط يجب ألا تختلف سواء كنا أمام تحكيم تقليدي أو تحكيم إلكتروني، وهي الرضا والمحل والأهلية والسبب.
ولا يثير المحل والسبب أية صعوبة خاصة في التحكيم الإلكتروني l’arbitrage en ligne على خلاف رضا الأطراف الذي يثير صعوبات عديدة سواء بالنسبة لوجوده أو بالنسبة لإثباته، ذلك أن عدم مادية dématérialisation الإتفاق تجعل من الصعب اقتضاء رضا واضح.
فمما لا شك فيه أن اتفاق الأطراف على التحكيم يرتبط بتنازلهم نهائيا عن الرجوع إلى القضاء الوطني بشأن موضوع النزاع المتفق على حله بالتحكيم، كما أن النصوص المتعلقة بالتحكيم تتطلب أن يكون الإتفاق موقعا signée، وتوقيع الأطراف مطلوب لأغراض حمائية باعتبار أن من وظائف التوقيع بيان إرادة حقيقية في الارتباط بمضمون التصرف.
بالمقابل فإن الضغط على الأيقونة بالموافقة accepter أو التوقيع الإلكتروني لا يعطي صورة واضحة عن الإرادة، وذلك على عكس التوقيع اليدوي الذي يفيد بأن الموقع قرأ بدقة كل بنود الإتفاق قبل أن يضع عليه بصمته، والأمر على خلاف ذلك بالنسبة لمن يوافق على اتفاق في الشكل الإلكتروني حيث تكون الشروط غالبا ممزوجة في تفاصيل الاتفاق، وتتصاعد المخاطر عندما يكون هناك اتفاق تحكيم مدرجا بإحالة إلى وثيقة إلكترونية، أي عندما يتعين على الأطراف الرجوع إلى عقود نموذجية contrats-types أو اتفاق إطار يتضمن شرط التحكيم.
وذلك باعتبار أن صحة الشروط التحكيمية بالإحالة كانت محلا لتردد تشريعي وقضائي، ولا شك أنه يصعب القول بنفس المنطق في مجال التحكيم الإلكتروني، لأن إثبات اتفاق التحكيم بالإحالة سيكون صعبا.
ومع ذلك فيمكن التغلب على تلك الصعوبات بأن يتفق الأطراف على تأكيد القبول بالضغطة الثانية الدالة على الموافقة أو بأي إجراء آخر، مثل إرسال بريد إلكتروني courrier électronique مع تطلب إفادة بالاستلامaccusé de réception عند الاقتضاء، فكل ذلك يمكن أن يكشف عن وجود الرضا.
ولا شك أن مسألة حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية تستلزم أن نكون أكثر تشددا في تقدير صحة الرضا باتفاق التحكيم عندما يكون الموقع مستهلكا، لاسيما إذا تعلق الأمر باتفاق تحكيم بالإحالة arbitrage par référence.
المطلب الثاني: مضمون اتفاق التحكيم الإلكتروني
تنص العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم على حرية الأطراف في اختيار المسائل المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، بيد أن مسألتين منهما تكون من الأهمية بمكان، بحيث يمكن أن تؤثر على الإجراء التحكيمي، أولهما مسألة تحديد قواعد القانون الواجب التطبيق، والثانية تتعلق بتشكيل المحكمة التحكيمية.
الفقرة الأولى: القانون الواجب التطبيق في التحكيم الإلكتروني
مع مراعاة القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، يمكن للأطراف تحديد القانون الذي يحكم ما يثور بينهم من منازعات، فيمكنهم تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم، كما يمكنهم تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم.
1- القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم
إن اختيار الأطراف للقانون الذي يحكم سير إجراءات المنازعة أمر مهم، لما له من أثر في تحديد أنظمة الإثبات وتحديد الوسائل الفنية التي تضمن احترام مبادئ المواجهة والدفاع والقواعد المتعلقة بالاجتماعات الإلكترونية. وهناك حرية كاملة للأطراف في اختيار القواعد التي تنظم إجراءات المنازعة، سواء بوضع هذه القواعد في اتفاق التحكيم أم بالإحالة لقانون معين لتنظيم هذه الإجراءات.
ولا توجد مشكلة في حالة اتفاق الأطراف على الخضوع لإجراءات التحكيم الإلكتروني كما هو موجود في نظام المحاكم الافتراضية (مثلا نظام تحكيم المحكمة الإلكترونية)، ولكن تكمن المشكلة في حالة اتفاق الأطراف على الخضوع لإجراءات التحكيم التقليدية (مثلا نظام غرفة التجارة الدولية C.C.I أو للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985 أو غيرهما)، لأنه لا يتصور أن تواجه هذه القواعد خصوصيات العالم الإفتراضي المتعلقة بكيفية اتصال الأطراف بمحكمة التحكيم الإلكترونية وطرق تقديم الوثائق، وإن كان يمكن للأطراف التغلب على هذه الصعوبة بإبرام اتفاق تكميلي لتنظيم المسائل الفنية التي تواجههم.
وتجدر الإشارة إلى أن عدم اتباع الإجراءات التي اختارها الأطراف لتنظيم سير المنازعة أو عدم اتباع الإجراءات المضمنة في قانون مقر محكمة التحكيم، يعوق تنفيذ الحكم.
وعليه، من الضروري تحديد مكان التحكيم الإلكتروني، لكن الملاحظ أن أنظمة التحكيم الإلكتروني لم تشر إلى هذا المكان، كما أن محتويات هذه المادة لا تتفق وطبيعة التحكيم الإلكتروني، لأن أغلب المراكز الإلكترونية لا ترتبط بإقليم دولة معينة.
وهناك العديد من الطرق التي تساعد على تحديد هذا المكان، ومنها مكان وجود المحكم، إلا أنه معيار غير كاف حتى في التحكيم العادي، فهل يجب الإعتداد بمكان وجود المحكم في بداية الإجراء، أو الإعتداد بقانون موطنه أو محل إقامته، فضلا عن تعقد المشكلة حال تعدد المحكمين، كما أنه لا يمكن الإعتماد على مكان التركيز الجغرافي لمقدم الخدمة، لأنه قد يتعدد مقدمو الخدمات ويقع كل منهم في دولة مختلفة، ومن الخطأ أن نؤسس قواعد قانونية على متغيرات إلكترونية.
كما لا يمكن الأخذ بالحل الذي يفضل نظرية التحكيم غير التوطيني délocalisé التي توجب الإعتراف لهذا التحكيم بالطابع غير التوطيني وغير الوطني dénationalisé وهو ما يعني عدم إسناد هذا النوع من التحكيم إلى قانون مكان التحكيم، ويصعب قبول ذلك الحل بالنسبة إلى المحاكم الوطنية ولا يتوافق مع أحكام اتفاقية نيويورك.
لذلك يبدوا أن الحل الأقرب إلى الإقناع هو ترك الحرية الكاملة للأطراف والمحكمين في تحديد مكان افتراضي للتحكيم، لأن ذلك يتفق من جهة مع عدم وجود مقر مادي لبعض مراكز التسوية الإلكترونية،ويتوافق من جهة أخرى مع المادة (14/1) من لائحة غرفة التجارة الدولية،ونص المادة (20/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
2- القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم
يتمتع شرط التحكيم الوارد في العقد التجاري الدولي باستقلالية كاملة عن العقد الأصلي، وهو شيء معترف به ويعتبر من الأساسيات في فلسفة التحكيم التجاري الدولي فقها و قضاءا، سواء كان شرط التحكيم بندا في العقد أم اتفاق مستقل، وتتيح هذه الاستقلالية لأطراف العقد حرية كاملة في اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفي حالة غياب الإرادة الصريحة أو الضمنية للأطراف يطبق المحكم قواعد القانون التي يرى أنها ملائمة أو التي ترتبط بالنزاع برابطة وثيقة، مع ضرورة عدم تعارض ذلك الاختيار مع القوانين والنصوص المتعلقة بالنظام العام.
في نفس الاتجاه، نصت المادة (15/1) من نظام المحكمة الإلكترونية على حق الأطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، وفي حالة عدم الاختيار يختار المحكم، القانون الوطني الذي يرتبط بالنزاع برابطة وثيقة، ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة أن تهتم محكمة التحكيم بالعقد وبالأعراف الجارية في العالم الإفتراضي.
كذلك شدد نظام المحكمة الإلكترونية مع أنه لم يذكر مصطلح النظام العام على ضرورة احترام المحكم للمبادئ العامة للتحكيم principes généraux de l’arbitrage ومنها مبدأ المواجهة بين الأطراف contradictoire، ومبدأ المساواة égalité بين الخصوم، ومبدأ السرية confidentialité، وكافة حقوق الدفاع.
ويتضح من ذلك أن التحكيم الإلكتروني لا يختلف عن التحكيم العادي فيما يتعلق بالقانون المطبق على موضوع النزاع، فيمكن للأطراف اختيار هذا القانون، كما يمكن للمحكم القيام بهذا الاختيار في حالة عدم وجود اتفاق، شريطة ألا يتعارض ذلك مع قواعد النظام العام.
الفقرة الثانية: هيئة التحكيم الإلكتروني
يعد اختيار المحكمين من الأمور المهمة في عملية التحكيم، حيث يوضع الأمر بعد هذا الاختيار في يد المحكم أو المحكمين المختارين، ويمكن للأطراف تعيين المحكمين سواء بالنص على تعيينهم في اتفاق التحكيم مباشرة أم بالإشارة إلى نظام تحكيم مؤسسي كغرفة التجارة الدولية بباريس أو نظام المراكز الإلكترونية.
وجرى العمل على أن يقوم كل طرف باختيار محكم ويقوم المحكمين المختارين باختيار الثالث، وقد يتم هذا الاختيار في اتفاق التحكيم أو بعد نشوء النزاع. وعندما يتفق الأطراف على اللجوء إلى نظام تحكيم مؤسسي فإن حريتهم تكون مقيدة في اختيار المحكم، حيث تنص المادة (8) من لائحة تحكيم المحكمة الإلكترونية Cyber tribunal على أنه: “محكمة التحكيم يتم تشكيلها بتسمية محكم وحيد أو ثلاث محكمين، واختيار المحكمين وتحديد عددهم تتولاه السكرتارية“. بمعنى أنه حيث يحيل الأطراف إلى القواعد المنظمة للمراكز الإلكترونية فإن أمانة المركز هي التي تتولى تعيين أعضاء المحكمة.
وعلى خلاف ذلك تأتي المادة (8/3) من القواعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية بباريس، والتي تعطي للأفراد الحرية في اختيار المحكمين ولا تعطي لمؤسسة التحكيم حق التدخل في تعيين المحكمين إلا في حالة عدم الاتفاق (8/4)، وفي نفس الاتجاه تذهب المادة (10/1) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.
ومما لا شك فيه أن ثمة صعوبات يمكن أن تثور عندما يكون حياد المحكم أو استقلاليته محل شك، ويتعين والحال ما ذكر، اتباع إجراء معين غالبا ما ينص عليه في لائحة هيئة التحكيم. ومن ذلك ما تقرره لائحة غرفة التجارة الدولية بطريقة وقائية في المادة (7/2) من أن المحكم قبل تسميته أو مصادقته يوقع تصريحا باستقلاله ويبلغ السكرتارية كتابة بالوقائع أو الظروف التي يمكن أن تؤثر على استقلاله في نظر الأطراف.
ولا شك أن هذا الإجراء يصعب إقراره بشأن التحكيم الإلكتروني في الحدود التي يقضي فيها مثل هذا النوع من التحكيم من كتابة التصريح وتوقيعه.
على أن طلب الرد يمكن أن يتم بإخطار يرسل إإلكترونيا عبر الأنترنت، وهو ما تقرره المادة 23 من نظام التحكيم التابع ل O.M.P.I، والمادة 20 من لائحة Cyber tribunal.
ويجوز الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم ولكن يجب أن يثار الدفع في ميعاد لا يتأخر عن وقت قيد بيان الدفاع، ويكون للمحكمة سلطة الفصل في اختصاصها كمسألة أولية، أو أن ترجأ الفصل في الدفع إلى وقت الفصل في موضوع النزاع، ويكون لها كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية فيما يتعلق بموضوع النزاع.
وعلى أي حال فإنه يتعين على المحتكمين مراعاة مسألة اختصاص المحكم، ذلك لأنهم أصحاب المصلحة في حسم نزاعهم من خلال محكم خبير بإدارة التجارة الإلكترونية.
باعتبار أن الإجراء التحكيمي يمر بمرحلتين، مرحلة نشوء النزاع وبدء الخصومة، ومرحلة إصدار حكم في النزاع، وهذا ما سنحاول معالجته في هذا المبحث.
المطلب الأول: إجراءات التحكيم الإلكتروني
نظرا لأهمية تنظيم عملية التحكيم دأبت مراكز التحكيم عن بعد، على تنظيم سير العملية بما يتوافق مع طبيعة الأنترنت وما تتطلبه من إجراءات خاصة يجب مراعاتها وإلا كان الفشل مصير هذه الإجراءات، لذلك فقد اتبعت مراكز التحكيم سلسلة من الإجراءات تبدأ منذ إحالة النزاع للمركز لحين صدور الحكم وسوف نستعرض لتلك الإجراءات على الشكل الآتي:
الفقرة الأولى: بدء إجراءات التحكيم الإلكتروني والسير فيها
أولا: بدء إجراءات التحكيم الإلكتروني
نوجز فيما يلي أهم الإجراءات المتخذة لعرض النزاع على مركز للتحكيم الإلكتروني:
- التوجه إلى موقع التحكيم المعين على شبكة الأنترنت والنقر بعد ذلك على مفتاح إحالة النزاع فيظهر على الشاشة نموذج formulaire طلب التحكيم المعد سلفا من قبل المركز، ويجب أن يتضمن طلب التحكيم la demande d’arbitrage عدة بيانات تتمثل فيما يلي:
- أسماء الأطراف بالكامل وعناوينهم البريدية والإلكترونية وطبيعة أعمالهم وتحديد وسيلة الاتصال بهم (هاتف- فاكس- بريد إلكتروني).
- وصف لطبيعة وظروف النزاع وأية حلول يراها مناسبة لحله.
- تحديد عدد المحكمين (5-3-1) وعند إغفال ذلك يعتبر قد اختار محكما وحيدا.
- اختيار الإجراءات المتبعة خلال نظر النزاع، وبإغفال ذلك سيعد راضيا وموافقا على الإجراءات التي اعتمدها المحكم.
- إرفاق نسخة من اتفاق التحكيم للمركز.
- إعداد قائمة بالأدلة والبيانات المستند إليهما في الادعاء وارفاقهما مع طلب التحكيم.
2- يتعين بعد ذلك أن يوجه المدعي إلى أمانة المركز طلب التحكيم وتقوم الأمانة خلال خمسة أيام من تاريخ تلقي الطلب بتحديد مدى دخول هذا الطلب في اختصاصها من عدمه. وإذا رأت الأمانة أن الوساطة هي أنسب الطرق للتسوية، فإنها تدعوا أطراف النزاع إلى اللجوء إليها أولا، ويجب على الأمانة أن تفتح ملفا للدعوى تضعه على موقع خاص بها ولا يسمح بالدخول إليه إلا عن طريق استخدام رقم سري.
3 – أداء الرسوم الإدارية المحددة وفق جدول الرسوم.
4 – يبدأ تاريخ نظر النزاع باستلام المركز لطلب التحكيم، ليقوم عند ذلك المركز بإخطار المحتكم ضده بالادعاء. وهنا نرى اختلافا واضحا في ميعاد بدء الإجراءات بين التحكيم الإلكتروني والتحكيم العادي، فأغلب قوانين التحكيم نصت على بدء إجراءات التحكيم منذ إعلام المحتكم ضده ضمانا لحقوق الدفاع وحق الخصم في العلم بإجراءات التحكيم، خصوصا أن الإخلال بحقوق الدفاع هو من الأمور الإجرائية التي يمكن الاستناد إليها لقبول دعوى بطلان حكم التحكيم.
5- وبقيام المركز بإعلام المحتكم ضده بطلب التحكيم يمنح مهلة لإرسال جواب للمركز، والذي يجب أن يتضمن دفوعه واعتراضاته على الادعاء وقائمة بالبيانات المؤيدة لادعائه، بالإضافة لتحديد عدد وأسماء المحكمين، وفي حالة اختيار المحتكم محكما فردا للنظر في النزاع وعارض المحتكم ضده هذا الاختيار خلال مدة خمسة عشر يوما من بدء التحكيم فعليه أداء الرسوم عن ثلاثة محكمين وإرسال قائمة بأسماء ثلاثة محكمين ليكون أحدهم في هيئة التحكيم.
6 – يقوم المركز بتعيين الهيئة إذا ما تجاهل المحتكم ضده طلب التحكيم ولم يقدم جوابا خلال المدة المحددة له، مع إخطاره بضرورة تقديم الجواب.
7 – إذا وجد المركز نقصا ببيانات المحتكم ضده بالجواب فعلى المركز إخطاره بذلك خلال أسبوع من استلام الجواب ومنحه مهلة يومين لإكمال النقص.
8 – أعطت مراكز التحكيم لطرفي النزاع الحق في تنحية المحكم الذي اختاره الطرف الآخر أو الذي اختاره المركز، أو حتى إذا كان هو من اختاره، في حالة وجود شكوك جدية تثور حول حياد ونزاهة المحكم، وذلك بإخطار يقدم للمركز خلال مدة معينة حددتها بعض المراكز بعشرة أيام تبتدئ من تاريخ ظهور السبب إن كان هو من اختاره ومن تاريخ الإخطار إن لم يقم باختياره، ليقرر المركز بعدها تنحية المحكم أو صلاحيته للنظر في النزاع خلال خمسة عشر يوما من تقديم الطلب.
9 – يمكن للمحتكم ضده أن يرفق مع جوابه ادعاء مقابلا خلال إجراءات النظر في النزاع مع دفع الرسوم الإدارية المقررة لادعائه المقابل وتزويد المحتكم بنسخة منه مرفقا بالبيانات والدفوع لتحكم الهيئة بالحكم في الادعاءين معا، وللمحتكم ضده أن يطلب في هذه الحالة إجراء مقاصة.
10- يعين المركز موعد المحاكمة باستكمال بيانات طرفي النزاع.
11 – تكون جلسات المحاكمة سرية وسريعة بحيث يمكن ألا تتجاوز ثلاثة أيام في حال طلب سماع الشهود أو طلب الخبرة الفنية أو تقديم أية بينة سبق أن أشار إليها المحتكم ضمن قائمة بياناته وإخطار المركز أنه سيقدمها وقت المحاكمة.
ثانيا: سير إجراءات التحكيم الإلكتروني
تبدأ إجراءات المحاكمة أمام هيئة التحكيم في اليوم المعلن عنه مسبقا، والذي أخطر به المحتكمين بعد أن يكون المركز قد تسلم جوابا وبيانات المحتكم ضده ومنحه فترة كافية لتقديم أية بيانات إضافية أو التعديل فيها، ويتم السماح لهم بأن يوكلوا ممثلين عنهم.
وإذا كانت الجلسات في التحكيم العادي تعقد لسماع الأطراف والشهود والخبراء، فهل من المقبول إدارة الجلسات في الشكل الإلكتروني؟
توجد العديد من الوسائل تسمح بتبادل الأصوات والصور والنصوص، فهناك البريد الإلكتروني la courrier électronique والذي يسمح بنقل الوثائق والمستندات، وهناك المؤتمرات المبرمة عن بعد conférences à distance والتي تسمح لكل شخص بأن يرسل ويقرأ في آن واحد رسائل بالمشاركة مع أشخاص آخرين، وتجعل الأطراف كأنهم موجودون طبيعيا في مكان واحد، وتستخدم هذه الطريقة في الولايات المتحدة الأمريكية في الدعاوى القضائية العادية.
ولم تشر القواعد المنظمة للتحكيم العادي لهذه الوسائل، فلقد نصت القواعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية CCI في المادة (20) على أن تسمع المحكمة أقوال الأطراف والشهود والخبراء حضوريا، كما أنها لم تشر في المادة (21) إلا للجلسات التي تعقد طبيعيا، وأكدت على ضرورة حضور الأطراف شخصيا حيث جاء في هذه المادة “عندما تعقد الجلسة تستدعي محكمة التحكيم الأطراف للحضور أمامها في المكان والزمان المحددين من قبلها”.
ونرى أن المصطلحات المستخدمة في هذه النصوص مثل “الحضور” و”المكان” وغيرهما لا تتناسب مع خصوصية التحكيم الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأطراف الراغبين في الخضوع للقواعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية الإتفاق على سماع مرافعاتهم في شكل مبادلات إلكترونية. ويتوافق ذلك مع ما جاء في المادة (21/2) من القواعد المنظمة للمحكمة الإلكترونية Cyber tribunal التي أجازت حدوث الحوار بين الخصوم بكل وسيلة معقولة. لذا فإنه يجب أن يشمل مصطلح الجلسة – بجانب الحضور الطبيعي للأطراف- المؤتمرات الإلكترونية والاجتماعات السمعية البصرية، والتبادل الفوري الموثق للاتصالات الإلكترونية بالطريقة التي تسمح بإرسال واستقبال هذه المعلومات.
ومن تم، يمكن إدارة جلسات التحكيم إلكترونيا، لأن هذه الوسائل تؤدي نفس الدور الذي تقوم به الجلسات التي تعقد طبيعيا، بحيث تنقل الصور في الحال مما يتيح الفرصة لأصحاب الشأن برؤية المؤتمر بشكل يضمن احترام حقوق الدفاع وحق المواجهة، بل قد يتم ضمان احترام المبادئ أكثر من القضاء والذي تتم أغلب إجراءاته عبر المسطرة الكتابية دون سماع الأطراف أو في بعض الأحيان دون سماع المحامي.
وتقتصر إجراءات المحاكمة أمام هيئة التحكيم على تقديم بينات محددة هي: البينة الخطية والشخصية وطلب الخبرة الفنية.
- البينة الخطية
الأصل أن يقدم الطرفين بياناتهم أمام الهيئة مباشرة شريطة أن يكون قد أشير لهذه البيانات ضمن قائمة البيانات المقدمة للمركز عند الادعاء أو الجواب، واستثناء على هذا الأصل أجازت مراكز التحكيم لهيئة التحكيم أن توافق على تقديم أية بينة لم يشر إليها مقدمها من الطرفين ضمن قائمة بياناته وذلك إذا ما رأت وجود أسباب جدية ومبررة لقبول البينة ومدى أهميتها في حسم النزاع. كما أن لهيئة التحكيم ومن تلقاء نفسها أن تطلب أية بينة إضافية تراها ضرورية للفصل في النزاع.
إن تبادل المستندات وأدلة الإثبات بين الأطراف يساعد المحكم على الفصل في موضوع النزاع، ولم تذكر نصوص التحكيم العادي سوى الوثائق المكتوبة، لأنه لم يخطر ببال واضعي هذه النصوص إمكانية وجود وثائق إلكترونية، ومع ذلك فإن منطوق المادة(3/2) من القواعد المنظمة لغرفة التجارة الدولية يسمح بحدوث الإتصال بالمحكمة إلكترونيا، علاوة على أن القواعد المنظمة للمحكمة الإلكترونية نصت على أن الإتصال بالأمانة يكون من خلال البريد الإلكتروني(المادة 3)، كما نص نظام التحكيم المعجل التابع ل O.M.P.I على إمكانية نقل الوثائق إلكترونيا، باستثناء الوثائق الأصلية التي ترسل بالبريد العاجل.
- البينة الشخصية
وهي معمول بها في شتى قوانين الإثبات وتعمل بها مراكز التحكيم عن بعد، تاركة لطرفي النزاع حرية الاستعانة بشهادة الشهود في إثبات أية واقعة تؤيد ادعائهم مع تحديد آلية سماع الشاهد والاتصال به، إما عن طريق الهاتف أو استدعائه لجلسة سرية لاستجوابه ومناقشته حول النقاط المتعلقة بالنزاع، وذلك بعد إخطار الهيئة في جميع الأحوال لتقرر التأييد أو الرفض، وتكون نفقات سماع الشاهد على من طلبه.
- طلب الخبرة الفنية
أجازت مراكز التحكيم الإلكتروني لطرفي النزاع طلب الخبرة الفنية لإثبات وقائع تتعلق بموضوع النزاع كالعيب في المبيع أو تقدير الثمن الحقيقي له أو تحديد مقدار الضرر الذي لحق بالمشتري…الخ. ويتعين على من يرغب في طلب الخبرة الفنية أن يخطر الهيئة بذلك في وقت يسبق المحاكمة بمدة معقولة مع تحديد الوقائع المطلوبة إجراء الخبرة حولها لتقرر الهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه، وفي حالة الموافقة عليها يقسم الخبير بعدها القسم القانوني ويمنح مهلة ثلاثين يوما على الأكثر لتسليم تقرير الخبرة، ليقوم الأطراف بعدها بمناقشة الخبير حول تقريره، وللهيئة من تلقاء نفسها أن تطلب إجراء الخبرة وذلك في أي وقت من أوقات المحاكمة بعد إحاطة طرفي النزاع بذلك.
وتترك مراكز التحكيم حرية دعم أو دحض تقرير الخبرة للأطراف وتقديم أية ملاحظات أو انتقادات، لتقرر الهيئة بعد ذلك أن تأخذ بالتقرير أم لا، وتفقد الهيئة هذا الحق في حال رضا طرفي النزاع بالتقرير.
ويثور التساؤل حول مصير الإجراءات التي اتخذت في حال وفاة أحد المحكمين أو فقدانه أهليته؟
وقد نصت مراكز التحكيم على استبدال المحكم، كمحاولة منها للحفاظ على استقرار عملية التحكيم والسير فيها قدما، دونما أية معوقات وخصوصا عنصر الزمن المقيد للهيئة في صدور القرار خلاله، وهذه الحالات هي (الوفاة، فقدان المحكم لأهليته، إصابة المحكم بعجز يمنعه من الاستمرار في نظر النزاع، رد المحكم…الخ).
هذا وقد نصت مراكز التحكيم الإلكتروني على حق طرفي النزاع في طلب إنهاء النظر إذا ما توصلا لتسوية ودية، بشرط أن يأتي الطلب قبل صدور الحكم التحكيمي.
وبعد انتهاء محكمة التحكيم من سماع الإدعاء والدفاع وفحص وسائل الإثبات المقدمة من الأطراف، تقوم المحكمة بإصدار حكمها في النزاع في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ قفل باب المرافعة ما لم تمد أمانة المركز هذا الميعاد مدة أطول بناء على طلب المحكمة، اذا كانت هناك أسباب جوهرية.
الفقرة الثانية: حكم التحكيم الإلكتروني
حكم التحكيم الصادر في الشكل الإلكتروني يجب أن يستوفي بعض الشروط في مرحلة إعداده، وذلك حتى يعترف له بالآثار في مرحلة تنفيذه، ونعرض لذلك فيما يلي:
إعداد الحكم، بهدف حماية المحتكمين توجب النصوص المتعلقة بالتحكيم شروطا تتعلق بشكل الحكم وأخرى بكيفية الإخطار بهذا الحكم، فهل يستوفي حكم التحكيم الإلكتروني هذه الشروط؟
أولا: شكل الحكم
رغم أن العديد من التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية تتطلب ضرورة كتابة حكم التحكيم، إلا أن معظمها لم تشترط شكلا خاصا لصياغتها، فقد تكون بخط اليد أو بالوسائل الإلكترونية، لذا فإن صدور الحكم بالكتابة الإلكترونية يحقق شرط الشكل المطلوب.
أما فيما يتعلق بالتوقيع على الحكم، فقد نصت المادة (31) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على ضرورة توقيع المحكم أو المحكمين حال تعددهم على حكم التحكيم وهذا هو المعمول به في التحكيم العادي، حيث يقوم المحكمون بتوقيع الحكم بخط اليد، إلا أن التوقيع بخط اليد غير ميسر في التحكيم الإلكتروني، لذا اقترح البعض إرسال نسخة مطبوعة من الحكم إلى أعضاء لجنة التحكيم لتوقيعها، وهذا الحل لا يمكن قبوله لأنه يخرج عن الإطار الإلكتروني الذي يجرى فيه التحكيم، ونرى بأن الحل يتمثل في إعطاء التوقيع الإلكتروني نفس حجية التوقيع العادي، وهو ما أقرته المادة (54) من لائحة المنظمة العالمية للملكية الفكرية O.M.P.I، والمادة (25/3) من لائحة المحكمة الإلكترونية.
ويبدوا أن القانون المغربي رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية يسير في نفس الإتجاه بحيث اقر المشرع في المادة 417 /1 من ق.ل.ع نفس القوة الثبوتية الممنوحة للوسائل التقليدية هي نفسها الممنوحة للوسائل الالكترونية، ونفس الشيء أكدته محكمة النقض في احدى قراراتها ” رقم 83 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2023 في الملف التجاري رقم 1717/3/1/2021 .
ثانيا: تبليغ الحكم Notification de la sentence
توضح النصوص المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي أسلوب تبليغ الحكم، فلقد نصت المادة (28) من قواعد التحكيم في غرفة التجارة الدولية لسنة 1998على أنه: “يعلم الأطراف بالحكم من أمانة المحكمة أو بتسليمهم صورة طبق الأصل منه”، كما نصت المادة (31/4) من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة 1985على أنه: “تسلم صورة من الحكم للأطراف“. فهل تنطبق المصطلحات الموجودة في هذه النصوص مثل “التسليم” و”صورة طبق الأصل” مع التحكيم الإلكتروني الذي يجري عن طريق الاستعانة بالوسائل الرقمية؟
نرى أن المهم هو أن يصل الحكم إلى الأطراف دون تعديل أثناء النقل، أما وسيلة التبليغ فهي غير مهمة، ونستدل على ذلك بنص المادة (3/2) من قواعد غرفة التجارة الدولية والتي تشير إلى إمكانية حدوث التبليغ “بكل وسيلة اتصال تسمح بإقامة الدليل على الإرسال”.
ولقد نصت المنظمات المعنية بالعالم الإلكتروني على مسألة تبليغ الحكم، منها المادة(54) من لائحة O.M.P.I والتي نصت على أنه: ” ينقل المركز القرار إلى كل طرف وشريك وذلك بأن يضع نصه على موقعه بشبكة الأنترنت تحت رقم رجوع للملف “، كما نصت المادة (25/4) من القواعد المنظمة للمحكمة الإلكترونية Cyber tribunal على أنه: ” تتولى السكرتارية نشر الحكم على موقع القضية وتبلغه للأطراف بكل وسيلة ممكنة “، لكن لم يوضح النص كيفية حدوث التبليغ، والراجح قيام المحكم بإرساله عن طريق البريد الإلكتروني المشفر أو عن طريق البريد العادي.
وللأطراف بعد استلامهم قرار المحكم الرجوع لهيئة التحكيم والاستفسار حول أية أخطاء مادية أو حسابية أو غموض شاب القرار، ويمكن للهيئة من تلقاء نفسها تصحيح ذلك خلال ثلاثين يوما من صدور القرار.
المطلب الثاني: آثار الحكم effets de la sentence
يترتب على صدور حكم التحكيم بعض الآثار، وأهمها قابلية ذلك الحكم للتنفيذ فور صدوره، وفي نفس الوقت قابليته للحفظ عند الاقتضاء تأكيدا لمبدأ السرية.
الفقرة الأولى: تنفيذ الحكم exécution de la sentence
عندما يفضل الأطراف اللجوء للتحكيم، فإنه يجب عليهم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم دون تأخير، ومع ذلك قد يكون الطرف الخاسر سيء النية ويرفض تنفيذ الحكم، مما يضطر الطرف المستفيد من الحكم إلى اللجوء للقضاء لطلب تنفيذ هذا الحكم، وعليه أن يقدم أصل الحكم أو صورة طبق الأصل منه للإعتراف به وتنفيذه، بالإضافة إلى أصل أو صورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم.
ولا يوجد مشكلة في التحكيم العادي إلا أن الأمر ليس كذلك في التحكيم الإلكتروني لسببين:
– المعلوماتية لا تميز بين الأصل والصورة.
– وجود صعوبات تتعلق بالتصديق authentification على الوثائق الإلكترونية.
ولم تحل المادة (54) من لائحة O.M.P.I هذه المشكلة حيث نصت على أنه: ” تسلم للطرف المدعي صورة مطابقة لأصل القرار“، إلا أنها لم توضح الوسيلة التي يتم بها التصديق الكتابي. ولقد جاءت المادة (8) من القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 1996 بحل لهذه المشكلة حيث نصت على تماثل الوثيقة مع الأصل بشرطين هما:
– ضمان مصداقية نقل المعلومات كاملة دون تحريف.
– إثبات مضمون المعلومات.
كما يمكن للأطراف النص في اتفاق التحكيم على قبول الوثائق الإلكترونية في الإثبات، على أن هناك إشكال يطرح بصدد دعوى الأمر بالتنفيذ، حيث يتعذر تحديد مكان صدور الحكم التحكيمي والذي يشكل معيارا في ظل اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لتمييز الحكم الوطني عن الحكم الأجنبي.
وما دام يتعذر اعتبار الحكم التحكيمي الإلكتروني صادرا في بلد القاضي، فهو سيعتبر من حيث المبدأ صادرا في الخارج أي “حكم أجنبي“، لكن بالمقابل يتعذر تطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، والتي تستوجب معرفة بلد صدور حكم التحكيم ليتأكد القاضي من أن البلد الذي صدر فيه ذلك الحكم لا يمانع في تنفيذ أحكام تحكيمية “وطنية” على إقليمه.
وبذلك يصبح هذا الحكم التحكيمي “عائما” ويتعذر إعطاء الأمر بتنفيذه في أي دولة.
الفقرة الثانية: حفظ الحكم
تفرض مسألة حفظ الحكم بالنسبة للمودع لديه، مشكلتين أساسيتين:
– ضمان الكمال بالنسبة لمحتوى الحكم.
– السماح ببقاء الحكم سريا إذا رغب الأطراف بذلك.
ولا تثير مسألة الحفظ أي مشكلة في مجال التحكيم العادي، بحيث نصت المادة (28/4) من قواعد غرفة التجارة الدولية على أنه: ” يودع أصل الحكم لدى أمانة المحكمة “، ولم تشر اتفاقية نيويورك والقانون المغربي رقم 53.05 إلى مسألة الحفظ، كذلك لم تتطرق لائحة المحكمة الإلكترونية للحفظ، وإن كانت قد نصت على أنه: “يكون الحكم منشورا على موقع القضية “(م25/4).
وتثور مشكلة أخرى تتعلق بإيداع حكم التحكيم الإلكتروني في المحكمة المختصة ومدى إمكانية حدوث ذلك، فهناك بعض الدول التي توجب إيداع الحكم التحكيمي، من ذلك المادة (47) من قانون التحكيم المصري. وبالتالي يثار إشكال حول مدى إمكانية إيداع حكم التحكيم الإلكتروني لدى كتابة الضبط بالمحكمة؟ وهل المحاكم الوطنية مؤهلة للاحتفاظ بهذا الإيداع من الناحية الفنية والتقنية؟، وما هو الشكل الذي يتم فيه الاحتفاظ بحكم التحكيم الإلكتروني؟
ونعتقد أنه رغم قانونية وإمكانية الإتفاق والتوقيع الإلكتروني، فلابد من التذكير أن اتفاق التحكيم وحكم التحكيم الموجود على دعامات ورقية مطلوب دائما حين تقديم طلب الإعتراف بالحكم وتنفيذه، حيث إن المحاكم لا تتعامل بالوثائق الإلكترونية وإن كانت ستعترف بها، ومن تم فلا بد من أن يكون حكم التحكيم قابلا للاستخراج على الورق حتى يكون قابلا للتنفيذ.
خــاتـــمــــة:
في ختام هذه الدراسة توصلنا الى مجموعة من الاقتراحات من شأنها أن تساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من ادراج الوسائل البديلة لفض المنازعات ” التحكيم الالكتروني نموذجا” في النزاعات التي قد تطرأ وتشكل بديلا عن الجهاز القضائي وهي كالآتي:
– مكافحة الجرائم الإلكترونية بإشراك جميع القطاعات الحكومية وكافة الفاعلين والهيئات الحقوقية، ورسم استراتيجية متكاملة للأمن الإلكتروني من خلال التوعية والتحسيس بمخاطر سوء استعمال التكنولوجيا والتبليغ عن كافة الجرائم الالكترونية بسرعة من أجل ضمان سهولة الكشف عنها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
– سد الفراغ التشريعي المتعلق بالبيئة الرقمية بتشعباتها المختلفة وتحيين القوانين العقابية مواكبة للجرائم المستحدثة، لاسيما في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، مع الحرص على أن تكون هذه التشريعات منبثقة من المجتمع المحلي حرصا على فعاليتها.
– إحداث هيئات وطنية ودولية متخصصة في مكافحة الجرائم الالكترونية المستحدثة، مع التشجيع على خدمة تلقي الشكايات عبر بوابة إلكترونية خاصة بذلك والعمل بها ونشر ثقافتها.
– إدراج مواد خاصة بالأمن المعلوماتي وطرق الاستعمال الآمن للفضاء الرقمي ضمن المناهج الدراسية، على اعتبار أن العصر الحالي هو عصر التكنولوجيا.
– ضرورة تكثيف الجهود الوطنية لنشر المعرفة وزيادة الوعي بالجرائم الإلكترونية ومدى خطورتها ووسائل الوقاية منها وسبل مواجهتها، مع إبرام اتفاقيات عربية ودولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتحديد مصادر هذه المواقع، والعمل على ضبط مروجيها وحجبها.
ولا يسعنا سوى القول بأن التحكيم الإلكتروني والذي نشأ حديثاً وما زال في طور التحديث والتنظيم القانوني والتقني مازال بحاجة ماسة إلى اصلاح مكامن الضعف (تحديد هوية طرفي النزاع – سرية العملية وإثبات الإتفاق التحكيمي) من قبل المنظمات الدولية والدول الأطراف، لوضع إطار شامل يتحقق به شمولية الاعتراف والتنظيم لهذا النوع الجديد من أنواع التحكيم، على اعتبار أن أي نظام قانوني يشوبه القصور خصوصا بعد طرحه للتنفيذ، وذلك ما يشوب أيضا التحكيم الإلكتروني كتجربة وضعت للتيسير على المتنازعين.
لائحة المراجع:
- عادل أبو هشيمة، “عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص”، دار النهضة العربية، ط 2004.
- حازم حسن جمعة، “اتفاق التحكيم الإلكتروني وطرق الإثبات عبر وسائل الاتصال الحديثة”، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية، مركز البحوث والدراسات – دبي- الإمارات العربية المتحدة، 26-28/04/2003 .
- حسام الدين فتحي ناصف، “التحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الدولية” دار النهضة العربية، طبعة 2005.
- د.عبد الله درميش، “التحكيم الدولي في المواد التجارية”، ر د د ع، كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة 1982-1983.
- رامي علوان، “التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنت واثبات التعاقد الالكتروني”، مجلة الحقوق،ع 4، س 26، ديسمبر 2002.
- بشار محمود دودين، “الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت”، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، ط 2006.
- أحمد عبد الكريم سلامة، “قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي”، دار النهضة العربية، ط 2004.
- محمد الإدريسي العمراوي، “دور القاضي في تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية”، مجلة الملحق القضائي، ع 33، 1998.
- أبو العلا علي أبو العلا النمر، “القانون الواجب التطبيق على المسائل الإجرائية للتحكيم”، دار النهضة العربية، ط الأولى.
- أشرف عبد العليم الرفاعي، “النظام العام والقانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم في العلاقات ذات العنصر الأجنبي”، دار الفكر الجامعي، طبعة 2003م.
- محمد أمين الرومي، النظام القانوني للتحكيم الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 2006.
- حفيظة السيد الحداد، “الموجز في النظرية العامة في التحكيم التجاري الدولي”، منشورات الحلبي الحقوقية، ط 2004.
- اشرف عبد العليم الرفاعي، “القانون الواجب التطبيق على موضوع التحكيم والنظام العام في العلاقات الخاصة الدولية”، دار الفكر الجامعي،طبعة 2003.
المواقع الالكترونية
Les Ouvrages
FOUCHARD (PH) et GAILLARD (E) et GOLDMAN (B), « Traité de l’arbitrage commercial international », éd LITEC DELTA, 1996, n 818.
NAVARRO (J.L), « le preuve et l’écrit entre la tradition et la modernité », J.C.P éd G, n 50, décembre 2002.
CAPRIOLI (E.A), «Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique».
HUET (J) et VALMACHINO (S), «Réflexion sur l’arbitrage électronique dans le commerce international», Gaz pal 2000.
SCHULTZ (T), « résolution des litiges et ius numericum», revue interdisciplinaire d’études juridiques, n 48, 2002.
CAPRIOLI (E.A), « arbitrage et médiation dans le commerce électronique » Revue de l’arbitrage n°2, 1999.
-COUPEL-CORDONNIER (N), « les conventions d’arbitrage et d’élection du for en droit international privé », L.G.D.J 1999.
KAUFMANN (K, G), «le lieu de l’arbitrage à l’aune de la mondialisation», rev.arb 1998, n3.
KALLE (S), « Arbitrage et commerce électronique », R.D.A.I, 2001, n 1.
– GAUTRAIS (V),« le contrat électronique international »,éd Bruylant, Bruxelles, 2ème partie.



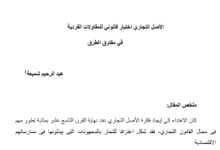

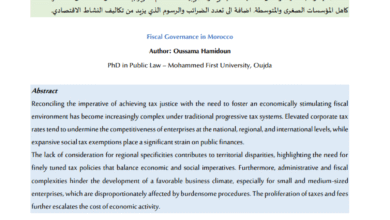
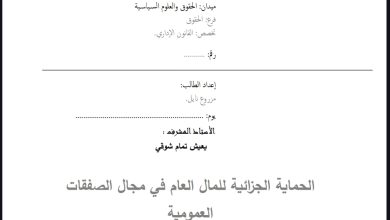

4 تعليقات