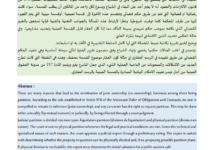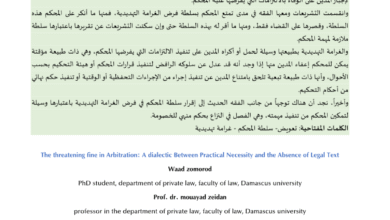التحكيم في العقود الهندسية – دراسة في القانون السوداني الدكتور : عثمان محمد أحمد الأمين حماد
[]
التحكيم في العقود الهندسية – دراسة في القانون السوداني
الدكتور : عثمان محمد أحمد الأمين حماد
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة حائل السعودية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665





















التحكيم في العقود الهندسية – دراسة في القانون السوداني
الدكتور : عثمان محمد أحمد الأمين حماد
الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون جامعة حائل السعودية
الملخص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحكيم في العقود الهندسية في القانون السوداني، مع التركيز على أهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الهندسية وتوضيح التنظيم القانوني له في السودان. تم تناول ماهية التحكيم وطبيعته القانونية، وكذلك التحديات التي يواجهها التحكيم في السودان مثل ضعف الوعي القانوني وصعوبات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة التجارب الدولية في التحكيم الهندسي، مع استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها في النظام السوداني. توصل البحث إلى ضرورة تحديث التشريعات السودانية لتواكب المعايير الدولية، وتأسيس مراكز تحكيم متخصصة في العقود الهندسية. كما تم التأكيد على أهمية نشر ثقافة التحكيم الهندسي وتعزيز تدريب المحكمين في هذا المجال.
الكلمات المفتاحية: التحكيم الهندسي، العقود الهندسية، قانون التحكيم السوداني، تسوية النزاعات، مراكز التحكيم.
Arbitration in engineering contracts – a study in Sudanese law
Dr. Othman Mohammed Ahmed Al-Amin Hamad
Associate Professor at the College of Sharia and Law, University of Hail, Saudi Arabia
Abstract:
This research aims to study arbitration in engineering contracts under Sudanese law, focusing on the importance of arbitration as a means of resolving engineering disputes and clarifying its legal framework in Sudan. The study addresses the nature of arbitration, its legal basis, and the challenges faced by arbitration in Sudan, such as lack of legal awareness and difficulties in enforcing foreign arbitration awards. Additionally, international experiences in engineering arbitration were reviewed, with lessons learned that could be applied to the Sudanese system. The research concluded that there is a need to update Sudanese legislation to align with international standards, establish specialized arbitration centers in engineering contracts, and promote the culture of engineering arbitration while enhancing the training of arbitrators in this field.
Keywords: Engineering Arbitration, Engineering Contracts, Sudanese Arbitration Law, Dispute Resolution, Arbitration Centers
مقدمة
يُعَد التحكيم أحد أبرز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، حيث يُستخدم على نطاق واسع في العقود الهندسية نظرًا لتعقيدها الفني والتقني، وما تتطلبه من حلول سريعة وفعالة. في السودان، تُعتبر العقود الهندسية من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع زيادة مشاريع البنية التحتية والتطوير العمراني. غير أن هذه العقود غالبًا ما تنشأ عنها نزاعات تتطلب حلولًا متخصصة، وهو ما يجعل التحكيم الهندسي أداة قانونية مهمة لضمان استمرارية المشاريع دون تأخير أو تصعيد قضائي قد يعرقل التنفيذ.
يهدف هذا البحث إلى دراسة التحكيم في العقود الهندسية وفقًا للقانون السوداني، من خلال تحليل الإطار القانوني للتحكيم، وبيان مدى توافقه مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه التحكيم الهندسي في السودان. كما يستعرض البحث التجارب الدولية في التحكيم الهندسي، مع استخلاص الدروس المستفادة التي يمكن تطبيقها لتحسين نظام التحكيم في السودان.
أولًا: أهمية الموضوع
يكتسب التحكيم في العقود الهندسية أهمية بالغة نظرًا لطبيعة هذه العقود التي تتسم بالتعقيد الفني والتقني، وتعدد أطرافها، وارتفاع تكلفتها. وغالبًا ما تنشأ نزاعات بين الأطراف بسبب التأخير في التنفيذ، أو عدم الالتزام بالمواصفات، أو الخلافات حول التكاليف والتعديلات في العقد. ويعد التحكيم وسيلة فعالة لحل هذه النزاعات بسرعة وكفاءة، بعيدًا عن الإجراءات القضائية الطويلة والمعقدة.
في السودان، شهدت مشاريع البنية التحتية والمقاولات توسعًا ملحوظًا، مما زاد الحاجة إلى آليات قانونية فاعلة لحل النزاعات. ومع صدور قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، أصبح من الضروري دراسة مدى ملاءمة الإطار القانوني الحالي لتسوية النزاعات الهندسية بفعالية.
ثانيًا: أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
- توضيح مفهوم التحكيم في العقود الهندسية وبيان أهميته كوسيلة لتسوية النزاعات.
- تحليل الإطار القانوني السوداني للتحكيم ومدى توافقه مع المعايير الدولية.
- دراسة إجراءات التحكيم في النزاعات الهندسية وفقًا لقانون التحكيم السوداني.
- تحديد التحديات التي تواجه التحكيم الهندسي في السودان واقتراح حلول لتطويره.
- إجراء مقارنة مع قوانين دول أخرى لاستنباط الدروس المستفادة وتقديم توصيات لتحسين النظام القانوني للتحكيم الهندسي في السودان.
ثالثًا: أسباب اختيار الموضوع
- التزايد المستمر للنزاعات في المشاريع الهندسية في السودان، مما يستدعي دراسة وسائل تسويتها بطرق أكثر كفاءة وسرعة.
- أهمية التحكيم كبديل عن القضاء التقليدي، خاصة في القضايا الفنية التي تتطلب خبرة متخصصة لا تتوافر دائمًا في المحاكم.
- تطور التشريعات السودانية في مجال التحكيم، مما يستوجب دراسة مدى استجابتها لاحتياجات المجتمع الهندسي والقانوني.
- قلة الدراسات المتخصصة التي تتناول التحكيم الهندسي في السودان، مما يجعل هذا البحث إضافة علمية مفيدة.
رابعًا: منهج البحث وأدواته
يعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي من خلال:
- تحليل النصوص القانونية السودانية المتعلقة بالتحكيم، وخاصة قانون التحكيم لسنة 2016م.
- دراسة السوابق القضائية في السودان المتعلقة بالتحكيم الهندسي.
- المقارنة مع الأنظمة القانونية في دول أخرى لاستخلاص الدروس المفيدة.
- الاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة، مثل القوانين والتشريعات، والمقالات العلمية، والدراسات السابقة ذات الصلة.
خامساً: مشكلة البحث:
تُعَد العقود الهندسية من أكثر العقود تعقيدًا نظرًا لتداخل الجوانب القانونية والفنية فيها، مما يجعل النزاعات الناشئة عنها شائعة ومتعددة الأسباب، مثل التأخير في التنفيذ، اختلاف المواصفات الفنية، زيادة التكاليف، أو الإخلال ببنود العقد. وفي ظل هذه التحديات، يبرز التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات الهندسية بعيدًا عن بطء وتعقيد إجراءات القضاء العادي.
ورغم صدور قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، إلا أن هناك العديد من الإشكاليات التي تواجه التحكيم في العقود الهندسية بالسودان، ومن أبرزها:
- مدى ملاءمة الإطار القانوني السوداني للتحكيم الهندسي مقارنة بالمعايير الدولية.
- صعوبة تنفيذ قرارات التحكيم في السودان، خاصة القرارات الأجنبية.
- غياب مراكز تحكيم متخصصة في العقود الهندسية، مما يؤثر على كفاءة العملية التحكيمية.
- ضعف الوعي القانوني لدى الأطراف المتعاقدة بأهمية التحكيم وشروطه.
- تداخل دور المحاكم السودانية في الرقابة على التحكيم، مما قد يحد من استقلاليته وفعاليته.
بناءً على ما سبق، تتمثل إشكالية البحث الرئيسية في السؤال التالي:
إلى أي مدى يوفر قانون التحكيم السوداني الإطار القانوني والإجرائي المناسب لحل النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية بفعالية، وما هي التحديات التي تواجه تطبيقه، وكيف يمكن تطويره ليتماشى مع المعايير الدولية؟
الأسئلة الفرعية للبحث:
- ما الأساس القانوني للتحكيم في العقود الهندسية وفقًا للقانون السوداني؟
- ما مدى كفاءة التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الهندسية مقارنة بالقضاء؟
- ما التحديات القانونية والعملية التي تواجه التحكيم في العقود الهندسية بالسودان؟
- كيف يمكن تطوير النظام القانوني السوداني للتحكيم ليتناسب مع طبيعة النزاعات الهندسية؟
- ما الدروس المستفادة من التجارب الدولية في التحكيم الهندسي التي يمكن تطبيقها في السودان؟
سادساً: فرضيات البحث:
- التحكيم في العقود الهندسية بالسودان يعاني من تحديات قانونية وإجرائية تحد من فعاليته.
- هناك حاجة إلى تطوير التشريعات السودانية الخاصة بالتحكيم لتتماشى مع المعايير الدولية.
- إنشاء مراكز تحكيم متخصصة في السودان سيسهم في تحسين جودة تسوية النزاعات الهندسية.
هذه الإشكالية تمثل محور البحث، حيث سيتم تحليل الجوانب القانونية والإجرائية للتحكيم الهندسي في السودان، مع اقتراح حلول عملية لتطويره.
سابعًا: الدراسات السابقة:
رغم أهمية الموضوع، فإن الدراسات المتعلقة بالتحكيم في العقود الهندسية في السودان قليلة، ومن أبرز الدراسات ذات الصلة:
1- دراسات عامة عن التحكيم في السودان: تناولت هذه الدراسات قانون التحكيم السوداني ومدى توافقه مع المعايير الدولية، لكنها لم تركز بشكل كافٍ على العقود الهندسية.
2- دراسات حول العقود الهندسية ونزاعات المقاولات: ركزت بعض الأبحاث على التحديات القانونية التي تواجه العقود الهندسية، لكنها لم تناقش التحكيم كحل رئيسي لهذه النزاعات.
3- دراسات مقارنة بين التحكيم والقضاء في السودان: أوضحت هذه الدراسات مزايا وعيوب كل وسيلة، لكنها لم تتناول خصوصية العقود الهندسية.
بناءً على ذلك، يسعى هذا البحث إلى سد الفجوة من خلال تقديم دراسة متخصصة حول التحكيم في العقود الهندسية في السودان، تجمع بين التحليل القانوني والتطبيقي.
ونظرًا للأهمية المتزايدة للتحكيم في تسوية النزاعات الهندسية في السودان، ولما يشهده قطاع الإنشاءات من تطور، فإن هذه الدراسة ستسلط الضوء على الجوانب القانونية والإجرائية للتحكيم في العقود الهندسية، مع تقديم حلول للتحديات التي تواجهه، بهدف تحسين البيئة القانونية والاستثمارية في هذا المجال.
ثامنًا: خطة البحث: تم تقسيم البحث إلى عدد ثلاثة مباحث، وعدد من المطالب، وذلك وفق التقسيم التالي:
المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم في العقود الهندسية
المطلب الأول: ماهية التحكيم وتعريفه في القانون السوداني
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الهندسية
المطلب الثالث: أهمية التحكيم في تسوية النزاعات الهندسية
المبحث الثاني: التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الهندسية في السودان
المطلب الأول: القوانين الحاكمة للتحكيم في السودان
المطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العقود الهندسية
المطلب الثالث: إجراءات التحكيم في العقود الهندسية
المبحث الثالث: تحديات التحكيم في العقود الهندسية وآفاق تطويره في السودان
المطلب الأول: تحديات التحكيم في العقود الهندسية بالسودان
المطلب الثاني: مقترحات تطوير التحكيم في العقود الهندسية
المطلب الثالث: دراسة مقارنة مع تجارب دولية في التحكيم الهندسي
الخاتمة: وتشمل:
ملخص لأهم النتائج.
توصيات البحث.
المبحث الأول: الإطار العام للتحكيم في العقود الهندسية
يُعتبر التحكيم من أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصة في العقود التي تتسم بالتعقيد الفني والتقني، مثل العقود الهندسية. ويُفضل الأطراف اللجوء إلى التحكيم في النزاعات الهندسية بسبب طبيعته المتخصصة وسرعته في إصدار الأحكام مقارنة بالقضاء التقليدي.
في السودان، تُنظَّم إجراءات التحكيم وفق قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، الذي وضع إطارًا قانونيًا لحل النزاعات من خلال التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم. كما أن التحكيم الهندسي يستند إلى قواعد دولية، مثل شروط عقد الفيديك (FIDIC)، التي تُستخدم على نطاق واسع في المشاريع الهندسية الكبرى.
سيتناول هذا المبحث التعريف بالتحكيم في العقود الهندسية، والفرق بينه وبين القضاء العادي، بالإضافة إلى مزاياه وعيوبه، وذلك من خلال دراسة الإطار القانوني السوداني ومقارنته بالممارسات الدولية.
المطلب الأول: ماهية التحكيم وتعريفه في القانون السوداني:
يُعرف التحكيم بأنه وسيلة قانونية لحل النزاعات خارج المحاكم، حيث يتفق الأطراف على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيمية محايدة تُصدر حكمًا ملزمًا. وتكمن أهمية التحكيم في توفير آلية مرنة وسريعة لحسم النزاعات، خصوصًا في المجالات التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، مثل العقود الهندسية.
يُعد قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 المرجع الأساسي للتحكيم في السودان، حيث يحدد شروط صحة اتفاق التحكيم، وإجراءات تعيين المحكمين، وتنفيذ قرارات التحكيم. كما أن السودان طرف في اتفاقية نيويورك 1958 التي تعزز الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
يهدف هذا المطلب إلى تحديد مفهوم التحكيم وأساسه القانوني، مع بيان الفرق بين التحكيم والقضاء العادي، وتوضيح مزاياه وعيوبه في العقود الهندسية.
أولًا: تعريف التحكيم وأساسه القانوني: التحكيم هو “اتفاق بين طرفين أو أكثر على إحالة نزاع معين، نشأ أو قد ينشأ مستقبلاً، إلى هيئة تحكيمية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم، بحيث يكون قرار هذه الهيئة نهائيًا وملزمًا” .
ويستند التحكيم في السودان إلى عدة مصادر قانونية، من بينها:
القانون السوداني: يحدد الإجراءات الخاصة بالتحكيم، مثل تعيين المحكمين، وسير الجلسات، والطعن في الأحكام.
الاتفاقيات الدولية: مثل اتفاقية نيويورك 1958، التي تسهل تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في السودان.
القواعد الدولية للتحكيم: مثل قواعد الفيديك (FIDIC) التي تُستخدم في المشاريع الهندسية الكبرى، خاصة تلك التي تمولها المؤسسات الدولية.
ثانيًا: الفرق بين التحكيم والقضاء العادي: يختلف التحكيم عن القضاء العادي في عدة جوانب رئيسية:
| المعيار | القضاء العادي | التحكيم |
| الجهة المختصة | محكمة رسمية تابعة للدولة | هيئة تحكيم يختارها الأطراف |
| المرونة والإجراءات | إجراءات قانونية رسمية ومقيدة | إجراءات مرنة يحددها الأطراف |
| المدة الزمنية | قد تستغرق القضايا سنوات | أسرع من القضاء |
| التخصص الفني | القضاة ليسوا متخصصين دائماً | المحكمون خبراء في المجال الهندسي |
| السرية | علنية في معظم الحالات | سرية تامة للنزاع والأطراف |
| القابلية للطعن | يمكن الطعن بعدة درجات | قرارات نهائية في الغالب |
ومن ثم، فإن التحكيم يُعَد خيارًا مثاليًا للنزاعات الهندسية نظرًا لحاجة هذه القضايا إلى السرعة، والمرونة، والتخصص الفني.
ثالثًا: مزايا التحكيم وعيوبه في العقود الهندسية: للتحكيم عدد من المزايا والعيوب في العقود الهندسية يمكن اجمالها في التالي:
1- مزايا التحكيم: وتتمثل في:
أ- السرعة في حسم النزاعات: حيث تستغرق قضايا التحكيم وقتًا أقل مقارنة بالمحاكم.
ب- توفير التكاليف: رغم أن بعض إجراءات التحكيم قد تكون مكلفة، إلا أنها غالبًا أقل تكلفة من التقاضي الطويل.
ج- التخصص الفني: يُمكن للأطراف اختيار محكمين ذوي خبرة في المجال الهندسي، مما يعزز جودة الأحكام.
د- السرية: يتيح التحكيم درجة عالية من الخصوصية، مما يحمي أسرار المشاريع الهندسية.
هـ- المرونة في الإجراءات: يتيح للأطراف حرية اختيار القوانين والإجراءات المناسبة لحل النزاع.
2- عيوب التحكيم: وتتمثل في:
أ- التكلفة المرتفعة في بعض الحالات: خاصة إذا كان التحكيم دوليًا أو يتطلب محكمين خبراء مكلفين.
ب- عدم وجود آلية استئناف فعالة: إذ تكون أحكام التحكيم نهائية في أغلب الأحيان، مما قد يكون غير منصف في بعض الحالات.
ج- تفاوت جودة المحكمين: فقد يفتقر بعض المحكمين إلى الكفاءة المطلوبة، مما يؤثر على جودة الأحكام.
د- صعوبة تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية: رغم انضمام السودان لاتفاقية نيويورك، قد تواجه بعض الأحكام عراقيل عند التنفيذ بسبب تعقيدات قانونية محلية.
ويُعَد التحكيم وسيلة فعالة لحل النزاعات في العقود الهندسية، حيث يوفر سرعة ومرونة وسرية أكبر مقارنة بالقضاء العادي. ومع ذلك، فإنه لا يخلو من العيوب، مثل التكلفة المرتفعة وصعوبة الطعن في بعض الأحكام. يعتمد التحكيم في السودان على قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، إضافة إلى القواعد الدولية مثل FIDIC. ورغم المزايا العديدة التي يوفرها التحكيم الهندسي، إلا أن هناك تحديات قانونية وإجرائية تستدعي المزيد من التطوير لضمان فاعليته.
المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقود الهندسية
تُعتبر العقود الهندسية من العقود المعقدة التي تجمع بين الجوانب القانونية والفنية، نظرًا لطبيعة المشاريع التي تنظمها، والتي تشمل تصميم وتنفيذ البنى التحتية، والمباني، والمشاريع الكبرى. وتختلف هذه العقود عن غيرها من العقود المدنية أو التجارية من حيث أطرافها، التزاماتها، وأنواعها، مما يجعلها تخضع لتنظيم قانوني دقيق، سواء من خلال القوانين المحلية أو العقود النموذجية المعتمدة عالميًا، مثل عقود الفيديك (FIDIC).
تتميز العقود الهندسية بوجود نزاعات متكررة تتعلق بالتأخير في التنفيذ، عدم المطابقة للمواصفات، أو اختلاف تقديرات التكلفة، مما يفرض الحاجة إلى آليات واضحة لحل النزاعات، مثل التحكيم. لذا، فإن دراسة الطبيعة القانونية لهذه العقود تساعد على فهم حقوق والتزامات الأطراف، وأسباب النزاعات، والآليات المناسبة لحلها.
وسيتناول هذا المطلب تعريف العقود الهندسية وأطرافها، أنواع العقود الهندسية الشائعة، وخصوصية النزاعات التي تنشأ عنها، مع التركيز على الوضع القانوني لهذه العقود في السودان.
أولًا: مفهوم العقود الهندسية وأطرافها
1- تعريف العقود الهندسية: العقد الهندسي هو اتفاق بين طرفين أو أكثر لتنفيذ مشروع هندسي وفقًا لمواصفات محددة، خلال مدة زمنية معينة، مقابل تكلفة متفق عليها. ويتميز هذا النوع من العقود بطبيعته المركبة، حيث يشمل جوانب فنية، قانونية، ومالية معقدة.
وقد عرَّف الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) العقد الهندسي بأنه: “اتفاق قانوني يُبرم بين صاحب العمل والمقاول أو الاستشاري لتنفيذ أعمال بناء أو تصميم أو صيانة، وفقًا لمواصفات فنية معينة، ويشمل مسؤوليات والتزامات متبادلة لكل طرف”.
2- أطراف العقود الهندسية: تتعدد الأطراف المعنية بالعقود الهندسية، وأهمها:
أ- صاحب العمل (Employer/Owner): الجهة المالكة للمشروع، سواء كانت حكومة، شركة، أو فردًا.
ب- المقاول (Contractor): الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وفقًا للعقد.
ج- الاستشاري (Consultant/Engineer): المهندس المشرف الذي يتولى تصميم المشروع، مراجعة تنفيذ الأعمال، والتأكد من الالتزام بالمواصفات.
د- الموردون والمقاولون الفرعيون: الجهات التي تزود المشروع بالمواد أو تقوم بتنفيذ أجزاء محددة منه.
ثانيًا: أنواع العقود الهندسية: تختلف العقود الهندسية بحسب طبيعة المشروع وآلية التعاقد، ومن أبرز أنواعها:
1- عقود الفيديك (FIDIC Contracts): تصدر عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC) وتُعتبر المعيار العالمي للعقود الهندسية.
تتضمن عدة نماذج، منها:
أ- العقد الأحمر (Red Book): يستخدم في عقود البناء التقليدية، حيث يقوم المقاول بتنفيذ المشروع بناءً على تصاميم يحددها صاحب العمل.
ب- العقد الأصفر (Yellow Book): يُستخدم في مشاريع التصميم والتشييد، حيث يكون المقاول مسؤولًا عن التصميم والتنفيذ معًا.
ج- العقد الفضي (Silver Book): يُطبق في عقود تسليم المفتاح، حيث يكون المقاول مسؤولًا عن تسليم المشروع جاهزًا للتشغيل.
تُستخدم هذه العقود على نطاق واسع في المشاريع الكبرى الممولة من البنك الدولي والمؤسسات الدولية.
2- عقود المقاولات المحلية:
أ- تنظمها التشريعات الوطنية في كل دولة، مثل قانون المعاملات المدنية السوداني.
ب- تعتمد على المعايير المحلية في التشييد والمواصفات الفنية.
ج- تخضع لإشراف الجهات الحكومية، خاصة في مشاريع البنية التحتية.
3- عقود التصميم والتنفيذ (Design and Build Contracts):
أ- يكون فيها المقاول مسؤولًا عن التصميم والتنفيذ معًا، مما يقلل من النزاعات المتعلقة بالتصميم.
ب- تُستخدم في المشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، مثل المشاريع الحكومية والمشاريع الخاصة ذات الميزانيات المحددة.
ج- تُعتبر أكثر مرونة لكنها تتطلب مقاولًا ذا خبرة في التصميم والتنفيذ.
ثالثًا: خصوصية النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية: نظرًا لتعقيد المشاريع الهندسية، فإن النزاعات التي تنشأ عنها تتميز بخصوصية تجعلها مختلفة عن النزاعات التجارية أو المدنية العادية، ومن أبرز هذه الخصوصيات:
1- الطبيعة الفنية للنزاع: غالبًا ما تتطلب النزاعات الهندسية خبرة تقنية متخصصة، مثل تقييم جودة البناء، احتساب الكميات، أو تحليل أسباب التأخير.
لهذا السبب، يُفضَّل اللجوء إلى التحكيم الهندسي بدلًا من القضاء العادي، نظرًا لإمكانية تعيين خبراء تقنيين كمحكمين.
2- تأثر النزاع بالعوامل الاقتصادية والتعاقدية: بعض النزاعات تنشأ بسبب التغييرات في الأسعار أو تقلبات أسعار المواد، مما يؤثر على التزامات المقاول وصاحب العمل.
قد تكون هناك مطالبات مالية بسبب التأخير أو التعديلات على التصميم أثناء التنفيذ.
3- تداخل عدة أطراف في النزاع: قد ينشأ النزاع بين المقاول وصاحب العمل، أو بين المقاول والاستشاري، أو حتى بين المقاول والمقاولين الفرعيين.
تعقد هذه الطبيعة المتشابكة من إجراءات التقاضي أو التحكيم، حيث تحتاج كل مطالبة إلى تحليل دقيق لعلاقات الأطراف المختلفة.
وتُعد العقود الهندسية من العقود المعقدة التي تتطلب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا، حيث تشمل أطرافًا متعددة مثل المقاولين، الاستشاريين، وأصحاب المشاريع. وتختلف هذه العقود حسب طبيعة المشروع، إذ تشمل عقود الفيديك، العقود المحلية، وعقود التصميم والتنفيذ، وكل منها يحدد التزامات الأطراف وفقًا لمعايير قانونية وفنية مختلفة.
وتتميز النزاعات الناشئة عن العقود الهندسية بأنها ذات طابع فني واقتصادي وقانوني معقد، مما يستوجب استخدام آليات تسوية فعالة، مثل التحكيم الهندسي، لضمان السرعة والعدالة في حل النزاعات.
المطلب الثالث: أهمية التحكيم في تسوية النزاعات الهندسية
تُعتبر النزاعات الهندسية من أكثر النزاعات تعقيدًا نظرًا لطبيعة المشاريع التي تشمل عناصر فنية وقانونية ومالية متداخلة. وتتنوع أسباب هذه النزاعات بين التأخير في التنفيذ، الاختلاف حول المواصفات الفنية، الخلافات المالية، والمطالبات بالتعويض، مما يستدعي آليات فعالة وسريعة لحلها دون التأثير على سير المشاريع.
في هذا السياق، يُعد التحكيم الهندسي أحد أفضل الوسائل لحل النزاعات في العقود الهندسية، حيث يوفر المرونة، التخصص، والسرعة مقارنة بالقضاء العادي. في السودان، يتم تنظيم التحكيم وفق قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، والذي يتيح للأطراف اختيار التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات بدلاً من اللجوء إلى المحاكم التقليدية.
يهدف هذا المطلب إلى دراسة طبيعة النزاعات الهندسية الشائعة، دور التحكيم في تسويتها، والمقارنة بين التحكيم الهندسي والقضاء العادي في السودان، لتوضيح مدى فاعلية التحكيم كآلية لحل هذه النزاعات.
أولًا: طبيعة النزاعات الهندسية الشائعة: تتميز النزاعات الهندسية بطابعها الفني المعقد، حيث تنشأ عادةً بسبب التفسيرات المختلفة للعقد، الظروف الاقتصادية، والجوانب التقنية المرتبطة بالمشاريع. ومن أبرز النزاعات الهندسية:
1- النزاعات المتعلقة بالتأخير في التنفيذ: قد يتسبب التأخير في التنفيذ في خسائر مالية ضخمة، سواء لصاحب العمل أو المقاول. تنشأ هذه النزاعات غالبًا بسبب سوء التخطيط، تأخير الموافقات، نقص المواد، أو سوء الإدارة.
2- النزاعات المتعلقة بالمواصفات الفنية والجودة: تتعلق بمخالفة المواصفات الهندسية المتفق عليها، مثل استخدام مواد غير مطابقة أو تنفيذ أعمال غير دقيقة. قد تكون هذه النزاعات نتيجة عدم وضوح العقود أو الإهمال الفني من قبل المقاول.
3- النزاعات المالية والمطالبات بالتعويض: تشمل النزاعات حول الدفعات المالية، تقدير التكاليف الإضافية، وتغير الأسعار. قد تحدث خلافات حول المطالبات بالتعويض عن التأخير أو العيوب الإنشائية.
4- النزاعات المتعلقة بتفسير العقود: نظرًا لتعقيد العقود الهندسية، قد تنشأ خلافات حول تفسير بنود معينة، مثل التزامات الأطراف ومسؤولياتهم. هذه النزاعات تحتاج غالبًا إلى خبراء قانونيين وفنيين لفهم العقود وتفسيرها بدقة.
ثانيًا: دور التحكيم في تسوية هذه النزاعات: نظرًا لتعقيد النزاعات الهندسية، فإن التحكيم يُعتبر من أكثر الوسائل فاعلية في حلها، نظرًا لما يوفره من سرعة، مرونة، وسرية، بالإضافة إلى إمكانية تعيين محكمين ذوي خبرة في المجال الهندسي.
1- توفير بيئة متخصصة لحل النزاعات: يسمح التحكيم للأطراف باختيار محكمين متخصصين في الهندسة والمقاولات، مما يسهل فهم الجوانب الفنية للنزاع. يُساعد المحكمون الخبراء في تقديم تفسيرات دقيقة لبنود العقود الهندسية، مما يساهم في الوصول إلى أحكام عادلة.
2- سرعة الفصل في النزاعات: مقارنة بالقضاء، يتميز التحكيم بسرعة إصدار الأحكام، مما يحد من التأخيرات التي قد تعطل تنفيذ المشاريع. قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 يحدد إجراءات مرنة لتسريع عملية التحكيم، مثل السماح للأطراف بالاتفاق على مدة محددة لإصدار الحكم.
3- الحد من التكلفة المالية للنزاع: رغم أن التحكيم قد يكون مكلفًا في بعض الحالات، إلا أنه أقل تكلفة من التقاضي المطول في المحاكم، خاصة في المشاريع الكبرى. تقليل فترات النزاع يُساهم في تجنب الخسائر المالية الناتجة عن توقف المشاريع.
السرية وحماية سمعة الأطراف: يتميز التحكيم بالسرية التامة، مما يحمي الأطراف من تأثير النزاعات على سمعتها التجارية. على عكس القضاء، حيث تكون الجلسات علنية، فإن إجراءات التحكيم تظل محصورة بين الأطراف المعنية.
ثالثًا: مقارنة بين التحكيم الهندسي والقضاء العادي في السودان: يُظهر الجدول التالي أهم الفروقات بين التحكيم الهندسي والقضاء العادي فيما يتعلق بتسوية النزاعات الهندسية في السودان:
| المعيار | القضاء العادي | التحكيم الهندسي |
| مدة الفصل في النزاع | بطيئة (قد تمتد لسنوات) | سريعة (عدة أشهر) |
| الخبرة الفنية | القضاة ليسوا دائما متخصصين | محكمون متخصصون في الهندسة |
| المرونة في الإجراءات | إجراءات قانونية مقيدة | إجراءات مرنة يتم الاتفاق عليها |
| التكاليف | التكاليف القانونية قد تكون مرتفعة بسبب طول مدة التقاضي | قد تكون مرتفعة لكنها أقل من التقاضي الطويل |
| السرية | القضايا علنية ويمكن أن تؤثر على سمعة الأطراف | سرية تامة تحمي الأطراف |
| قابلية الطعن | يمكن الطعن في الأحكام أمام درجات متعددة من المحاكم | محدودة جداً |
يتضح من هذه المقارنة أن التحكيم يُعد الخيار الأمثل لحل النزاعات الهندسية، حيث يضمن سرعة الفصل في النزاع، وجودة القرارات الصادرة، والمرونة في الإجراءات، في حين أن القضاء العادي قد يكون بطيئًا، مكلفًا، ويفتقر إلى الخبرة الفنية المتخصصة.
ونظرًا لتعقيد المشاريع الهندسية، فإن النزاعات الناشئة عنها تحتاج إلى وسيلة تسوية سريعة وفعالة، وهو ما يوفره التحكيم مقارنة بالقضاء العادي. فبينما يتميز القضاء بطول مدة التقاضي والتكاليف العالية، يوفر التحكيم المرونة، السرعة، والتخصص، مما يجعله الحل الأمثل لمعالجة الخلافات في العقود الهندسية.
في السودان، رغم أن قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 يوفر إطارًا قانونيًا متطورًا للتحكيم الهندسي، إلا أن هناك حاجة لتطوير مراكز تحكيم متخصصة، وتعزيز ثقافة التحكيم بين الشركات الهندسية والمقاولين، لضمان أقصى استفادة من هذه الآلية.
المبحث الثاني: التنظيم القانوني للتحكيم في العقود الهندسية في السودان
يُعد التحكيم أحد أهم الوسائل البديلة لحل النزاعات في العقود الهندسية، حيث يتيح للأطراف الفصل في نزاعاتهم خارج نطاق القضاء التقليدي، مما يسهم في تحقيق العدالة بطرق أكثر سرعة وكفاءة. في السودان، يخضع التحكيم إلى تنظيم قانوني متكامل، يتجسد في قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، والذي تم إعداده ليتماشى مع المعايير الدولية، مثل اتفاقية نيويورك 1958 للاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها.
ورغم أن القانون السوداني يعترف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات الهندسية، إلا أن هناك جدلًا حول مدى انسجامه مع القوانين الدولية، بالإضافة إلى دور المحاكم السودانية في دعم أو التدخل في عمليات التحكيم. وعليه، سيناقش هذا المبحث الإطار القانوني للتحكيم في السودان، ومدى توافقه مع المعايير الدولية، ودور المحاكم السودانية في دعم التحكيم أو التدخل فيه.
المطلب الأول: القوانين الحاكمة للتحكيم في السودان:
أولًا: قانون التحكيم السوداني لسنة 2016م: يُعد قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم التحكيم في السودان، حيث يحدد الإجراءات، نطاق التطبيق، وشروط صحة اتفاق التحكيم. وقد جاء هذا القانون ليحل محل القوانين السابقة، وليتماشى مع التطورات العالمية في مجال التحكيم.
أهم ملامح القانون:
1- إمكانية الاتفاق على التحكيم: يتيح القانون للأطراف في أي عقد الاتفاق على إحالة النزاعات إلى التحكيم، سواء قبل نشوء النزاع (بإدراج شرط التحكيم في العقد) أو بعد نشوء النزاع باتفاق لاحق (المادة 4).
2- استقلالية شرط التحكيم: تنص المادة 5 على أن شرط التحكيم مستقل عن العقد الأصلي، مما يعني أن بطلان العقد الأساسي لا يؤثر على صحة شرط التحكيم.
3- تحديد هيئة التحكيم: يُعطي القانون الأطراف حرية تحديد عدد المحكمين واختيارهم، على أن يكون العدد فرديًا (المادة 10).
4- الإجراءات التحكيمية: ينظم القانون إجراءات التحكيم، بما في ذلك تقديم المذكرات، جلسات الاستماع، وصدور الأحكام، مع التأكيد على ضرورة توفير العدالة والحياد (المادة 18).
5- تنفيذ قرارات التحكيم: وفقًا للمادة 34، تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة، ويمكن تنفيذها عبر المحاكم المختصة ما لم تكن مخالفة للنظام العام.
6- إمكانية الطعن المحدودة: يحدد القانون الحالات التي يمكن فيها الطعن على حكم التحكيم، مثل مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو التعارض مع النظام العام (المادة 36).
ثانيًا: مدى انسجام القانون السوداني مع المعايير الدولية (اتفاقية نيويورك 1958): تُعتبر اتفاقية نيويورك 1958 من أهم المعاهدات الدولية التي تنظم تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، حيث تلزم الدول الموقعة عليها بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها وفقًا لشروط معينة. وقد انضم السودان إلى الاتفاقية، مما يعكس التزامه بتعزيز التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات.
مدى توافق قانون التحكيم السوداني مع اتفاقية نيويورك: الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية: تنص المادة 38 من قانون التحكيم السوداني على أن المحاكم السودانية تلتزم بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يتفق مع اتفاقية نيويورك.
الأسباب المحدودة لرفض التنفيذ: يحدد القانون أسبابًا معينة فقط لرفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، مثل مخالفة النظام العام أو غياب اتفاق التحكيم الصحيح، وهي أسباب تتماشى مع المادة V من اتفاقية نيويورك.
استقلالية التحكيم عن القضاء: مثلما توصي المعايير الدولية، فإن القانون السوداني يقلل من تدخل القضاء في التحكيم، مما يعزز استقلاليته.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات، مثل غياب محاكم متخصصة في التحكيم، مما قد يؤثر على سرعة تنفيذ الأحكام التحكيمية في السودان.
ثالثًا: دور المحاكم السودانية في دعم أو التدخل في التحكيم: تلعب المحاكم السودانية دورًا مزدوجًا في التحكيم؛ فهي تدعمه من خلال تنفيذ الأحكام التحكيمية، لكنها في بعض الحالات قد تتدخل، مما يثير مخاوف بشأن تأثير القضاء على فعالية التحكيم.
1- دعم المحاكم للتحكيم: وفقًا لقانون التحكيم، تختص المحكمة المدنية العليا بالنظر في طلبات تنفيذ أحكام التحكيم. كما تمنح المحاكم السودانية سلطة تعيين المحكمين في حالة فشل الأطراف في ذلك، مما يضمن استمرار عملية التحكيم بسلاسة (المادة 11). ويُمكن للمحاكم إصدار أوامر وقتية لحماية حقوق الأطراف أثناء التحكيم، مثل تجميد الأصول أو وقف تنفيذ العقود.
2- التدخل القضائي في التحكيم: رغم أن القانون يسعى إلى تقليل تدخل القضاء، إلا أن بعض الحالات تشهد تدخلًا غير مرغوب فيه من المحاكم، مثل: إلغاء قرارات التحكيم لأسباب غير واضحة، مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني. وبطء إجراءات تنفيذ الأحكام التحكيمية، حيث قد تستغرق المحكمة فترة طويلة قبل البت في التنفيذ. والتوسع في تفسير “مخالفة النظام العام”، مما يسمح للمحاكم بإلغاء بعض قرارات التحكيم بحجة أنها تتعارض مع القانون السوداني، حتى لو لم تكن هناك أسباب جوهرية لذلك.
هذه العوامل قد تؤثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في نظام التحكيم في السودان، مما يستدعي ضرورة تعزيز التدريب القضائي المتخصص في التحكيم وتقليل التدخل غير المبرر.
ويُعد قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 خطوة مهمة نحو تعزيز التحكيم في العقود الهندسية، حيث يوفر إطارًا قانونيًا يتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية نيويورك 1958. كما أن دور المحاكم في دعم التحكيم يعزز من فعاليته، لكن لا يزال هناك تحدٍ يتمثل في بعض أوجه التدخل القضائي غير المبرر، مما يتطلب إصلاحات قانونية لتعزيز استقلالية التحكيم وضمان سرعة تنفيذ الأحكام.
المطلب الثاني: اتفاق التحكيم في العقود الهندسية
يُعد اتفاق التحكيم من أهم الركائز التي يقوم عليها التحكيم في العقود الهندسية، حيث يمثل الأساس القانوني لإحالة النزاعات إلى هيئة تحكيمية بدلاً من القضاء العادي. ويُدرج هذا الاتفاق عادةً في العقد الهندسي على شكل شرط تحكيم مسبق أو يتم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع من خلال مشارطة تحكيم مستقلة.
يتطلب اتفاق التحكيم توافر شروط قانونية محددة لضمان صحته وقابليته للتنفيذ، وإلا فقد يكون عرضة للبطلان أو عدم التنفيذ. كما أن لهذا الاتفاق آثار قانونية ملزمة للأطراف، حيث يحدد اختصاص الهيئة التحكيمية ويفرض قيودًا على اللجوء إلى المحاكم. ومع ذلك، قد تنشأ إشكاليات تتعلق ببطلان شرط التحكيم أو عدم تنفيذه، سواء بسبب عيوب في الاتفاق أو نتيجة لعدم تعاون أحد الأطراف.
يهدف هذا المطلب إلى دراسة شروط صحة شرط التحكيم في العقود الهندسية، آثاره القانونية، وأبرز الإشكاليات المرتبطة ببطلانه أو عدم تنفيذه.
أولًا: شروط صحة شرط التحكيم في العقود الهندسية: يُعد شرط التحكيم في العقود الهندسية اتفاقًا قانونيًا يتطلب توافر شروط أساسية لضمان صحته وقابليته للتنفيذ، وذلك وفقًا لقانون التحكيم السوداني لسنة 2016 والمعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك 1958م.
1- توافر الأهلية القانونية للأطراف: يجب أن يكون الأطراف المتعاقدون ذوي أهلية قانونية كاملة عند إبرام شرط التحكيم، وإلا عُد الاتفاق باطلًا. وفي العقود الهندسية، تكون الأهلية مطلوبة لأصحاب الشركات والمقاولين والاستشاريين الذين يوقعون العقود.
2- وضوح اتفاق التحكيم وتحديد نطاقه: يجب أن يكون اتفاق التحكيم واضحًا ومحددًا، بحيث يتضمن:
أ- نوع النزاعات التي يشملها التحكيم (مثل النزاعات المالية أو الفنية).
ب- الإجراءات المتبعة في التحكيم (مثل القواعد الإجرائية، مكان التحكيم، لغة التحكيم).
ج- عدم الوضوح في تحديد هذه الأمور قد يؤدي إلى نزاعات حول صلاحية شرط التحكيم.
3- استقلالية شرط التحكيم عن العقد الأساسي: وفقًا للمادة 5 من قانون التحكيم السوداني، فإن شرط التحكيم مستقل عن العقد الأساسي، بمعنى أن بطلان العقد لا يؤدي بالضرورة إلى بطلان شرط التحكيم، إلا إذا كان شرط التحكيم ذاته غير قانوني.
4- أن يكون شرط التحكيم مكتوبًا: يشترط القانون السوداني أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، سواء كان في العقد الأساسي أو في اتفاق منفصل (المادة 7 من قانون التحكيم السوداني). ويمكن أن يكون الاتفاق في شكل وثيقة مكتوبة، تبادل رسائل إلكترونية، أو إشارة إلى نظام تحكيم معتمد.
5- عدم مخالفة النظام العام: لا يكون شرط التحكيم صحيحًا إذا كان يتعارض مع النظام العام السوداني أو التشريعات الوطنية، مثل التحكيم في القضايا الجنائية أو المسائل المتعلقة بالحقوق السيادية.
ثانيًا: آثار اتفاق التحكيم على أطراف العقد: يؤدي اتفاق التحكيم إلى آثار قانونية ملزمة للأطراف المتعاقدة، حيث يؤثر على حقوقهم والتزاماتهم فيما يتعلق بتسوية النزاعات الناشئة عن العقد الهندسي، وهذه الآثار هي:
1- التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء: بمجرد توقيع اتفاق التحكيم، يُصبح الأطراف ملزمين قانونيًا بعدم اللجوء إلى المحاكم لحل النزاع، إلا في الحالات التي يسمح فيها القانون بذلك (المادة 8 من قانون التحكيم السوداني). إذا لجأ أحد الأطراف إلى المحكمة، يمكن للطرف الآخر الدفع بعدم الاختصاص بسبب وجود اتفاق تحكيم.
2- تحديد اختصاص هيئة التحكيم: يُحدد اتفاق التحكيم سلطة الهيئة التحكيمية في الفصل في النزاع، ويمنحها الصلاحية لإصدار قرارات ملزمة. يحق للأطراف الاتفاق على تعيين المحكمين، إجراءات التحكيم، والقوانين المطبقة.
3- الأثر على تنفيذ العقود الهندسية: قد يُؤدي شرط التحكيم إلى تأخير تنفيذ المشاريع الهندسية إذا نشأ نزاع يتطلب الفصل فيه عبر التحكيم، مقارنة بحل النزاع بشكل مباشر عبر المحاكم. ومع ذلك، فإن التحكيم يساعد في تفادي تعطيل المشروع بالكامل من خلال تقديم حلول أسرع وأكثر تخصصًا.
ثالثًا: إشكاليات بطلان شرط التحكيم أو عدم تنفيذه: رغم أن اتفاق التحكيم يُعتبر ملزمًا قانونيًا، إلا أن هناك إشكاليات قانونية قد تؤدي إلى بطلانه أو عدم تنفيذه، ومنها:
1- بطلان شرط التحكيم بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية: إذا لم يكن اتفاق التحكيم مكتوبًا أو كان غامضًا فيما يتعلق بنطاق النزاع أو إجراءات التحكيم، فقد يتم الطعن عليه بالبطلان. وفي بعض الحالات، قد يتمسك أحد الأطراف بأن شرط التحكيم تم إدراجه في العقد دون علمه أو دون موافقته الصريحة.
2- امتناع أحد الأطراف عن تنفيذ اتفاق التحكيم: قد يرفض أحد الأطراف تعيين المحكمين أو المشاركة في إجراءات التحكيم، مما يؤدي إلى تأخير حل النزاع. في هذه الحالة، يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة لطلب تعيين محكم بديل وفقًا للمادة 11 من قانون التحكيم السوداني.
3- صعوبة تنفيذ أحكام التحكيم: رغم أن السودان طرف في اتفاقية نيويورك 1958، إلا أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية قد يواجه معوقات قانونية، خاصة إذا تم الدفع بأن الحكم يخالف النظام العام. وقد تلجأ بعض المحاكم إلى إلغاء حكم التحكيم أو عرقلة تنفيذه، مما يضعف الثقة في التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الهندسية.
4- تعارض شرط التحكيم مع قوانين العقود الهندسية المحلية: بعض العقود الهندسية في السودان تخضع لتشريعات وزارة الأشغال العامة أو الجهات الحكومية، والتي قد تتطلب تسوية النزاعات عبر لجان متخصصة بدلاً من التحكيم. وفي هذه الحالات، قد يتم الطعن في شرط التحكيم بحجة عدم توافقه مع القوانين الوطنية المنظمة للمقاولات.
ويُعتبر اتفاق التحكيم في العقود الهندسية عنصرًا أساسيًا لضمان حل النزاعات بطريقة فعالة وسريعة، شريطة استيفاء شروطه القانونية. ومع ذلك، فقد يواجه شرط التحكيم تحديات مثل البطلان أو عدم التنفيذ بسبب نقص الوضوح القانوني أو تدخل المحاكم. لذا، يُوصى بضرورة تعزيز الوعي بأهمية التحكيم، وضمان توافق شرط التحكيم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية، لضمان فعاليته كوسيلة لحل النزاعات في المشاريع الهندسية.
المطلب الثالث: إجراءات التحكيم في العقود الهندسية:
تتسم العقود الهندسية بالتعقيد الفني والقانوني، مما يستلزم وجود آلية متخصصة لحل النزاعات الناشئة عنها. التحكيم، باعتباره وسيلة بديلة للتقاضي، يخضع لإجراءات منظمة تحدد كيفية تعيين المحكمين، والقواعد التي تحكم سير العملية التحكيمية، وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن هيئات التحكيم.
في هذا الإطار، تُعد إجراءات التحكيم أمرًا جوهريًا لضمان تحقيق العدالة بين الأطراف، حيث يتم تحديد كيفية تشكيل هيئة التحكيم، والقواعد الإجرائية التي سيتم اتباعها، بالإضافة إلى مدى إلزامية تنفيذ قرارات التحكيم في السودان. لذا، يهدف هذا المطلب إلى دراسة تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين، القواعد الإجرائية المعتمدة في التحكيم الهندسي، ومدى إلزامية تنفيذ قرارات التحكيم في السودان.
أولًا: تشكيل هيئة التحكيم واختيار المحكمين: يُعتبر تشكيل هيئة التحكيم من الخطوات الأساسية في التحكيم الهندسي، حيث يجب أن تتوفر في المحكمين الخبرة القانونية والفنية لضمان الفصل العادل في النزاعات:
1- عدد المحكمين وتعيينهم: وفقًا للمادة 10 من قانون التحكيم السوداني لسنة 2016، يجوز للأطراف الاتفاق على عدد المحكمين، بشرط أن يكون العدد فرديًا. وفي حالة عدم اتفاق الأطراف، يتم تعيين هيئة من ثلاثة محكمين، حيث يقوم كل طرف باختيار محكم، ثم يتفق المحكمان المختاران على تعيين المحكم الثالث الذي يترأس الهيئة. وإذا لم يتمكن الأطراف من تعيين المحكمين، يحق للمحكمة المختصة التدخل لتعيينهم وفقًا للمادة 11 من القانون.
2- معايير اختيار المحكمين في العقود الهندسية: يجب أن يكون المحكمون ذوي خبرة في العقود الهندسية، خاصة عند التعامل مع عقود FIDIC أو المشاريع الكبرى. وغالبًا ما يكون المحكم الرئيسي قاضيًا سابقًا أو محاميًا متخصصًا في التحكيم الهندسي، بينما يكون المحكمان الآخران من المهندسين الاستشاريين أو الخبراء الفنيين. يشترط أن يكون المحكم محايدًا ومستقلًا عن الأطراف المتنازعة، وألا يكون له مصلحة مباشرة في النزاع.
ثانيًا: القواعد الإجرائية المعتمدة (مثل قواعد (FIDIC) أو (ICC): تخضع إجراءات التحكيم في العقود الهندسية إلى قواعد قانونية دولية ومحلية، من أبرزها قواعد (FIDIC) الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية، وقواعد (ICC) غرفة التجارة الدولية.
1- قواعد FIDIC في التحكيم الهندسي: في العقود الهندسية الدولية، تنص شروط FIDIC على ضرورة إحالة النزاعات إلى مجلس فض النزاعات (DAB) قبل اللجوء إلى التحكيم. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم وفقًا لقواعد محكمة التحكيم الدائمة أو قواعد التحكيم التابعة لـ ICC. وتُطبق هذه القواعد بشكل واسع في العقود الهندسية الكبيرة، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات الحكومية.
2- قواعد (ICC) غرفة التجارة الدولية: توفر غرفة التجارة الدولية (ICC) قواعد تحكيم موحدة تُطبق في النزاعات الهندسية، وتتميز بـ:
أ- إجراءات سريعة للفصل في النزاعات الهندسية.
ب- إمكانية تعيين محكمين متخصصين في المجال الهندسي.
ج- إلزامية تنفيذ قرارات التحكيم عبر المحاكم المحلية للدول الأعضاء.
3- القواعد الإجرائية وفقًا لقانون التحكيم السوداني: ينظم قانون التحكيم السوداني 2016 الإجراءات التي يجب اتباعها، حيث يتطلب من الأطراف:
أ- تقديم طلب التحكيم رسميًا، يوضح تفاصيل النزاع.
ب- تقديم الدفوع القانونية والمذكرات الفنية.
ج- عقد جلسات استماع، تتضمن شهادات الخبراء والفحص الفني للعقد الهندسي.
د- إصدار القرار التحكيمي خلال المدة المتفق عليها، أو خلال 6 أشهر في حال عدم الاتفاق (المادة 28 من قانون التحكيم السوداني).
ثالثًا: تنفيذ قرارات التحكيم في السودان ومدى إلزاميتها: يُعد تنفيذ قرارات التحكيم من أكثر المراحل حساسية، حيث يحدد مدى فعالية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات الهندسية.
1- مدى إلزامية قرارات التحكيم في السودان: تنص المادة 34 من قانون التحكيم السوداني على أن قرارات التحكيم نهائية وملزمة للأطراف، ولا يجوز استئنافها إلا في حالات استثنائية مثل:
أ- إذا كان الحكم مخالفًا للنظام العام السوداني.
ب- إذا ثبت وجود فساد أو تحيز في هيئة التحكيم.
ج- إذا صدر الحكم بناءً على اتفاق تحكيم باطل.
2- إجراءات تنفيذ قرارات التحكيم: يتم تقديم طلب تنفيذ قرار التحكيم إلى المحكمة المختصة، مرفقًا بـ:
أ- نسخة أصلية من حكم التحكيم.
ب- ترجمة رسمية للحكم إذا كان بلغة أجنبية.
ج- إثبات إخطار الطرف الآخر بالحكم.
ويمكن للمحكمة رفض تنفيذ الحكم إذا تبين أنه يخالف القوانين السودانية أو أنه صدر بطريقة غير قانونية.
3- تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في السودان: السودان طرف في اتفاقية نيويورك 1958، مما يعني أن قرارات التحكيم الأجنبية يمكن تنفيذها مباشرة في السودان، شريطة أن تستوفي الشروط التالية:
أ- أن يكون الحكم صادراً عن هيئة تحكيم معترف بها.
ب- ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو القوانين السودانية.
ج- أن يكون الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها.
تُعد إجراءات التحكيم في العقود الهندسية عنصرًا جوهريًا لضمان العدالة والسرعة في الفصل في النزاعات. يبدأ التحكيم بتشكيل هيئة التحكيم وفق معايير قانونية وفنية، ويستند إلى قواعد إجرائية معترف بها دوليًا مثل FIDIC وICC، ثم يُصدر الحكم التحكيمي الذي يتم تنفيذه في السودان وفقًا لقانون التحكيم واتفاقية نيويورك 1958. رغم أن قرارات التحكيم ملزمة ونهائية، إلا أن تنفيذها قد يواجه عقبات قانونية تتطلب إصلاحات لضمان سرعة التنفيذ وتعزيز ثقة المستثمرين في التحكيم الهندسي.
المبحث الثالث: تحديات التحكيم في العقود الهندسية وآفاق تطويره في السودان
يشهد مجال التحكيم في العقود الهندسية في السودان تطورًا تدريجيًا، إلا أنه ما يزال يواجه عددًا من التحديات التي تؤثر على فعاليته كوسيلة لحل النزاعات. تتنوع هذه التحديات من ضعف الوعي القانوني حول أهمية التحكيم، إلى صعوبات تنفيذ الأحكام التحكيمية، فضلًا عن نقص في المراكز المتخصصة في التحكيم الهندسي.
تعتبر تحديات التحكيم في العقود الهندسية عقبة أمام تسوية النزاعات بشكل فعال وسريع، مما ينعكس على تطوير المشاريع الهندسية وتفعيل الاستثمارات في السودان. يهدف هذا المبحث إلى تحليل التحديات الرئيسية التي يواجهها التحكيم الهندسي في السودان، كما سيتم تسليط الضوء على آفاق تطوير آليات التحكيم لتجاوز هذه العوائق وتحسين أداء النظام التحكيمي.
المطلب الأول: تحديات التحكيم في العقود الهندسية بالسودان:
توجد عدة تحديات تؤثر على فعالية التحكيم في العقود الهندسية في السودان. تتراوح هذه التحديات بين قانونية وفنية، وتؤثر بشكل مباشر على سير العملية التحكيمية وقدرة الأطراف على الوصول إلى حلول مرضية وسريعة. من أبرز هذه التحديات هي ضعف الوعي القانوني، صعوبات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وقلة المراكز المتخصصة في التحكيم الهندسي.
1- ضعف الوعي القانوني بأهمية التحكيم: من أكبر التحديات التي يواجهها التحكيم في العقود الهندسية في السودان هو ضعف الوعي القانوني بين الأطراف المتعاقدة حول أهمية التحكيم كوسيلة فعالة لحل النزاعات.
والوعي المحدود لدى الشركات الهندسية والمقاولين بأهمية إدراج شرط التحكيم في عقودهم الهندسية يؤثر سلبًا على قدرتهم على حل النزاعات بسرعة وفعالية. وكثير من الأطراف لا يدركون الفوائد القانونية والفنية للتحكيم، بما في ذلك السرعة، التخصص، وتوفير النفقات مقارنة بالقضاء العادي.
والجهل بالإجراءات التحكيمية المعتمدة والممارسات الدولية مثل قواعد (FIDIC) و(ICC) يعيق من فهم الأطراف لكيفية تنفيذ قرارات التحكيم في حالات النزاع.
2- صعوبات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية: على الرغم من أن السودان يعد طرفًا في اتفاقية نيويورك 1958، إلا أن هناك صعوبات عملية تواجه تنفيذ الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج.
تنشأ مشاكل قانونية في تأكيد تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في المحاكم السودانية، خاصة في حال كانت الأحكام متعارضة مع النظام العام السوداني.
وهناك حالة من عدم التنسيق بين محاكم التحكيم المحلية والمحاكم السودانية، مما يؤدي إلى تعقيد تنفيذ الأحكام أو إبطاء الإجراءات القضائية ذات الصلة. إضافة إلى ذلك، قد يواجه المستثمرون الأجانب صعوبة في ضمان تنفيذ قرارات التحكيم في ظل غياب مراكز تحكيم متخصصة.
3- قلة مراكز التحكيم المتخصصة في المجال الهندسي: على الرغم من الحاجة الملحة إلى وجود مراكز تحكيم متخصصة في العقود الهندسية، إلا أن السودان لا يزال يعاني من نقص حاد في هذه المراكز.
لا توجد مراكز تحكيم معترف بها دوليًا تعمل على تسوية النزاعات الهندسية بشكل متكامل، مما يحد من قدرة الأطراف على اللجوء إلى محكمين متخصصين في القضايا الهندسية.
كثير من المراكز الحالية تفتقر إلى الخبرة الفنية في التحكيم الهندسي، حيث أن غالبية المحكمين لا يتمتعون بخبرة متخصصة في مجال الهندسة أو المشاريع الضخمة.
إضافة إلى ذلك، تقتصر إجراءات التحكيم المحلية على القواعد العامة، مما يؤدي إلى افتقارها إلى التخصص في القضايا المتعلقة بعقود المقاولات والتصميمات الهندسية.
4- تحديات قانونية وإجرائية أخرى: الطابع الغامض لبعض القوانين المحلية المتعلقة بالتحكيم، مثل تلك التي تتعلق بـ أحكام التحكيم المؤقتة أو التنفيذ العاجل للأحكام.
تزايد الدعاوى القضائية أمام المحاكم التقليدية بسبب ضعف إيمان الأطراف بنظام التحكيم، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء على النظام القضائي.
عدم وجود آليات فعالة لضمان تطبيق الأحكام التحكيمية على الأطراف المتعنتة، مما يُعطل العدالة التحكيمية في العديد من الحالات.
يعد التحكيم في العقود الهندسية في السودان أداة حيوية لحل النزاعات في هذا القطاع المهم. ومع ذلك، يواجه هذا النظام العديد من التحديات التي تؤثر سلبًا على فعاليته. إن زيادة الوعي القانوني، تسهيل تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وإنشاء مراكز تحكيم متخصصة هي خطوات أساسية لتطوير التحكيم الهندسي في السودان. ومن المهم أن يعمل المجتمع القانوني والمهني على إزالة هذه العقبات وتطوير بيئة قانونية تسهم في تعزيز الاستثمارات وتحقيق العدالة في النزاعات الهندسية.
المطلب الثاني: مقترحات تطوير التحكيم في العقود الهندسية
يعتبر التحكيم في العقود الهندسية أداة حاسمة لضمان تسوية فعالة وسريعة للنزاعات التي قد تنشأ في إطار المشاريع الهندسية الكبرى. ولكن في ضوء التحديات التي تم استعراضها في المطلب السابق، أصبح من الضروري العمل على تطوير نظام التحكيم ليصبح أكثر فاعلية وكفاءة. من خلال تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز دور المراكز التحكيمية الوطنية وتوسيع نطاق ثقافة التحكيم الهندسي بين الأطراف المعنية، يمكن للسودان أن يُحسن بيئة التحكيم الهندسي ويجعلها أكثر توافقًا مع المعايير الدولية.
في هذا المطلب، سيتم طرح مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير التحكيم في العقود الهندسية في السودان. تشمل هذه المقترحات تحديث التشريعات السودانية لتواكب المعايير الدولية، تعزيز دور مراكز التحكيم الوطنية، ونشر ثقافة التحكيم الهندسي بين المقاولين والاستشاريين.
1- تحديث التشريعات السودانية بما يتماشى مع المعايير الدولية: تعد التشريعات أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على فعالية نظام التحكيم، وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية يساعد في تحسين النظام القانوني بشكل عام.
أ- ضرورة تحديث قانون التحكيم السوداني: يقتضي الأمر تحديث قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية نيويورك 1958. يجب أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر وضوحًا فيما يتعلق بإجراءات التحكيم، خاصة في الحالات التي تتعلق بالنزاعات الهندسية.
يوصى بتعديل القانون ليعكس ممارسات التحكيم الحديثة، مثل التحكيم الإلكتروني في النزاعات الدولية، أو إعطاء مرونة أكبر في اختيار المحكمين ذوي الخبرة الفنية في القضايا الهندسية. تحسين تنفيذ أحكام التحكيم سواء كانت محلية أو دولية، وضمان سهولة تطبيقها عبر آليات أكثر شفافية وسلاسة.
ب- التوافق مع المعايير الدولية: على المشرع السوداني الانضمام إلى اتفاقيات دولية أخرى مثل اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقوبات التحكيم التجاري الدولي وقانون النموذج للتحكيم التجاري الدولي، من أجل تسهيل تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية.
يجب أن يتم تعزيز الاستقلالية والحيادية للمحكمين في العقود الهندسية، بحيث يتم الالتزام بمعايير دولية ثابتة تضمن النزاهة وعدم التأثير السياسي على عملية التحكيم.
2- تعزيز دور مراكز التحكيم الوطنية: يعد دور مراكز التحكيم الوطنية من الأركان الأساسية في تحسين كفاءة التحكيم الهندسي، حيث يمكن للمراكز المتخصصة أن تسهم في توفير محكمين ذوي خبرة في المجال الهندسي، فضلًا عن التركيز على الإجراءات المتخصصة.
أ- إنشاء مراكز تحكيم متخصصة في المجال الهندسي: ينبغي على السودان العمل على تأسيس مراكز تحكيم متخصصة في القضايا الهندسية الكبرى، تكون تابعة للهيئات القانونية الرسمية مثل غرفة التجارة السودانية.
تتيح هذه المراكز توفير محكمين متخصصين في مجال الهندسة، والذين يمتلكون الخبرة الفنية اللازمة لفهم العقود الهندسية المعقدة. ويجب أن تتبنى هذه المراكز قواعد تحكيم دولية معترف بها مثل قواعد (FIDIC) أو (ICC)، بحيث تضمن تسوية النزاعات بأسلوب قانوني فاعل ومتوافق مع المعايير الدولية.
ب- تدريب المحكمين المتخصصين: من الضروري تدريب المحكمين في السودان على أحدث التقنيات القانونية والهندسية، من خلال دورات تعليمية وورش عمل مع مؤسسات دولية متخصصة في التحكيم الهندسي.
التدريب يشمل أيضًا تطوير القدرات التقنية للمحكمين ليتمكنوا من فهم تعقيدات العقود الهندسية والاستفادة من الخبرات الهندسية والمالية اللازمة.
3- نشر ثقافة التحكيم الهندسي بين المقاولين والاستشاريين: تلعب ثقافة التحكيم دورًا مهمًا في تحفيز الأطراف المعنية على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من القضاء التقليدي.
أ- نشر ثقافة التحكيم الهندسي: يجب نشر الوعي بين المقاولين والاستشاريين الهندسيين حول أهمية التحكيم كأداة لحل النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة. يمكن أن يتم ذلك عبر دورات توعوية وندوات متخصصة من قبل مراكز التحكيم والهيئات القانونية.
يجب أن تركز الحملات التوعوية على الفوائد العملية للتحكيم في العقود الهندسية، مثل توفير الوقت والمال مقارنة بالقضاء التقليدي. وإشراك الجامعات والمعاهد الهندسية في نشر هذه الثقافة من خلال إدخال موضوعات التحكيم الهندسي ضمن مناهجها.
ب- تشجيع المقاولين على إدراج شرط التحكيم: يجب على المؤسسات القانونية والمقاولين إدراج شرط التحكيم في عقودهم الهندسية لتسهيل الوصول إلى حلول تحكيمية في حال حدوث نزاع.
توعية المقاولين بالكيفية التي يمكن بها إدراج شروط التحكيم بوضوح ضمن عقود FIDIC أو عقود المقاولات المحلية، مما يسهل استخدام التحكيم عند الحاجة.
تطوير نظام التحكيم في العقود الهندسية في السودان يتطلب تحديث التشريعات، تعزيز دور مراكز التحكيم المتخصصة، وزيادة الوعي الثقافي بأهمية التحكيم الهندسي بين مختلف الأطراف المعنية. من خلال هذه المقترحات، يمكن للسودان أن يتقدم خطوة نحو تعزيز بيئة التحكيم، بما يساهم في تحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار في القطاع الهندسي. إذ يظل التحكيم أحد الوسائل الفعالة التي تساهم في حل النزاعات بشكل سريع وغير مكلف، ويجب تعزيز آليات تطبيقه لمواكبة التطورات القانونية الدولية.
المطلب الثالث: دراسة مقارنة مع تجارب دولية في التحكيم الهندسي:
يمثل التحكيم الهندسي أحد أبرز الوسائل لتسوية النزاعات في المشاريع الهندسية المعقدة، وذلك لما يقدمه من مزايا مقارنة بالقضاء التقليدي. ولكن رغم هذه المزايا، يواجه التحكيم في السودان تحديات قد تكون ناتجة عن عدم مواكبة التشريعات المحلية لأفضل الممارسات الدولية. ولتحقيق تحسينات حقيقية في نظام التحكيم الهندسي السوداني، يمكن النظر في التجارب الدولية ونماذج قوانين التحكيم في الدول العربية والدول المتقدمة.
يهدف هذا المطلب إلى دراسة مقارنة بين تجارب دولية في التحكيم الهندسي، لا سيما في الدول العربية والدول المتقدمة، مع التركيز على الدروس المستفادة من هذه التجارب. كما سنستعرض إمكانية تبني بعض الممارسات الناجحة في السودان، بما يسهم في تطوير نظام التحكيم الهندسي في البلاد.
1- نماذج من قوانين التحكيم في الدول العربية والدول المتقدمة:
أ- قوانين التحكيم في الدول العربية: تختلف قوانين التحكيم في الدول العربية، ولكن هناك نقاط مشتركة يمكن الاستفادة منها في تعزيز فعالية التحكيم الهندسي في السودان.
في مصر:
يمتاز قانون التحكيم المصري (القانون رقم 27 لسنة 1994) بأنه يتوافق مع المعايير الدولية، ويدعم التحكيم التجاري الدولي. يعكس القانون اهتمامًا بتطوير المحاكم التحكيمية على المستوى المحلي، كما يتيح مرونة في تشكيل هيئة التحكيم من خلال التوسع في شروط اختيار المحكمين. أما في مجال العقود الهندسية، فقد سمح بوجود مراكز تحكيم متخصصة تتعامل مع النزاعات الهندسية.
الدروس المستفادة: مرونة اختيار المحكمين، وتخصص مراكز التحكيم في القضايا الهندسية.
في الإمارات:
الإمارات العربية المتحدة تعتبر من الدول الرائدة في التحكيم على مستوى المنطقة، حيث تعتمد على قانون التحكيم الاتحادي (قانون رقم 6 لسنة 2018) الذي يتماشى مع اتفاقية نيويورك 1958. كما أن مركز دبي للتحكيم الدولي يقدم خدمات تحكيم متخصصة في النزاعات الهندسية عبر تطبيق قواعد (FIDIC).
الدروس المستفادة: وجود مراكز تحكيم متخصصة على مستوى إقليمي ودولي، والالتزام بالقواعد الدولية مثل (FIDIC).
2- قوانين التحكيم في الدول المتقدمة: الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تمتلك نظمًا متطورة للتحكيم الهندسي يمكن الاستفادة منها:
في الولايات المتحدة الأمريكية:
تعتمد الولايات المتحدة على قانون التحكيم الفيدرالي الذي يتيح تسوية النزاعات الهندسية عبر مراكز متخصصة، مع احترام مبادئ الحياد والاستقلالية. كما تدعم الولايات المتحدة مراكز التحكيم مثل مركز التحكيم الدولي في نيويورك، الذي يقدم خدمات تحكيم في القضايا الهندسية باستخدام قواعد (ICC).
الدروس المستفادة: احترام الحياد والاستقلالية، ودور مراكز التحكيم الدولية في تقديم التحكيم الهندسي.
في المملكة المتحدة:
تحتفظ المملكة المتحدة بنظام تحكيم قوي ومتطور يعتمد على قانون التحكيم لعام 1996. يتمتع هذا القانون بمرونة كبيرة ويُستخدم على نطاق واسع في حل النزاعات الهندسية، كما أن محكمة التحكيم البريطانية تقدم خدمات تحكيم دولية في القضايا الهندسية.
الدروس المستفادة: وجود إطار قانوني مرن، وتركيز على النزاعات الهندسية عبر محاكم متخصصة.
2- دروس مستفادة من التجارب الدولية: من خلال الاطلاع على تجارب الدول العربية والمتقدمة في مجال التحكيم الهندسي، يمكننا استخلاص مجموعة من الدروس التي يمكن أن تساهم في تحسين نظام التحكيم في السودان:
أ- أهمية التخصص في التحكيم الهندسي: تشير التجارب الدولية إلى أهمية التخصص في النزاعات الهندسية، حيث أن النزاعات في هذا المجال تتطلب معرفة فنية وتقنية للمشاكل المتعلقة بالبناء والهندسة.
يجب أن يعمل السودان على إنشاء مراكز تحكيم متخصصة تتعامل مع القضايا الهندسية بشكل حصري، مما يسهم في تسوية النزاعات بسرعة ودقة أكبر.
تدريب المحكمين المتخصصين في التحكيم الهندسي بحيث تكون لديهم معرفة فنية وقانونية بالقطاع.
ب- التوافق مع المعايير الدولية: توحيد الإجراءات مع المعايير الدولية مثل قواعد (FIDIC)، والتي تُستخدم في العديد من الدول، يعزز من القدرة على تنفيذ التحكيم الدولي.
يجب أن يسعى السودان لتطوير قانون التحكيم بحيث يتوافق مع اتفاقية نيويورك 1958 من حيث تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية في محاكمه. كما يجب أن يتم تطوير إطار قانوني يعزز الحياد والاستقلالية في محاكم التحكيم الهندسي.
3- إمكانية تبني بعض الممارسات الناجحة في السودان: بناءً على ما تم استعراضه من تجارب دولية، يمكن للسودان أن يتبنى بعض الممارسات الناجحة لتحسين فعالية التحكيم الهندسي، مثل: إدخال مراكز تحكيم متخصصة في العقود الهندسية تكون تابعة للهيئات القانونية السودانية، مما يعزز من قدرة البلاد على تسوية النزاعات الهندسية بشكل أكثر تخصصًا. وتبني قواعد (FIDIC) أو (ICC) في النظام التحكيمي السوداني، وتدريب المحكمين على هذه القواعد الدولية. وتطوير بنية تحتية قانونية تواكب التطورات العالمية في مجال التحكيم الهندسي، من خلال تحديث القوانين السودانية ليتماشى مع المعايير الدولية.
إن دراسة التجارب الدولية في التحكيم الهندسي تكشف عن أفضل الممارسات التي يمكن للسودان الاستفادة منها في تطوير نظام التحكيم المحلي. من خلال تبني التخصص، والتوافق مع المعايير الدولية، يمكن للسودان تحسين فعالية التحكيم الهندسي وزيادة جاذبية الاستثمارات في القطاع الهندسي. إن اعتماد ممارسات مثل إدخال مراكز تحكيم متخصصة وتبني قواعد التحكيم الدولية من شأنه أن يسهم في تعزيز الثقة في النظام التحكيمي السوداني وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.
الخاتمة
في ختام هذا البحث، تم تناول التحكيم في العقود الهندسية في السودان بشكل شامل، مع التركيز على تنظيمه القانوني، وأهمية التحكيم في تسوية النزاعات الهندسية. وقد توصلنا إلى عدد من النتائج الرئيسية التي تؤكد على أهمية تحسين هذا النظام في السودان، وأوصينا بعدد من التوصيات، يمكن ذكرها على النحو التالي:
أولاً: النتائج:
1- أهمية التحكيم في العقود الهندسية: يُعد التحكيم وسيلة فعالة لحل النزاعات الهندسية بشكل أسرع وأكثر كفاءة مقارنة بالقضاء التقليدي، حيث يساعد على تقليل الزمن والتكاليف المرتبطة بحل النزاعات.
2- الإطار القانوني للتحكيم في السودان: إن قانون التحكيم السوداني لسنة 2016 يحتاج إلى تحديث ليتماشى مع المعايير الدولية مثل اتفاقية نيويورك 1958، كما أن هناك حاجة لتطوير مراكز التحكيم المتخصصة في القضايا الهندسية.
3- التحديات التي تواجه التحكيم في السودان: تم تسليط الضوء على بعض التحديات مثل ضعف الوعي القانوني بأهمية التحكيم، صعوبات تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية، وقلة مراكز التحكيم المتخصصة.
4- دروس مستفادة من التجارب الدولية: تم التأكيد على أهمية تبني أفضل الممارسات الدولية، مثل التخصص في التحكيم الهندسي وتوحيد الإجراءات مع المعايير الدولية مثل قواعد (FIDIC) و (ICC)، مما يساعد في تحسين فعالية النظام التحكيمي في السودان.
ثانياً: توصيات البحث: بناءً على ما تم التوصل إليه من نتائج، يوصي هذا البحث بما يلي:
1- تحديث قانون التحكيم السوداني: ليواكب المعايير الدولية، ويُراعى فيه قواعد التحكيم الدولية مثل اتفاقية نيويورك 1958م، وقواعد (FIDIC) و (ICC)، لضمان سهولة تنفيذ الأحكام التحكيمية في السودان.
2- إنشاء مراكز تحكيم متخصصة في العقود الهندسية: يُوصى بتأسيس مراكز تحكيم متخصصة في النزاعات الهندسية، بحيث يتم اختيار محكمين ذوي خبرة فنية في هذا المجال، مما يساهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
3- نشر ثقافة التحكيم الهندسي: يجب العمل على نشر الوعي بين المقاولين والاستشاريين بأهمية التحكيم الهندسي، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية. يمكن تعزيز هذه الثقافة من خلال الجامعات والمعاهد الهندسية التي تشارك في تعليم مفاهيم التحكيم.
4- تعزيز التعاون مع مراكز التحكيم الدولية: على السودان تعزيز علاقاته مع مراكز التحكيم الدولية مثل مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز التحكيم في نيويورك، لاستفادة من خبراتهم في تسوية النزاعات الهندسية الدولية.
5- تشجيع المحكمين على التخصص: ينبغي على السودان إنشاء برامج تدريبية متخصصة لتحسين قدرات المحكمين في القضايا الهندسية، مع التركيز على تطوير المهارات الفنية والقانونية للمحكمين.
6- تبني أفضل الممارسات الدولية: يجب على السودان تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم الهندسي، خاصة تلك المعتمدة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من أجل تحسين نظام التحكيم وتعزيز الثقة فيه.
إن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يساهم في تحسين بيئة التحكيم الهندسي في السودان، مما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات وتحقيق العدالة في تسوية النزاعات المتعلقة بالمشاريع الهندسية.
المراجع باللغة العربية:
اتفاقية نيويورك 1958م بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
أحمد الهادي، مزايا التحكيم الهندسي مقارنة بالقضاء التقليدي، (القاهرة: دار الفكر العربي، (2020).
أحمد سليمان، التحكيم التجاري الدولي في الدول العربية، الطبعة الثانية، (القاهرة: دار النهضة العربية، 2018).
أحمد كامل، فض النزاعات في عقود المقاولات، (القاهرة: دار النهضة العربية، (2021).
قانون التحكيم الإماراتي، 2018.
قانون التحكيم البريطاني، 1996.
قانون التحكيم السوداني للعام 2016م.
قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي، 2018.
قانون التحكيم المصري، 1994.
قانون المعاملات المدنية السوداني، 1984م.
المجلس الهندسي السوداني، تطوير أسس التحكيم الهندسي في السودان، الخرطوم، 2022.
محمد السيد، القانون الهندسي والتحكيم في المشاريع الإنشائية، (القاهرة: دار الفكر الجامعي، 2020).
محمد عبد الله، التحكيم في العقود الهندسية وفقًا لقواعد الفيديك، المجلة العربية للتحكيم، العدد 10، (2020).
محمد عبد الله، النزاعات في عقود الإنشاءات ودور التحكيم في حلها، المجلة العربية للتحكيم، العدد 12، (2021).
يوسف عبد الرحمن، العقود الهندسية في القانون السوداني، المجلة القانونية السودانية، العدد 5، (2019).
المراجع باللغة الإنجليزية:
David Jones ، Construction Contracts: Principles and Practice, Oxford Press, 2018.
FIDIC، Conditions of Contract for Construction (Red Book), Second Edition, (2017).
FIDIC، Conditions of Contract for Construction, 2017.
FIDIC، The FIDIC Contracts Guide.
ICC، ICC Rules of Arbitration, (2020).
مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير
الباحث: أيوب بنقاسم
طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص
جامعة محمد الخامس بالرباط – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال –
مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد
الملخص:
إن من بين الشركات التي عمل القانون رقم 5.96 على تنظيمها نجد شركات التوصية، هذه الأخيرة التي نجدها على نوعين، شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، فالأولى هي من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي إذ أن شخصية جميع الشركاء فيها هي محل اعتبار، فلا يجوز لأي منهم أن يتنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة باقي الشركاء، أما الثانية، فهي من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي إذ أن شخصية الشريك الموصي ليست بذات اعتبار، فيستطيع بالتالي أن يتنازل عن حصته إلى الغير دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
شركات التوصية هذه تتكون عموما من شركاء متضامنين، وشركاء موصين، هذا الأخير أي الشريك الموصي كغيره من الشركاء يتمتع بمجموعة من الحقوق وتفرض عليه بالمقابل مجموعة من الالتزامات، ولعل من أبرزها عدم جواز قيامه بأي عمل من أعمال التسيير، بحيث يسود في إطار هذا النوع من الشركات مبدأ أساسي ألى وهو مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير، بحيث يضطلع بمهمة التسيير الشركاء المتضامنين أو أحد من الأغيار.
The Principle of Prohibiting the Limited Partner’s Intervention in Management
AYYOUB BENKACEM
Doctoral Researcher in Private Law
Mohammed V University in Rabat – Faculty of Legal, Economic, and Social Sciences, Agdal-
Doctoral Studies Center in Law and Economics
Abstract :
Among the companies regulated by Law No. 5.96, we find limited partnership companies. These companies are divided into two types: the simple limited partnership and the joint-stock limited partnership. The former is a company based on personal considerations, where the identity of all partners is of significant importance. Therefore, none of the partners can transfer their share to others without the consent of the other partners. On the other hand, the latter is a company based on financial considerations, where the identity of the limited partner is not of major importance, allowing them to transfer their share to others without needing the consent of the other partners.
These limited partnerships generally consist of general partners and limited partners. The latter, i.e., the limited partner, like other partners, enjoys a set of rights but is also subject to various obligations. One of the most important of these obligations is the prohibition on performing any management-related actions. A fundamental principle in this type of company is the principle of prohibiting the limited partner from intervening in management. Management responsibilities are therefore carried out by the general partners or by an external party.
مقدمة:
تعتبر الشركات التجارية الإطار الأكثر ملائمة للقيام بالمشاريع في ظل الاقتصاديات الحديثة، ذلك أن التاجر الفرد يعجز في غالب الأحيان عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة وتشغل مئات العمال، كما أن الاقتصاد الحديث يتطلب كفاءة كبيرة في التسيير والإدارة، غالبا ما لا تتوفر في التاجر الفرد، من هنا كانت الشركات التجارية أفضل تسليحا وأحسن كفاءة لمزاولة الأعمال التجارية، فهي لها قدرة على تعبئة ادخار الأشخاص (الذاتيين والاعتباريين)، وجمع الرساميل التي تحتاج إليها في استثماراتها، كما أنها بحكم طريقة تكوينها وإدارتها تنشأ منذ ولادتها مسلحة بالأدوات القانونية والمادية التي تمكنها من مزاولة نشاطها بكفاءة، ودون أن يهددها ما يهدد الأشخاص الذاتيين من مرض أو عجز أو شيخوخة، ودون أن يعرقل نشاطها عوامل عاطفية أو عائلية أو نفسية، فهي شخص اعتباري يتحكم في مصيره، والنقص الوحيد الذي يهدده هو ضعف الأداء من قبل المسيرين أو الأعضاء.
في هذا الإطار وبالنظر للأهمية التي تكتسيها الشركات التجارية، فقد عمل المشرع المغربي كغيره من التشريعات على تنظيمها وفق إطار تشريعي محكم، بحيث جاء القانون رقم 17.95 لينظم شركات المساهمة من جهة، وجاء القانون رقم 5.96 لينظم شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من جهة أخرى، وجدير بالذكر في هذا السياق إلى أن هذين القانونين عرفا منذ صدورهما إلى الأن العديد من التغييرات والتعديلات ، هذه الأخيرة التي تندرج في إطار السياق المتعلق بإصلاح المنظومة التشريعية المرتبطة بمجال المال والتجارة والأعمال.
وهكذا فمن بين الشركات التي عمل القانون رقم 5.96 على تنظيمها نجد شركات التوصية، هذه الأخيرة التي نجدها على نوعين، شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم، فالأولى هي من الشركات التي تقوم على الاعتبار الشخصي إذ أن شخصية جميع الشركاء فيها هي محل اعتبار، فلا يجوز لأي منهم أن يتنازل عن حصته إلى الغير إلا بموافقة باقي الشركاء، أما الثانية، فهي من الشركات التي تقوم على الاعتبار المالي إذ أن شخصية الشريك الموصي ليست بذات اعتبار، فيستطيع بالتالي أن يتنازل عن حصته إلى الغير دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
إن شركات التوصية تتكون عموما من شركاء متضامنين، وشركاء موصين، هذا الأخير أي الشريك الموصي كغيره من الشركاء يتمتع بمجموعة من الحقوق وتفرض عليه مجموعة من الالتزامات، ولعل من أبرزها عدم جواز قيامه بأي عمل من أعمال التسيير، وهو ما يشكل موضوع هذا المقال بحيث يسود في إطار هذا النوع من الشركات مبدأ أساسي ألى وهو مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير.
يحوز هذا الموضوع أهمية كبيرة سواء من الناحية العلمية، أو من الناحية العملية أهمية تتجلى أساسا في كونه يشكل مادة دسمة للبحث، كما أن البحث فيه من شأنه إغناء المكتبة القانونية المغربية على وجه الخصوص خاصة أمام قلة الكتابات التي تناولته بالدراسة، فضلا عن معرفة الأسباب والدواعي التي دفعت غالبية التشريعات إلى حظر أو منع الشركاء الموصين من التدخل في التسيير…
وانطلاقا من الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع فإن ذلك يدفعنا إلى طرح الإشكال الرئيسي التالي: ما أساس حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير؟
وتتفرع عن هذا الإشكال الرئيسي العديد من التساؤلات الفرعية من قبيل:
- أين تتجلى حدود هذا الحظر، بمعنى أين يبدأ وأين ينتهي؟ هل هو حظر يتعلق بالإدارة الداخلية أم بالإدارة الخارجية أم يشملهما معا؟
- ما هي مبررات حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير؟
- ما هو الجزاء المترتب على مخالفة الحظر؟ …
إلى غير ذلك من التساؤلات الفرعية التي نجيب عنها وعن الإشكال الرئيسي من خلال مبحثين اثنين، بحيث نتحدث في (المبحث الأول) عن أساس مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير، على أن نخصص (المبحث الثاني) للحديث عن الأثار المترتبة عن مخالفة هذا الحظر.
المبحث الأول: أساس مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير
نص المشرع في إطار مقتضيات المادة 25 من القانون رقم 5.96 المتعلق بباقي الشركات على أنه: “ لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل…“، من خلال هذه المادة يتضح على أن المشرع المغربي كغيره من التشريعات حظر أو منع الشريك الموصي من القيام بأي عمل من أعمال التسيير، غير أن التساؤل الذي يطرح في هذا السياق ينصب أساسا حول نطاق تطبيق هذا الحظر أو المنع ومبرراته وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال هذا المبحث.
لكن قبل الإجابة عن هذا التساؤل، نشير إلى حكم لمحكمة النقض المصرية بتاريخ 27/06/2000 في الطعن رقم 393 لسنة 69 القضائية والذي أكدت من خلاله هذا الحظر حيث جاء فيه:
“ وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 23 من قانون التجارة السابق الساري العمل بها بالمادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وفي المادة 28 منه والمادة 519 من القانون المدني يدل على أن إدارة شركة التوصية البسيطة تكون فقط للشركاء المتضامنين أو لأحدهم أو لمدير من غير الشركاء وأنه لا يجوز للشركاء الموصين تولي إدارة هذه الشركة ولو بناء على توكيل وكل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلا على أن يقتصر حق هؤلاء على مجرد إبداء النصح ومراقبة أعمال الإدارة فحسب…“
المطلب الأول: ماهية مبدأ الحظر
سنعمل على معالجة هذا المطلب من خلال فقرتين اثنتين بحيث سنخصص (الفقرة الأولى) للحديث عن التسيير في شركات التوصية، على أن نتحدث في (الفقرة الثانية) عن نطاق تطبيق مبدأ الحظر.
الفقرة الأولى: التسيير في شركات التوصية
كما سبق وأشرنا فشركات التوصية على نوعين شركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، بحيث يتولى التسيير في الأولى الشركاء المتضامنون فقط وفق نفس أحكام إدارة شركة التضامن، دون الشركاء الموصين الذين لا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمل من أعمال الإدارة ولو كانت لديهم وكالة، فإذا خالفوا هذا المنع قامت مسؤوليتهم تجاه الغير الذي قد ينخدع بسبب ذلك حول حقيقة وضعهم في الشركة (المادة 25)، أما بالنسبة للثانية أي شركة التوصية بالأسهم فهي تسير بواسطة مسير أو أكثر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا يعين من بين الشركاء المتضامنين أو من الأغيار ولا يمكن أن يكون من الشركاء الموصين.
وانطلاقا من ذلك يتضح جليا على أن مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير، هو مبدأ يسري على شركة التوصية بنوعيها أي سواء تعلق الأمر بشركات التوصية البسيطة أو شركات التوصية بالأسهم، إلا أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو:
هل هذا الحظر يسري على أعمال الإدارة الداخلية أم الخارجية أم يشملهما معا ؟
الفقرة الثانية: نطاق مبدأ الحظر
إن الإجابة عن التساؤل المطروح أعلاه يقتضي منا بداية تحديد المقصود بأعمال الإدارة الخارجية وأعمال الإدارة الداخلية، فالأولى يقصد بها الأعمال التي تتطلب تمثيل الشركة أمام الغير، والتي يكون من شأنها أن تجعل الشركة دائنة أو مدينة، أما الثانية أي أعمال الإدارة الداخلية فيقصد بها الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة وإدارتها دون أن يترتب على القيام بأحدها ظهور الشريك الموصي أمام الغير كممثل للشركة، ومن أمثلة هذه الأعمال الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، الاشتراك في المداولات الخاصة ببعض القرارات لعزل المدير أو تعديل عقد الشركة، طلب صورة من حساب الأرباح…
وفي هذا الإطار فإن أعمال التسيير المحظورة على الشريك الموصي، هي أعمال التسيير
” الخارجية “ فقط، هذا معناه، بمفهوم المخالفة أنه لا يشمل أعمال التسيير الداخلية، هذه القاعدة تجد مصدرها في اجتهاد القضاء الفرنسي بدءا من رأي مجلس الدولة بتاريخ 20 أبريل 1809 الذي جاء فيه أن الحظر يشمل “الأعمال التي يجريها الشريك الموصي ممثلا شركة التوصية كمدير حتى لو تمت بوكالة“، والقضاء بعد ذلك توسع في هذا المفهوم، ولم يبحث عن تدخل الشريك الموصي في التسيير فحسب وإنما تعداه إلى سلوكه الذي يوحي للغير أنه يتصرف كمدير ممثل للشركة، ثم بعد ذلك تبنى المشرع الفرنسي هذا الاجتهاد القضائي مفرقا بين أعمال التسيير “ الخارجية “، التي يحظر على الشريك الموصي إتيانها وأعمال التسيير “ الداخلية “ المباح له القيام بها.
إن هذا الموقف الذي تبناه القضاء الفرنسي بداية ثم بعده المشرع الفرنسي والذي يقضي بأن الحظر يسري فقط على أعمال التسيير الخارجية لا الداخلية، هو نفس الموقف الذي تبناه المشرع المغربي، وهو ما يتضح جليا من خلال مقتضيات المادة 25 السالفة الذكر والتي تنص على أنه “ لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل.“، فعبارة “ تجاه الأغيار ” في نظرنا توحي بأن المنع يقتصر على أعمال التسيير الخارجية ولا يمتد ليشمل أعمال التسيير الداخلية.
وفي هذا السياق، تؤسس إباحة أعمال الإدارة الداخلية على أساس أن مباشرة هذه الأعمال يعتبر من الحقوق الأساسية اللصيقة بصفة الشريك والتي لا يمكن أن يحرم من مباشرتها، بالإضافة إلا أن هذه الأعمال لا تؤثر على ائتمان الغير ولا تضر بمصالحه.
المطلب الثاني: مبررات مبدأ الحظر
إن منع الشركاء الموصين من الإدارة جاء نتيجة طبيعية لعدم مسؤوليتهم عن ديون الشركة حتى لا يقوموا بتصرفات قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشركة وبالشركاء المتضامنين، وحتى لا ينخدع المتعاملون مع الشركة (أي الأغيار) بتلك الإدارة فيطمئنوا إلى مسؤولية الشركاء الموصين عن ديون الشركة ويدخلونها في الضمان العام لديونهم.
وانطلاقا من ذلك نستطيع أن نحدد مبررات مبدأ الحظر في:
الفقرة الأولى: حماية الغير
يذهب البعض إلى أن الأساس الحقيقي لقاعدة منع الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة هو حماية الغير الذي يتعامل معها، ذلك أن الشريك الموصي يكون مسؤولا عن ديون الشركة في حدود الحصة المالية التي يقدمها إليها، وقد يوحي تدخله في الإدارة للغير أنه شريك متضامن يسأل عن ديون الشركة في جميع أمواله. غير أن هذا الرأي انتقد على أساس أن تقلد الشريك الموصي لوظيفة الإدارة ليس من شأنه أن يوقع الضرر بالغير، كما يتوهم أصحاب هذا الرأي، لأن التعامل يكون دائما بعنوان الشركة، وهذا العنوان لا يظهر فيه اسم الشريك الموصي، إضافة إلى أن الغير بإمكانه الاطلاع على عقد الشركة التأسيسي أو على خلاصته المنشورة في السجل التجاري لمعرفة حقيقة وضع الشريك الذي يتعامل معه ما إذا كان متضامنا أو موصيا، وبالتالي ليس هناك مجال لانخداع الغير حول حقيقة صفة الشريك الموصي ومدى مسؤوليته، إلا إذا قصر هذا الغير في اطلاعه على حقيقة الأمر، وفي هذه الحالة يتحمل هو نتيجة إهماله وتقصيره، كما أن المشرع يسمح للأجنبي بإدارة شركة التوصية، وبالتالي فإن الإدارة لا تدل بطبيعتها على أن المدير هو شريك متضامن.
الفقرة الثانية: حماية الشركة والشركاء المتضامنين
يذهب البعض إلى أن السبب في منع الشريك الموصي من الإدارة الخارجية ليس حماية الغير فقط، بل حماية الغير والشركة والشركاء المتضامنين في ذات الوقت، فإذا أجيز للشريك الموصي أن يكون مديرا للشركة، فقد يكون ذلك سببا له في عدم الحرز أو عدم الاحتياط من الاندفاع في عملية المضاربة الشديدة الخطر طالما أنه مطمئن إلى تحديد مسؤوليته، مما يعرض الشركة في كثير من الأحيان لأسوأ العواقب، فالقول بأن منع الشريك الموصي من الإدارة الخارجية والسماح له بأعمال الإدارة الداخلية للاعتقاد بأن الحكمة من الحظر هي حماية الغير فقط، هو كلام محل نقد، حيث أن سماح المشرع للشريك الموصي بالقيام بأعمال الإدارة الداخلية لم يقصد منه المشرع نزع الحماية عن الشركاء المتضامنين، لكن المشرع سمح له بذلك حتى لا تغل يده تماما من الاهتمام بشؤون الشركة التي هو شريك فيها وحريص على مصلحتها فلو حظر المشرع عليه الإدارة الداخلية أيضا لما أمكن وصفه بأنه شريك، فقد أبقى له المشرع أعمال الإدارة الداخلية كدليل على عضويته في الشركة، وليس كدليل على حصر الحماية في الغير، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يذهب أخرون إلى أن الحكمة من حظر الإدارة الخارجية على الشريك الموصي هي حماية الشركاء المتضامنين أنفسهم، حيث أنه من العدل أن الشريك المسؤول عن ديون الشركة بأجمعها يكون هو الأولى بالإدارة ممن لا يسأل إلا بقدر حصته فقط، وأن الشريك الموصي في الغالب ليس تاجرا وليس له خبرة بالأعمال التجارية، إنما هو شخص يريد أن يستعين بخبرة الشركاء المتضامنين ويعاونهم على الكسب بما يقدمه لهم من رأس المال، لذا خشي المشرع أنه لو ترك للموصي حق الاشتراك في الإدارة الخارجية أن يجازف في تصرفاته طمعا في الكسب، وهو مطمئن إلى أنه لن يخسر في النهاية أكثر من قيمة حصته، ولو زادت ديون الشركة الناتجة عن تصرفاته عن قيمة رأس مالها فيضر بذلك بالشركاء المتضامنين.
المبحث الثاني: الأثار المترتبة عن مخالفة الحظر
إن مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير هو مبدأ تبنته غالبية التشريعات كما تبناه القضاء أيضا على النحو الذي رأينا، وبناء على ذلك فإن أي مخالفة لهذا الحظر من قبل الشركاء الموصين من شأنها أن ترتب أثارا.
في هذا السياق ينص المشرع المغربي في إطار مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 5.96 على أنه: “ في حالة مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، يسأل الشريك الموصي بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن ديون والتزامات الشركة المترتبة عن الأعمال الممنوعة، ويمكن أن يلزم تضامنا بكل التزامات الشركة أو ببعضها فقط، حسب عدد وأهمية الديون والالتزامات المذكورة.“
المطلب الأول: جزاء مخالفة الحظر في مواجهة الغير
بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 25 المذكورة أعلاه يتضح بأن جزاء مخالفة الحظر في مواجهة الغير، قد يكون وجوبيا أي بقوة القانون (الفقرة الأولى)، وقد يكون جوازيا (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الجزاء الوجوبي
الجزاء الوجوبي أو الإجباري، هو ذلك الجزاء الذي يقع بقوة القانون بحيث يسأل فيه الشريك الموصي مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة عن ديون الشركة من جراء الأعمال التي قام بها، فلا تكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الموضوع.
بحيث يتمثل هذا الجزاء في المسؤولية الشخصية للشريك الموصي، مسؤولية غير محدودة وبالتضامن عن النتائج السلبية المترتبة عن كل عمل إدارة خارجي تجاه الغير، ويقع هذا الجزاء بقوة القانون كما قلنا دون أدنى تقدير من طرف القاضي، وتقتصر المسؤولية التضامنية في الأعمال المحظورة التي باشرها الشريك الموصي، بمعنى أنه يبقى مسؤولا مسؤولية محدودة بالنسبة للأعمال الأخرى الغير محظورة. ويستشف هذا الجزاء الوجوبي الذي يقع بقوة القانون كما أسلفنا، من الشق الأول من الفقرة الثانية من المادة 25 السالفة الذكر.
الفقرة الثانية: الجزاء الجوازي
تقرر مسؤولية الشريك الموصي من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة ليس فقط عن أعمال التسيير الخارجية التي أجراها وإنما عن كل التزامات الشركة أو بعضها، فإذا تعددت أعمال التسيير الخارجية التي أجراها الشريك الموصي أو بلغت حدا من الأهمية والجسامة، يمكن أن يلزم بكافة ديون الشركة أو بعضها، وبناء عليه فإن قيام مسؤولية الشريك الموصي بهذه الطريقة هي جوازية، فهي من تقدير القاضي الذي يحدد عدد وجسامة أعمال التسيير الخارجية التي قام بها الشريك الموصي وما ترتب على ذلك من أثر بالنسبة إلى الغير، لذا تترتب مسؤوليته كالشريك المتضامن عن ديون الشركة كلها أو بعضها، لفترة معينة أو غير معينة، تبعا لعدد وأهمية وجسامة أعمال التسيير الخارجية التي قام بها، ولا يكون ملتزما بالتضامن ومن غير تحديد عن ديون الشركة قبل الغير الذي تعاقد معه فقط، وإنما قبل جميع دائني الشركة عن الديون التي يحددها القاضي حتى ولو لم يكن الشريك الموصي طرفا في العقود التي رتبت تلك الديون على الشركة.
وجدير بالذكر في هذا الإطار، إلى أن هذا الجزاء الجوازي، لا يوقع على الشريك الموصي نتيجة تدخله في أعمال الإدارة الخارجية للشركة إلا إذا كان الغير حسن نية، أي يكون قد اعتقد فعلا بأن الشريك الموصي شريك متضامن مسؤول بأمواله الخاصة ويفترض حسن النية لدى الغير إلى أن يتمكن الشريك المعني من إثبات سوء نيته.
المطلب الثاني: جزاء مخالفة الحظر في مواجهة الشركاء المتضامنين
انطلاقا من مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 25 السالفة الذكر والتي جاء فيها ” لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل “ يتضح أن الشريك الموصي قد يأتي بعض الأعمال التي تلزم الشركة بناء على توكيل، غير أن هذه الأخيرة تبقى محظورة على الشريك الموصي شأنها في ذلك شأن الأعمال التي يأتيها هذا الشريك من تلقاء نفسه.
وبناء على ذلك، فإن جزاء مخالفة الحظر في مواجهة الشركاء المتضامنين يختلف بحسب ما إذا قام الشريك الموصي بعمل من أعمال التسيير من تلقاء نفسه أي بدون توكيل، أو قام بهذه الأعمال بناء على توكيل.
الفقرة الأولى: جزاء قيام الشريك الموصي بأعمال التسيير من تلقاء نفسه
إذا قام الشريك الموصي بهذه الأعمال دون صدور توكيل بها من الشركاء المتضامنين فإنهم لا يسألون في مواجهة الشريك الموصي بأي التزام، وتنعقد مسؤوليته منفردا كاملة عن هذه الأعمال التي خالف بها الحظر، إلا إذا كانت الشركة قد استفادت من هذه الأعمال، فيحق للشريك الموصي الرجوع على الشركة أو الشركاء المتضامنين بمقدار الفائدة التي عادت على الشركة طبقا للقواعد العامة في الإثراء بلا سبب.
الفقرة الثانية: جزاء قيام الشريك الموصي بأعمال التسيير بناء على توكيل
إذا منح الشركاء المتضامنون الشريك الموصي توكيلا للقيام بهذه الأعمال التي خالف بها الحظر المفروض، فإن مسؤولية الشريك الموصي في مواجهة الشركاء تبقى محدودة بحدود الحصة التي شارك فيها دون أن يتعدى ذلك ماله الخاص، وإذا كان مدير الشركة من غير الشركاء وهو الذي فوض الشريك الموصي للقيام بهذه الأعمال، فإن المدير يعتبر هو المسؤول في مواجهة الشركاء عن هذا العمل، كما لو كان قد صدر منه هو، ويبقى المدير والشريك الموصي في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية في مواجهة الشركاء المتضامنين تطبيقا لأحكام الوكالة.
خاتمة:
تمتاز شركات التوصية بكونها شركات تحتوي على نوعين من الشركاء، شركاء متضامنين وشركاء موصين، بحيث يخضع الشركاء المتضامنين للنظام المطبق على الشركاء في شركة التضامن، فيسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة، في حين يسأل الشركاء الموصون عن الديون المستحقة على الشركة في حدود حصتهم.
إن تحديد مسؤولية الشريك الموصي بمقدار حصته في شركات التوصية أثر على مركزه القانوني في الشركة لا سيما على حقوقه فيها، حيث قلص من مقدار حقوقه غير المالية مقارنة مع مقدار هذه الحقوق بالنسبة للشريك المتضامن وحجة المشرع الأساسية في ذلك هو حماية الغير المتعامل مع الشركة.
وهكذا تدور الشركات التجارية عموما بين محظور ومسموح، حيث سمح المشرع للشريك أو المساهم القيام بمجموعة من الأعمال لكنه حظر عليه في المقابل القيام بأخرى، ولعل هذا ما يسود أيضا داخل شركات التوصية بنوعيها، حيث حظر المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات الأخرى على الشريك الموصي التدخل في أعمال التسيير خاصة الخارجية منها.
وعموما فقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والخلاصات يتمثل أبرزها فيما يلي:
- ارتباط الحظر فقط بأعمال التسيير الخارجية دون أعمال التسيير الداخلية، حيث يمكن إتيان هذه الأخيرة من قبل الشريك الموصي، في حين تحظر عليه الأولى سواء أتاها من تلقاء نفسه أو أتاها بناء على توكيل.
- أن الغاية من وراء الحظر ليس الحظر من أجل الحظر وإنما حماية الغير والشركة والشركاء المتضامنين.
- وعلى مستوى المسؤولية يصبح الشريك الموصي مسؤولا بالتضامن ومن غير تحديد عن ديون الشركة شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامن، في حال تدخله في أعمال التسيير الخارجية.
- إن عدم المساواة بين الشركاء المتضامنين والموصين في بعض الحقوق بحجة الاختلاف في المسؤولية لا نراه مبررا، لأنه أدى إلى عدم المساواة بين الشركاء في بعض الحقوق وهذا ما ساهم بشكل كبير في ندرة هذا النوع من الشركات في الحياة العملية، ذلك أن الشركاء الموصين يعزفون عن توظيف أموالهم في شركات تحرمهم من أهم الحقوق لاسيما الحق في الإدارة.
وفي ضوء ما سبق وما تم التوصل إليه وبالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها موضوع الدراسة، فإننا نرى على أن المشرع يتعين عليه السماح للشريك الموصي بالقيام بأعمال التسيير، سواء كانت هذه الأعمال داخلية أو خارجية، خاصة وأنه يسمح للغير الأجنبي على الشركة القيام بهذه الأعمال، فالشريك الموصي أولى بذلك، وإن تطلب الأمر وضع قيود على هذا التسيير.
لائحة المراجع:
- المؤلفات العامة:
- علال فالي، التعليق على قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركات التوصية وشركة المحاصة على ضوء 20 سنة من القضاء التجاري 1998-2018، مطبعة المعارف الجديدة، الطبعة الأولى، الرباط، 2019.
- فؤاد معلال، شرح القانون التجاري الجديد، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الرابعة، 2012.
- المقالات:
- سهام باسل، المركز القانوني للشركاء الموصين في شركات التوصية، مجلة الدراسات الحقوقية، الجلد 8، العدد 02، السنة 2021.
- محمود أمين بن قادة، الحالات التي يسأل فيها الشريك الموصي من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة، مجلة القانون الدولي والتنمية، المجلد 2، العدد 1، السنة 2014.
- محمد مصطفى حمدي، الشريك الموصي بين المحظور والمسموح دراسة نقدية، مجلة كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف، العدد 29، ديسمبر 2024، الجزء الثالث.
نور الدين صحراوي، مبدأ حظر تدخل الشريك الموصي في التسيير في شركة التوصية البسيطة، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد الرابع، المجلد الأول، ص 326.