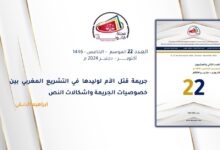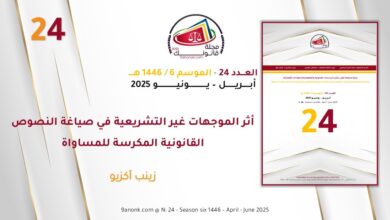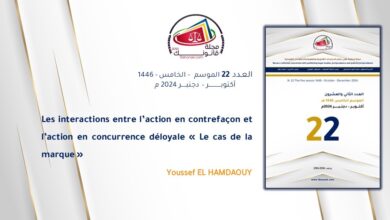تفـويض التشريع في النظام السياسي الموريتاني في ظل دستور 1991 المعدل 2017
تفـويض التشريع في النظام السياسي الموريتاني في ظل دستور 1991 المعدل 2017
تفـويض التشريع في النظام السياسي
الموريتاني في ظل دستور 1991 المعدل 2017
لخصارة بنت سعدنا
أستاذة متعاونة مع كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة انواكشوط ،
موريتانيا
The mandate
legislation of the Mauritanian political system in the light of constitution of
1991 modified in 2017
Lkhsaarra BENT SAIDDANA
المقدمة:
لقد
أصبح من حق البرلمان أن يمنح للحكومة الترخيص في أن تمارس مهمة التشريع، عن طريق
نصوص تنظيمية من الناحية العضويـة، تصدر من طرف السلطة التنفيذية، لكنها من
الناحيـة المـادية نصوص تشـريعيـة لكــونها تتعـلق بمــواد تشريعيـة[1].
وما
من شك أن هذا النوع من التشريع يؤدي إلى تقوية مكانة السلطة التنفيـذية على حساب
السلطة التشريعية، ذلك أن السلطة التنفيـذية لديهـــا من المهام ما يتطلب التدخل
السريـع والعـاجـل في بعض الأحيان، الذي لا يمكن أن يـوكل أمر التشريع فيه للسلطـة
التشريعية التي تتسم إجـراءاتها بالبـطء والتعقيد، وهذا ما حدا بالمشرع الدستوري
إلى تقدير إمكانية ترخيـص التشـريع فيها للحكومــــة[2].
ويقصد
بالتفويض التشريعي: “كل ترخيص يمنحه البرلمان للحكومة لممارسه الوظيفة
التشريعية في مجال معين ولمــدة معينة لتحقيــق هـدف معيــن”[3].
وهـذا النوع من التشريــع الحكومي تلجأ إليه الحكـومـة
بسبب ازديـــاد مهـامهـا، وعـدم نجـاعـة البـرلمـان في مواجهــة المشـاكـل الصعبـة
التي تتطـلب التــدخـل السـريـع، عـكس مـا عـليه الحـال بالنسبة للحكـومـة التي
تتــوفر عــلى الـوسائـل الكـافـيـة لمــواجهة الأحـداث بسـرعة.
والمـراسيم التفويضية هي قـرارات لها قوة القانون تصدرهـا السلطة
الــتـنـفـيـــــذيـــة لـتـــنظـم بها بعض المســائل التي لا يتنـــاولهـا إلا
التشريع في الأصـل،
بحيث تفويض السلطــة التشريعيـة تلك المهمة للحكومة. وتصدر
هذه المراسيـم والبرلمان منعقد، عكس مراسيم الضرورة التـي تصدر حـال غـياب
البــــرلمـان[4].
وبما أن ذلك يعتبر تنازلا من البـرلمان عن اختصاصاته
المخولة له دستوريا، مما لا يتماشى ومبدأ الفصل بين السلطات، الذي تعتمـده غـالبية
الـدساتير المعاصرة، فإن هذا النوع من التشريع أصبح معمولا به في بعض الأنظمة الدستورية،
وقد كـــــــرســه الدستور الفـــــــرنسـي لسنة 1958، كما أخذ به الدستـــور
المــــوريتاني.
فماهي أسبـاب التفويض وما طبيعته (المطلب الأول)
، وماهي شروطه (المطلب الثاني) ، وما هو
نطاق هذه المراسيم؟ (المطلب الثالث).
المطلب الأول: أسباب التفـويض وطبيعته
سنتطرق
لذلك من خلال أسباب التفويض (الفرع الأول)، وطبيعته (الفرع الثاني).
الفرع الأول: أسباب التفويض
تعود أسباب تفويض التشريع إلى بعض الظروف التي
تجعـل البـــرلمـان يقدر بـأنه من الأفـــــــــضـل ترك الأمـر للحكـــــــــومـة،
لتعالج المسألـة بمقتــــضـى مـرسوم، حيث معــالجـة الأمور من طرف الحكــــومـة
تـكـون أسـرع وأسهـل، بعيــــدا عن المسطــــرة التشريعــــية التي تتســــم بالبطء،
والتعقيــــد[5].
وغـرض التفويض هـذا يختـلف مــن وقت لآخــر إلا أنـــه غـــالبـــا مـا يكـــون
مـــــرتبطا ببرنامج الحكومـــة.
وفي
هـذا السياق نصت المادة (60) من الدستور المـوريتاني لسنة 1991على انه:”
للحكومة بعـد وفاق رئـيس الجمهـورية ومن اجل تنفـيذ بـــــرنـــــامجهـا أن
تستـأذن البـرلمان في إصدار أمـر قانــــونـي خـلال أجـل مسمـى يقضي باتخــاذ
إجـــــراءات مـن العـادة أن تكون في مجال القــــانـــون.
يـتخـذ
هـذه الأوامـر القـانونية مجلس الوزراء وتتطلب وفاق رئيس الجمهـورية الــذي
يوقعهـــا.
تـدخل الأوامـر القانونية حيـز التطبيق فـور نشـــــرهـا،
غيـر أنها تصبح لاغـية إذا لم يتسلم البرلمان مشـروع قـانون التصديق، قبل التاريخ
الذي حـدده قـــانــون التــــأهيل.
وبعد
انقضاء الأجـل المذكـور في الفـقـرة الأولى من هذه المادة تصبح هذه الأوامر
القانونـية غير قـــــــابلـة للتعديـل إلا بموجب القانـون في المواضيع الخاصـــة
بالتشريـــع.
ويصبح
قانـــون التأهيــــل لاغــيا إذ حلــت الجمعيــة الوطنيــة”.
وهـذه
الأوامـر ليست جـــــديـدة على النظام السياسي الموريتاني، فـقد كانت الوظيفة
التشريعية في مـوريتانيا تمارس عن طــــريـق أوامـر قـــانــــونـية، في الفــــــتـرة
الممتدة مـا بين 10 يـوليو 1978 وحتى صدور دستـور 1991، وتنصيب المـؤسسات التي أقـــــامهـا،
حيث أنه أمــتـد إلى غـاية تنصيب رئيس الجمهورية في 18ــ 04 ــ 1992 ، والاجتماع
الأول للبرلمان في27ـ 04 ــ 1992.
وقد كـانت البـلاد خلال هـذه المـدة،
تحكمـــــــهـا اللجنة العسكـــــريـة، بموجب مـواثيق دستـــــــوريـة آخـرها هـو
ميثاق 09 فبـــــــــرايـر 1985 الـذي نص في مـــادتـه الثـــــــــالثـة على أن
اللجنة العسكـــــريـة هي التي تمـارس السلطـة التشـريعية وتمــــــارسهــــــــا
بــأوامــــر قـــــانونيـــة.
وغير بعيد إذا ما نظرنا إلى النظام السياسي
الجـزائري نلاحظ أن دستـوري 1989 و1996 (وتعديلاته اللاحقة 2016 و2020) جـاءا
خـاليين من النـص عـلي تفويض التشــــــريع[6].
غير
أن المتتبع للتطور الدستـوري الجزائري يجـد أن هـذه التقــــنية كـانت
مـــــوجـودة في دستـور1976 المـادة (153) وأيضـا دستـور 1963، بنـص المادة (58)
من دستـور 1963 على أنه: ” يجـوز لرئيـس الجمهــــــــــوريـة أن يطلب من
المجـلس التفويـــــض لـه لمــدة محدودة حـق اتخـاذ تدابيــــــر ذات
صبغـــــــــــــــــة تشريعية عـن طـريق أوامـر تشريعيـة تتخـذ في نطاق مجـلس الـوزراء،
وتعرض على مصادقــة المجلس الوطـني في أجـــل ثـلاثة أشهـر”[7].
وهي حق لرئيـس الجمهــــورية وليــــــس للحكـــــومـــــة. ونفـس المقتضى تقـــــــريبـا نص عليـه الدستـور
التـونسي لسنـة 1959، حيث أسند هذه المهمة لرئيس الجمهـــــوريــــة[8].
وبالتالي
فـإن عبـارة” للحكـــــومـة…” الواردة في الدستور المـوريتاني توحي
بأن هـذا الحق للحكـومة، بمــــوجبـه تطلب الإذن من البـرلمـان، عـلى عـكـس ما
عليه الحال في بعـض الدساتيـر كــــالدستـور المغـربي مثلا الذي ينـص على أنه:
” للقانـون أن يـأذن للحكـومة أن تتخذ في ظـرف من الزمن مــــــحـدودة ولغاية
معينة، بمقتضى مـــــــراسيـم تدابيـر يختـص القـانون عـادة باتخـــاذهـا،
ويجـــــــــــــــــري العمـــل بهـــــذه المـــراسيــــم بمجرد
نشـــــرهــــــا.
غـــــيـر
أنه يجب عـــــــرضهـا عـلى الـبرلمان بقصد المصادقــة عند انتهاء الأجل الذي حدده
قانون الإذن بإصدارهـا. ويـبطـل قانون الإذن إذا ما وقـع حل مجلسي البرلمـــان أو
أحـدهمــــا”[9].
ومما
سبق يتبيـن لنا أن حق تفويض التشريع هنا حق للبـرلمان وليس للحكــــومـــة.
و
يرى أستـاذنا الدكتـور سيـدي محمد بن سيدأب أن هـذا الاختلاف في التعبير فـقـط،
ولا يـؤدي إلى اختـلاف في المعـنى، وإن كـانت الصيـــــــاغـة توحـي بأن المبادرة
بتفـويض التشـــــــــريـع تصـدر مـن البــــرلمـان، فـإن المشـرع الدستـــوري لم
يقصد هـذا المعنى، و إنمـا رمى إلى إقــرار حــق البــــــرلمــــان في أن يـأذن
للحكومة بالتشـريع بــدلا مـنه إذا طـلبت هي ذلك، واقتـنع
البــــرلمـــــــــــــان بالمبــررات التي تقـــــــــــدمهـا الحكـــــومـة في
هـذا المجال[10]،
هـذا مـا يـــــــــــوافـق الرأي
الــــــراجـح في فقـــه القانـون العام الفرنسي، الذي يـرى أنه لا يجـوز للبرلمان
أن يثيـر مسألـــة اللجـوء إلى التفـويض من تلقــــاء نفســـــــــــــــه[11].
ومصطلـح
“أومـر قانـونية” التي وردت في المادة (60) من الدستـور
المـــوريتانـــي بـدل “مـــــــراسيــم “التي استخــــدـمـت في بعض
الدساتيـر الأحـرى تدل على فـرق في التسمـية لا المعنـى، وبالتالي فـلهما نفـس
القيمـــة القـــانــونـــية.
وهـذه
الأوامـر القانونية يـمكن تعـــــــديـــلهـا وإلغــائهـا بمـوجب أوامـر قـانونية
خـلال مـدة التفـويـض، وبعـد انقـضاء تـلك المـدة، فإن تعديلها يكون غــــــيـر
ممــــكـــــن إلا بمـــــوجـــب القـــــانــون[12].
وقـد
لجأت الحكـومة المــوريتانيـة إلى تطبيق المـادة (60) من الدستور إثر تداعـيـــات
جـائـحـة كوفيد 19، حيث صادقت الحكـومـة خلال اجـتـمـاعـها بتاريخ 01 مارس 2020 على
مشـروع قانون تـــــأهيـلي بطلب:” تخـويل الحكومـة خلال أجل ثـــــلاثـة (03)
أشهر اتخاذ أوامـر قــــــانونيـة تتضمـن جميع الاجـراءات الضـــروريـة
لمكـــــــــــــافحـة وباء كـــــوفيــــــد 19 وكـــافـــــة
تأثيـــــــراتــــــه”.
وفي
هـذا الصدد انقسم الفقهــاء القانـونيين إلى اتجاهين، حيث رأى أصحاب الاتجـاه
الأول: أن طلب إذن التفويض هنا في غيـــــر محلـه، لأنه مـن الأنسب والحـالة هذه
تطبيق حـــــــالة الاستثنـاء أو الطـــــــــــــــــــوارئ.
وقـد
رأى ذ. يعقوب بن السيـف، أن طلب الحــكـومة للتـــــأهـيل هـو مـن:” أجـل
تنفيـذ بــــــرنامجهـا “حسب نـص (المادة60) ، وعـلى ذلك يتعلــــق
الأمـــــر إمـــــا:
ـ بالسعـي للحصول على مقــــــومـات تساعـد على تنفيذ البـرنامج يمكن
التـــأهــــيل مـــن الـــوصــــول لهـــــا.
ـ أو للتمكين من تحسين الأداء للوصول لتنفيـذ البـرنامج بكفـاءة وجـودة
أفضــــل.
ـ أو
بهدف التغلب على عقبات تحول دون تنفـيـذ البـرنامج الحكومي، يمكـن التغلب
عليهــــا حيــــــن تمنح الحكـــومـــة صلاحيـــة التشريـع بشأنهـــــا.
فالتفويض
في الصور السابقة جميعها يعود على تنفيـذ البرنامج الحكـومي مبــاشــرة.
لكن
العنوان الذي أعطي لمشـروع القانون التأهيلي لا يتعلق ببـرنامج الحكومة، بل
بمسـؤوليات السلطة التي عليها القيام بها في الظروف العـادية، وفق ما تضع عليها
القوانين والنظـم المعمول بها، من مسؤوليات وبما تتيحه لها من سلطات، فالحكومة غير
مجبرة على تنفيذ أهداف لم ترد في برنامجها، والتأهيل وجد للمساعدة في تنفيذ
البرنامج لا القيام بالمسؤوليات حين قيام ظروف غير طبيعية، رصدت لها آليات مقدرة
بمقـــــدارهــــا[13].
وعلى
هذا المنوال سار المحامي والنائب البرلماني العيد ولد محمد ولد أمبارك، وذلك
بقوله: أنه كان بمقدور الحكـومة اللجوء إلى المادة(39) (حالة الاستثناء)، والمادة
(71) من الدستور، التي تتيح إعلان حالة الطوارئ، مذكرا في هذا الصدد بالجــــدل
الدائــــــر بين القانــــونـييـن حـول المــوضــوع[14].
بينما
اعتبر أصحاب الرأي الآخر أن مثل هذا الظرف يتطلب اتخاذ قرارات وطنية كبرى في
الظروف الاستثنائية، مما يستدعي اللجوء إلى المادة(60) من الدستور.
وتعليقا
على هذا النقاش يقول الأستاذ محمد الأمين ولد داهي:” أن دولة القانون تفرض
إتباع مسطرة محددة في اعتماد القوانين، لكن تسيير التوازنات العامة في الظروف الاستثنائية،
يفرض على السلطات السياسية اتخاذ قرارات كبرى عبر مسطرة حددت بصفة واضحة في المادة
(60) من دستور الجمهورية الثانية الصادر في يوليو 1991.
وأن
البرلمان هو من يقر القوانين، باعتباره ممثلا للشعب، والحكومة هي من تنفذ تلك
القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، لكن إصدار القوانين يحتاج إلى وقت، حيث
يلزم انتظار خمسة عشر (15) يوما لتتـم المـوافقة عليهـا من البرلمان، ثم أسبوعا
آخر لاعتمـــادهـا من المجلس الدستوري، وفق الرقابة السابقـة على دستوريـة
القوانين، وهو يتطلب انتظار ثلاثة (3) أسابيع إذا سارت الأمور دون تعقيد، وفي ظل
مواجهة “فيروس كورونا” لا يمكـــن انتظار هـــذه المــدة”.
مما
يدعو الحكومة إلى أن تطلب من الـــــــــــبرلمان في ظل هذه الظروف السماح لها
مــؤقتـا بصلاحيات اتخاذ القوانين على شكـل أوامـر قانـــونيـة وهـــو ما يعرف
ب:” قانون التأهيل”[15].
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للأوامر التفويضية.
لقد أدرج الدستور الموريتاني المادة (60)
المتعلقة بالمراسيم التفـويضية بالباب الرابع المتعـلق بعلاقة السلطة
التنفـيـــــذيـة بالسلطة التشريعية حيث جاءت هذه المادة مبـــــــــــاشـرة بعد
المـادة 59 التي تنص على أن المواد الخـارجة عـن مجال القـانون تكون مـن اختصاص
اللائحة و هــــو ما يحمل على القول بأنها أي (المـــــــــــراسـيم التفـويضية )
ذات طبيـــعـة تنظيمية، وعـلى غـرار المادة 38 من الدستــور الفـرنسي فإن اجتـهاد الفقهــاء اجمـع على أنها ذات
طبيــعة تنظيميـة، رغم انـضـوائها ضمـن مـجـال القانـون، مـــمـا يؤدي إلى
خــضــــــوعهـا لـــــرقـابـة القضـاء الإداري بسبب الشطط في استعمـال السلطـة،
قبل أن يصـادق عليها البرلمان، أمـا بعـد مـصـــــادقـته عليهـا فـإنها تـكـتـسـب
قـوة الـــــقـانـون ممـا يحصنها من أي طعـن قضائي[16]
.
ومن القـــــــائــــلين بـــذلــك الأستــــاذ
مصطفــــى قلــــوش [17].
و في
هـذا الإطار يقـول الأستاذ مـحمد اشركي: ” إن الأمر الذي لا خـلاف فـيـه هـو
أن هـذه المــــراسـيم حين يـصـادق
عـلـيـها البـــــرلـمـان تكـتـســــــي قـوة الـقـانون وبأثـــر رجعـي، يمتـد إلى
تاريخ اتخـــاذها.
أما قبل المصادقة عليها فـتـــظـل ذات طبـيعـة
مـــــزدوجـة، فهي تنظيمـية باعـتـبـــارهـا صادرة عن سلطة إدارية، وتـشــــريعـية
باعــــتبــــارهـا تـتناول مــوضـــوعـا ينـدرج في مجــال القــانــون”[18].
إلا
أن هنالـك رأي آخر يرى أنـهـا ذات طبـيـعــة تـشـــريـعـية. و مـن رواد هـذا
الاتـجـاه الأستـاذ عبدالله حـداد، حـيـث ذهب إلى أنه:” يـمـكـن للـسـلطـة
التـنـــفـيـــذيـــة أن تـتـــــــــولــــــــى مــــهــــمــــــــة
التشريـــــــــــــع، إما في غــــيــــــبـة البــــــرلمان أو
بــــتـــــــفــــويـــض مـــنـــه، واســـــــتـنادا إلى الــمـعيار الشكـلي،
فــــــــــــإنــهـا تـــــــتـخـذ هـذه الأعمـال بصفتـها سلطـة تشـــــريعية لا
سلطـة إدارية، و عليه فعنـــــدمـا تتـاح الفـرصة للمجـلس الأعلى ليبدي رأيـه، فلا
شـك أنه سيــــــــــــرفـض النظـر فيها لاعتبــــارها أعــــــــــمالا صادرة عن
سلطــــة تشــــريعيـــة”.
والـواقع
أن هذه المـراسيم تعتبر مـراسيم تنظيمية عنـد صــدورهـا، ويكـون بالإمكان الطعـن
فيهـا أمـام القـضـاء الإداري بسبب الشطط في استعمال السلطة، أما بعـد
المصـــــادقـة البرلمانيـة عـــليهـا تكتسـي الطابع التشريعي، وتتحصـن ضـد أي
طعـــــن قضائـي.
المطلب الثاني: شــروط التـفويض
هنـــــــاك
شـــــــروط حــــــددهـــــــا المشــــرع الدستــــوري يجب أن تتـوفـــــر حتــى
يمكــــــن للحكــــومـــة أن تطلب تفـــــويض التشــــريـــع، وهـــذه الشـروط هي
تحديد مــدة التفويض والغـــــرض منه(الفــــرع الأول)، وعـــــرض الأوامــــــر
القــــانونيـــــة (المــــراسيـــم) المتخـــذة في إطـــار التفـــــويض عــلى
البــرلمــــان في الآجـال التي حــــــددها قانــــون التأهيــــل (الفــــــرع
الثاني).
الفرع الأول: تحديد مدة وغرض التفويض
إذا
كان غرض الحكومة من التفويض هو تنفـيذ المخطط العام لسياستهـا وبرامجها، التي تكون
عـادة معـروفة من طرف البرلمان، فإن هذا الغرض من شأنـه أن يوسع من مجالات تدخـل
المـراسيم التفـــــويضيـة، مـا دام غرض التفويض هو تنفيذ البرنامج الحكومي الذي
يتـم اعـداده كل سنة ويعرض على أنظار الجمعية الوطنيــة[19]
.
غير
أن النصوص الدستورية استوجبت أن يكون غرض التفويض معينا لا محـددا ولا مضبوطا،
رغـم أن تحديد غرض التفويض ضروري لأنه ليس إلا ترخيصا استثنائيـا[20]
، لذلك فـإن التأويل السليم ” للغرض المعين” يستدعي ألا يجـرد البـرلمان
من جوانب هـامة من اختصاصه بموجب التفويض، وبالتالي فإنه يجب تضييق التأويل
بالنسبة للغرض المعين نظرا لكون التفويض يشكل استثناء على الاختصاص العـــام
للبــــرلمان [21].
وقـد
سار في نفس الاتجاه الأستاذ “لافروف” وهـو بصدد تحليل المادة 38 من
الدستور الفرنسي، حيث يقول: ” لا يمكن أن يتعلق الأمر بتفـــــويض يتخلــى
بمقتضــاه البرلمان عن مجموع اختصاصاتــــه”[22].
كما أن مـدة التفويض يجب تحـديدها، لكي لا يتحول
ذلك التفويض إلى استئثار مطلق، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تضييق مجال القانون،
لأن البرلمان خلال تلك المدة يحظر عليه التشريـع في المواضيع محـل التفويض، تفاديا
للتعارض بين التشريع الحكومي والتشريع
البرلماني، وإذا لم يلتزم البرلمان بذلك، فإنه يحق للحكومة معارضة المقترحات
والتعديلات الداخلة في الميدان المفوض لها. حيث نصت المادة (62/3) من الدستور
الموريتاني على أنه: ” للحكومة والبرلمان حق التعديل.
لا
تقبل مقترحات أو تعديلات البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص
في الموارد العمومية، أو إحداث نفقات عمومية أو تضخمها، إلا إذا كانت مصحوبة
بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر. كما يمكن أن ترفض حينما
تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عمـــلا بالمـــــادة 59 أو تـنافي
تفويضا بمقتضى المادة 60 من الدستور.
إذا
مـا خالف البـــــرلمـان الرفض الـذي تثـيره الحكومة عملا بمقتضيات إحدى
الفقــــــرتيـن الســابقتين، أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أن يلجأ إلى المجلس
الدستـوري الــذي يبـــت في الأمـــر في ظــرف ثمــانيـــة أيـــــام”.
وبسبب
عـدم تحـديد المشرع الدستـوري المـوريتاني مدة التفويض، فـإن هــذا التفويـض قـد
يستمر لمـدة طويلة نسبيـا في ظل غيـاب النص، مما قد ينجـم عنه مـيول السلطة
التنفيذية إلى التدخل في الميدان التشريعـي، بغية الوصول إلى هدف لا يمكن تحقيقه
إلا بالتدرج وخلال عـدة سنوات، ذلك أن الـــــــبرلمـان يمكنه السماح لها بالترخيص
لتحقيق أهدافهـا، خـاصة وأن الحكــــــومة تتمتع بأغلبية برلمانيـــــة
مـــريحــــة[23].
وعليه
يجب أن تكون مـدة التفويض معقـولة لكي لا تحـول بين البرلمـــان وممــــارسة
اختصاصــه.
وفي
إطار المـــشــــــاكـل التي قد تـــطـــرحـهـــا مـدة التـــفــــويـض، يــمـكـن
التسـاؤل حول مسألة تجاوز الحـــكـومة للأجل المــحـدد لها في قانون
التــــفـــــويض، مادام الدستور لم يحدد أي إجـراء يـمكن أن يلحـق الحكومة في
حــالـة عدم التـــــــــزامــها بالأجــل الــمحـــدد.
لكن
هذا الاحتـــمـال مستبعـد لأن الحكـومة، حتى ولو لم تنتظر جزاء قــــــانونيـا،
يحتمل أن يطبق عليهـا، من خلال المسؤوليـة السياسية [24].
كما أن التدابيـر التي تتخذهـا في هـذا الاتجـاه تكون قابلة للإلغـــاء عن طريق
دعــــوى تجـــاوز السلطـــة.
وقـانون
الإذن هذا يصبح لاغيا إذا ما تم حل البرلمـان، لكن في حـالة انتهاء ولاية
البـرلمان، الذي أصدر قانـــون الإذن قبـل أن تنتهي فترة التفويض فهل يسقـط قانـون
الإذن؟ يرى الأستاذ سليمان محمـد الطماوي أن قانون الإذن يـصبح لاغيـا في حـالة حل
البرلمـان أو انـــــتهـاء ولايته الـتشـــــــريعيـة[25]، ويـتـرتب عـلى ذلك أن الــــــــــمراســــيـم
المـطبـقـة لـقـانون الإذن يجب أن يصادق عليها المجـلس الـذي صـوت عـلى قانـون
الإذن، لا في ظــل مجلــس آخـــر.
ويلاحظ
أن مثل هـذه الحــــــالـة قد حدث في المغرب سنة 1997، حيث فـوضت الحــكـومة
بــــمـوجب القانون المالي للسنة المـالية 1997/1998 (المادة2)، حق إصدار مـراسيم
خلال تلك السنة لـتقوم بــمـــــوجـبهـا بتغــــــــييـر أســعـار أو وقـف
اســـتــيفـاء الرسوم الجـــمــــركــيـة.
و
ردا عـلى ذلك التساؤل رأي الدكتور مصطفى قلوش أن قانـون الإذن لا يـنتهي بانتـهاء
ولايـة البـرلمان الذي وافق على الترخيص، حيـث يـــمـكـــن للحــكــومــة أن
تــتـخـذ مـراسيم في ظـل البــرلمــان الجـديـــــد[26].
الفرع الثاني: عرض المراسيم
التفويضية على مصادقة البرلمان
لــقـد نص الــــــدسـتور الـموريتاني على
الجزاء المترتب على عدم عرض الأوامر المتخذة في إطار التفويض على الــبرلمـان في
الأجـــل المحــــدد له، وهــو إلغاؤهــــا [27].
إضافة إلى اشتراط موافقة رئيس
الجمهورية على الأوامر القـانونية المتخذة، وهــذه المــوافقــة تكــــون في
مـــرحلتيــــن:
الأولى منها هي تقديـم طلب
التفويض إلى البرلمان، حيث لا يمكن للحكـومة أن تتقدم بهذا الطلب إلا بعد
مـــوافقـة رئيس الجمهـورية عليه، أما المرحلة الثـــانيـة فهي مــــرحلـة اتخاذ هـذه الأوامـر في
مجلس الوزراء، إذ أنه لابد من مـوافقة وتوقيع الرئـيس على تلك الأوامــــر قبــل
إصـدارها[28].
ومن المسلم به أن هـذه المـراسيم المتخذة من طرف
الحكـومة في نطاق التفويض يتـم العـمل بمقتـضاها بمجرد نشرها، غير أنه يجب عرضها
على البرلمان قبل انتهاء أجل التفويض، وذلك لكي يبدي رأيه فيها إما بقبولها، وعند
ذلك تبقى سارية المــفعـول، أو يرفضها وحـيـنئـذ تـــصـبح لا غـية[29].
وقانون الإذن يحمي المراسيم التفويضية من كل طعن قضائي ما دامت
الحكـومة لم تخترق هذا القانـون، أو تستمر في العمل به بعد انقضاء الأجــل
المحـــدد لــه. وعند خرق قانون الإذن تصبح المراسيم المتخذة بـمــــــوجـبـه
عـبارة عن قرارات إدارية مــن حيــث الشكل، حيث أنه يمكن الطعن فيها أمام القضاء
الإداري.
المطلب الثالث: نطاق التفويض وآثاره وطبيعته القانونية
إذا
كانت الدساتير تسمح بتفويض التشريع، فإن التساؤل يطرح حول نـــطـاقه (الفرع الأول)،
والآثار المترتبة عليه (الفرع الثاني).
لم
يحدد الدستور الموريتاني نطاق التفويض، على غرار الدستور الفرنسي لسنة 1958، الذي
أنقسم الفقهاء بخصـوصه إلى اتجاهين، الأول يـرى أن التفويض يكون في المجـال المخصص
للقانـون سواء كان القانـون العادي أو الأساسي، حيث يـرى الدكتور محسن خليل:
” أن التـفــويـض يرد على جميع المسائل التي تختص بها القوانيـن بنـوعيها
العـادية والنظـامية، ذلك أن المادة 38 من
الدستور الفرنسي قد أجازت التفويـض لتنفيذ الحكـومــــــــــة برنامجها، و هي
عبارة عـاـمـة لا تحـمـل في معناها أي تحــديـد أو تعيين للمسائل محـل
التفـــــويض، الأمـر الذي يؤدي إلى الاتسـاع المطلق في موضوعات التــــــفـويض في المسائل التي يختص القانون بتنظيمها، وإلى القـول في النهاية
باختفاء النطـاق المخصص للقانون الذي لا
يمكن لغيره أن يطـــرقـــــه”[30].
أمـا الاتجاه الآخـر فيـرى أن التفـويض لا يكون
إلا في نطاق القــــوانيـن العـــاديـة، وقد رأى الأستـاذ محمـد أشـــركــى أن:
” قبول تفويض التشريع في مجال القـــــوانيـن التنظيمية يجعلها مـماثله
للقـوانين العـاديـة ممـا يــؤدي إلى إعفــاءها من الرقـــابة الإلـزامية
…”[31]
. وبالتالي فإن نطاق التفويض ينبغي أن يكون في الميدان المخصص للقانون العــــادي.
أعطى
المشرع الدستوري المــــوريتـاني الحكـومة حق معـارضة المقـتـرحـات والتعديلات
البرلمانية إذا كـانـت تنـافي تفويضا بـمـقتضى المادة (60) من الدستـور، وإذا مـا
خــالـف البرلمان الرفـض الذي تثيـره الــحـكـــــومـة في هـذه الـحـالة أصبح
لرئيس الجـمهـورية الحـق في أن يلجأ إلى المجلـس الدستوري الذي يـبت في الأمــــر
في ظــرف 8 أيام (المادة 62 /4). ويتـرتب على التفـــــويض آثار بالنسبـة للحكومة
حيث يصبح بإمكان الحـكـومـة أن تـعـدل أو تـلغـي مـســائـل تـشـــــــريـعيـة
ســــــابـقـة أقـــــرهـا البــــــرلمـان إذا كانت لا تــنســجـم مـع
ســيـــاسـتهــا العـــــامـــة [32]
.
وهذا
ما يؤدي إلى أن يصبح تـــــفـويض الــــتشـريع أداة فــعـالة لدي
الـحــكـــومــــة قـــــد تستخدمها لإلغاء أو تعــــديـل النـــصـــوص
التـــشريعـــية.
إلا
أن ممـارسة الـحــكـــــومـة للــــوظــيـفة التشـريعية عن طريق الأوامـر
التـــــفــــــويـضية يـؤدي إلى خـلـق نوع من الاضــــــــطـراب في سلـم تـدرج
القــــــواعـد القـــــــانــــــــــونـية، وذلك لأنه يـجـعـل هـذه الأوامـر لها
نـــفـس قـوة القـــواعــد القـــــانــــــــونـية العادية التي تصـــدر عـــــن
الســـلـــــطـــــــة الـــتشـــريعية[33].
ولهذا
فإنه يجب أن لا تبالغ الحكومة في اســتـعمـال هذا الحق، إلا في حالة وجــود ضـرورة
تسـتدعي اللجـوء إلى ذلك، لكي لا يكون هــنــاك تغول في استعمال هـذا الامتياز
الذي قد يكـون على حساب السلطة الأصلية للتــشــــريــــع (البــــرلــمان).
الخاتمة:
ومن
خلال ما سبق يلاحظ أن السلطة التنفيـذية يمكن لها أن تتدخـل عن طـريق تقنية تفويض
التشـريع في ميدان كان مخصصا للبرلمان، بشرط مـــــوافقـة الـبرلمان وهـو يعـد
سيـد قـراره في هذا المجال، إذ لا يمكن للرئيس ولا الحكومة إلزامه بالاستجابة
للطلب الخاص بالتفـويض، كما أن هذا الأخير لا يمكـن أن يتم إلا وفق الشروط التي
حددها الدستور.
ـ H . GOURDON; Le régime de l’ordonnance en Algérie ; Revue algérienne des
sciences juridiques n°1 ; 1977 ; p : 25.