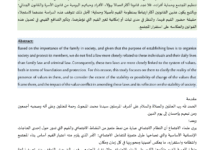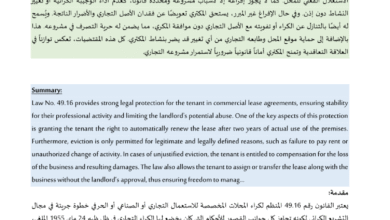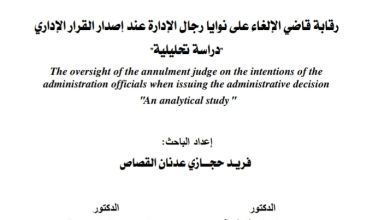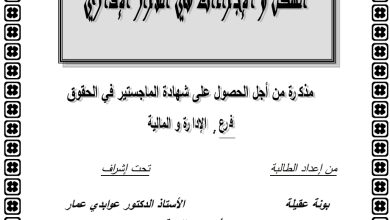حقوق اللاجئين وفق قـواعد القانون الدولي
حقوق اللاجئين وفق قـواعد القانون الدولي – دراسة حـــالة اللاجئين السوريين في الأردن – الدكتور عميد عاصم خصاونه، الدكتور “محمد براء” باسل أبو عنزه، الدكتورة فاطمة امراح
ملخَّص:
كان للأزمة السورية التي اندلعت عام 2011 تأثيراً كبيرًا على المملكة الأردنية الهاشمية، حيث استقبلت المملكة جرّاءَ هذه الأزمة أعداداً كثيرة من اللاجئين السوريين، فترتب على ذلك تَبِعات أمنية واقتصادية واجتماعية عديدة واجهت المملكة. وتأتي هذه الدراسة لبيان مفهوم اللاجئ وحقوق اللاجئين في القانون الدولي، من خلال التطرق للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وهي؛ “اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1967”. ثم تتناول دراسة حالة اللاجئين السوريين في الأردن والوضع القانوني لهم والتحديات التي يواجهونها. وتتضمن الدراسة عددا من الاستنتاجات والتوصيات لتحسين أوضاع اللاجئين حتى يتمكنوا من العودة الى وطنهم فور انتهاء تلك الازمة.
الكلمات الدالة: اللاجئ، القانون الدولي، اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1951، الأزمة السورية، المملكة الأردنية الهاشمية.
Abstract
The Syrian crisis that erupted in 2011 had a significant impact on the Hashemite Kingdom of Jordan, which received many Syrian refugees because of the crisis. This crisis resulted in numerous security, economic, and social repercussions for the Kingdom. This study aims to clarify the concept of refugees and refugee rights in international law by examining the relevant international agreements, namely the 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. It then examines the situation of Syrian refugees in Jordan, their legal status, and the challenges they face. The study includes several conclusions and recommendations to improve the conditions of refugees so they can return to their homeland once the crisis ends.
Keywords: Refugee, international law, 1951 United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, Syrian crisis, Hashemite Kingdom of Jordan.
مقدمة:
تعد مشكلة اللاجئين من أكثر المواضيع التي تستأثر باهتمام الأوساط الدولية في الوقت الراهن، فحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ارتفع عدد اللاجئين منذ عام 2011 – أي منذ اندلاع ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي – من 15,2 مليون إلى 43,7 مليون لاجئ حتى نهاية حزيران/ يونيو 2024.
والحديث عن مشكلة اللاجئين يثير الانتباه بالدرجة الأولى إلى وجود صراعات وحروب دفعت إلى الانتقال الجماعي للأفراد من موطنهم الأصلي إلى أماكن أخرى أكثر أماناً واستقراراً، على الأقل من الناحية السياسية والأمنية. وبالرغم من اختلاف أسباب اللجوء إلا أن الأزمات السياسية تعد السبب الرئيس لهجر اللاجئين لأوطانهم، ولذلك استقبلت منطقة الشرق الأوسط أكبر تجمعات اللاجئين في العالم. وتعد الحروب والنزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة وبالأخص الصراع العربي الإسرائيلي، والأزمات السياسية في بعض الدول العربية، وموجات الربيع العربي، سبباً في تواجد عدد من مخيمات اللجوء إما على الحدود بين دولة عدم الاستقرار وجوارها، أو داخل دول الجوار الإقليمي لمنطقة الصراع.
وتعد أزمة اللاجئين السوريين منذ اندلاعها إلى غاية سقوط نظام بشار الأسد، من بين أكبر الأزمات الإنسانية، التي استدعت تدخل مفوضية اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة، لتوفير الحماية الدولية للاجئين، وإيجاد حلول إنسانية مؤقتة، من خلال بناء مخيمات على الحدود السورية مع بلدان الجوار، أو مخيمات خارج حدود سوريا.
اولاً: أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في تسليط الضوء على أهمية موضوع اللاجئين والحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها في بلدان اللجوء، خاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين، وما يطرحه ذلك من صعوبات على الدول المضيفة، لخلق ظروف تمكن اللاجئين من ممارسة حقوقهم، وتوضيح التزامات اللاجئين في بلدان اللجوء في ظل القانون الدولي، خاصة في نطاق اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1951″، و”البروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967″.
وتكمن أهمية الدراسة في انها تسلط الضوء على حالة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، على اعتبار أن الأزمة السورية إحدى الأزمات الطويلة التي كانت لها انعكاسات على الدولة المضيفة، من النواحي الأمنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثانياً: إشكالية الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في بيان حقوق اللاجئين السوريين والالتزامات المترتبة عليهم في المملكة الأردنية الهاشمية، خاصةً وان المملكة لم توقع على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1967″.
ثالثاً: منهج الدراسة:
نظراً لطبيعة موضوع الدراسة، فقد تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع اللاجئين، وكذلك دراسة حالة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، بناءً على مذكرةُ التفاهم التي وقَّعتها الحكومة الأردنية مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” في العام 1998، والتي تم تعديلُها جزئيا في عام 2014، كون المملكة لم تكن طرفاً في “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951.
رابعاً: أقسام الدراسة:
تحتوي هذه الدراسة على مبحثين اثنين ينقسم كلٌّ منهما إلى مطلبين، وذلك على النحو الآتي:
المبحث الأول: مفهوم اللاجئ وحقوقه في القانون الدولي.
المطلب الأول: مفهوم اللاجئ في القانون الدولي.
المطلب الثاني: الضمانات القانونية للاجئين في القانون الدولي.
المبحث الثاني: دراسة حالة اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية.
المطلب الأول: الوضع القانوني للاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية.
المطلب الثاني: التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في المملكة الأردنية الهاشمية.
المبحث الأول: مفهوم اللاجئ وحقوقه في القانون الدولي.
تعد النزاعات المسلحة والحروب من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الموت والنزوح واللجوء والمعاناة للشعوب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النزاعات التي تنخرط فيها أطراف متنازعة داخل دولة واحدة (نزاعات مسلحة غير دولية) كالأزمة السورية، وتلك التي تنخرط فيها قوات مسلحة من دولتين أو أكثر (نزاعات مسلحة دولية) كالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت بإلحاق الضرر بملايين البشر بطرق لا حصر لها، منها التهجير القسري.
لقد أحدثت حركة الهجرة القسرية السورية الحالية (اللجوء) تغييرات عميقة في نظام الهجرة في الشرق الأوسط. فقبل عام 2011، كانت سوريا تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، في الغالب من أصول فلسطينية وعراقية وسودانية وصومالية. لكن مع اندلاع الأزمة السورية، أصبحت سوريا واحدة من البلدان الرئيسة التي تصدر اللاجئين إلى العالم، إذ فرَّ أكثر من 5,6 ملايين سوري من ديارهم، معظمهم إلى البلدان المجاورة. ووفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا ولبنان والأردن والعراق حاليًا الغالبية العظمى منهم.
ويمكن القول، أن ما تشهده الساحة العالمية والإقليمية اليوم من نزاعات وحروب، فرض بالضرورة طرح سؤال عن مدى تطبيق القانون الدولي على أرض الواقع من قبل ول اللجوء، وعن نصيب الحماية التي يحظى بها اللاجئ في ظل القانون الدولي، وبالتالي فإن دراسة حقوق اللاجئين في القانون الدولي، يفرض في البداية تعريف اللاجئ وفقا للقانون الدولي والحقوق التي نصت عليها عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المطلب الأول: مفهوم اللاجئ في القانون الدولي:
يرتبط موضوع اللجوء كغيره من أنواع الهجرة الدولية بوجود الدولة، واللجوء هو انتقال قسري من الدولة الأصل إلى دولة أخرى بحثاً عن الأمن والأمان، وقد أكدت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، على حق كل فرد في اللجوء الى الدول الأخرى، ويمكن للأشخاص المتهمين بجرائم سياسية، الاستفادة من هذا الحق، اما الأشخاص المتهمين بجرائم عادية أو أعمال تتناقض مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، فانهم لا يستفيدون من هذا الحق. كما ان المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أُقر عام 1966 منحت الشخص حرية مغادرة بلد ما بما في ذلك بلده، وهذ يعني ان المغادرة قد تكون للإقامة القانونية أو اللجوء.
وقد عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951 اللاجئ بأنه:” “كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد”. والقارئ لهذه المادة يلاحظ ان الاتفاقية وضعت قيدين للجوء، أولهما: قيد زماني للجوء، بحيث ينطبق وصف اللاجئ على الأحداث التي وقعت قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951، الا ان الاتفاقية لم توضح المقصود بهذه الاحداث أو طبيعتها، وبالتالي فان كل شخص توافرت فيه الشروط الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، بعد تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 1951، لا ينطبق عليه وصف لاجئ، وهو الامر الذي تم تداركه في البروتكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1967، حيث تم اعتبار كل شخص تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية بعيداً عن شرط التاريخ لاجئاً.
وثانيهما: قيد جغرافي للجوء، وهو أن تكون الاحداث قد وقعت في أوروبا. حيث أن “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951 أول وثيقة قانونية تحدد من هو اللاجئ وما هي حقوقه، كما تحدد الالتزامات القانونية للدول المضيفة، وتبين نوع الحماية القانونية للاجئ، فهي أول اتفاقية دولية تتطرق لحقوق اللاجئين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم، الا أنها كانت تعكس الاهتمامات السياسية في حينه، وحصر تطبيق الاتفاقية على اللاجئين الأوروبيين. الا ان تعريف اللاجئ جاء وفقاً للمفاهيم الأوروبية، وأقصى حالات اللجوء في المناطق الأخرى، خاصة حالات اللجوء في العالم الثالث. كما حصرت اللاجئين ممن تعرضوا للاضطهاد قبل 1 كانون الثاني/ يناير 1951، علما أن أزمات اللجوء مستمر ولا تقتصر على قارة دون غيرها. وبسبب تزايد مأسي اللاجئين خاصة منها في القارة الافريقية كالجزائريين الذين كانوا قد هربوا إلى المغرب وإلى تونس في أعقاب حرب استقلال الجزائر، وكذلك مناطق أخرى خلال ستينيات القرن الماضي شهدت نزوح أعداد من اللاجئين داخل القارة الأفريقية تزامنا مع سعي دول افريقية لتصفية الاستعمار، ولهذا السبب، تم إقرار بروتوكول إضافي في العام 1967 تابع لاتفاقية 1951، الذي أزال التحديد الزماني والجغرافي.
وتتميز “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” لعام 1951 بأنها المرجع الأساسي على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للاجئين، كما إنها تعرف “اللاجئ” وتبين شروط منحه صفة اللجوء أو سحبها، كما تتضمن احكاماً خاصة بالوضع القانوني للاجئين وحقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن انها لا تضع الكثير من الالتزامات على الدول، من أجل تشجيع الدول على الانضمام للاتفاقية، ولذلك فإنها تقبل بإمكانية التحفظ على موادها.
ويمكن القول، إن مشكلة اللجوء وأسبابه من المواضيع المهمة على الساحة الدولية، وأن حقوق اللاجئين، تناولتها العديد من الاتفاقيات الدولية، بداية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 والبروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1967، وهما الإطار القانوني المؤطر للحقوق والضمانات القانونية التي تمكن اللاجئين من الحماية الدولية، وهو ما سيتم الإحاطة به في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: الضمانات القانونية للاجئين في القانون الدولي:
يقصد بالضمانات القانونية للاجئين، الحقوق المكفولة لهم بموجب القانون الدولي، والمتناسبة مع خصوصية ووضع اللجوء، سواء منها الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو التي تضمنها المنظمات الدولية المعنية بحماية هذه الفئة. وتعني الحماية الدولية للاجئين عمليات التدخل من قبل الدول أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR)) بالنيابة عن ملتمسي اللجوء، بقصد الاعتراف بحقوقهم، وأمنهم، وسلامتهم، وحمايتها وفقاً للمعايير الدولية.
فالأصل أن واجب توفير الحماية للمواطن تقع على عاتق الدولة الأم، غير أنه في حالة هروبه بسبب اضطهاد أو خوف له ما يبرره خارج حدود دولته؛ فإن الحماية تصبح مسؤولية المجتمع الدولي. وهذه الحماية الدولية تمنح له بصفته ‘لاجئ’ وهي تعد حماية دولية مؤقتة إلى حين عودته الطوعية أو انتهاء سبب اللجوء. وبذلك تكون الحماية والسلامة في دولة اللجوء من اهم الضمانات الدولية لحقوق اللاجئين في القانون الدولي.
وبالإضافة للضمانة سالفة الذكر تتضمن مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية نصوصا تتعلق بشكل غير مباشر بحقوق اللاجئ، ومنها ماورد من حقوق وضمانات للإنسان بشكل عام في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهديين الدوليين. إلا انه تبقى “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1967″، المرجع الرئيس لحقوق اللاجئين في القانون الدولي، وأحد المصادر الرئيسية للصكوك الناظمة لمسألة اللجوء، لذلك تعتبر بمثابة حجر الزاوية في النظام الدولي لحماية اللاجئين، المتضمن لحقوق هذه الفئة ولمبررات زوالها.
أولاً: حقوق اللاجئ في القانون الدولي:
يعود الفضل في إعطاء مدلول شامل للحماية إلى المفوضية السامية، ويتعدى ذلك المعنى الضيق للحماية بتوفير الخدمات القنصلية ومنح وثائق سفر للاجئين . وتتمثل هذه الحماية في نوعين من الحقوق تمنح للاجئين ويمكن تقسيمها لحقوق عامة وأخرى خاصة.
1– الحقوق العامة:
تتمثل الحقوق العامة للاجئ في الحقوق الأساسية التي تمنح له لصفته الإنسانية، وهي بذلك مكفولة للبشرية كافة دونما تمييز، ومن أهمها الحق في الحياة، والحق في عدم التمييز إضافة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية كالحق في التنقل والسكن والحق في العمل.
الحق في الحياة: هو أول الحقوق الطبيعية اللصيقة بالكائن البشري، وهو من الحقوق غير القابلة للتعطيل أو التنازل أو التفويت، وقد أكدت عليه مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الانسان، حيث جاء في المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه: ” لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه”. كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن: “الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا” .
الحق في عدم التمييز: يعد من الحقوق الأساسية في الصكوك الناظمة لحقوق الإنسان، وبمثابة حق عام يتفرع عنه العديد من الحقوق الأخرى. والحق في عدم التمييز من الحقوق التي تظهر أهميتها عند الحديث عن حقوق اللاجئين، خاصة في حالة اتباع دول الاستقبال لسياسة تمييزية مجحفة ضد اللاجئين. وقد أخد مبدأ عدم التمييز مكانا بارزا في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والتي تضمنت في مادتها الثالثة على أنه:” تطبق الدول المتعاقدة أحكام تلك الاتفاقية دون تمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو الموطن”. والحق في الحماية من التمييز والاضطهاد بسبب الدين يخول لكل فرد التمتع بحق ممارسة شعائره الدينية.
الحقوق المدنية والاقتصادية: يضمن القانون الدولي عدد من الحقوق المدنية والاقتصادية للإنسان بوجه عام وللاجئ على وجه الخصوص. وقد تضمنت الاتفاقية الخاصة باللاجئين عدد من هذه الحقوق، نذكر منها الحق في التنقل بحرية وحق السكن والحق في التعليم والرعاية الصحية. وهي حقوق يستفيد منها اللاجئون المقيمون بصورة نظامية في بلدان الاستقبال، وتثار هنا إشكالية اللاجئين غير الشرعيين ومدى إمكانية تمتعهم بهذا الحق، والحديث هنا عن حق طالبي اللجوء ممن لم يتم تسوية وضعيتهم بعد. والرأي الراجح بان هذا الحق يكون بالنسبة للاجئ غير الشرعي مقيد بقانون الدولة المستضيفة.
أما الحقوق الاقتصادية فمنها مثلا الحق في العمل، حيث أكدت الاتفاقية الخاصة باللاجئين على منح الدول المستضيفة للاجئ على أراضيها الحق في ممارسة عمل مدفوع الاجر، أو عمل حر على أراضيها كما هو الحال بالنسبة للمعاملة الممنوحة للأجانب عامةً، كالعمل في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وإنشاء شركات تجارية أو صناعية، أو ممارسة مهن حرة، وذلك وفق دساتير وقوانين الدول المضيفة للاجئين.
كما خولت المادة 15 من نفس الاتفاقية للاجئ حق الانتماء للجمعيات غير السياسية وحق الانتماء للنقابات.
2 – الحقوق الخاصة باللاجئ:
وهي الحقوق التي تثبت له بناء على وضعه الخاص المتمثل في صفته كلاجئ وهي:
أ- الحق في الحماية من الإعادة القسرية:
يعتبـر الحق في الحماية من الإعادة القسرية من المبادئ الأساسية التي يُبنى عليها نظام الحماية الدولية للاجئين، وبموجب هذا الحق يُحظر على الدول إعادة اللاجئين إلى الأماكن التي قد تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر. كما أن الحديث عن حقوق اللاجئين المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لا يمكن لها أن تقوم دون تطبيق الحق في الحماية من الإعادة القسرية. نذكر منها على سبيل المثال الحق في عدم الملاحقة أو المسائلة للدخول بصورة غير قانونية، والحق في عدم الطرد أو الإعادة إلى دولة الاضطهاد، ولكن ضمانات عدم الطرد والإبعاد، تعد غير مطلقة، إذ يمكن استخلاص ثلاث ملاحظات في قراءة وتحليل المادة 32 من الاتفاقية الخاصة بشؤون اللاجئين وهي:
1) خصت المادة هذه الضمانة للاجئ الموجود فوق تراب الدولة المستضيفة بصورة نظامية، وبالتالي فهي تقصى طالبي اللجوء، ومنهم أولئك الذين دخلوا بطرق غير شرعية ضمن هجرات جماعية مختلطة.
2) تعطي نفس المادة للدولة المستضيفة الحق في اتخاد التدابير اللازمة بالطرد في حالة الإحساس بتهديد الأمن الوطني والنظام العام للدولة المستضيفة. وأمام غياب تحديد دقيق لمفهوم تهديد الأمن الوطني والنظام العام، فإن الاتفاقية تمنح سلطة تقديرية واسعة للدولة المستضيفة، واعتماده كمبرر لطرد اللاجئين غير المرغوب فيهم.
3) رغم وضع شرط إعطاء الفرصة للاجئ من أجل إثبات براءته إلا أنه إجراءٌ يخضع لقانون الدولة المستضيفة، وقد يكون قيداً في مواجهة اللاجئ لصعوبة الإجراءات القانونية المتبعة، و/ أو عدم قدرة اللاجئ على تطبيقها أو لعدم احاطته بها.
ب- الاعفاء من مبدأ المعاملة بالمثل:
تطبيق المعاهدات الدولية مقيد بمبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعني أن نطاق تطبيق المعاهدة يتسع أو يضيق بحسب تصرف أو تصرفات الدول الأطراف فيما بينها، وقد تتضمن بعض المعاهدات إشارة صريحة إلى قاعدة المعاملة بالمثل.
غيـر أن اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين تستثني مبدأ المعاملة بالمثل، من خلال المادة السابعة والتي تضمنت في فقرتها الأولى والثانية والثالثة على انه، إذا تعذر على الدولة المستضيفة معاملة اللاجئ معاملة فضلى فيكون من واجبها معاملته كأجنبي. ويتمتع جميع اللاجئين بعد مرور ثلاث سنوات على إقامتهم بالإعفاء من شرط المعاملة بالمثل على أرض الدول المستضيفة. وأن تواصل كل دولة مستضيفة منحهم المزايا والحقوق التي كانوا يستحقونها، دون الاخذ بعين الاعتبار شرط المعاملة بالمثل.
كما حثت الفقرة الرابعة من ذات المادة الدول المستضيفة بالنظر في إمكانية منح اللاجئين، مزايا وحقوقا بالإضافة إلى تلك الممنوحة لهم بموجب الفقرتين الثانية والثالثة مع عدم توفر شرط المعاملة بالمثل. وهو تأكيد على التعامل مع وضع اللاجئ بصفة أكثر إنسانية بغض النظر عن استيفائه للشروط الواردة في الفقرتين الثانية والثالثة من ذات المادة.
ج- الحقوق الإدارية والقضائية:
تعتبر الحقوق الإدارية من أهم الحقوق الممنوحة للاجئ طبقاً لمقتضيات الاتفاقية الخاصة باللاجئين، ويعني ذلك تأمين المساعدة الإدارية من قبل الدولة المستضيفة أو من طرف سلطة دولية، مع مراعاة ما يمنح للمعوزين من معاملة استثنائية. ويتمثل في إصدار وثائق رسمية للاجئين لتسهيل حياتهم اليومية وإعطائهم الحق في ممارسة حقوقهم المدنية، كما يحق للاجئين تسجيل أطفالهم حديثي الولادة للحصول على شهادات ميلاد قانونيّة، مما يساهم في حمايتهم وحفظ حقوقهم المدنية والاجتماعية.
وتضمن القانون الدولي للاجئين كذلك عدة ضمانات قضائية هامة، منها ما يلي:
* يعترف القانون الدولي بالشخصية القانونية للاجئين، مما يتيح لهم اكتساب الحقوق والالتزامات مثل أي شخص آخر.
* حق التقاضي أمام المحاكم، حيث يتمتع اللاجئون بحق التقاضي الحر أمام المحاكم في الدول المتعاقدة، مع الحصول على نفس المعاملة التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بالمساعدة القضائية والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
* حق إثبات براءته، ويبدو أنه رغم وضع شرط إعطاء الفرصة للاجئ لإثبات براءته فإنه يخضع للقانون العام والمسطرة القضائية لدولة الملجأ، مما قد يفسر أنه شرط على الدولة المضيفة، وكذلك قد يكون قيدا أمام اللاجئ لصعوبة المساطر القضائية بدولة الملجأ، وعدم قدرته على تطبيقها أو لجهله بها.
ثانياً: مبررات زوال الحقوق المكفولة للاجئ:
من الممكن إلغاء اللجوء والحماية الدولية المؤقتة في بعض الحالات منها:
1 – انتهاء سبب اللجوء، كانتهاء النزاع او الحرب في البلد الأصل. شرطية العودة الطوعية.
2 – إذا دخل اللاجئ بلده الأصلي: فإذا سافر اللاجئ إلى بلده أو اتصل بسفارة أو قنصلية بلده، فقد يفقد وضعه كلاجئ، وذلك لأن وضعية اللجوء تمنح لأن طالبها يعتبر بحاجة إلى الحماية من بلد المنشأ. أو لاستئناف الحماية الوطنية: في حالة اختار اللاجئ أن يحتمي بحماية بلد جنسيته مرة أخرى، سواء عبر العودة الطوعية أو استعادة الجنسية بعد فقدانها.
3- الإدانة بجرائم ضد السلام وضد الإنسانية وبجرائم الحرب أو بكل ما يتناقض مع مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتهديد النظام العام وأمن الدولة التي منحت اللجوء على أراضيها.
4 – كما يجوز تعليق اللجوء الممنوح من قبل دائرة الهجرة واللجوء، إما لأسباب مقنعة بتشكيل اللاجئ خطرً على الأمن القوميّ للدولة المانحة للجوء. أو بسبب عدم استيفاء شروط اللجوء: إذا ثبت أن الشخص لم يكن يتعرض لاضطهاد فعلي في بلده الأصلي، أو إذا كانت ادعاءاته غير مثبتة أمام القضاء أو لإدانته بارتكاب جريمة خطيرة. أو عند تبين تزويره وثائق الحصول على اللجوء.
المبحث الثاني: دراسة حالة اللاجئين السوريين في الأردن
كان للأحداث التي وقعت في سوريا منذ بدء أحداث الربيع العربي عام 2011 أثرها الكبير على دولة الأردن، إذ لم تقتصر الآثار التي عانى منها الأردن جرّاءَ الأزمة السورية المستمرة منذئذٍ وحتى الآن، على استقباله أعداداً كبيرة من اللاجئين السوريين، وإنما كانت هنالك تَبِعات أمنية واقتصادية واجتماعية عديدة.
فمنذ بدء الأزمة السورية استقبل الأردن موجاتٍ متتاليةً من اللاجئين من سوريا، التي يرتبط معها بحدود على امتداد 370 كيلومترا. وقد تسببت الأزمة في سوريا بمشاكل عديدة للأردن، إضافةً لقضية اللاجئين. فإلى جانب العبء الثقيل والمفاجئ الذي مثَّله تدفّقُ اللاجئين بأعدادٍ كبيرة، والآثار الاقتصادية كذلك، حيث اضطُرَّ لإقامة المخيمات وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، فقد عانى الأردن كذلك من مشاكل أمنية كثيرة. ولعلّنا نشير هنا إلى محاولات جماعات إرهابية أو متطرفة عنيفة التسلل من الأراضي السورية إلى الأردن، وتهريب السلاح والمتفجرات بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، الأمر الذي اضطُرَّ الأردن لتعزيز الأمن على حدوده مع سوريا. وقد قعت بالفعل مئات من محاولات التسلل الخطيرة إلى الأراضي الأردنية خلال سنوات الأزمة الماضية، رصدتها القوات الأردنية وتصدَّت لها، وخاصة في مخيم “الرُّكبان” للاجئين السوريين، الواقع داخل الأراضي السورية قريباً من الحدود مع الأردن حيث يقطن في المخيم 59 ألف سوري، غالبيتهم العظمى من اللاجئين العاديين الذين يرغبون في دخول الأردن، غير أنه يقيم في المخيـــــم أيضا بعض “أمراء الحرب، وكذلك العيون والأنصار وربمـــا أعضاء لتنظيم داعش الإرهابي”.
كما يشكل عملاء داعش المتواجدون في المخيم تهديداً أمنيًا لقوات الحدود الأردنية، الأمر الذي يدفعهم لإخضاع جميع اللاجئين عند وصولهم إلى الطرف الأردني من الحدود لفحوصات أمنية مكثفة للتأكد من أنهم “نظيفون”، حيث عثر بالفعل في بعض الحالات على أسلحة وأحزمة ناسفة وحتى طائرات (درون) مع اللاجئين.
كذلك واجه الأردن معضلة تهريب المخدرات من سوريا إلى داخل أراضيه، حيث صدرت عدة تقارير عن تورط نظام بشار الأسد، وأخيه ماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة العسكرية، بإنتاج حبوب “الكبتاغون” المخدّرة في معامل خاصة تابعة له ولفرقته، يتم تهريبها وخاصة إلى الدول القريبة من الحدود السورية، مما أدى لإغراقها بهذا المخدر منذ عام 2011 بهدف الحصول على التمويل اللازم لاستمرار آلة الحرب ودفع رواتب الجنود وتمويل مصالح آل الأسد وثرائهم. حيث قدر ما تدره تجارة “الكبتاغون” على خزينة آل الأسد حوالي 50 مليار دولار سنويا، كما أكتشف السوريون عقب سقوط النظام العديد من معامل إنتاج “الكبتاغون” تلك في دمشق وريفها ومناطق أُخرى.
وكعادته في استقبال اللاجئين من دول الجوار التي وقعت فيها حروب أو نزاعات داخلية طوال القرن الماضي (من فلسطين ولبنان والعراق وغيرها)، فتح الأردن ذراعيه لاستقبال اللاجئين السوريين الفارّين من مناطقهم التي شهدت أعمال عنف مسلح أو ممارسات قمعية ارتكبها نظام الأسد في مواجهة الحراك الشعبي الذي قام به السوريون عام 2011 للمطالبة باسترداد حريتهم وكرامتهم ومقدّرات بلدهم، بعد مرور نصف قرن على الحكم السلطوي لحزب البعث السوري (منذ 1963)، منها أربعون عاما تحت الحكم الدكتاتوري لحافظ الأسد (1971-2000) ثم ابنه بشار، الذي تمكّن من مدِّ عمر النظام السلطوي على مدى ربع قرن بفضل مساعدة بعض القوى الخارجية (إيران وحزب الله اللبناني وروسيا)، إلى أن تمكنت قوى الثورة السورية أخيراً من إسقاط النظام بعد سيطرتها على العاصمة دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، حيث فرَّ بشار الأسد من سوريا، وهربَ أركانُ نظامه الوالغون في الدم السوري وأولهم أخوه ماهر. فوضعت الثورة بذلك نهايةً لحُكم بشار ولسيطرة حزب البعث على سوريا. وبعد سقوط النظام بثلاثة أيام، قرر حزب البعث الذي جثم على صدور السوريين على مدى ستة عقود “تعليق عمله حتى إشعار آخر”.
ويُعتبر سقوط النظام البعثي في سوريا، انعطافةً تاريخيةً هامةً لسوريا، ومن المنتظَر أن تكون له آثاره التي من أهمها عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين – إن لم يكن جميعهم – إلى بلدهم حالما يستقر الوضع هناك، علماً بأن أعدادا منهم قد بدأت بالفعل بالعودة إلى سوريا في اليوم التالي لسقوط النظام.
ولقد استمر الأردن في استضافة حوالي 1,3 مليون لاجئ سوري منذ بدء الأزمة عام 2011 وحتى الآن، وقدم كل ما في استطاعته من خدمات وتسهيلات لهم. ومع أن هذه الأزمة قد طال أمدُها، ورغم أن الدعم الدولي بهذا الخصوص أخذ يتضاءل في الأعوام الأخيرة، إلا أن الأردن ظل، حكومةً وشعباً، مرحّباً باللاجئين السوريين، بانتظار أن تتهيَّأ الظروف المناسبة لعودتهم. وتمثَّل موقفه إزاء عودتهم إلى بلدهم في أن تلك العودة يجب أن تكون طوعية لا قسرية، حسبما أكّد مسؤولوه في أكثر من مناسبة. وفي حين أن العديد من اللاجئين السوريين قد يسارعون في العودة إلى وطنهم بعد سقوط النظام هناك وبدء مرحلة جديدة في تاريخ سوريا، فمن المتوقع أيضا أن يتريّث آخرون منهم ريثما يستقر الوضع وتتضح الصورة في بلدهم. حيث تنطوي عودة هؤلاء إلى الوطن على مغامرة، ولا سيّما أنّ الأوضاع المعيشية بالنسبة إلى اللاجئين السورين في الأردن مقبولة مقارنة بدول الجوار الأخرى مثل لبنان وتركيا.
المطلب الأول: الوضع القانوني للاجئين السوريين في الأردن
أولا: الإطار القانوني لسياسات الأردن تجاه اللاجئين السوريين والإطار:
لم يوقع الأردن على “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” المُبرمة عام 1951، ورغم أنه لم يُدخل أحكام تلك الاتفاقية في تشريعاته الداخلية، فإنه يُعتبر من أكثر الدول استضافةً للاجئين. وتُنظِّم شؤونَ اللاجئين الذين يستضيفهم مذكرةُ تفاهم وقَّعتها الحكومة الأردنية مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” عام 1998، وتم تعديلُها جزئيا عام 2014.
وبحسب المفوضية، فإن مذكرة التفاهم هذه “تشكِّل أساسَ أنشطة المفوضية في الأردن ذلك أنه في حال عدم وجود وثيقة قانونية دولية أو وطنية سارية للاجئين في بلدٍ ما، فإن مذكرة تفاهم كهذه تحدد معايير التعاون بين المفوضية والحكومة. وتقول المفوضية إن الأردن، رغم أنه ليس طرفا في الاتفاقية الدولية المذكورة، فهو “يَعتبر السوريين لاجئين، وأن مساحة الحماية المتوفرة للاجئين في الأردن مواتية على الرغم من هشاشتها نظرا للتحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
وبالإضافة لمذكرة التفاهم هذه، يعد الأردن طرفًا في العديد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تتضمن أحكاما تلتزم بها الدول تجاه جميع الناس الواقعين تحت ولايتها سواء كانوا مواطنين أو لاجئين أو مقيمين عاديين. وتشكل التزامات الأردن بموجب الاتفاقيات الدولية، إضافةً لمذكرة التفاهم المذكورة، الإطار القانوني المتَّبع في تعامل الأردن مع اللاجئين السوريين.
ففي إطار مذكرة التفاهم ما بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية، بات بإمكان اللاجئين السوريين العمل في الأردن، حيث يتم اصدار تصاريح عمل لهم من قبل وزارة العمل الأردنية كما يتم التعاون مع منظمة العمل الدولية لتنظيم دورات تدريبية بهدف إعداد العمال السوريين لسوق العمل في بعض المهن، ليحصلوا على شهادات تمكّنهم من التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي.
ونظراً لكون الأردن طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل (1989)، فقد احترم التزاماته بموجب هذه الاتفاقية وقام بتوفير الفرصة لجميع أطفال اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه للحصول على التعليم العام في المدارس الحكومية في جميع المدن والقرى الأردنية، كما تم افتتاح مدارس في المخيمات. كذلك، قدم قطاع الصحة الأردني للاجئين السوريين جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن الأردني دون أي تمييز.
علاوةً على أن بعض المبادئ التي تضمّنتها الاتفاقية قد أصبحت بمثابة عرفٍ مستقرٍ في القانون الدولي، مثل مبدأ عدم إعادة اللاجئين إلى دولة الاضطهاد، فأن الأردن يعد طرفاً في عدد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان (التي تمنع – مثلاً – إعادة الأجنبي إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد أو التعذيب)، كاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (1984) والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية (1966).
كذلك، يتضمن الدستور الأردني أيضا وخاصة في المادة رقم (21/1) على أنه “لا يُسَلَّم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية”.
ثانيا: التحديات التي يواجهها الأردن في إدارة أزمة اللاجئين السوريين
لم يتوان الأردن عن استقبال اللاجئين السوريين خلال الفترة التي سبقت ثورات الربيع العربي، رغم ضائقته الاقتصادية والتي بدأت مع أزمة الخليج الثانية (1990) التي نجم عنها عودة العمالة الأردنية والفلسطينية من الخليج العربي إلى السوق الأردني، حيث أدى ذلك كله إلى تحديات اقتصادية كبيرة للأردن من أبرزها ارتفاع نِسَب البطالة والمديونية والفقر وايجاد فرص عمل.
- التحديات الاقتصادية في ظل قلة الموارد
مع بدء تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ازدادت ظروفه الاقتصادية صعوبةً، وبات من مظاهرها تباطؤ النمو الاقتصادي، وخلل في ميزان المدفوعات، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتدنّي مستوى الدخل، وزيادة النمو السكاني مع عدم زيادة الدخل الشهري للمواطنين، إضافةً لزيادة البطالة والمديونية، والضغط على البنية التحتية، وازدياد الطلب على الخدمات الأساسية. لقد كان للازمة السورية ونزوح اللاجئين أثره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الدول المجاورة وخاصة الأردن نظرًا للقرب الجغرافي أولًا، وثانيًا لشح الموارد الطبيعية الذي تعاني منه الأردن بالفعل، حيث تسببت الحرب في سوريا بلجوء حوالي سبعة ملايين مواطن سوري إلى دول أُخرى، استقبل الأردن منذ بداية الحرب في سوريا نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، منهم 670 ألف لاجئ مسجلون لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعيش نحو 20% منهم في مخيمات الزعتري والأزرق شمال وشرق الأردن، ويضم الأخير نحو 38 ألف لاجئ.
قام الأردن بإنشاء أربع مخيمات خاصة باللاجئين السوريين متجاوزا قدراته الاستيعابية في احتواء اللاجئين في المخيمات وخارجَها، وهو ما شكّل ضغطًا على العديد من القطاعات؛ فاللاجئون داخل المخيمات بحسب الإحصاءات الرسمية يشكّلون فقط حوالي 10% من مجموع اللاجئين السوريين.
ب. التعليم: أتاح الأردن للاجئين السوريين الحصول على الخدمات العامة ومنها التعليم المدرسي إذ يستضيف الأردن أكثر من 150 ألف طالب سوري مسجّلين في النظام التعليمي الرسمي، يكبدون الحكومة الأردنية الكثير حيث لا تتجاوز ما يحصل عليه الأردن من مساعدات دولية للسوريين ال30% مما تتكبده الحكومة ـ حيث وصلت تكلفة الطالب السوري في المرحلة الأساسية ابين 450-الى 800 دينار في المرحلة الثانوية وتبلغ في التخصص المهني 1100 مما جعل العملية التعليمية في تراجع مستمر وازدياد الضغوط علــى وزارة التربية والتعليم التي تبدو عاجزة أمام قلة المـــــوارد عاجزة عن ادارة ملف تعليــــم الطلبة السوريين .
ج. ازدياد معدل البطالة: سمح الأردن للاجئين السوريين بدءً من عام 2016 بالعمل في قطاعات مختلفة من السوق المحلي كي لا يبقوا معتمدين فقط على ما يصل من المساعدات الدولية التي أخذت تنخفض عاما بعد عام. وبذلك، “بات الأردن أول بلد في المنطقة العربية يسهّل توفير تصاريح العمل للاجئين السوريين عبر الإعفاء من الرسوم المعتادة وتخفيف المتطلبات الإدارية”، بحسب ما أفادت مفوضية اللاجئين، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2017، أصدرت وزارة العمل الأردنية ما يقرب من 30,000 تصريح عمل للاجئين السوريين. كما أصدرت قوانين تمكّن اللاجئين السوريين من العمل رسمياً خارج المخيمات في كافة أنحاء الأردن، كما بات بإمكان اللاجئين السوريين التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل في القطاعات المعتمدة للعمال الأجانب، مثل الزراعة والبناء والمنسوجات والمواد الغذائية. وقالت المفوضية حينذاك إن الحكومة الأردنية “قد تعهَّدت بتوفير ما يصل إلى 200,000 فرصة عمل على مدى عدة سنوات للاجئين السوريين، مقابل قروض دولية ومزايا تجارية واستثمارات من المجتمع الدولي من شأنها أيضاً أن تعود بالفائدة على السكان الأردنيين”.
جدير بالذكر أنه تم منح أكثر من 370 الف تصريح عمل للسوريين على الرغم من ازدياد معدل البطالة في الأردن حيث أفاد تقييم “الوضع الاجتماعي والاقتصادي للاجئين في الأردن” الذي تجريه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن الربع الرابع من 2023، أن معدل البطالة بلغ 27.2% بين اللاجئين السوريين و43.8% بين اللاجئين غير السوريين، هذا في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة بين الأردنيين 16.9% بحسب بيانات فترة الربع الثالث من عام 2023.
د. ارتفاع معدل المواليد:
يواجه الأردن إشكاليةً أُخرى متمثلة في معدل المواليد لدى اللاجئين السوريين إذ بلغ عددهم منذ بداية الأزمة السورية أكثر من 200 ألف طفل، ما يعني أن معدل الخصوبة بين السوريين 4.7 %، أي حوالي ضعف معدل الخصوبة في الأردن البالغ 2.6%. وقد واجه الأردن ضغوطًا متزايدة في ظل تقلص المساعدات وشح الدعم من المجتمع الدولي لمساعدته على مواجهة هذه الأزمة الإنسانية وتَبِعاتها. وقد وضع الأردن خططَ استجابة للأزمة، وأطلق مناشدات للحصول على الدعم اللازم. وبالطبع فلم يكن ذلك الدعم ملبّيا تماما للاحتياجات، خاصةً في السنوات الأخيرة. ففي حين أن الدعم الدولي بلغ عام 2016 حوالي 70% من حجم الاحتياجات، فقد أخذ بالانخفاض بعد ذلك حتى بلغ 33% عام 2022، ثم انخفض إلى 6% عام 2023.
ثالثا: تقييم مدى استجابة الأردن لاحتياجات اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية:
استقبل الأردن اللاجئين السوريين احتراما منه لالتزاماته الدولية وحرصا منه على إغاثة الملهوفين، فوفّر لهم الإقامة في أمان وظروف إنسانية تحفظ كرامتهم وسلامتهم بحسب ما تسمح به إمكانياته المادية، إضافةً لما وصله من دعم مالي وإغاثي دولي، رغم عدم تناسب حجمه مع المتطلبات. ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية يعيش نحو ثلثي اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللاجئين حيث يعيش العديد منهم في المحافظات الشمالية المحاذية للحدود السورية ومنها محافظة اربد والمفرق فضلا عن عمان.
قدم الأردن لهؤلاء اللاجئين فرص الاستفادة من الخدمات الحكومية، كالصحة والتعليم، وسمح لهم بالعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتنقّل ما بين تلك القطاعات بمرونة. كما أقام مراكز أمنية في المخيمات لتوفير الأمن والسلامة العامة للاجئين، وإلى جانب السياسات الإيجابية للحكومة الأردنية إزاء اللاجئين السوريين، فإن المجتمع الأردني أظهر ترحيبا وتعاطفا مع هؤلاء اللاجئين، وهو أمر مهم بالتأكيد لمؤازرة السياسات الحكومية حيال اللاجئين في أي بلد ولإشعار اللاجئين أنفسهم بالترحيب والأمان في بلد اللجوء. ذلك أنه في حال غياب الترحيب باللاجئين من قِبَل المجتمع المحلّي، مثلما يحصل قي بعض الدول الأُخرى، فقد يؤدي ذلك إلى قصور في السياسات الرسمية تجاه اللاجئين، كما قد تنشأ مظاهر عدائية من المجتمع المحلّي، سواء فردية أو عامة، تجاه أولئك اللاجئين، تجعلهم يفقدون الشعور بالأمن، ما يضاعف حِدَّة أزمتهم الإنسانية الناشئة عن ظروف بلدهم واضطرارهم للجوء رغماً عنهم. وقد أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالأردن في أكثر من مناسبة، وشكرته حكومةً وشعباً على “كرم الضيافة المستمرة ورحابة الصدر في استقبال واستضافة اللاجئين”.
لقد كلَّفَ ملفُّ اللاجئين السوريين الأردنَّ أعباءً ثقيلة، خاصةً بعد تضاؤل حجم الدعم الدولي الآتي من الدول المانحة والمنظمات الدولية المعنية. فبعد أن كان الدعم الدولي يمثّل نسبة معقولة من تغطية احتياجات اللاجئين في الأردن، إلى جانب ما تتحمله الحكومة الأردنية من تكاليف بهذا الصدد، ألقى استمرار الأزمة السورية لفترة طويلة أعباءً ثقيلةً على القدرات المالية التي تحتاج إليها المنظمات الدولية لتلبية احتياجات اللاجئين. ففي تموز/يوليو 2023، أعلنت وكالات الأمم المتحدة عن خفض كبير في برامج المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن، يسري على أولئك الذين يقيمون في المناطق الحضرية وكذلك في مخيمَي الزعتري والأزرق، وهما أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن. وجاء ذلك النقص في التمويل في إطار اتجاه أوسع نطاقًا يؤثّر في اللاجئين السوريين في مختلف أنحاء المنطقة. وقد تسببت الأزمات المتزامنة في أوكرانيا والسودان وغزة بإجهاد شديد أيضًا للمساعدات الإنسانية، ما أرغم منظمات المساعدات على بذل جهود أكبر بموارد أقل وأدّى إلى تبدّل أولويات الجهات المانحة. وهذا مثَّلَ قلقاً جديدا للأردن وغيره من الـــــــدول المضيفة لما يعنيه من اضطــــــرارها إلى تحمّل العبء المالي للاستجابة لأزمــــة اللاجئين.
ومع ذلك، فقد استمر الأردن في تقديم كل ما يمكن من خدمات للاجئين السوريين، ولم يلجأ لمحاولة حملهم على العودة إلى بلدهم قبل توفر الظروف المناسبة لذلك. ومن الطبيعي أن يكون الحل الأمثل لمشكلة اللاجئين في أية حالة هو في عودتهم إلى بلدهم، إلا أنه ينبغي عدم إكراههم على ذلك دون توفر الظرف الأمني المناسب في وطنهم الذي خرجوا منه مُكرَهين. ويُعتبر تأكيد الأردن على أن عودة اللاجئين إلى بلدهم يجب أن تكون “طوعية”، بمعنى أنهم لن يُجبرهم على ذلك، موقفا محمودا في ظل استمرار ذات الظروف التي أجبرتهم على اللجوء طوال السنوات الماضية وحتى سقوط النظام مؤخراً. وبالطبع، فإن تخوّف اللاجئين من العودة كان مفهوما وله ما يبرره.
وقد اظهرت استطلاعات للرأي العامَ الماضي أن 97٪ من اللاجئين السوريين في الأردن و92٪ منهم في لبنان لا يرغبون في العودة تحت الظروف الحالية. وفي حين أن مسؤولين في دول أُخرى (تركيا ولبنان) كانوا في الفترة الأخيرة قد خرجوا بوعود انتخابية بأنهم سيُعيدون اللاجئين السوريين إلى بلدهم قسرياً، في مخالفة للقانون الدولي، فإن الأردن لم يفعل ذلك، بالرغم من عدم مصادقته على الاتفاقية الدولية للاجئين، ذلك أن طبيعة النظام الأردني الإنسانية لا تسمح بذلك، كما أن الأردن المتلقي للعديد من المساعدات الخارجية لا يستطيع الدخول بمثل هكذا مجازفة من شأنها أن تؤثر على مجمل علاقاته مع الدول المانحة.
ويعد الأردن ثاني دولة من حيث استضافة اللاجئين السوريين نسبةً لعدد السكان على مستوى العالم، بعد لبنان. وفيما يتعلق بالخدمات والفرص التي وفرها الأردن لهؤلاء اللاجئين السوريين، فأن الأردن قد حسَّنَ سُبلَ الوصول إلى التعليم والعمل بشكل قانوني للسوريين الذين أجبروا على الفرار من ديارهم، وبات يُسمَح منذ عام 2016 للاجئين السوريين بالعمل في عدة قطاعات من الاقتصاد الأردني، وبحلول عام 2021 تم إصدار ما يقرب من 62 ألف تصريح عمل للسوريين، نِصفُها تصاريح مَرِنة تسمح للاجئين بالتنقل بين الوظائف المماثلة في نفس القطاع، وكذلك التنقل بين أصحاب العمل وبين المحافظات، وهو أعلى رقم سنوي منذ استحداث تصاريح العمل للاجئين السوريين..
المطلب الثاني: التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن
أولا: التحديات الأساسية التي يواجهها اللاجئون السوريون في الأردن (مثل التعليم، العمل، والرعاية الصحية):
نظرا لظروف الأردن الاقتصادية ومحدودية ثرواته الطبيعية، فقد اضطُر عبر العقود الماضية للاعتماد في جزء من موارده المالية على القروض (الداخلية والأجنبية) والتسهيلات والمساعدات التي يقدمها عدد من الدول الأجنبية (كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان)، والعربية الغنية (كالسعودية والإمارات وقطر)، التي يهمّها مساعدته لتلبية جزء من احتياجاته المالية ومشاريعه التنموية، من أجل المحافظة على استقراره والاستمرار في القيام بدور إيجابي في المنطقة. وبالتالي، فإن أية تحديات موجودة في الأردن هي في الواقع تحديات يواجهها مواطنوه قبل أن يواجهها اللاجئون، سواء السوريون منهم أو غيرهم من اللاجئين في الأردن.
وفي تعامله مع حالة اللجوء السوري، وجد الأردن نفسه يواجه إشكالية تتمثّل في وجود قسمين من اللاجئين: القسم الأول، ويعيش داخل المخيمات حياةً لا تروق له، حيث تحدث أحيانا اضطرابات ومطالبات بالخروج من المخيم، والقسم الثاني، ويعيش خارج المخيمات (ويمثّل النسبة الأكبر من مجموع اللاجئين)، وهؤلاء يعيشون في المدن والقرى، بحيث يشكل ذلك ضغطاً على قطاعات واسعة مثل التعليم والصحة والسكن والطاقة وتفاقم مشكلة البطالة والجرائم…الخ
لقد فرضت أزمة اللجوء السوري أعباءً كبيرة وباهظة على الأردن، حيث بلغت تكلفة استضافة اللاجئين السوريين في الأردن نحو 1,6 مليار دولار موزعة على 10 قطاعات، وقُدِّرتْ تكلفة استضافتهم خلال الأعوام 2014-2016 بنحو 4,5 مليار دولار، هذا أضافة إلى ما يعانيه الأردن بالفعل من أزمات عديدة في مختلف القطاعات الحيوية، كتفاقم مشكلة المياه، وأزمة توفر وظائف بسوق العمل نتيجة مُزاحمة اللاجئين السوريين للعمالة الأردنية ما أدى لارتفاع نسبة البطالة، هذا أضافة إلى الضغط الهائل على المدارس الحكومية، وعلى قطاع الصحة، والكهرباء، والقطاع الأمني.
غيـر أن الأردن عمل جاهدا على معالجة معظم تلك التحديات بالتعاون مع المفوضية السامية والمانحين الدوليين لتوفير الخدمات اللازمة للاجئين، من إعاشة، ورعاية الصحية، وتعليم، وتوفير فرص العمل في سوق العمل المحلي.
ثانيا: معوقات تأمين الحماية الشاملة للاجئين في الأردن
أكّد الأردن في أكثر من مناسبة أنه في استقباله للّاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين العرب، إنما يؤدي واجباً إنسانيا وقوميا، وأنه يفعل ذلك احتراما منه لالتزاماته الدولية بهذا الشأن من جهة، وحرصاً منه على إيواء واستضافة ذوي الحاجة من الأشقاء العرب الفارّين بحياتهم من لهيب الحرب من جهة ثانية. وقد كانت حالة عدم الاستقرار في المنطقة، نتيجة الحروب والنزاعات الداخلية والانقلابات العسكرية في دول الجِوار، وكذلك الاضطهاد الداخلي في عدد منها، هي السبب الرئيسي في حالات اللجوء التي استقبلها الأردن.
- ازدياد عدد السكان وتغير التركيبة السكانية:
كان لموجات اللجوء والهجرة من دول الجِوار العربية إلى الأردن طوال العقود السبعة الماضية آثارٌ كبيرةٌ المتمثلة في ازدياد عدد السكان من ناحية وتغير التركيبة السكانية من ناحية أخرى. إذ ارتفع عدد السكان خلال الفترة من عام 1952 إلى عام 2017 من 586 ألف نسمة إلى 10,530 مليون نسمة. ويُتوقَّع أن يصل عدد سكانه إلى حوالي 12,9 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى 13,4 مليون نسمة عام 2050.
ومنذ نشوء الأزمة السورية عام 2011 بدأ الأردن باستقبال موجات من اللاجئين السوريين الذين جاءوا إليه بحثاً عن الأمن والأمان نتيجةً لعوامل القُرب الجغرافي، والتقارب الثقافي والاجتماعي، والاستقرار الذي يتمتع به الأردن، إضافةً لسهولة الوصول والإقامة. وهو ما أدى إلى تغير تركيبته السكانية وبات مواطنوه وسكانه ينحدرون من منابتَ وأُصولٍ شَتَّى، وظهرت فيه عادات وممارسات ومشاكل جديدة، واتجاهات فكرية مختلفة ومتعددة. وفي حين أنه يمكن النظر إلى ذلك كله، أو إلى شيء منه، نظرةً سلبية باعتبار بعض تلك العناصر دخيلةً على أي مجتمع يتعرض لمثل ذلك، إلا أنه يمكن – من ناحية أُخرى – اعتبار ذلك تطورا طبيعيا للمجتمع الأردني كغيـره من المجتمعات في العصر الحديث المتنوعة ثقافيا، وأن يُرى في ذلك نتائج وعوامل إيجابية، حيث يشكّل التنوع الثقافي قوة محركة للتنمية، ليس على مستوى النمو الاقتصادي فحسب بل أيضاً كوسيلة لعيش حياة فكرية وعاطفية ومعنوية وروحية أكثر اكتمالاً، وهو ما تنصّ عليه الصكوك الدولية التي تنظم مجال التراث الثقافي، التي تتيح ركيزة صلبة لتعزيز التنوّع الثقافي.
- تضاؤل الدعم الدولي:
استقبل الأردن 1,3 مليون لاجئ سوري منذ بدء الأزمة السورية حتى الآن، وقدَّم إليهم كل ما يستطيع من استضافة وخدمات وأمن. وفي حين أن المنظمات الدولية ومجتمع المانحين قدَّموا إليه العون في البداية لتغطية نسبة معقولة من تكاليف مواجهة أزمة اللجوء السوري إليه، فقد أخذ ذلك الدعم الدولي يتضاءل عاماً بعد عام. وبالطبع فإن تضاؤل الدعم الدولي إلى حدود دُنيا هو مشكلة رئيسية واجهها الأردن، إذ كان عليه أن يوفر العجز في التمويل من موازنته، وذلك أمر صعب ومرهق للغاية بالنسبة لبلد محدود الإمكانيات كالأردن.
وكما تبين فإن عدم انضمام الأردن للاتفاقية الدولية للاجئين لم يمثِّل عائقا أمام استقبالِه واستضافتِه للّاجئين السوريين وتقديمِ كل إمكانياته من أجل توفير الأمن والخدمات المختلفة إليهم، رغم امتداد فترة لجوئهم لسنوات عديدة، ورغم تضاؤل الدعم الدولي له في هذا السياق. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن انخفاض الدعم الدولي إلى الحدود الدنيا هو العائق الأول أمام قيام الأردن بمهمته الإنسانية هذه. وفي الواقع، فإنه ينبغي أن لا يغيب عن بال المانحين الدوليين أن الدولة التي تستقبل اللاجئين إنما تفعل ذلك نيابةً عن المجتمع الدولي بأسره، فهي تقوم بذلك كواجب إنساني وأخلاقي يفرضه عليها قربُها الجغرافي من بلد النزاع الذي يفرُّ منه اللاجئون، وليس لذنْبٍ ارتكبتْه هي وعليها تحمُّل تبعاته لوحدها.
الخاتمة:
استعرضت الدراسة مفهوم اللاجئ والضمانات القانونية للاجئين في القانون الدولي، وفقاً ل”اتفاقية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 1951، والبروتوكول الخاص باللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1967″. كما تضمنت الدراسة التطرق الى الوضع القانوني للاجئين السوريين والتحديات التي يواجهونها في المملكة الأردنية الهاشمية، خاصة وان المملكة الأردنية الهاشمية – التي تعد من أكثر الدول استضافةً للاجئين – لم توقع على “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” المُبرمة عام 1951، وانما تُنظِّم شؤونَ اللاجئين التي تستضيفهم المملكة مذكرةُ تفاهم وقَّعتها الحكومة الأردنية مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” عام 1998، والتي تم تعديلُها جزئيا عام 2014. وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات المبينة على النحو الآتي:
النتائج:
- يؤخذ على تعريف “الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين” عام 1951 أنها ركزت على تصنيف اللاجئ كفرد يُجبر على مغادرة وطنه نتيجة خوف مُبرر من الاضطهاد أو التعرض له بسبب انتمائه إلى جنسية معينة، أو عرق، أو دين، أو آرائه السياسية، ولم يشمل التعريف الأفراد الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم نتيجة تهديد حياتهم جراء نشوب حرب أهلية، أو بسبب عدوان خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية.
- نظراً لتزايد أعداد اللاجئين في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري إعادة تقييم آليات الحماية الدولية الحالية المتبعة للتعامل مع قضايا اللجوء على الصعيد الدولي، والتي كانت تعتمد في الماضي بشكل رئيسي على التعامل مع حالات محددة وظروف معينة لمعالجة هذه المشكلة، مع التركيز على إعادة النظر في بعض المفاهيم المرتبطة بهذه القضايا، بهدف تحقيق استجابة أكثر شمولاً وكفاءة.
- إن الأردن قام بواجبه الإنساني والقومي نحو اللاجئين السوريين على مدى الأربعة عشر سنة الماضية وفقا لما لديه من إمكانيات بشكل أشادت به الدول والمنظمات، رغم أنه ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين الدولية لعام 1951، وعدم تضمين أحكام هذه الاتفاقية في تشريعاته، إلا أنه كان هناك إطارا قانونيا ينظَّم شؤون اللاجئين السوريين لديه، وهي مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، هذا إضافةً لالتزامات الأردن في إطار اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع جميع أشكال التمييز واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الصكوك الدولية، والتي شكَّلت إطارا قانونيا مناسبا وكافيا لقيامه بواجبه الإنساني والأخلاقي نحو اللاجئين السوريين. وقد انعكس ذلك كله على سياساته، سواء من حيث توفير الفرصة لأطفال اللاجئين في الانضمام للمدارس الحكومية أو في تمكين اللاجئين من العمل في سوق العمل الأردني، وتوفير إمكانيات السكن والإعاشة والخدمات الصحية، وغير ذلك.
- أن الأردن، نظراً لظروفه الخاصة التي بيَّناها من حيث الإمكانيات والتركيبة السكانية، لا يمكن أن يُتوقَّع منه أن يقدِّم للاجئين (أي لاجئين على أرضه) فرصة التجنيس و / أو البقاء على أرضه بشكلٍ دائم. ولعلَّ مسألة تجنيس اللاجئ أو منحه الإقامة في بلد اللجوء، التي تتضمّنها الاتفاقية الدولية للاجئين هي السبب في امتناع الأردن عن الانضمام إليها. وهو أمر يمكن تفهمه في ضوء التركيبة السكانية للأردن، وأنه قبول الأردن بتجنيس اللاجئين لديه سيؤدي في نهاية الأمر إلى تأكل التركيبة السكانية الأصلية للشعب الأردني، الذي سيصبح حينها مزيجا ثقافيا لشعوب عده.
التوصيات:
- لا شك أن اللاجئ، أي لاجئ، يطمح في استقرار الوضع في بلده ليتمكن من العودة إليه واستئناف حياته بشكل طبيعي وآمن. وهذا بالطبع ينطبق على اللاجئين السوريين في الأردن. والآن، بعد أن سقط النظام السابق الذي كان السبب في هذا اللجوء، فإن الحل الأمثل لمسألة اللجوء السوري في الأردن، هو في تمكينهم من العودة إلى سوريا من خلال تهيئة الحكومة الجديدة للظروف الأمنية التي تسهِّل عودتهم الطوعية إلى بلدهم ليستأنفوا حياتهم الطبيعية، وليساهموا في إعادة إعمار بلدهم عَقِبَ تلك الحرب المدمِّرة.
- أن يقدم للأردن الدعم اللازم من المجتمع الدولي، سواء من دول مانحة ومنظمات دولية وإقليمية معنيّة، في هيئة تسهيلات مالية، أو مساعدات أو إعفائه من بعض ديونه الخارجية، ليتم توجيه تلك الإمكانيات نحو مساعدة اللاجئين السوريين الموجودين لديه، والاستمرار بتقديم ما يلزمهم من إعاشة وخدمات وتسهيلات إلى أن يعودوا إلى بلدهم سالمين مطمئنين.
- ينبغي على الحكومة الأردنية فتح قنوات تواصل مع النظام السوري الجديد من أجل مناقشة سبل تنظيم عودة اللاجئين السوريين الموجودين بأرضها على نحو تدريجي لا يضر بمصالحهم.
قائمة المصادر
مصادر عربية:
الوثائق:
- مجلس النواب الأردني، دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 وتعديلاته، المادة 21 فقرة1، (عمان: مطبوعات مجلس النواب، الطبعة العاشرة، 2022).
كتب باللغة العربية:
- هاني مفلح الزبون، القانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئين: دراسة حالة، (عمَّان: دار وائل للنشر والتوزيع، 1 يناير 2019).
- فاطمة أمراح، الهجرة الدولية بالمغرب، الجانب القانوني والجيو/استراتيجي، ردمك 1-95-568-9920- 978، الناشر مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية- المغرب الطبعة الأولى 2022.
- عبد الواحد الناصر، الحياة القانونية الدولية، مدخل لفهم اتجاهات التطورات وإشكاليات التطبيق في القانون الدولي العام، الرقم الدولي: 8 -05-516 – 9954- 978، منشورات الزمن طبعة 2011.
كتب باللغة الانجليزية:
– KAMEL DORAÏ, Conflict and Migration in the Middle East: Syrian Refugees in Jordan and Lebanon, ‘Critical Perspectives On Migration In the Twenty-First Century’, E-International Relations Publishing, Bristol, England, 2018.
مقالات:
- نادية فالح العموش، أثر الأزمة السورية على الأردن، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، (عمان: الجامعة الأردنية، مجلّد 43، ملحق 6، 2016).
-نور الدين بيدكان، مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي، المجلة المغربية للدراسات الدولية والاستراتيجية، الطبعة الأولى 2019.
- شريف عبد الحميد حسن رمضان، الإشكالية بين الالتزام الدولي بمنح حق اللجوء وحق الدولة المضيفة في عدم المنح وتطبيقاتها على سوريا، مجلة روح القوانين، العدد الواحد وستون. المملكة العربية السعودية إصدار يوليوز 2020.
- عبد الحميد الوالي إشكالية اللجوء على الصعيدين الدولي والعربي، بيسان للنشر والتوزيع والاعلام بيروت، طبعة 2007
- بلال حميد بدوي حسن، دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نموذجا)، رسالة الحصول على درجة الماجستير قانون عام، جامعة الشرق الأوسط، 2016.
- الحسين الشكراني، اللاجئ البيئي بين التشكل والتطور الحالة الافريقية، مركز تكامل للدراسات والأبحاث، 2021.
تقارير:
– معهد السياسات والمجتمع، أزمة اللجوء السوري في الأردن: ما وراء الأرقام، عمان، 29/08/2024
رسائل علمية:
- محمد عبد السلام سليم المجالي، الحماية القانونية للاجئين في الأردن ووضع اللاجئ الفلسطيني وفقا للاتفاقيات والمواثيق الوطنية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق من في الحقوق من جامعة العلوم الإسلامية العالمية، الأردن- عمان، 2017.
- أسحار سعد عبد اللطيف جاسم، المركز القانوني للاجئين في دولة اللجوء: الحالة السورية نموذجاً، (عمان : رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2014).
مواقع إلكترونية
تم الاطلاع عليه بتاريخ 15/12/ 2024
الحماية المؤقتة الاطار القانوني منظمة الأمم المتحدة، زيارة الموقع بتاريخ 9 يناير2025 –https://emergency.unhcr.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9
- الحدث، ” الأردن: نحو 18 ألف سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد”، الحدث، عمان، 26 ديسمبر 2024, الحدث، في:
- الجزيرة نت، العودة إلى سوريا.. لاكروا: أين يعيش اللاجئون السوريون اليوم؟، الدوحة، 11/12/2024، الجزيرة نت في:
- الجزيرة نت، “تمويل 10% من احتياجاته فقط. عقد على “الزعتري” والمانحون يديرون ظهورهم”، الدوحة، 24-7-2022 في:
- الشرق الأوسط، “سوريا: «حزب البعث» يعلق عمله «حتى إشعار آخر” الرياض، 11 ديسمبر 2024، الشرق الأوسط في:
- العربي الجديد، “اللاجئون السوريون في الأردن لا يستعجلون العودة إلى الوطن”، العربي الجديد، لندن، 8 ديسمبر 2024 في:
- الرأي، ” التربية “تقف مكتوفة الأيدي أما ضغط 150 الف طالب سوري”، 25-4-2015، تحديث 21-31-2024، في:
- محمد شعبان أيوب، ماهر الأسد.. إمبراطور الكبتاغون وصانع الموت في سوريا، الجزيرة نت،16/12/2024|آخر تحديث: 17/12/2024في:
- الأمم المتحدة، النداء العالمي ،2015، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، الأردن، في: https://www.unhcr.org/ar/53787ec96
- الأمم المتحدة، ” الأردن يصدر عدداً قياسياً من تصاريح العمل للاجئين السوريين”، جنيف، 25، يناير 2022، في:
- الأمم المتحدة، “اتفاق جديد حول تصاريح العمل يساعد اللاجئين السوريين في الأردن”، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، جنيف، 15 اكتوبر 2017، في:
- الأمم المتحدة، “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، جنيف، المفوضية السامية لحقوق الأنسان، 23 مارس 1976) في:
- الأمم المتحدة، ” اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 26-6-1984، في: https://www.ohchr.org/ar/instruments-
- الأمم المتحدة، ” اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، الجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 26-6-1984، في:
- الأمم المتحدة، “اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية 21 ايار/مايو، واشنطن، في:
– الأمم المتحدة، “المفوضية تحتفل بمساهمات اللاجئين في المجتمع الأردني، عمان، 20-6-2022 في:
– حسام العسال،” %27 معدل البطالة بين اللاجئين السوريين و44% بين غير السوريين في الأردن”، تلفزيون المملكة، 2-3-2024، عمان،
– أر.تي عربي، “السوريات ينجبن أكثر من الأردنيات”. الصحة تكشف عدد المواليد السوريين منذ بداية اللجوء29-8-2023، ار. تي عربي، في:
- سامح بيبرس، “أزمة اللجوء السوري في الأردن: ما وراء الأرقام”، معهد السياسات والمجتمع، عمان، 29-8-2023، في:
- الخارجية الأردنية: حل مشكلة اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية لبلادهم”، موقع تليفزيون سوريا، دمشق، 2024.07.15 في:
English Sources
– Omari, Raed,”Border Guards face mounting challenges on north-eastern front”, The Jordan Times (Amman: The Jordan Press Foundation, May 05,2016 – Last updated at May 05,2016) at: