“حق الملكية والقيود الواردة عليه ـ دراسة في ضوء الفقه المالكي والقانون المغربي” الدكتور: يـاسـيـن العمراني
[]
“حق الملكية والقيود الواردة عليه ـ دراسة في ضوء الفقه المالكي والقانون المغربي”
الدكتور: يـاسـيـن العمراني
دكتوراه في الشريعة، كلية الشريعة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس / المملكة المغربية.
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
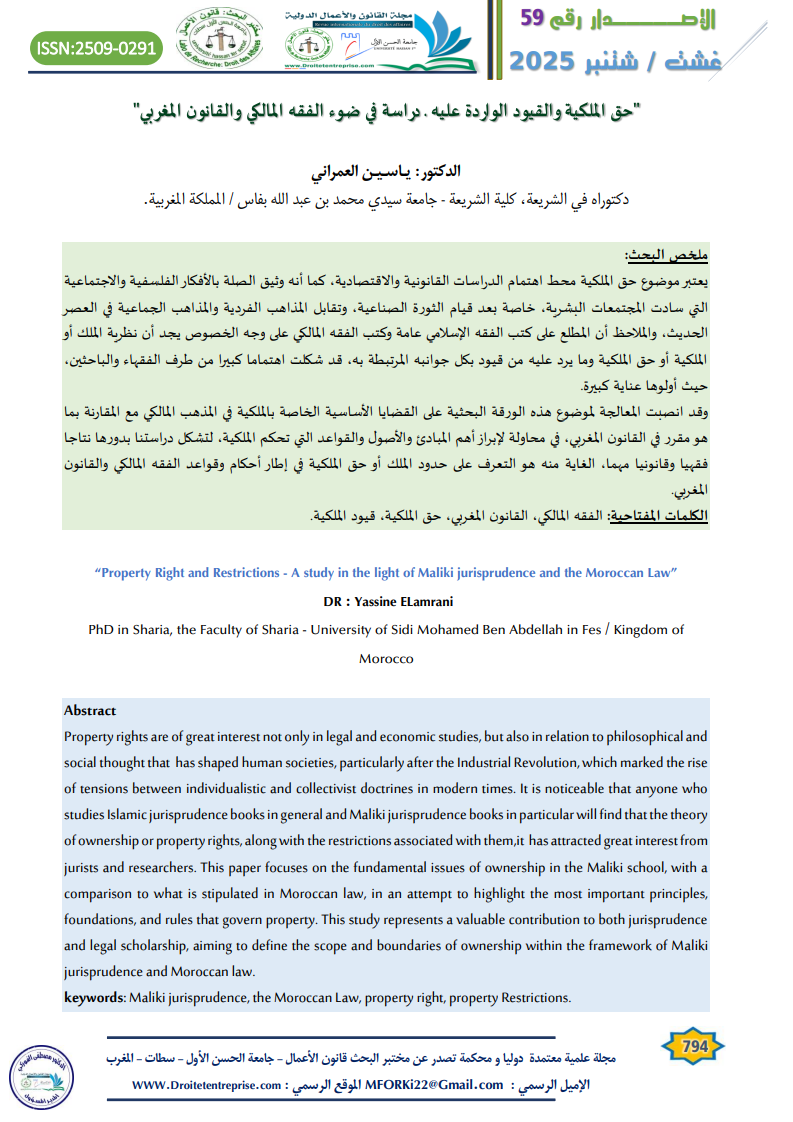
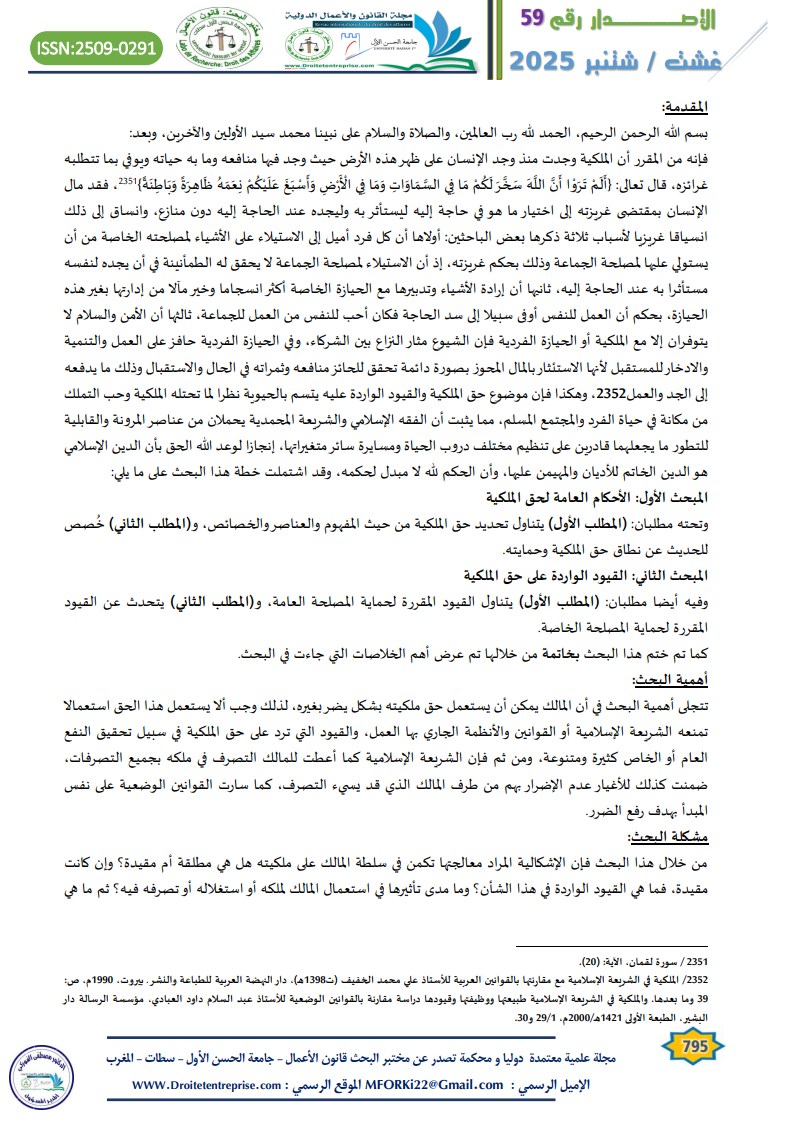
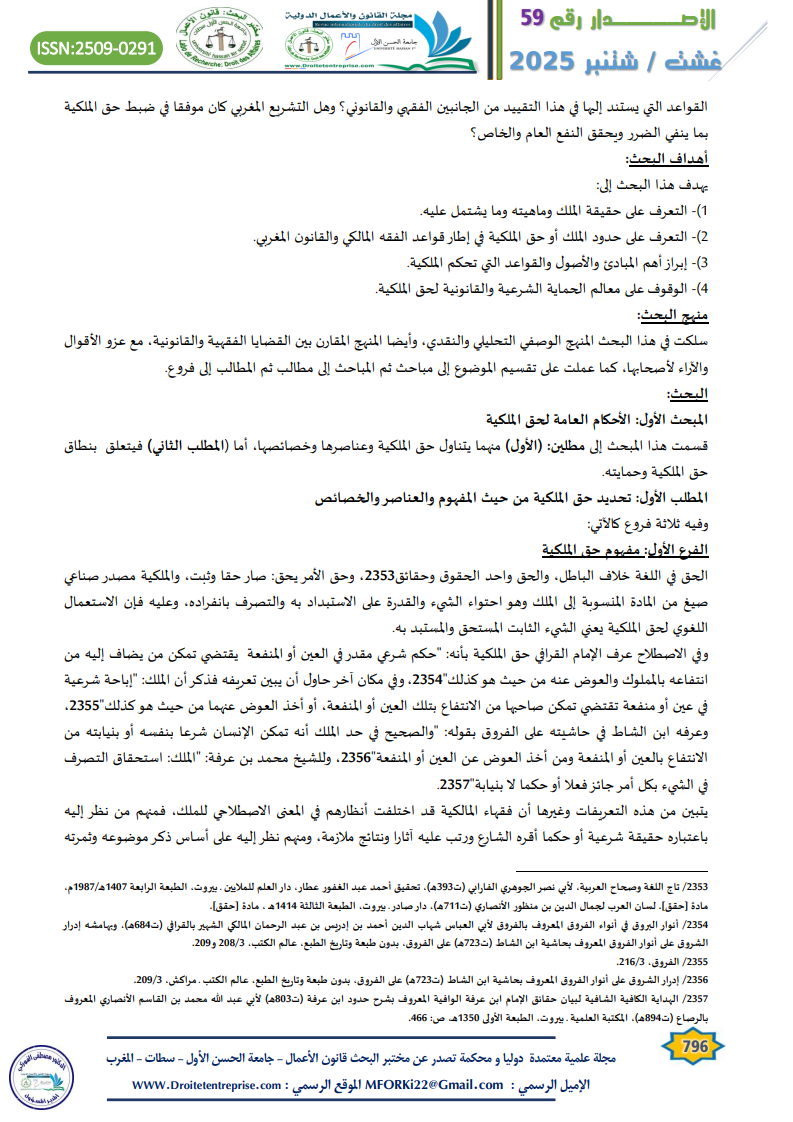
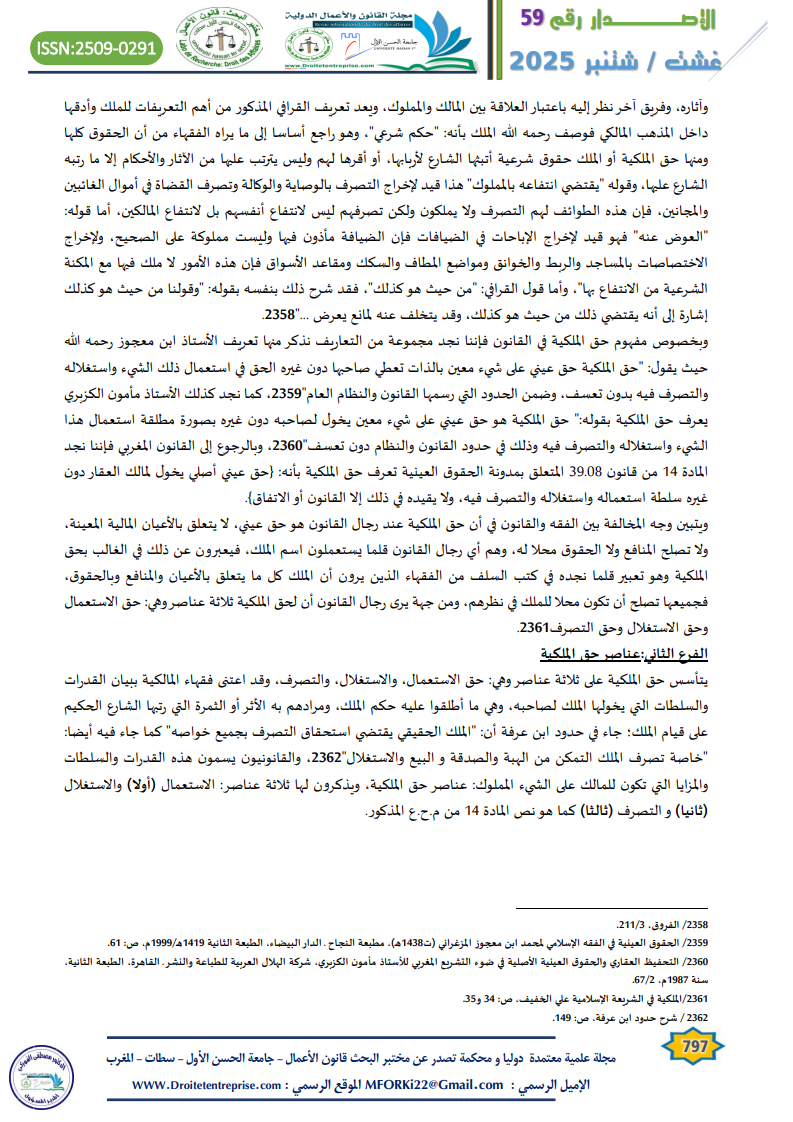
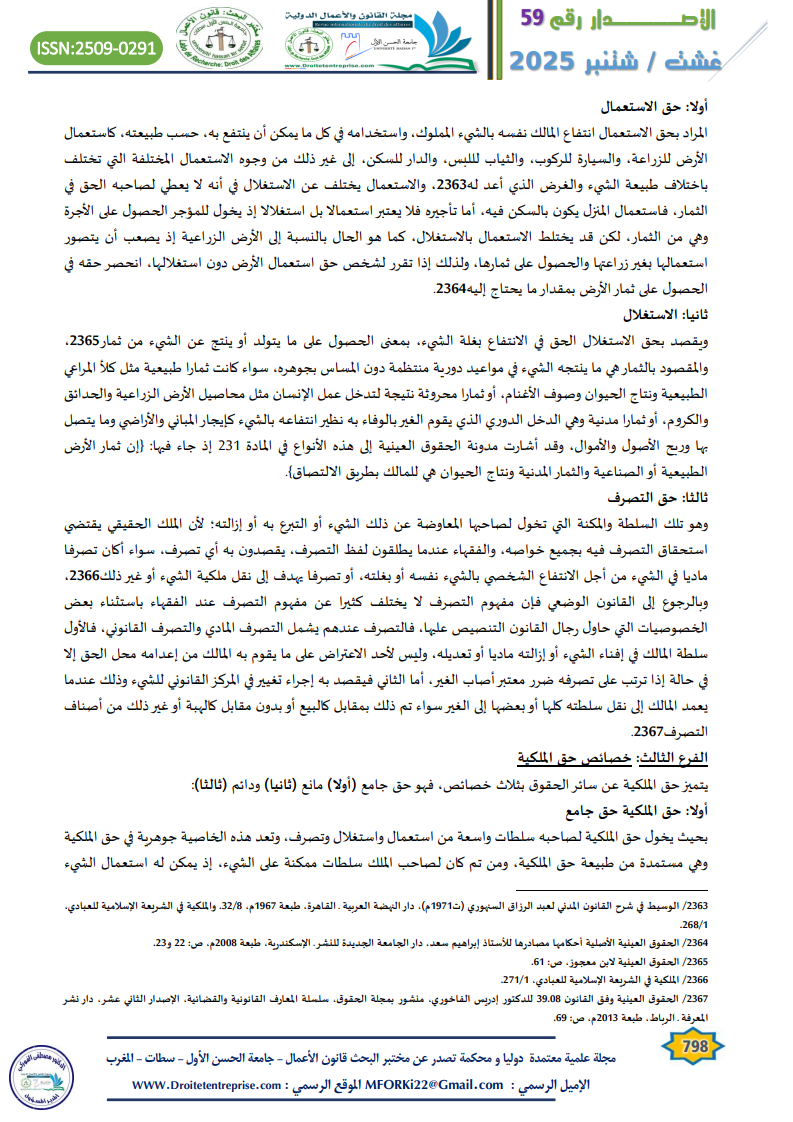
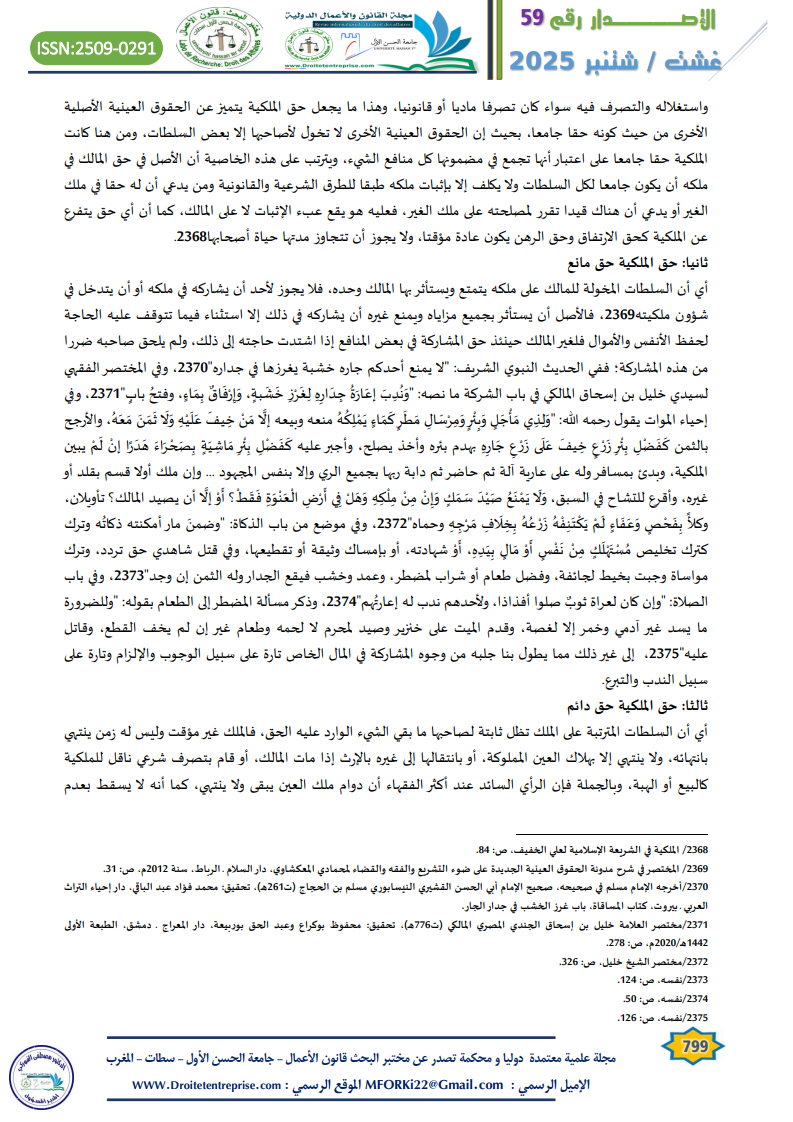
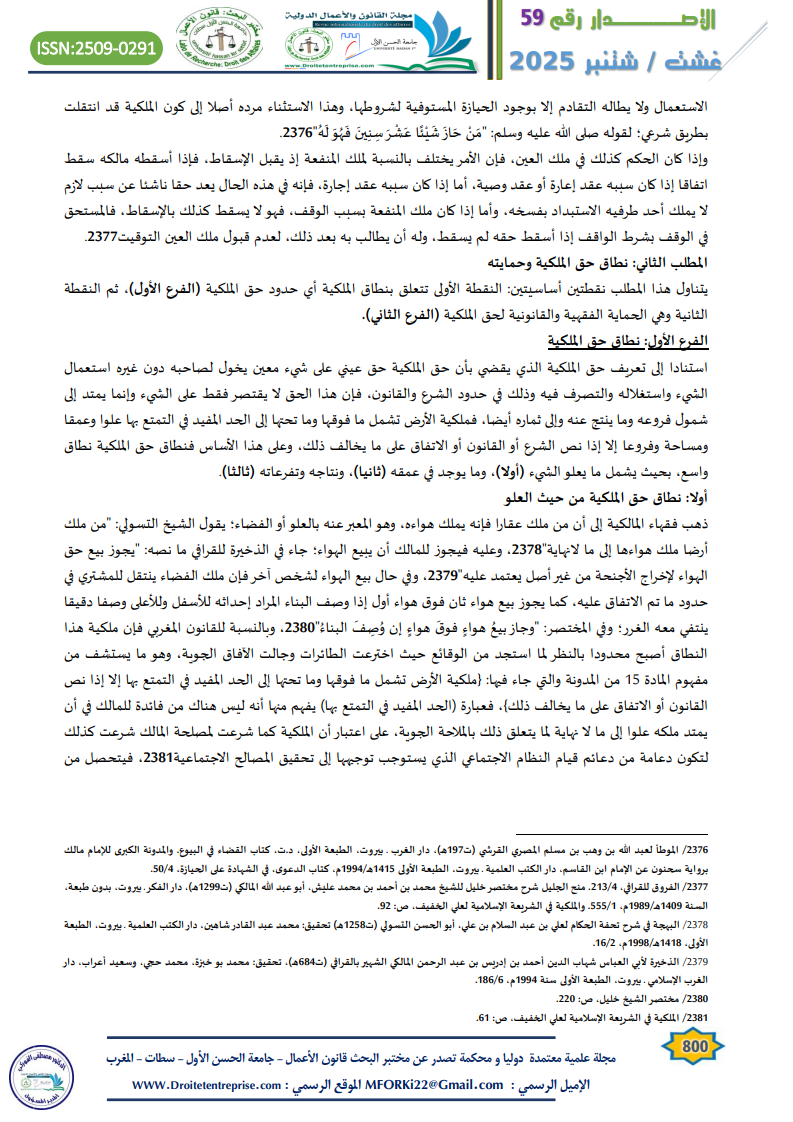
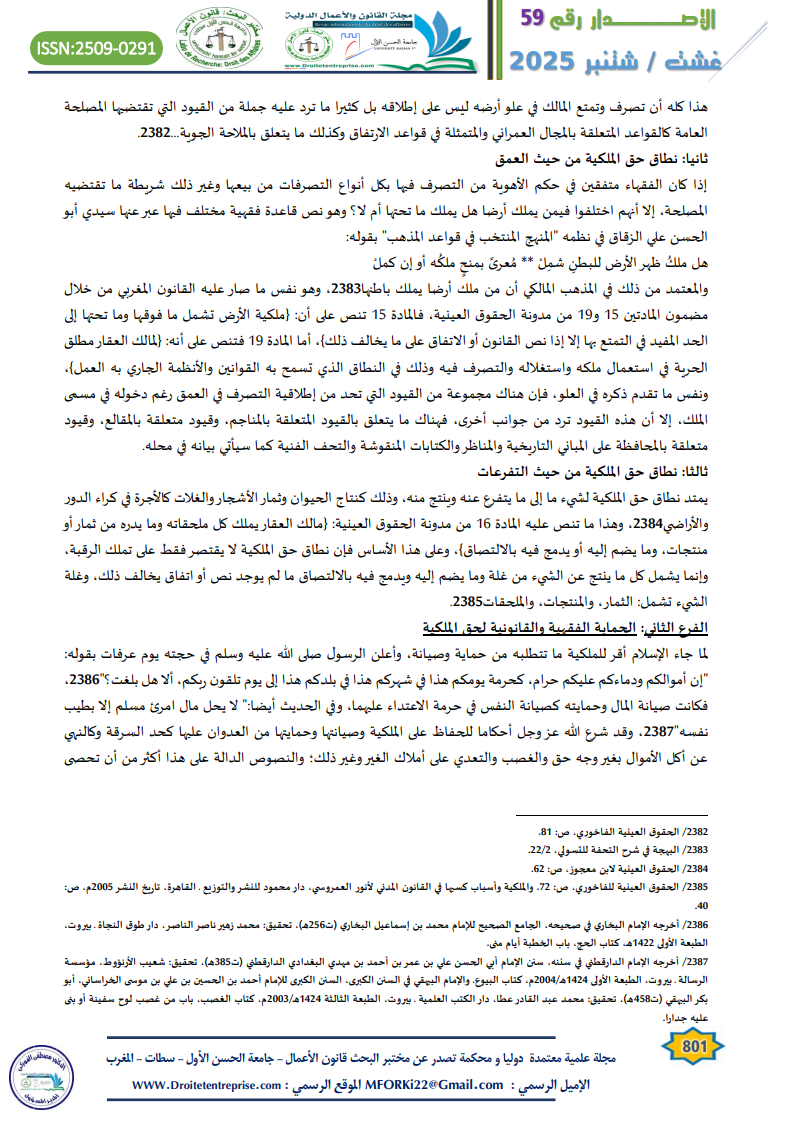
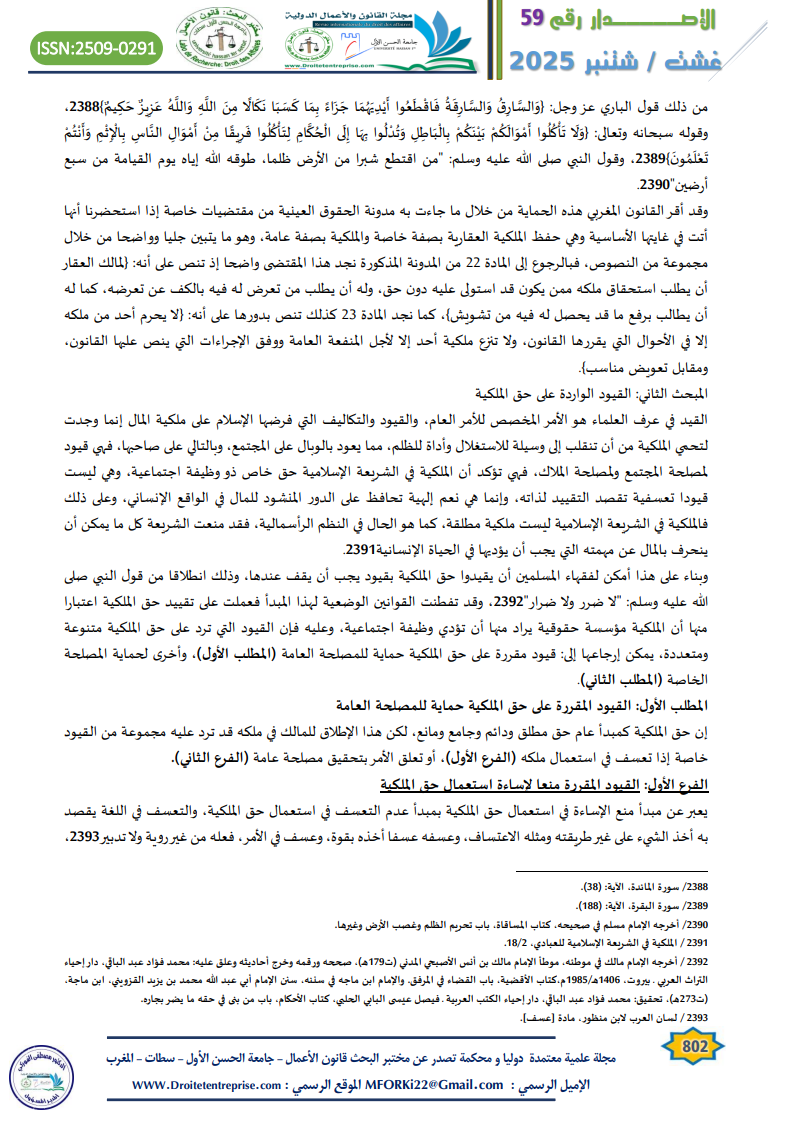
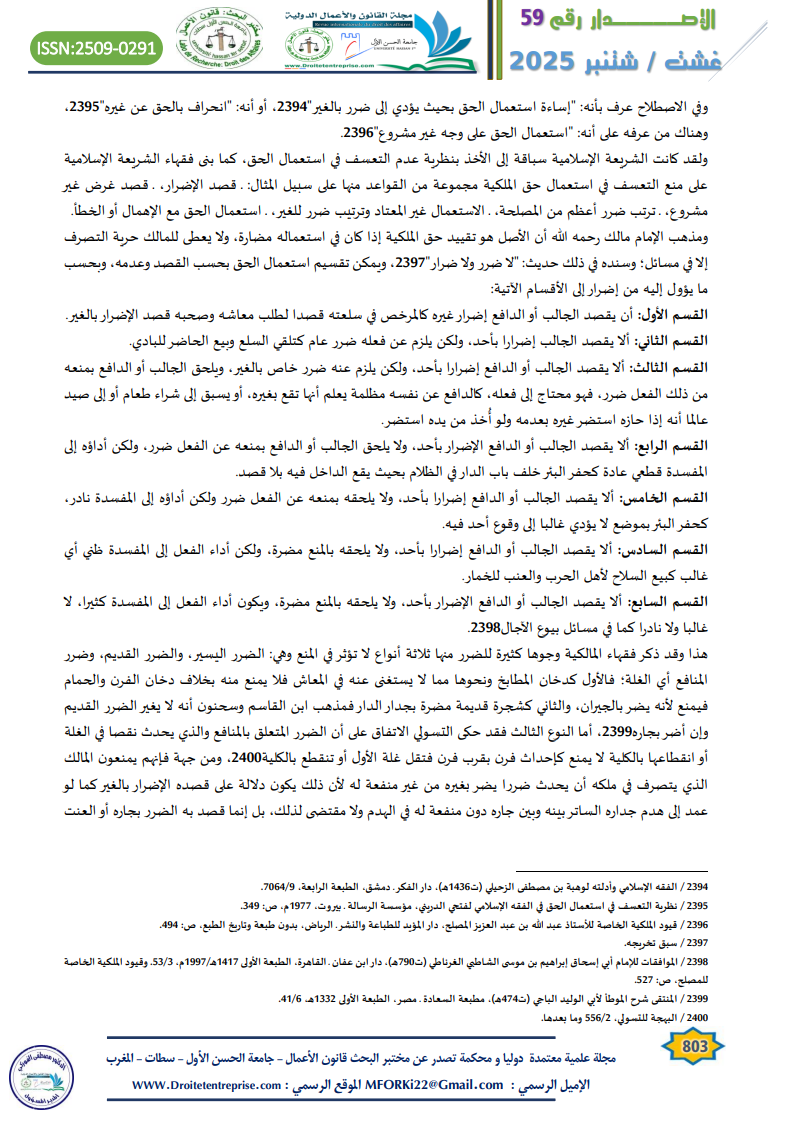
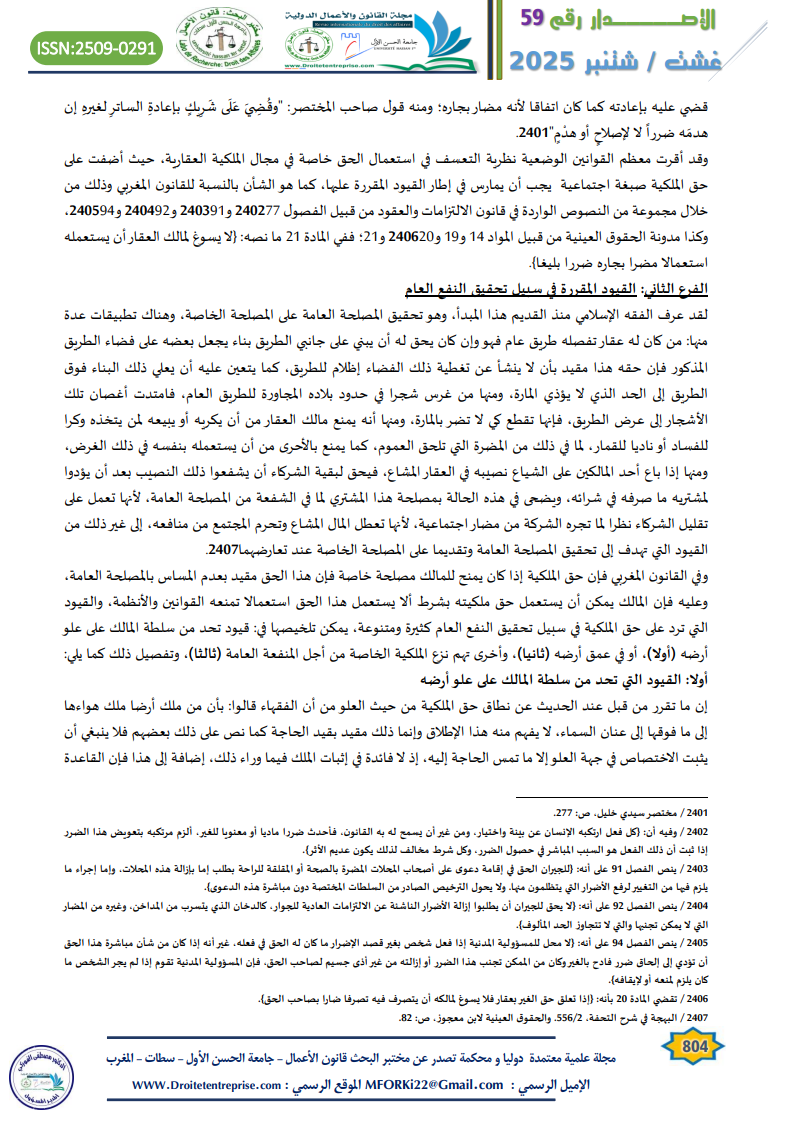
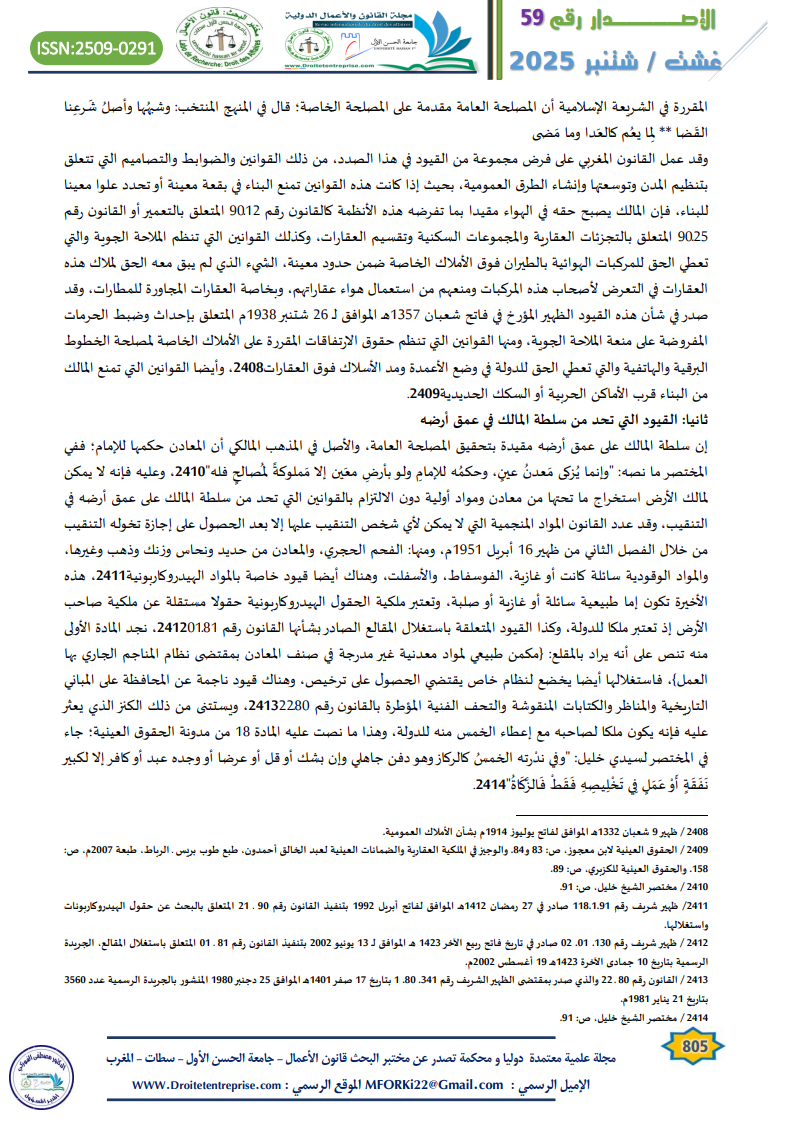
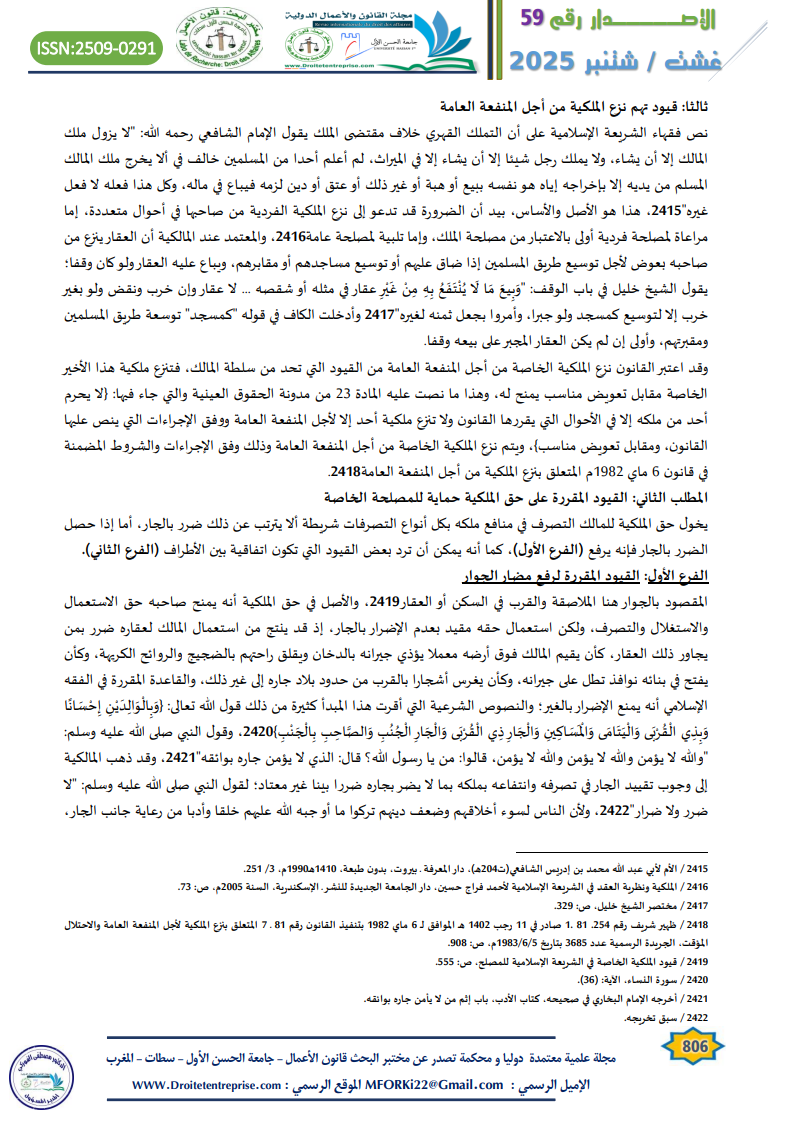
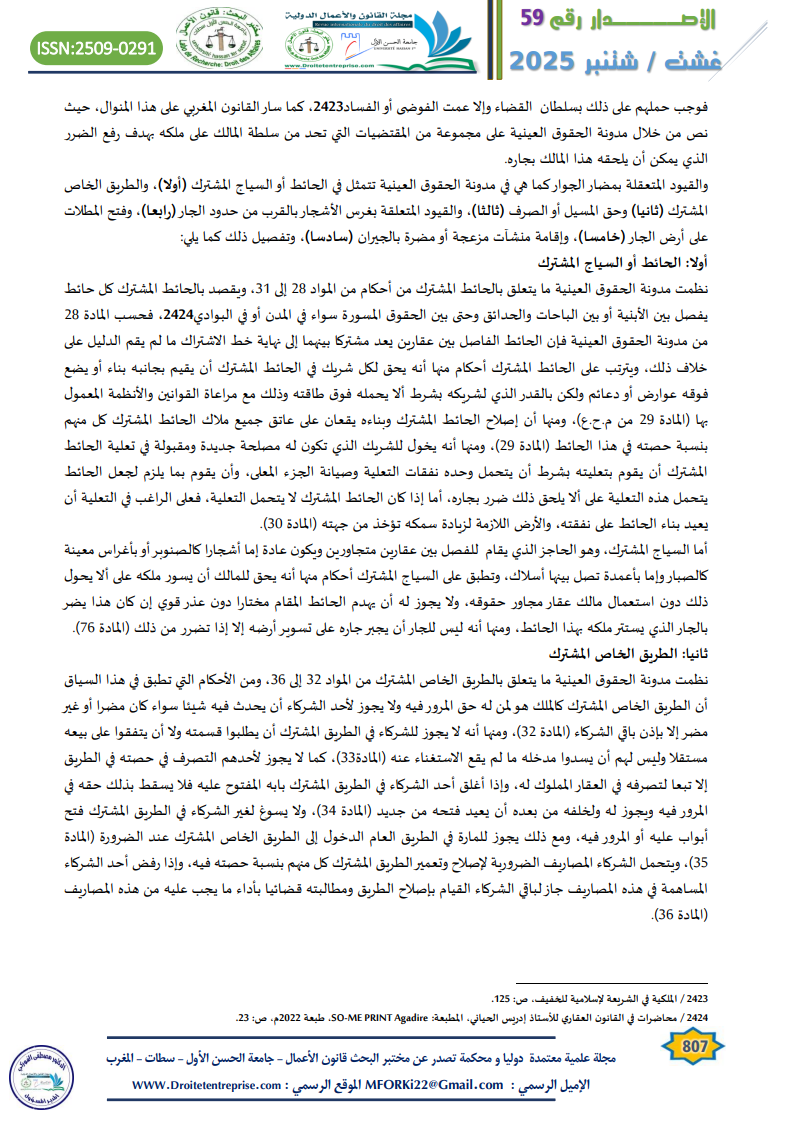
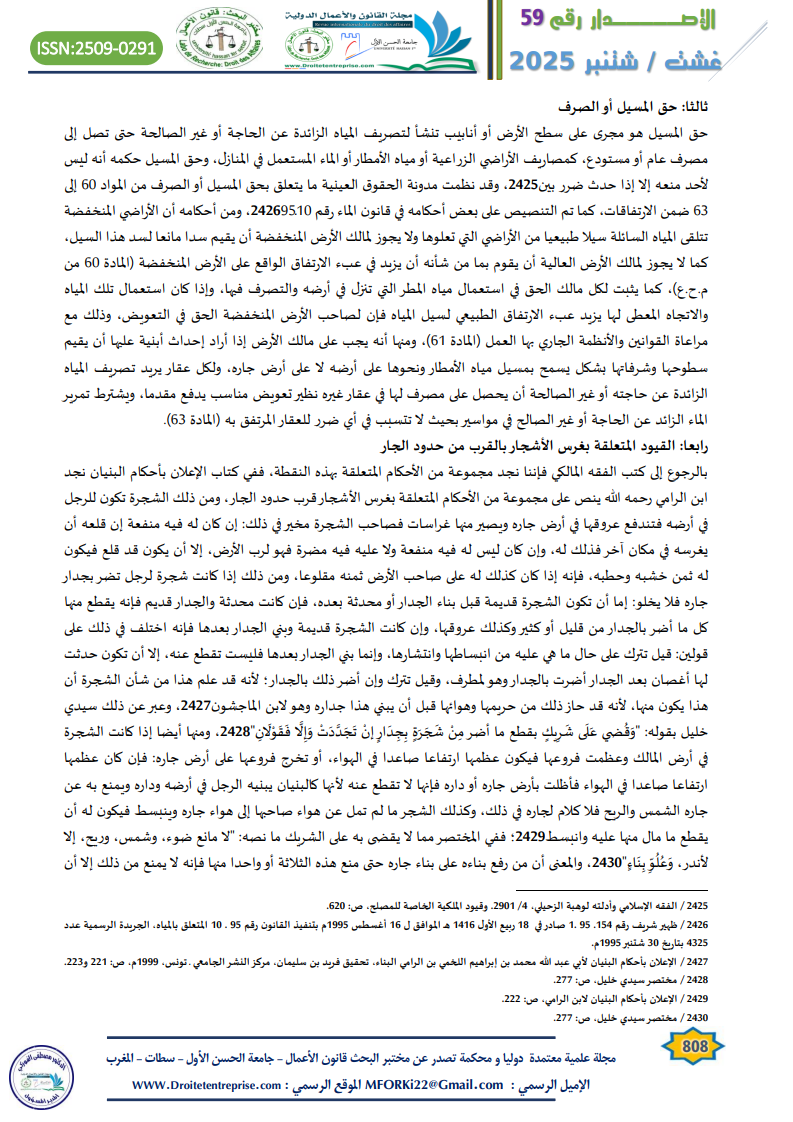
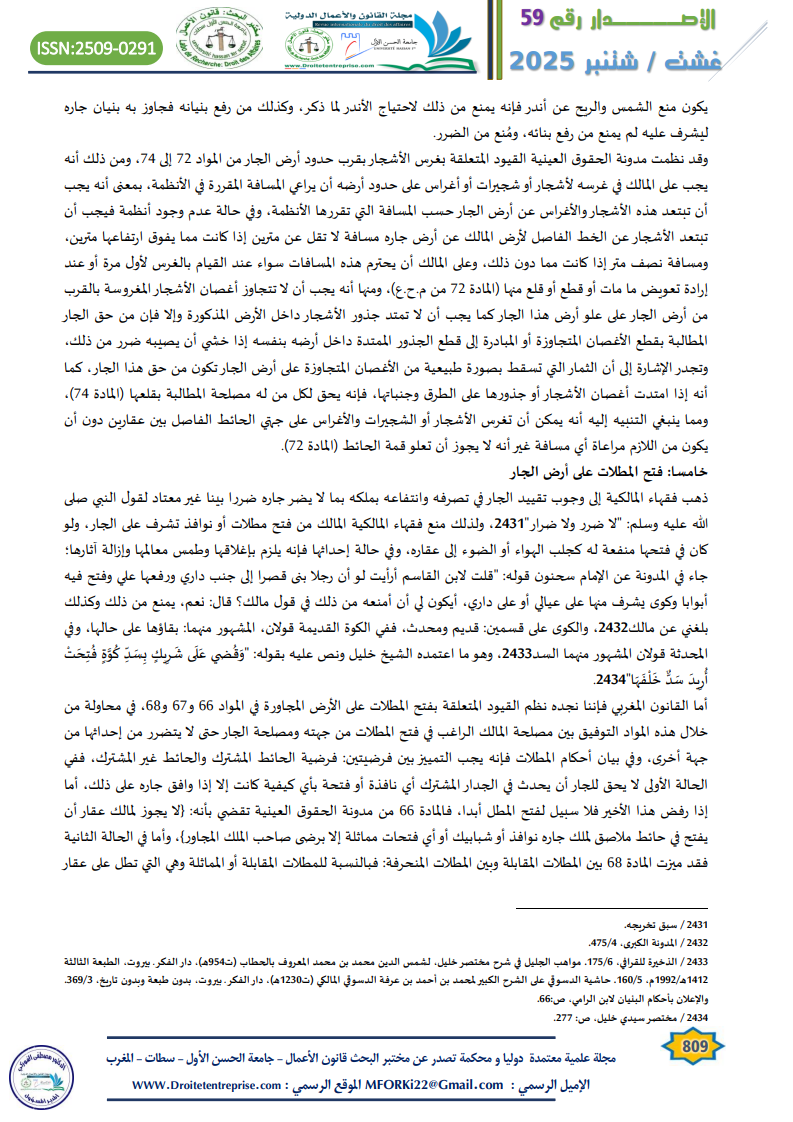
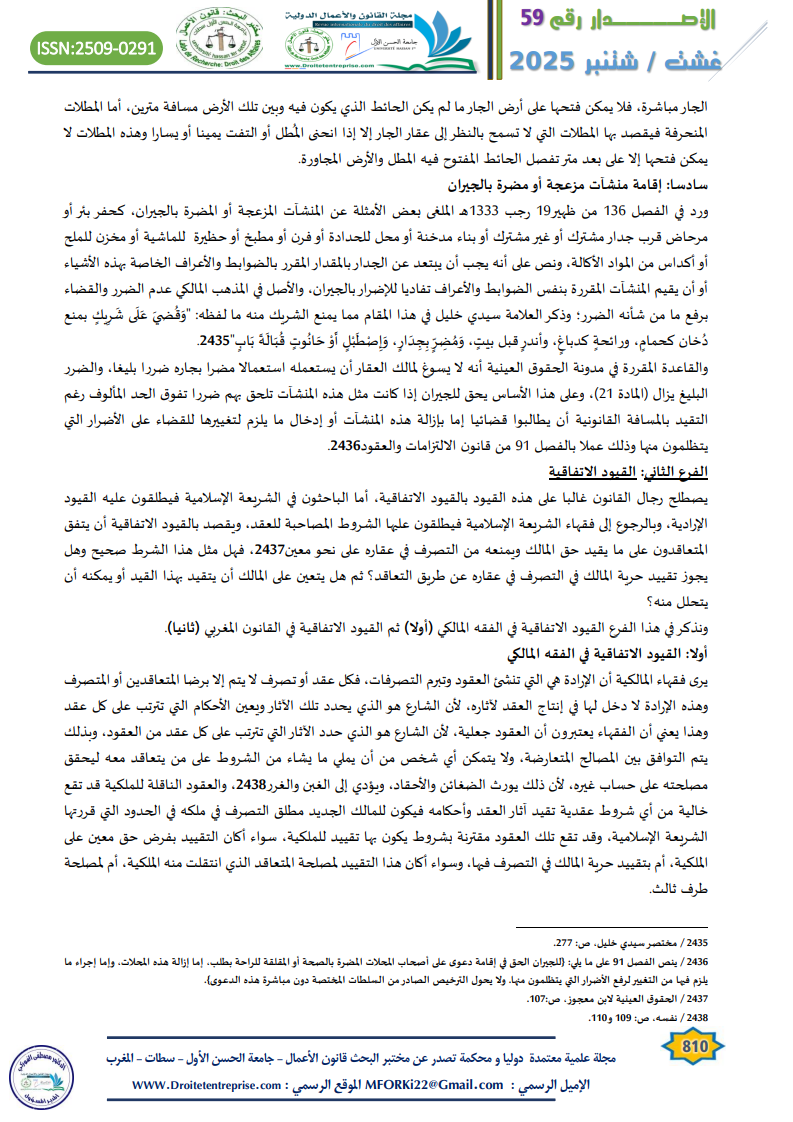
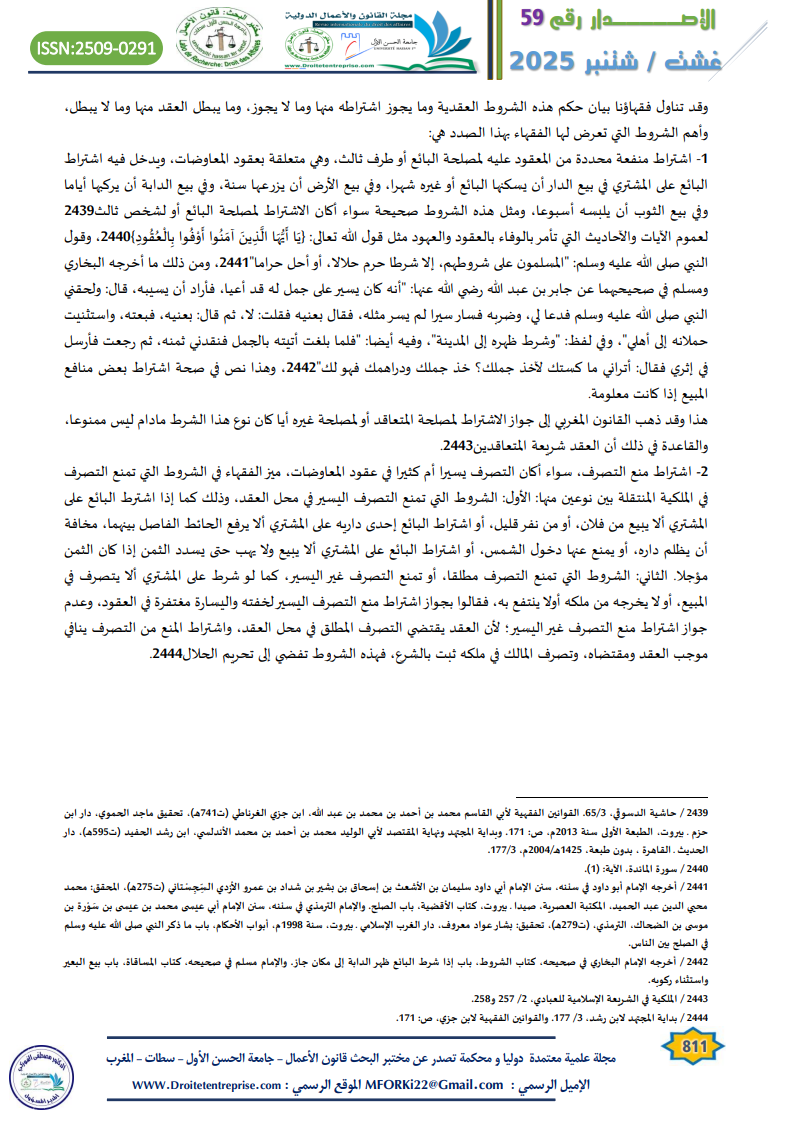
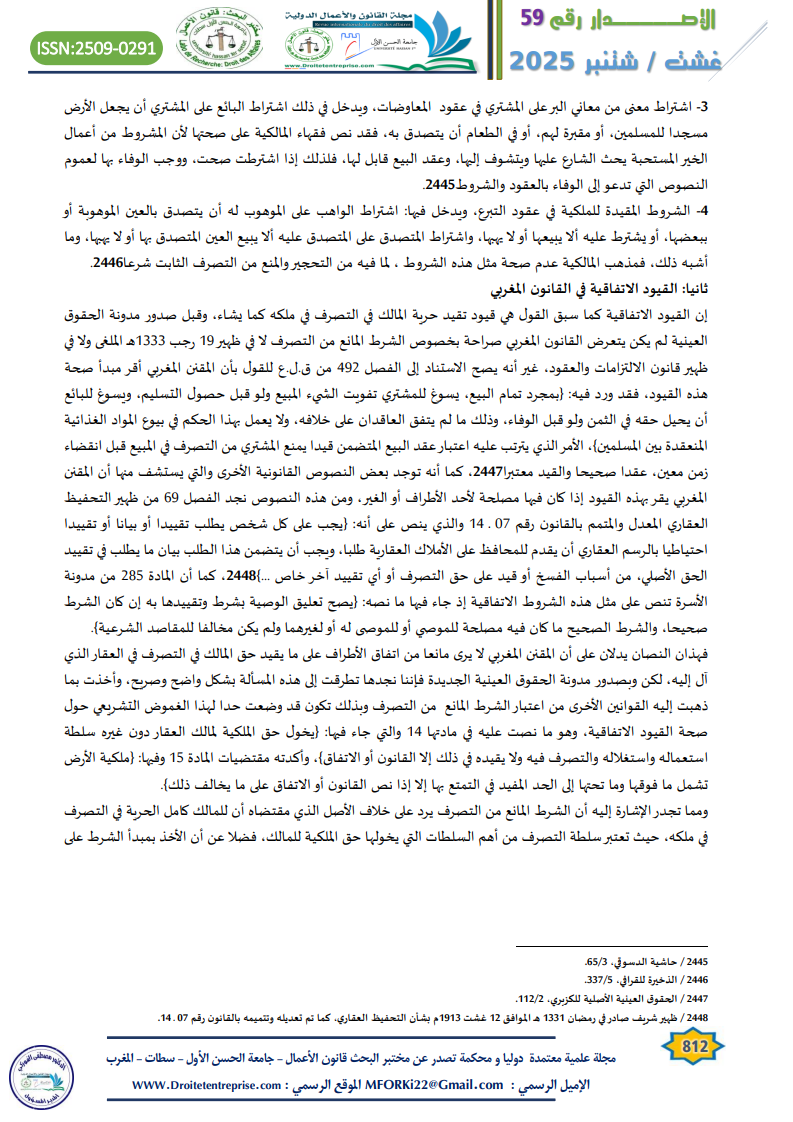
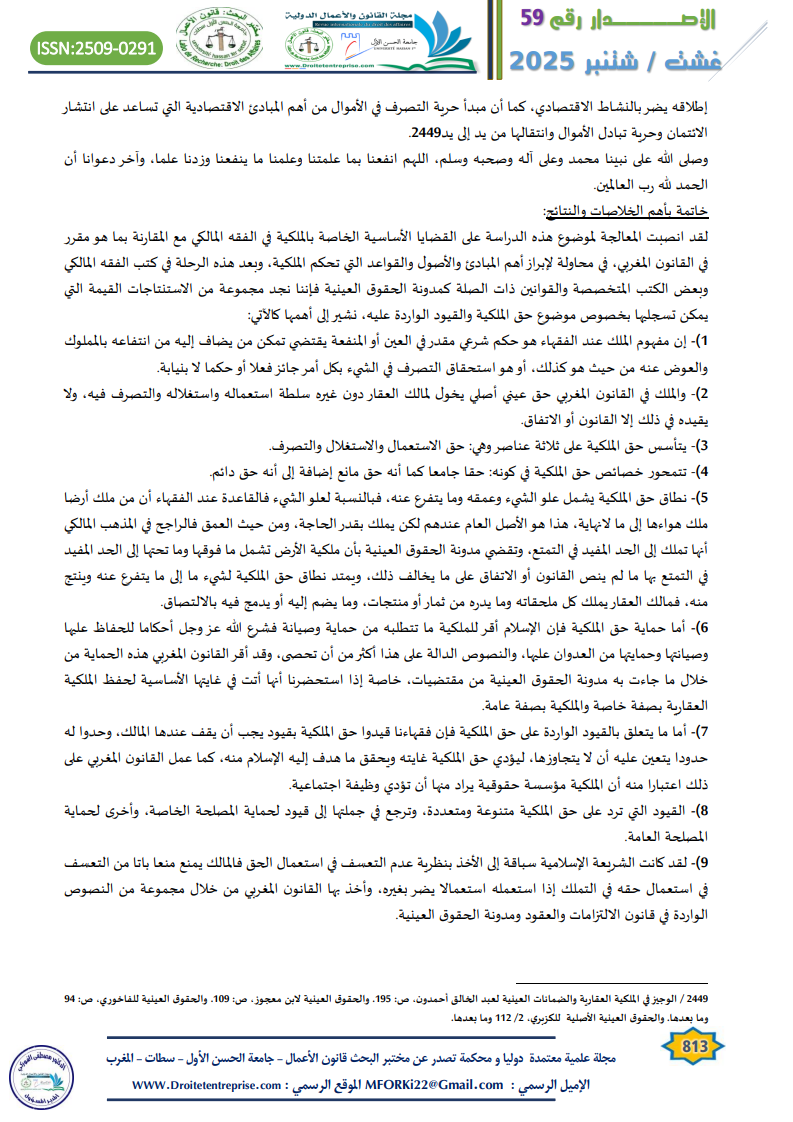
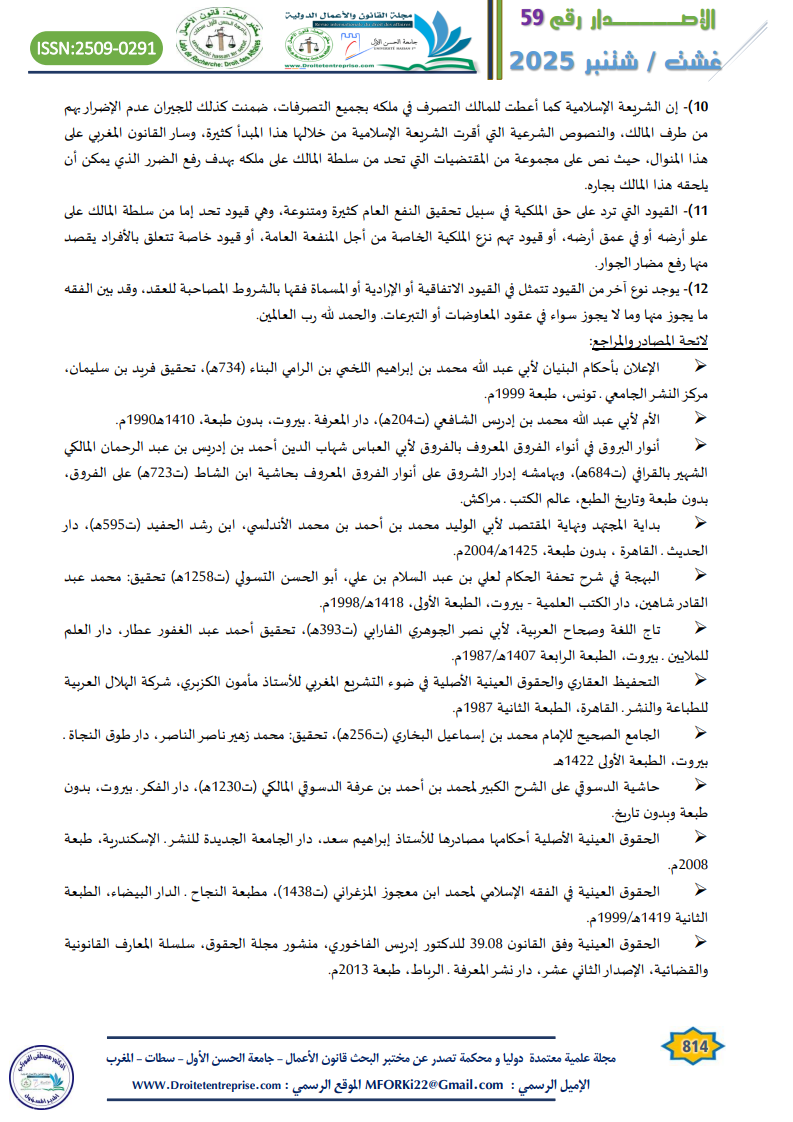
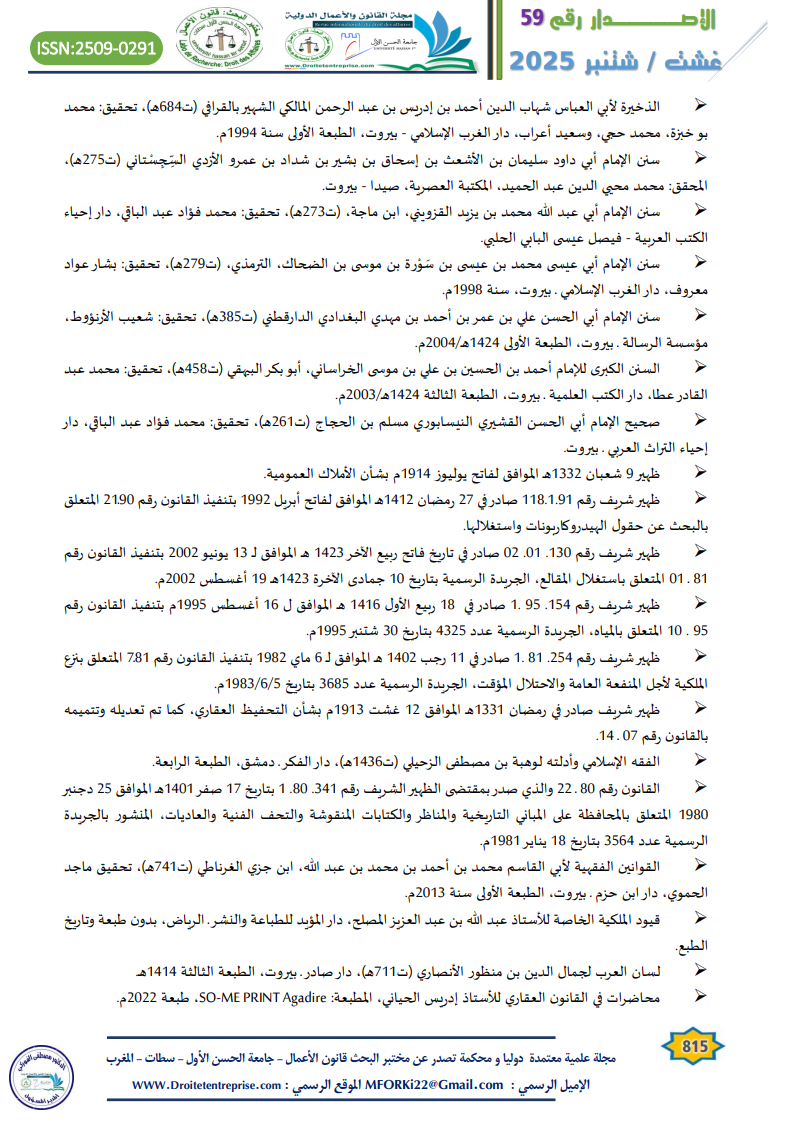
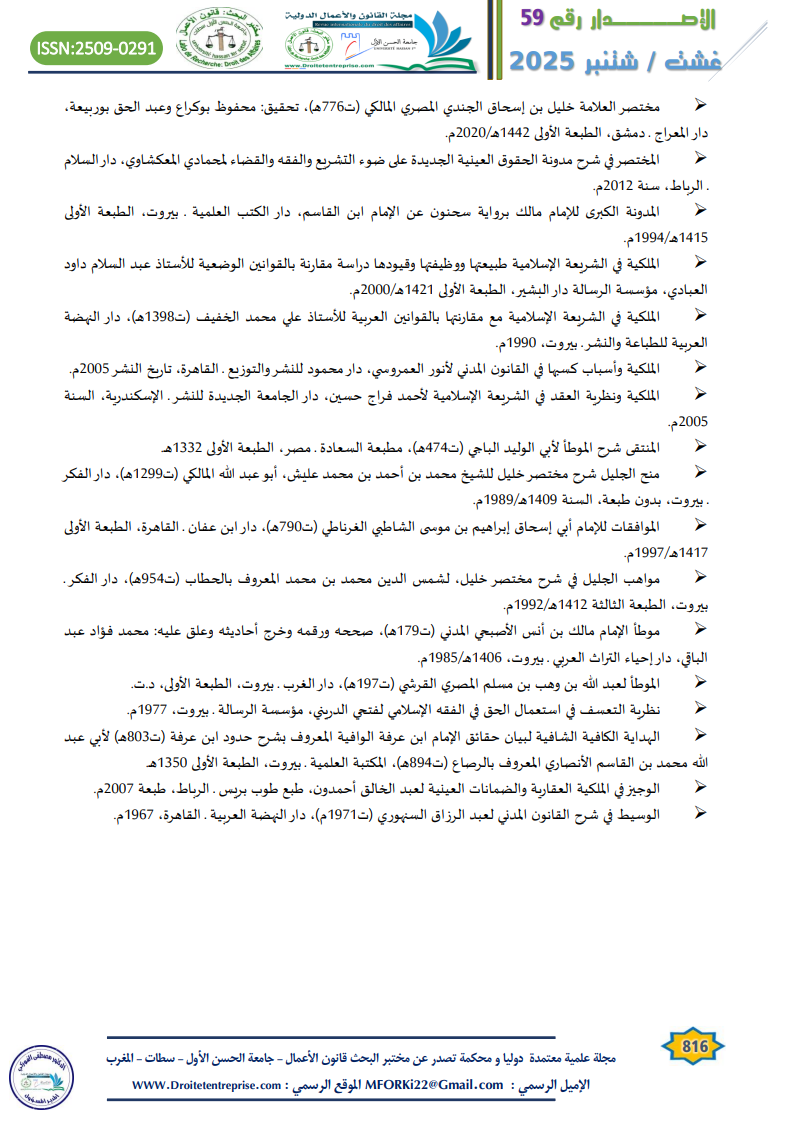
“حق الملكية والقيود الواردة عليه ـ دراسة في ضوء الفقه المالكي والقانون المغربي”
الدكتور: يـاسـيـن العمراني
دكتوراه في الشريعة، كلية الشريعة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس / المملكة المغربية.
ملخص البحث:
يعتبر موضوع حق الملكية محط اهتمام الدراسات القانونية والاقتصادية، كما أنه وثيق الصلة بالأفكار الفلسفية والاجتماعية التي سادت المجتمعات البشرية، خاصة بعد قيام الثورة الصناعية، وتقابل المذاهب الفردية والمذاهب الجماعية في العصر الحديث، والملاحظ أن المطلع على كتب الفقه الإسلامي عامة وكتب الفقه المالكي على وجه الخصوص يجد أن نظرية الملك أو الملكية أو حق الملكية وما يرد عليه من قيود بكل جوانبه المرتبطة به، قد شكلت اهتماما كبيرا من طرف الفقهاء والباحثين، حيث أولوها عناية كبيرة.
وقد انصبت المعالجة لموضوع هذه الورقة البحثية على القضايا الأساسية الخاصة بالملكية في المذهب المالكي مع المقارنة بما هو مقرر في القانون المغربي، في محاولة لإبراز أهم المبادئ والأصول والقواعد التي تحكم الملكية، لتشكل دراستنا بدورها نتاجا فقهيا وقانونيا مهما، الغاية منه هو التعرف على حدود الملك أو حق الملكية في إطار أحكام وقواعد الفقه المالكي والقانون المغربي.
الكلمات المفتاحية: الفقه المالكي، القانون المغربي، حق الملكية، قيود الملكية.
“Property Right and Restrictions – A study in the light of Maliki jurisprudence and the Moroccan Law”
DR : Yassine ELamrani
PhD in Sharia, the Faculty of Sharia – University of Sidi Mohamed Ben Abdellah in Fes / Kingdom of Morocco
Abstract
Property rights are of great interest not only in legal and economic studies, but also in relation to philosophical and social thought that has shaped human societies, particularly after the Industrial Revolution, which marked the rise of tensions between individualistic and collectivist doctrines in modern times. It is noticeable that anyone who studies Islamic jurisprudence books in general and Maliki jurisprudence books in particular will find that the theory of ownership or property rights, along with the restrictions associated with them,it has attracted great interest from jurists and researchers. This paper focuses on the fundamental issues of ownership in the Maliki school, with a comparison to what is stipulated in Moroccan law, in an attempt to highlight the most important principles, foundations, and rules that govern property. This study represents a valuable contribution to both jurisprudence and legal scholarship, aiming to define the scope and boundaries of ownership within the framework of Maliki jurisprudence and Moroccan law.
keywords: Maliki jurisprudence, the Moroccan Law, property right, property Restrictions.
المـقـدمـة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وبعد:
فإنه من المقرر أن الملكية وجدت منذ وجد الإنسان على ظهر هذه الأرض حيث وجد فيها منافعه وما به حياته ويوفي بما تتطلبه غرائزه، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً}، فقد مال الإنسان بمقتضى غريزته إلى اختيار ما هو في حاجة إليه ليستأثر به وليجده عند الحاجة إليه دون منازع، وانساق إلى ذلك انسياقا غريزيا لأسباب ثلاثة ذكرها بعض الباحثين: أولاها أن كل فرد أميل إلى الاستيلاء على الأشياء لمصلحته الخاصة من أن يستولي عليها لمصلحة الجماعة وذلك بحكم غريزته، إذ أن الاستيلاء لمصلحة الجماعة لا يحقق له الطمأنينة في أن يجده لنفسه مستأثرا به عند الحاجة إليه، ثانيها أن إرادة الأشياء وتدبيرها مع الحيازة الخاصة أكثر انسجاما وخير مآلا من إدارتها بغير هذه الحيازة، بحكم أن العمل للنفس أوفى سبيلا إلى سد الحاجة فكان أحب للنفس من العمل للجماعة، ثالثها أن الأمن والسلام لا يتوفران إلا مع الملكية أو الحيازة الفردية فإن الشيوع مثار النزاع بين الشركاء، وفي الحيازة الفردية حافز على العمل والتنمية والادخار للمستقبل لأنها الاستئثار بالمال المحوز بصورة دائمة تحقق للحائز منافعه وثمراته في الحال والاستقبال وذلك ما يدفعه إلى الجد والعمل، وهكذا فإن موضوع حق الملكية والقيود الواردة عليه يتسم بالحيوية نظرا لما تحتله الملكية وحب التملك من مكانة في حياة الفرد والمجتمع المسلم، مما يثبت أن الفقه الإسلامي والشريعة المحمدية يحملان من عناصر المرونة والقابلية للتطور ما يجعلهما قادرين على تنظيم مختلف دروب الحياة ومسايرة سائر متغيراتها، إنجازا لوعد الله الحق بأن الدين الإسلامي هو الدين الخاتم للأديان والمهيمن عليها، وأن الحكم لله لا مبدل لحكمه، وقد اشتملت خطة هذا البحث على ما يلي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لحق الملكية
وتحته مطلبان: (المطلب الأول) يتناول تحديد حق الملكية من حيث المفهوم والعناصر والخصائص، و(المطلب الثاني) خُصص للحديث عن نطاق حق الملكية وحمايته.
المبحث الثاني: القيود الواردة على حق الملكية
وفيه أيضا مطلبان: (المطلب الأول) يتناول القيود المقررة لحماية المصلحة العامة، و(المطلب الثاني) يتحدث عن القيود المقررة لحماية المصلحة الخاصة.
كما تم ختم هذا البحث بخاتمة من خلالها تم عرض أهم الخلاصات التي جاءت في البحث.
أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث في أن المالك يمكن أن يستعمل حق ملكيته بشكل يضر بغيره، لذلك وجب ألا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه الشريعة الإسلامية أو القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيود التي ترد على حق الملكية في سبيل تحقيق النفع العام أو الخاص كثيرة ومتنوعة، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية كما أعطت للمالك التصرف في ملكه بجميع التصرفات، ضمنت كذلك للأغيار عدم الإضرار بهم من طرف المالك الذي قد يسيء التصرف، كما سارت القوانين الوضعية على نفس المبدأ بهدف رفع الضرر.
مشكلة البحث:
من خلال هذا البحث فإن الإشكالية المراد معالجتها تكمن في سلطة المالك على ملكيته هل هي مطلقة أم مقيدة؟ وإن كانت مقيدة، فما هي القيود الواردة في هذا الشأن؟ وما مدى تأثيرها في استعمال المالك لملكه أو استغلاله أو تصرفه فيه؟ ثم ما هي القواعد التي يستند إليها في هذا التقييد من الجانبين الفقهي والقانوني؟ وهل التشريع المغربي كان موفقا في ضبط حق الملكية بما ينفي الضرر ويحقق النفع العام والخاص؟
أهـداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:
1)- التعرف على حقيقة الملك وماهيته وما يشتمل عليه.
2)- التعرف على حدود الملك أو حق الملكية في إطار قواعد الفقه المالكي والقانون المغربي.
3)- إبراز أهم المبادئ والأصول والقواعد التي تحكم الملكية.
4)- الوقوف على معالم الحماية الشرعية والقانونية لحق الملكية.
منهج البحث:
سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والنقدي، وأيضا المنهج المقارن بين القضايا الفقهية والقانونية، مع عزو الأقوال والآراء لأصحابها، كما عملت على تقسيم الموضوع إلى مباحث ثم المباحث إلى مطالب ثم المطالب إلى فروع.
البـحـث:
المبحث الأول: الأحكام العامة لحق الملكية
قسمت هذا المبحث إلى مطلين: (الأول) منهما يتناول حق الملكية وعناصرها وخصائصها، أما (المطلب الثاني) فيتعلق بنطاق حق الملكية وحمايته.
المطلب الأول: تحديد حق الملكية من حيث المفهوم والعناصر والخصائص
وفيه ثلاثة فروع كالآتي:
الفرع الأول: مفهوم حق الملكية
الحق في اللغة خلاف الباطل، والحق واحد الحقوق وحقائق، وحق الأمر يحق: صار حقا وثبت، والملكية مصدر صناعي صيغ من المادة المنسوبة إلى الملك وهو احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به والتصرف بانفراده، وعليه فإن الاستعمال اللغوي لحق الملكية يعني الشيء الثابت المستحق والمستبد به.
وفي الاصطلاح عرف الإمام القرافي حق الملكية بأنه: “حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك”، وفي مكان آخر حاول أن يبين تعريفه فذكر أن الملك: “إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بتلك العين أو المنفعة، أو أخذ العوض عنهما من حيث هو كذلك”، وعرفه ابن الشاط في حاشيته على الفروق بقوله: “والصحيح في حد الملك أنه تمكن الإنسان شرعا بنفسه أو بنيابته من الانتفاع بالعين أو المنفعة ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة”، وللشيخ محمد بن عرفة: “الملك: استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة”.
يتبين من هذه التعريفات وغيرها أن فقهاء المالكية قد اختلفت أنظارهم في المعنى الاصطلاحي للملك، فمنهم من نظر إليه باعتباره حقيقة شرعية أو حكما أقره الشارع ورتب عليه آثارا ونتائج ملازمة، ومنهم نظر إليه على أساس ذكر موضوعه وثمرته وآثاره، وفريق آخر نظر إليه باعتبار العلاقة بين المالك والمملوك، ويعد تعريف القرافي المذكور من أهم التعريفات للملك وأدقها داخل المذهب المالكي فوصف رحمه الله الملك بأنه: “حكم شرعي”، وهو راجع أساسا إلى ما يراه الفقهاء من أن الحقوق كلها ومنها حق الملكية أو الملك حقوق شرعية أتبثها الشارع لأربابها، أو أقرها لهم وليس يترتب عليها من الآثار والأحكام إلا ما رتبه الشارع عليها، وقوله “يقتضي انتفاعه بالمملوك” هذا قيد لإخراج التصرف بالوصاية والوكالة وتصرف القضاة في أموال الغائبين والمجانين، فإن هذه الطوائف لهم التصرف ولا يملكون ولكن تصرفهم ليس لانتفاع أنفسهم بل لانتفاع المالكين، أما قوله: “العوض عنه” فهو قيد لإخراج الإباحات في الضيافات فإن الضيافة مأذون فيها وليست مملوكة على الصحيح، ولإخراج الاختصاصات بالمساجد والربط والخوانق ومواضع المطاف والسكك ومقاعد الأسواق فإن هذه الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية من الانتفاع بها”، وأما قول القرافي: “من حيث هو كذلك”، فقد شرح ذلك بنفسه بقوله: “وقولنا من حيث هو كذلك إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث هو كذلك، وقد يتخلف عنه لمانع يعرض …”.
وبخصوص مفهوم حق الملكية في القانون فإننا نجد مجموعة من التعاريف نذكر منها تعريف الأستاذ ابن معجوز رحمه الله حيث يقول: “حق الملكية حق عيني على شيء معين بالذات تعطي صاحبها دون غيره الحق في استعمال ذلك الشيء واستغلاله والتصرف فيه بدون تعسف، وضمن الحدود التي رسمها القانون والنظام العام”، كما نجد كذلك الأستاذ مأمون الكزبري يعرف حق الملكية بقوله:” حق الملكية هو حق عيني على شيء معين يخول لصاحبه دون غيره بصورة مطلقة استعمال هذا الشيء واستغلاله والتصرف فيه وذلك في حدود القانون والنظام دون تعسف”، وبالرجوع إلى القانون المغربي فإننا نجد المادة 14 من قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية تعرف حق الملكية بأنه: {حق عيني أصلي يخول لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق}.
ويتبين وجه المخالفة بين الفقه والقانون في أن حق الملكية عند رجال القانون هو حق عيني، لا يتعلق بالأعيان المالية المعينة، ولا تصلح المنافع ولا الحقوق محلا له، وهم أي رجال القانون قلما يستعملون اسم الملك، فيعبرون عن ذلك في الغالب بحق الملكية وهو تعبير قلما نجده في كتب السلف من الفقهاء الذين يرون أن الملك كل ما يتعلق بالأعيان والمنافع وبالحقوق، فجميعها تصلح أن تكون محلا للملك في نظرهم، ومن جهة يرى رجال القانون أن لحق الملكية ثلاثة عناصر وهي: حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف.
الفرع الثاني:عناصر حق الملكية
يتأسس حق الملكية على ثلاثة عناصر وهي: حق الاستعمال، والاستغلال، والتصرف، وقد اعتنى فقهاء المالكية ببيان القدرات والسلطات التي يخولها الملك لصاحبه، وهي ما أطلقوا عليه حكم الملك، ومرادهم به الأثر أو الثمرة التي رتبها الشارع الحكيم على قيام الملك؛ جاء في حدود ابن عرفة أن: “الملك الحقيقي يقتضي استحقاق التصرف بجميع خواصه” كما جاء فيه أيضا: “خاصة تصرف الملك التمكن من الهبة والصدقة و البيع والاستغلال”، والقانونيون يسمون هذه القدرات والسلطات والمزايا التي تكون للمالك على الشيء المملوك: عناصر حق الملكية، ويذكرون لها ثلاثة عناصر: الاستعمال (أولا) والاستغلال (ثانيا) و التصرف (ثالثا) كما هو نص المادة 14 من م.ح.ع المذكور.
أولا: حق الاستعمال
المراد بحق الاستعمال انتفاع المالك نفسه بالشيء المملوك، واستخدامه في كل ما يمكن أن ينتفع به، حسب طبيعته، كاستعمال الأرض للزراعة، والسيارة للركوب، والثياب لللبس، والدار للسكن، إلى غير ذلك من وجوه الاستعمال المختلفة التي تختلف باختلاف طبيعة الشيء والغرض الذي أعد له، والاستعمال يختلف عن الاستغلال في أنه لا يعطي لصاحبه الحق في الثمار، فاستعمال المنزل يكون بالسكن فيه، أما تأجيره فلا يعتبر استعمالا بل استغلالا إذ يخول للمؤجر الحصول على الأجرة وهي من الثمار، لكن قد يختلط الاستعمال بالاستغلال، كما هو الحال بالنسبة إلى الأرض الزراعية إذ يصعب أن يتصور استعمالها بغير زراعتها والحصول على ثمارها، ولذلك إذا تقرر لشخص حق استعمال الأرض دون استغلالها، انحصر حقه في الحصول على ثمار الأرض بمقدار ما يحتاج إليه.
ثانيا: الاستغلال
ويقصد بحق الاستغلال الحق في الانتفاع بغلة الشيء، بمعنى الحصول على ما يتولد أو ينتج عن الشيء من ثمار، والمقصود بالثمار هي ما ينتجه الشيء في مواعيد دورية منتظمة دون المساس بجوهره، سواء كانت ثمارا طبيعية مثل كلأ المراعي الطبيعية ونتاج الحيوان وصوف الأغنام، أو ثمارا محروثة نتيجة لتدخل عمل الإنسان مثل محاصيل الأرض الزراعية والحدائق والكروم، أو ثمارا مدنية وهي الدخل الدوري الذي يقوم الغير بالوفاء به نظير انتفاعه بالشيء كإيجار المباني والأراضي وما يتصل بها وربح الأصول والأموال، وقد أشارت مدونة الحقوق العينية إلى هذه الأنواع في المادة 231 إذ جاء فيها: {إن ثمار الأرض الطبيعية أو الصناعية والثمار المدنية ونتاج الحيوان هي للمالك بطريق الالتصاق}.
ثالثا: حق التصرف
وهو تلك السلطة والمكنة التي تخول لصاحبها المعاوضة عن ذلك الشيء أو التبرع به أو إزالته؛ لأن الملك الحقيقي يقتضي استحقاق التصرف فيه بجميع خواصه، والفقهاء عندما يطلقون لفظ التصرف، يقصدون به أي تصرف، سواء أكان تصرفا ماديا في الشيء من أجل الانتفاع الشخصي بالشيء نفسه أو بغلته، أو تصرفا يهدف إلى نقل ملكية الشيء أو غير ذلك، وبالرجوع إلى القانون الوضعي فإن مفهوم التصرف لا يختلف كثيرا عن مفهوم التصرف عند الفقهاء باستثناء بعض الخصوصيات التي حاول رجال القانون التنصيص عليها، فالتصرف عندهم يشمل التصرف المادي والتصرف القانوني، فالأول سلطة المالك في إفناء الشيء أو إزالته ماديا أو تعديله، وليس لأحد الاعتراض على ما يقوم به المالك من إعدامه محل الحق إلا في حالة إذا ترتب على تصرفه ضرر معتبر أصاب الغير، أما الثاني فيقصد به إجراء تغيير في المركز القانوني للشيء وذلك عندما يعمد المالك إلى نقل سلطته كلها أو بعضها إلى الغير سواء تم ذلك بمقابل كالبيع أو بدون مقابل كالهبة أو غير ذلك من أصناف التصرف.
الفرع الثالث: خصائص حق الملكية
يتميز حق الملكية عن سائر الحقوق بثلاث خصائص، فهو حق جامع (أولا) مانع (ثانيا) ودائم (ثالثا):
أولا: حق الملكية حق جامع
بحيث يخول حق الملكية لصاحبه سلطات واسعة من استعمال واستغلال وتصرف، وتعد هذه الخاصية جوهرية في حق الملكية وهي مستمدة من طبيعة حق الملكية، ومن تم كان لصاحب الملك سلطات ممكنة على الشيء، إذ يمكن له استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه سواء كان تصرفا ماديا أو قانونيا، وهذا ما يجعل حق الملكية يتميز عن الحقوق العينية الأصلية الأخرى من حيث كونه حقا جامعا، بحيث إن الحقوق العينية الأخرى لا تخول لأصاحبها إلا بعض السلطات، ومن هنا كانت الملكية حقا جامعا على اعتبار أنها تجمع في مضمونها كل منافع الشيء، ويترتب على هذه الخاصية أن الأصل في حق المالك في ملكه أن يكون جامعا لكل السلطات ولا يكلف إلا بإثبات ملكه طبقا للطرق الشرعية والقانونية ومن يدعي أن له حقا في ملك الغير أو يدعي أن هناك قيدا تقرر لمصلحته على ملك الغير، فعليه هو يقع عبء الإثبات لا على المالك، كما أن أي حق يتفرع عن الملكية كحق الارتفاق وحق الرهن يكون عادة مؤقتا، ولا يجوز أن تتجاوز مدتها حياة أصحابها.
ثانيا: حق الملكية حق مانع
أي أن السلطات المخولة للمالك على ملكه يتمتع ويستأثر بها المالك وحده، فلا يجوز لأحد أن يشاركه في ملكه أو أن يتدخل في شؤون ملكيته، فالأصل أن يستأثر بجميع مزاياه ويمنع غيره أن يشاركه في ذلك إلا استثناء فيما تتوقف عليه الحاجة لحفظ الأنفس والأموال فلغير المالك حينئذ حق المشاركة في بعض المنافع إذا اشتدت حاجته إلى ذلك، ولم يلحق صاحبه ضررا من هذه المشاركة؛ ففي الحديث النبوي الشريف: “لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره”، وفي المختصر الفقهي لسيدي خليل بن إسحاق المالكي في باب الشركة ما نصه: “وَنُدِبَ إعَارَةُ جِدَارِهِ لِغَرْزِ خَشَبةٍ، وَإِرْفَاقٌ بِمَاءٍ، وفتحُ بابٍ”، وفي إحياء الموات يقول رحمه الله: “وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ، والأرجح بالثمن كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح، وأجبر عليه كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية، وبدئ بمسافر وله على عارية آلة ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود … وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره، وأقرع للتشاح في السبق، وَلَا يَمْنَعُ صَيْدَ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان، وكلأً بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه”، وفي موضع من باب الذكاة: “وضمنَ مار أمكنته ذكاتُه وترك كترك تخليص مُسْتَهْلَكٍ مِنْ نَفْسٍ أَوْ مَالٍ بِيَدِهِ، أَوْ شهادته، أو بإمساك وثيقة أو تقطيعها، وفي قتل شاهدي حق تردد، وترك مواساة وجبت بخيط لجائفة، وفضل طعام أو شراب لمضطر، وعمد وخشب فيقع الجدار وله الثمن إن وجد”، وفي باب الصلاة: “وإن كان لعراة ثوبٌ صلوا أفذاذا، ولأحدهم ندب له إعارتُهم”، وذكر مسألة المضطر إلى الطعام بقوله: “وللضرورة ما يسد غير آدمي وخمر إلا لغصة، وقدم الميت على خنزير وصيد لمحرم لا لحمه وطعام غير إن لم يخف القطع، وقاتل عليه”، إلى غير ذلك مما يطول بنا جلبه من وجوه المشاركة في المال الخاص تارة على سبيل الوجوب والإلزام وتارة على سبيل الندب والتبرع.
ثالثا: حق الملكية حق دائم
أي أن السلطات المترتبة على الملك تظل ثابتة لصاحبها ما بقي الشيء الوارد عليه الحق، فالملك غير مؤقت وليس له زمن ينتهي بانتهائه، ولا ينتهي إلا بهلاك العين المملوكة، أو بانتقالها إلى غيره بالإرث إذا مات المالك، أو قام بتصرف شرعي ناقل للملكية كالبيع أو الهبة، وبالجملة فإن الرأي السائد عند أكثر الفقهاء أن دوام ملك العين يبقى ولا ينتهي، كما أنه لا يسقط بعدم الاستعمال ولا يطاله التقادم إلا بوجود الحيازة المستوفية لشروطها، وهذا الاستثناء مرده أصلا إلى كون الملكية قد انتقلت بطريق شرعي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَازَ شَيْئًا عَشْرَ سِنِينَ فَهُوَ لَهُ”.
وإذا كان الحكم كذلك في ملك العين، فإن الأمر يختلف بالنسبة لملك المنفعة إذ يقبل الإسقاط، فإذا أسقطه مالكه سقط اتفاقا إذا كان سببه عقد إعارة أو عقد وصية، أما إذا كان سببه عقد إجارة، فإنه في هذه الحال يعد حقا ناشئا عن سبب لازم لا يملك أحد طرفيه الاستبداد بفسخه، وأما إذا كان ملك المنفعة بسبب الوقف، فهو لا يسقط كذلك بالإسقاط، فالمستحق في الوقف بشرط الواقف إذا أسقط حقه لم يسقط، وله أن يطالب به بعد ذلك، لعدم قبول ملك العين التوقيت.
المطلب الثاني: نطاق حق الملكية وحمايته
يتناول هذا المطلب نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى تتعلق بنطاق الملكية أي حدود حق الملكية (الفرع الأول)، ثم النقطة الثانية وهي الحماية الفقهية والقانونية لحق الملكية (الفرع الثاني).
الفرع الأول: نطاق حق الملكية
استنادا إلى تعريف حق الملكية الذي يقضي بأن حق الملكية حق عيني على شيء معين يخول لصاحبه دون غيره استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه وذلك في حدود الشرع والقانون، فإن هذا الحق لا يقتصر فقط على الشيء وإنما يمتد إلى شمول فروعه وما ينتج عنه وإلى ثماره أيضا، فملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوا وعمقا ومساحة وفروعا إلا إذا نص الشرع أو القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك، وعلى هذا الأساس فنطاق حق الملكية نطاق واسع، بحيث يشمل ما يعلو الشيء (أولا)، وما يوجد في عمقه (ثانيا)، ونتاجه وتفرعاته (ثالثا).
أولا: نطاق حق الملكية من حيث العلو
ذهب فقهاء المالكية إلى أن من ملك عقارا فإنه يملك هواءه، وهو المعبر عنه بالعلو أو الفضاء؛ يقول الشيخ التسولي: “من ملك أرضا ملك هواءها إلى ما لانهاية”، وعليه فيجوز للمالك أن يبيع الهواء؛ جاء في الذخيرة للقرافي ما نصه: “يجوز بيع حق الهواء لإخراج الأجنحة من غير أصل يعتمد عليه”، وفي حال بيع الهواء لشخص آخر فإن ملك الفضاء ينتقل للمشتري في حدود ما تم الاتفاق عليه، كما يجوز بيع هواء ثان فوق هواء أول إذا وصف البناء المراد إحداثه للأسفل وللأعلى وصفا دقيقا ينتفي معه الغرر؛ وفي المختصر: “وجاز بيعُ هواءٍ فوقَ هواءٍ إن وُصِفَ البناءُ”، وبالنسبة للقانون المغربي فإن ملكية هذا النطاق أصبح محدودا بالنظر لما استجد من الوقائع حيث اخترعت الطائرات وجالت الآفاق الجوية، وهو ما يستشف من مفهوم المادة 15 من المدونة والتي جاء فيها: {ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك}، فعبارة (الحد المفيد في التمتع بها) يفهم منها أنه ليس هناك من فائدة للمالك في أن يمتد ملكه علوا إلى ما لا نهاية لما يتعلق ذلك بالملاحة الجوية، على اعتبار أن الملكية كما شرعت لمصلحة المالك شرعت كذلك لتكون دعامة من دعائم قيام النظام الاجتماعي الذي يستوجب توجيهها إلى تحقيق المصالح الاجتماعية، فيتحصل من هذا كله أن تصرف وتمتع المالك في علو أرضه ليس على إطلاقه بل كثيرا ما ترد عليه جملة من القيود التي تقتضيها المصلحة العامة كالقواعد المتعلقة بالمجال العمراني والمتمثلة في قواعد الارتفاق وكذلك ما يتعلق بالملاحة الجوية….
ثانيا: نطاق حق الملكية من حيث العمق
إذا كان الفقهاء متفقين في حكم الأهوية من التصرف فيها بكل أنواع التصرفات من بيعها وغير ذلك شريطة ما تقتضيه المصلحة، إلا أنهم اختلفوا فيمن يملك أرضا هل يملك ما تحتها أم لا؟ وهو نص قاعدة فقهية مختلف فيها عبر عنها سيدي أبو الحسن علي الزقاق في نظمه “المنهج المنتخب في قواعد المذهب” بقوله:
هل ملكُ ظهر الأرض للبطنِ شمِلْ ** مُعرىً بمنحٍ ملكُه أو إن كملْ
والمعتمد من ذلك في المذهب المالكي أن من ملك أرضا يملك باطنها، وهو نفس ما صار عليه القانون المغربي من خلال مضمون المادتين 15 و19 من مدونة الحقوق العينية، فالمادة 15 تنص على أن: {ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك}، أما المادة 19 فتنص على أنه: {لمالك العقار مطلق الحرية في استعمال ملكه واستغلاله والتصرف فيه وذلك في النطاق الذي تسمح به القوانين والأنظمة الجاري به العمل}، ونفس ما تقدم ذكره في العلو، فإن هناك مجموعة من القيود التي تحد من إطلاقية التصرف في العمق رغم دخوله في مسمى الملك، إلا أن هذه القيود ترد من جوانب أخرى، فهناك ما يتعلق بالقيود المتعلقة بالمناجم، وقيود متعلقة بالمقالع، وقيود متعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية كما سيأتي بيانه في محله.
ثالثا: نطاق حق الملكية من حيث التفرعات
يمتد نطاق حق الملكية لشيء ما إلى ما يتفرع عنه وينتج منه، وذلك كنتاج الحيوان وثمار الأشجار والغلات كالأجرة في كراء الدور والأراضي، وهذا ما تنص عليه المادة 16 من مدونة الحقوق العينية: {مالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات، وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق}، وعلى هذا الأساس فإن نطاق حق الملكية لا يقتصر فقط على تملك الرقبة، وإنما يشمل كل ما ينتج عن الشيء من غلة وما يضم إليه ويدمج فيه بالالتصاق ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، وغلة الشيء تشمل: الثمار، والمنتجات، والملحقات.
الفرع الثاني: الحماية الفقهية والقانونية لحق الملكية
لما جاء الإسلام أقر للملكية ما تتطلبه من حماية وصيانة، وأعلن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفات بقوله: “إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟”، فكانت صيانة المال وحمايته كصيانة النفس في حرمة الاعتداء عليهما، وفي الحديث أيضا:” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه”، وقد شرع الله عز وجل أحكاما للحفاظ على الملكية وصيانتها وحمايتها من العدوان عليها كحد السرقة وكالنهي عن أكل الأموال بغير وجه حق والغصب والتعدي على أملاك الغير وغير ذلك؛ والنصوص الدالة على هذا أكثر من أن تحصى من ذلك قول الباري عز وجل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، وقوله سبحانه وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من اقتطع شبرا من الأرض ظلما، طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين”.
وقد أقر القانون المغربي هذه الحماية من خلال ما جاءت به مدونة الحقوق العينية من مقتضيات خاصة إذا استحضرنا أنها أتت في غايتها الأساسية وهي حفظ الملكية العقارية بصفة خاصة والملكية بصفة عامة، وهو ما يتبين جليا وواضحا من خلال مجموعة من النصوص، فبالرجوع إلى المادة 22 من المدونة المذكورة نجد هذا المقتضى واضحا إذ تنص على أنه: {لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق، وله أن يطلب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش}، كما نجد المادة 23 كذلك تنص بدورها على أنه: {لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، ولا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب}.
القيد في عرف العلماء هو الأمر المخصص للأمر العام، والقيود والتكاليف التي فرضها الإسلام على ملكية المال إنما وجدت لتحمي الملكية من أن تنقلب إلى وسيلة للاستغلال وأداة للظلم، مما يعود بالوبال على المجتمع، وبالتالي على صاحبها، فهي قيود لمصلحة المجتمع ولمصلحة الملاك، فهي تؤكد أن الملكية في الشريعة الإسلامية حق خاص ذو وظيفة اجتماعية، وهي ليست قيودا تعسفية تقصد التقييد لذاته، وإنما هي نعم إلهية تحافظ على الدور المنشود للمال في الواقع الإنساني، وعلى ذلك فالملكية في الشريعة الإسلامية ليست ملكية مطلقة، كما هو الحال في النظم الرأسمالية، فقد منعت الشريعة كل ما يمكن أن ينحرف بالمال عن مهمته التي يجب أن يؤديها في الحياة الإنسانية.
وبناء على هذا أمكن لفقهاء المسلمين أن يقيدوا حق الملكية بقيود يجب أن يقف عندها، وذلك انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، وقد تفطنت القوانين الوضعية لهذا المبدأ فعملت على تقييد حق الملكية اعتبارا منها أن الملكية مؤسسة حقوقية يراد منها أن تؤدي وظيفة اجتماعية، وعليه فإن القيود التي ترد على حق الملكية متنوعة ومتعددة، يمكن إرجاعها إلى: قيود مقررة على حق الملكية حماية للمصلحة العامة (المطلب الأول)، وأخرى لحماية المصلحة الخاصة (المطلب الثاني).
المطلب الأول: القيود المقررة على حق الملكية حماية للمصلحة العامة
إن حق الملكية كمبدأ عام حق مطلق ودائم وجامع ومانع، لكن هذا الإطلاق للمالك في ملكه قد ترد عليه مجموعة من القيود خاصة إذا تعسف في استعمال ملكه (الفرع الأول)، أو تعلق الأمر بتحقيق مصلحة عامة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: القيود المقررة منعا لإساءة استعمال حق الملكية
يعبر عن مبدأ منع الإساءة في استعمال حق الملكية بمبدأ عدم التعسف في استعمال حق الملكية، والتعسف في اللغة يقصد به أخذ الشيء على غير طريقته ومثله الاعتساف، وعسفه عسفا أخذه بقوة، وعسف في الأمر، فعله من غير روية ولا تدبير، وفي الاصطلاح عرف بأنه: “إساءة استعمال الحق بحيث يؤدي إلى ضرر بالغير”، أو أنه: “انحراف بالحق عن غيره”، وهناك من عرفه على أنه: “استعمال الحق على وجه غير مشروع”.
ولقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى الأخذ بنظرية عدم التعسف في استعمال الحق، كما بنى فقهاء الشريعة الإسلامية على منع التعسف في استعمال حق الملكية مجموعة من القواعد منها على سبيل المثال: ـ قصد الإضرار، ـ قصد غرض غير مشروع، ـ ترتب ضرر أعظم من المصلحة، ـ الاستعمال غير المعتاد وترتيب ضرر للغير، ـ استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ.
ومذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأصل هو تقييد حق الملكية إذا كان في استعماله مضارة، ولا يعطى للمالك حرية التصرف إلا في مسائل؛ وسنده في ذلك حديث: “لا ضرر ولا ضرار”، ويمكن تقسيم استعمال الحق بحسب القصد وعدمه، وبحسب ما يؤول إليه من إضرار إلى الأقسام الآتية:
القسم الأول: أن يقصد الجالب أو الدافع إضرار غيره كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه وصحبه قصد الإضرار بالغير.
القسم الثاني: ألا يقصد الجالب إضرارا بأحد، ولكن يلزم عن فعله ضرر عام كتلقي السلع وبيع الحاضر للبادي.
القسم الثالث: ألا يقصد الجالب أو الدافع إضرارا بأحد، ولكن يلزم عنه ضرر خاص بالغير، ويلحق الجالب أو الدافع بمنعه من ذلك الفعل ضرر، فهو محتاج إلى فعله، كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره، أو يسبق إلى شراء طعام أو إلى صيد عالما أنه إذا حازه استضر غيره بعدمه ولو أُخذ من يده استضر.
القسم الرابع: ألا يقصد الجالب أو الدافع الإضرار بأحد، ولا يلحق الجالب أو الدافع بمنعه عن الفعل ضرر، ولكن أداؤه إلى المفسدة قطعي عادة كحفر البئر خلف باب الدار في الظلام بحيث يقع الداخل فيه بلا قصد.
القسم الخامس: ألا يقصد الجالب أو الدافع إضرارا بأحد، ولا يلحقه بمنعه عن الفعل ضرر ولكن أداؤه إلى المفسدة نادر، كحفر البئر بموضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد فيه.
القسم السادس: ألا يقصد الجالب أو الدافع إضرارا بأحد، ولا يلحقه بالمنع مضرة، ولكن أداء الفعل إلى المفسدة ظني أي غالب كبيع السلاح لأهل الحرب والعنب للخمار.
القسم السابع: ألا يقصد الجالب أو الدافع الإضرار بأحد، ولا يلحقه بالمنع مضرة، ويكون أداء الفعل إلى المفسدة كثيرا، لا غالبا ولا نادرا كما في مسائل بيوع الآجال.
هذا وقد ذكر فقهاء المالكية وجوها كثيرة للضرر منها ثلاثة أنواع لا تؤثر في المنع وهي: الضرر اليسير، والضرر القديم، وضرر المنافع أي الغلة؛ فالأول كدخان المطابخ ونحوها مما لا يستغنى عنه في المعاش فلا يمنع منه بخلاف دخان الفرن والحمام فيمنع لأنه يضر بالجيران، والثاني كشجرة قديمة مضرة بجدار الدار فمذهب ابن القاسم وسحنون أنه لا يغير الضرر القديم وإن أضر بجاره، أما النوع الثالث فقد حكى التسولي الاتفاق على أن الضرر المتعلق بالمنافع والذي يحدث نقصا في الغلة أو انقطاعها بالكلية لا يمنع كإحداث فرن بقرب فرن فتقل غلة الأول أو تنقطع بالكلية، ومن جهة فإنهم يمنعون المالك الذي يتصرف في ملكه أن يحدث ضررا يضر بغيره من غير منفعة له لأن ذلك يكون دلالة على قصده الإضرار بالغير كما لو عمد إلى هدم جداره الساتر بينه وبين جاره دون منفعة له في الهدم ولا مقتضى لذلك، بل إنما قصد به الضرر بجاره أو العنت قضي عليه بإعادته كما كان اتفاقا لأنه مضار بجاره؛ ومنه قول صاحب المختصر: “وقُضِيَ عَلَى شَرِيكٍ بإعادةِ الساترِ لغيرهِ إن هدمَه ضرراً لا لإصلاحٍ أو هدْمٍ”.
وقد أقرت معظم القوانين الوضعية نظرية التعسف في استعمال الحق خاصة في مجال الملكية العقارية، حيث أضفت على حق الملكية صبغة اجتماعية يجب أن يمارس في إطار القيود المقررة عليها، كما هو الشأن بالنسبة للقانون المغربي وذلك من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود من قبيل الفصول 77 و91 و92 و94، وكذا مدونة الحقوق العينية من قبيل المواد 14 و19 و20 و21؛ ففي المادة 21 ما نصه: {لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا}.
الفرع الثاني: القيود المقررة في سبيل تحقيق النفع العام
لقد عرف الفقه الإسلامي منذ القديم هذا المبدأ، وهو تحقيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وهناك تطبيقات عدة منها: من كان له عقار تفصله طريق عام فهو وإن كان يحق له أن يبني على جانبي الطريق بناء يجعل بعضه على فضاء الطريق المذكور فإن حقه هذا مقيد بأن لا ينشأ عن تغطية ذلك الفضاء إظلام للطريق، كما يتعين عليه أن يعلي ذلك البناء فوق الطريق إلى الحد الذي لا يؤذي المارة، ومنها من غرس شجرا في حدود بلاده المجاورة للطريق العام، فامتدت أغصان تلك الأشجار إلى عرض الطريق، فإنها تقطع كي لا تضر بالمارة، ومنها أنه يمنع مالك العقار من أن يكريه أو يبيعه لمن يتخذه وكرا للفساد أو ناديا للقمار، لما في ذلك من المضرة التي تلحق العموم، كما يمنع بالأحرى من أن يستعمله بنفسه في ذلك الغرض، ومنها إذا باع أحد المالكين على الشياع نصيبه في العقار المشاع، فيحق لبقية الشركاء أن يشفعوا ذلك النصيب بعد أن يؤدوا لمشتريه ما صرفه في شرائه، ويضحى في هذه الحالة بمصلحة هذا المشتري لما في الشفعة من المصلحة العامة، لأنها تعمل على تقليل الشركاء نظرا لما تجره الشركة من مضار اجتماعية، لأنها تعطل المال المشاع وتحرم المجتمع من منافعه، إلى غير ذلك من القيود التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتقديما على المصلحة الخاصة عند تعارضهما.
وفي القانون المغربي فإن حق الملكية إذا كان يمنح للمالك مصلحة خاصة فإن هذا الحق مقيد بعدم المساس بالمصلحة العامة، وعليه فإن المالك يمكن أن يستعمل حق ملكيته بشرط ألا يستعمل هذا الحق استعمالا تمنعه القوانين والأنظمة، والقيود التي ترد على حق الملكية في سبيل تحقيق النفع العام كثيرة ومتنوعة، يمكن تلخيصها في: قيود تحد من سلطة المالك على علو أرضه (أولا)، أو في عمق أرضه (ثانيا)، وأخرى تهم نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة (ثالثا)، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولا: القيود التي تحد من سلطة المالك على علو أرضه
إن ما تقرر من قبل عند الحديث عن نطاق حق الملكية من حيث العلو من أن الفقهاء قالوا: بأن من ملك أرضا ملك هواءها إلى ما فوقها إلى عنان السماء، لا يفهم منه هذا الإطلاق وإنما ذلك مقيد بقيد الحاجة كما نص على ذلك بعضهم فلا ينبغي أن يثبت الاختصاص في جهة العلو إلا ما تمس الحاجة إليه، إذ لا فائدة في إثبات الملك فيما وراء ذلك، إضافة إلى هذا فإن القاعدة المقررة في الشريعة الإسلامية أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة؛ قال في المنهج المنتخب: وشبهُها وأصلُ شَرعِنا القَضا ** لِما يعُم كالعَدا وما مَضى
وقد عمل القانون المغربي على فرض مجموعة من القيود في هذا الصدد، من ذلك القوانين والضوابط والتصاميم التي تتعلق بتنظيم المدن وتوسعتها وإنشاء الطرق العمومية، بحيث إذا كانت هذه القوانين تمنع البناء في بقعة معينة أو تحدد علوا معينا للبناء، فإن المالك يصبح حقه في الهواء مقيدا بما تفرضه هذه الأنظمة كالقانون رقم 12ـ90 المتعلق بالتعمير أو القانون رقم 25ـ90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذلك القوانين التي تنظم الملاحة الجوية والتي تعطي الحق للمركبات الهوائية بالطيران فوق الأملاك الخاصة ضمن حدود معينة، الشيء الذي لم يبق معه الحق لملاك هذه العقارات في التعرض لأصحاب هذه المركبات ومنعهم من استعمال هواء عقاراتهم، وبخاصة العقارات المجاورة للمطارات، وقد صدر في شأن هذه القيود الظهير المؤرخ في فاتح شعبان 1357هـ الموافق لـ 26 شتنبر 1938م المتعلق بإحداث وضبط الحرمات المفروضة على منعة الملاحة الجوية، ومنها القوانين التي تنظم حقوق الارتفاقات المقررة على الأملاك الخاصة لمصلحة الخطوط البرقية والهاتفية والتي تعطي الحق للدولة في وضع الأعمدة ومد الأسلاك فوق العقارات، وأيضا القوانين التي تمنع المالك من البناء قرب الأماكن الحربية أو السكك الحديدية.
ثانيا: القيود التي تحد من سلطة المالك في عمق أرضه
إن سلطة المالك على عمق أرضه مقيدة بتحقيق المصلحة العامة، والأصل في المذهب المالكي أن المعادن حكمها للإمام؛ ففي المختصر ما نصه: “وإنما يُزكى مَعدنُ عينٍ، وحكمُه للإمامِ ولو بأرضِ معَين إلا مَملوكةً لمُصالحٍ فله”، وعليه فإنه لا يمكن لمالك الأرض استخراج ما تحتها من معادن ومواد أولية دون الالتزام بالقوانين التي تحد من سلطة المالك على عمق أرضه في التنقيب، وقد عدد القانون المواد المنجمية التي لا يمكن لأي شخص التنقيب عليها إلا بعد الحصول على إجازة تخوله التنقيب من خلال الفصل الثاني من ظهير 16 أبريل 1951م، ومنها: الفحم الحجري، والمعادن من حديد ونحاس وزنك وذهب وغيرها، والمواد الوقودية سائلة كانت أو غازية، الفوسفاط، والأسفلت، وهناك أيضا قيود خاصة بالمواد الهيدروكاربونية، هذه الأخيرة تكون إما طبيعية سائلة أو غازية أو صلبة، وتعتبر ملكية الحقول الهيدروكاربونية حقولا مستقلة عن ملكية صاحب الأرض إذ تعتبر ملكا للدولة، وكذا القيود المتعلقة باستغلال المقالع الصادر بشأنها القانون رقم 81ـ01، نجد المادة الأولى منه تنص على أنه يراد بالمقلع: {مكمن طبيعي لمواد معدنية غير مدرجة في صنف المعادن بمقتضى نظام المناجم الجاري بها العمل}، فاستغلالها أيضا يخضع لنظام خاص يقتضي الحصول على ترخيص، وهناك قيود ناجمة عن المحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية المؤطرة بالقانون رقم 80ـ22، ويستتنى من ذلك الكنز الذي يعثر عليه فإنه يكون ملكا لصاحبه مع إعطاء الخمس منه للدولة، وهذا ما نصت عليه المادة 18 من مدونة الحقوق العينية؛ جاء في المختصر لسيدي خليل: “وفي ندْرته الخمسُ كالركاز وهو دفن جاهلي وإن بشك أو قل أو عرضا أو وجده عبد أو كافر إلا لكبير نَفَقَةٍ أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ فَالزَّكَاةُ”.
ثالثا: قيود تهم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة
نص فقهاء الشريعة الإسلامية على أن التملك القهري خلاف مقتضى الملك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: “لا يزول ملك المالك إلا أن يشاء، ولا يملك رجل شيئا إلا أن يشاء إلا في الميراث، لم أعلم أحدا من المسلمين خالف في ألا يخرج ملك المالك المسلم من يديه إلا بإخراجه إياه هو نفسه ببيع أو هبة أو غير ذلك أو عتق أو دين لزمه فيباع في ماله، وكل هذا فعله لا فعل غيره”، هذا هو الأصل والأساس، بيد أن الضرورة قد تدعو إلى نزع الملكية الفردية من صاحبها في أحوال متعددة، إما مراعاة لمصلحة فردية أولى بالاعتبار من مصلحة الملك، وإما تلبية لمصلحة عامة، والمعتمد عند المالكية أن العقار ينزع من صاحبه بعوض لأجل توسيع طريق المسلمين إذا ضاق عليهم أو توسيع مساجدهم أو مقابرهم، ويباع عليه العقار ولو كان وقفا؛ يقول الشيخ خليل في باب الوقف: “وَبِيعَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ عقار في مثله أو شقصه … لا عقار وإن خرب ونقض ولو بغير خرب إلا لتوسيع كمسجد ولو جبرا، وأمروا بجعل ثمنه لغيره” وأدخلت الكاف في قوله “كمسجد” توسعة طريق المسلمين ومقبرتهم، وأولى إن لم يكن العقار المجبر على بيعه وقفا.
وقد اعتبر القانون نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة من القيود التي تحد من سلطة المالك، فتنزع ملكية هذا الأخير الخاصة مقابل تعويض مناسب يمنح له، وهذا ما نصت عليه المادة 23 من مدونة الحقوق العينية والتي جاء فيها: {لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون ولا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون، ومقابل تعويض مناسب}، ويتم نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة وذلك وفق الإجراءات والشروط المضمنة في قانون 6 ماي 1982م المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
المطلب الثاني: القيود المقررة على حق الملكية حماية للمصلحة الخاصة
يخول حق الملكية للمالك التصرف في منافع ملكه بكل أنواع التصرفات شريطة ألا يترتب عن ذلك ضرر بالجار، أما إذا حصل الضرر بالجار فإنه يرفع (الفرع الأول)، كما أنه يمكن أن ترد بعض القيود التي تكون اتفاقية بين الأطراف (الفرع الثاني).
الفرع الأول: القيود المقررة لرفع مضار الجوار
المقصود بالجوار هنا الملاصقة والقرب في السكن أو العقار، والأصل في حق الملكية أنه يمنح صاحبه حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، ولكن استعمال حقه مقيد بعدم الإضرار بالجار، إذ قد ينتج من استعمال المالك لعقاره ضرر بمن يجاور ذلك العقار، كأن يقيم المالك فوق أرضه معملا يؤذي جيرانه بالدخان ويقلق راحتهم بالضجيج والروائح الكريهة، وكأن يفتح في بنائه نوافذ تطل على جيرانه، وكأن يغرس أشجارا بالقرب من حدود بلاد جاره إلى غير ذلك، والقاعدة المقررة في الفقه الإسلامي أنه يمنع الإضرار بالغير؛ والنصوص الشرعية التي أقرت هذا المبدأ كثيرة من ذلك قول الله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه”، وقد ذهب المالكية إلى وجوب تقييد الجار في تصرفه وانتفاعه بملكه بما لا يضر بجاره ضررا بينا غير معتاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، ولأن الناس لسوء أخلاقهم وضعف دينهم تركوا ما أو جبه الله عليهم خلقا وأدبا من رعاية جانب الجار، فوجب حملهم على ذلك بسلطان القضاء وإلا عمت الفوضى أو الفساد، كما سار القانون المغربي على هذا المنوال، حيث نص من خلال مدونة الحقوق العينية على مجموعة من المقتضيات التي تحد من سلطة المالك على ملكه بهدف رفع الضرر الذي يمكن أن يلحقه هذا المالك بجاره.
والقيود المتعقلة بمضار الجوار كما هي في مدونة الحقوق العينية تتمثل في الحائط أو السياج المشترك (أولا)، والطريق الخاص المشترك (ثانيا) وحق المسيل أو الصرف (ثالثا)، والقيود المتعلقة بغرس الأشجار بالقرب من حدود الجار (رابعا)، وفتح المطلات على أرض الجار (خامسا)، وإقامة منشآت مزعجة أو مضرة بالجيران (سادسا)، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولا: الحائط أو السياج المشترك
نظمت مدونة الحقوق العينية ما يتعلق بالحائط المشترك من أحكام من المواد 28 إلى 31، ويقصد بالحائط المشترك كل حائط يفصل بين الأبنية أو بين الباحات والحدائق وحتى بين الحقوق المسورة سواء في المدن أو في البوادي، فحسب المادة 28 من مدونة الحقوق العينية فإن الحائط الفاصل بين عقارين يعد مشتركا بينهما إلى نهاية خط الاشتراك ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك، ويترتب على الحائط المشترك أحكام منها أنه يحق لكل شريك في الحائط المشترك أن يقيم بجانبه بناء أو يضع فوقه عوارض أو دعائم ولكن بالقدر الذي لشريكه بشرط ألا يحمله فوق طاقته وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها (المادة 29 من م.ح.ع)، ومنها أن إصلاح الحائط المشترك وبناءه يقعان على عاتق جميع ملاك الحائط المشترك كل منهم بنسبة حصته في هذا الحائط (المادة 29)، ومنها أنه يخول للشريك الذي تكون له مصلحة جديدة ومقبولة في تعلية الحائط المشترك أن يقوم بتعليته بشرط أن يتحمل وحده نفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى، وأن يقوم بما يلزم لجعل الحائط يتحمل هذه التعلية على ألا يلحق ذلك ضرر بجاره، أما إذا كان الحائط المشترك لا يتحمل التعلية، فعلى الراغب في التعلية أن يعيد بناء الحائط على نفقته، والأرض اللازمة لزيادة سمكه تؤخذ من جهته (المادة 30).
أما السياج المشترك، وهو الحاجز الذي يقام للفصل بين عقارين متجاورين ويكون عادة إما أشجارا كالصنوبر أو بأغراس معينة كالصبار وإما بأعمدة تصل بينها أسلاك، وتطبق على السياج المشترك أحكام منها أنه يحق للمالك أن يسور ملكه على ألا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور حقوقه، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط، ومنها أنه ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك (المادة 76).
ثانيا: الطريق الخاص المشترك
نظمت مدونة الحقوق العينية ما يتعلق بالطريق الخاص المشترك من المواد 32 إلى 36، ومن الأحكام التي تطبق في هذا السياق أن الطريق الخاص المشترك كالملك هو لمن له حق المرور فيه ولا يجوز لأحد الشركاء أن يحدث فيه شيئا سواء كان مضرا أو غير مضر إلا بإذن باقي الشركاء (المادة 32)، ومنها أنه لا يجوز للشركاء في الطريق المشترك أن يطلبوا قسمته ولا أن يتفقوا على بيعه مستقلا وليس لهم أن يسدوا مدخله ما لم يقع الاستغناء عنه (المادة33)، كما لا يجوز لأحدهم التصرف في حصته في الطريق إلا تبعا لتصرفه في العقار المملوك له، وإذا أغلق أحد الشركاء في الطريق المشترك بابه المفتوح عليه فلا يسقط بذلك حقه في المرور فيه ويجوز له ولخلفه من بعده أن يعيد فتحه من جديد (المادة 34)، ولا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه، ومع ذلك يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة (المادة 35)، ويتحمل الشركاء المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك كل منهم بنسبة حصته فيه، وإذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف (المادة 36).
ثالثا: حق المسيل أو الصرف
حق المسيل هو مجرى على سطح الأرض أو أنابيب تنشأ لتصريف المياه الزائدة عن الحاجة أو غير الصالحة حتى تصل إلى مصرف عام أو مستودع، كمصاريف الأراضي الزراعية أو مياه الأمطار أو الماء المستعمل في المنازل، وحق المسيل حكمه أنه ليس لأحد منعه إلا إذا حدث ضرر بين، وقد نظمت مدونة الحقوق العينية ما يتعلق بحق المسيل أو الصرف من المواد 60 إلى 63 ضمن الارتفاقات، كما تم التنصيص على بعض أحكامه في قانون الماء رقم 10ـ95، ومن أحكامه أن الأراضي المنخفضة تتلقى المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا مانعا لسد هذا السيل، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة (المادة 60 من م.ح.ع)، كما يثبت لكل مالك الحق في استعمال مياه المطر التي تنزل في أرضه والتصرف فيها، وإذا كان استعمال تلك المياه والاتجاه المعطى لها يزيد عبء الارتفاق الطبيعي لسيل المياه فإن لصاحب الأرض المنخفضة الحق في التعويض، وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل (المادة 61)، ومنها أنه يجب على مالك الأرض إذا أراد إحداث أبنية عليها أن يقيم سطوحها وشرفاتها بشكل يسمح بمسيل مياه الأمطار ونحوها على أرضه لا على أرض جاره، ولكل عقار يريد تصريف المياه الزائدة عن حاجته أو غير الصالحة أن يحصل على مصرف لها في عقار غيره نظير تعويض مناسب يدفع مقدما، ويشترط تمرير الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح في مواسير بحيث لا تتسبب في أي ضرر للعقار المرتفق به (المادة 63).
رابعا: القيود المتعلقة بغرس الأشجار بالقرب من حدود الجار
بالرجوع إلى كتب الفقه المالكي فإننا نجد مجموعة من الأحكام المتعلقة بهذه النقطة، ففي كتاب الإعلان بأحكام البنيان نجد ابن الرامي رحمه الله ينص على مجموعة من الأحكام المتعلقة بغرس الأشجار قرب حدود الجار، ومن ذلك الشجرة تكون للرجل في أرضه فتندفع عروقها في أرض جاره ويصير منها غراسات فصاحب الشجرة مخير في ذلك: إن كان له فيه منفعة إن قلعه أن يغرسه في مكان آخر فذلك له، وإن كان ليس له فيه منفعة ولا عليه فيه مضرة فهو لرب الأرض، إلا أن يكون قد قلع فيكون له ثمن خشبه وحطبه، فإنه إذا كان كذلك له على صاحب الأرض ثمنه مقلوعا، ومن ذلك إذا كانت شجرة لرجل تضر بجدار جاره فلا يخلو: إما أن تكون الشجرة قديمة قبل بناء الجدار أو محدثة بعده، فإن كانت محدثة والجدار قديم فإنه يقطع منها كل ما أضر بالجدار من قليل أو كثير وكذلك عروقها، وإن كانت الشجرة قديمة وبني الجدار بعدها فإنه اختلف في ذلك على قولين: قيل تترك على حال ما هي عليه من انبساطها وانتشارها، وإنما بني الجدار بعدها فليست تقطع عنه، إلا أن تكون حدثت لها أغصان بعد الجدار أضرت بالجدار وهو لمطرف، وقيل تترك وإن أضر ذلك بالجدار؛ لأنه قد علم هذا من شأن الشجرة أن هذا يكون منها، لأنه قد حاز ذلك من حريمها وهوائها قبل أن يبني هذا جداره وهو لابن الماجشون، وعبر عن ذلك سيدي خليل بقوله: “وَقُضي عَلَى شَرِيكٍ بقطع ما أضر مِنْ شَجَرَةٍ بِجِدَارٍ إنْ تَجَدَّدَتْ وَإِلَّا فَقَوْلَانِ”، ومنها أيضا إذا كانت الشجرة في أرض المالك وعظمت فروعها فيكون عظمها ارتفاعا صاعدا في الهواء، أو تخرج فروعها على أرض جاره: فإن كان عظمها ارتفاعا صاعدا في الهواء فأظلت بأرض جاره أو داره فإنها لا تقطع عنه لأنها كالبنيان يبنيه الرجل في أرضه وداره ويمنع به عن جاره الشمس والريح فلا كلام لجاره في ذلك، وكذلك الشجر ما لم تمل عن هواء صاحبها إلى هواء جاره وينبسط فيكون له أن يقطع ما مال منها عليه وانبسط؛ ففي المختصر مما لا يقضى به على الشريك ما نصه: “لا مانع ضوء، وشمس، وريح، إلا لأندر، وَعُلُوِّ بِنَاءٍ”، والمعنى أن من رفع بناءه على بناء جاره حتى منع هذه الثلاثة أو واحدا منها فإنه لا يمنع من ذلك إلا أن يكون منع الشمس والريح عن أندر فإنه يمنع من ذلك لاحتياج الأندر لما ذكر، وكذلك من رفع بنيانه فجاوز به بنيان جاره ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنائه، ومُنع من الضرر.
وقد نظمت مدونة الحقوق العينية القيود المتعلقة بغرس الأشجار بقرب حدود أرض الجار من المواد 72 إلى 74، ومن ذلك أنه يجب على المالك في غرسه لأشجار أو شجيرات أو أغراس على حدود أرضه أن يراعي المسافة المقررة في الأنظمة، بمعنى أنه يجب أن تبتعد هذه الأشجار والأغراس عن أرض الجار حسب المسافة التي تقررها الأنظمة، وفي حالة عدم وجود أنظمة فيجب أن تبتعد الأشجار عن الخط الفاصل لأرض المالك عن أرض جاره مسافة لا تقل عن مترين إذا كانت مما يفوق ارتفاعها مترين، ومسافة نصف متر إذا كانت مما دون ذلك، وعلى المالك أن يحترم هذه المسافات سواء عند القيام بالغرس لأول مرة أو عند إرادة تعويض ما مات أو قطع أو قلع منها (المادة 72 من م.ح.ع)، ومنها أنه يجب أن لا تتجاوز أغصان الأشجار المغروسة بالقرب من أرض الجار على علو أرض هذا الجار كما يجب أن لا تمتد جذور الأشجار داخل الأرض المذكورة وإلا فإن من حق الجار المطالبة بقطع الأغصان المتجاوزة أو المبادرة إلى قطع الجذور الممتدة داخل أرضه بنفسه إذا خشي أن يصيبه ضرر من ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن الثمار التي تسقط بصورة طبيعية من الأغصان المتجاوزة على أرض الجار تكون من حق هذا الجار، كما أنه إذا امتدت أغصان الأشجار أو جذورها على الطرق وجنباتها، فإنه يحق لكل من له مصلحة المطالبة بقلعها (المادة 74)، ومما ينبغي التنبيه إليه أنه يمكن أن تغرس الأشجار أو الشجيرات والأغراس على جهتي الحائط الفاصل بين عقارين دون أن يكون من اللازم مراعاة أي مسافة غير أنه لا يجوز أن تعلو قمة الحائط (المادة 72).
خامسا: فتح المطلات على أرض الجار
ذهب فقهاء المالكية إلى وجوب تقييد الجار في تصرفه وانتفاعه بملكه بما لا يضر جاره ضررا بينا غير معتاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”، ولذلك منع فقهاء المالكية المالك من فتح مطلات أو نوافذ تشرف على الجار، ولو كان في فتحها منفعة له كجلب الهواء أو الضوء إلى عقاره، وفي حالة إحداثها فإنه يلزم بإغلاقها وطمس معالمها وإزالة آثارها؛ جاء في المدونة عن الإمام سحنون قوله: “قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا بنى قصرا إلى جنب داري ورفعها علي وفتح فيه أبوابا وكوى يشرف منها على عيالي أو على داري، أيكون لي أن أمنعه من ذلك في قول مالك؟ قال: نعم، يمنع من ذلك وكذلك بلغني عن مالك، والكوى على قسمين: قديم ومحدث، ففي الكوة القديمة قولان، المشهور منهما: بقاؤها على حالها، وفي المحدثة قولان المشهور منهما السد، وهو ما اعتمده الشيخ خليل ونص عليه بقوله: “وَقُضي عَلَى شَرِيكٍ بِسَدِّ كُوَّةٍ فُتِحَتْ أُرِيدَ سَدٌّ خَلْفَهَا”.
أما القانون المغربي فإننا نجده نظم القيود المتعلقة بفتح المطلات على الأرض المجاورة في المواد 66 و67 و68، في محاولة من خلال هذه المواد التوفيق بين مصلحة المالك الراغب في فتح المطلات من جهته ومصلحة الجار حتى لا يتضرر من إحداثها من جهة أخرى، وفي بيان أحكام المطلات فإنه يجب التمييز بين فرضيتين: فرضية الحائط المشترك والحائط غير المشترك، ففي الحالة الأولى لا يحق للجار أن يحدث في الجدار المشترك أي نافذة أو فتحة بأي كيفية كانت إلا إذا وافق جاره على ذلك، أما إذا رفض هذا الأخير فلا سبيل لفتح المطل أبدا، فالمادة 66 من مدونة الحقوق العينية تقضي بأنه: {لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور}، وأما في الحالة الثانية فقد ميزت المادة 68 بين المطلات المقابلة وبين المطلات المنحرفة: فبالنسبة للمطلات المقابلة أو المماثلة وهي التي تطل على عقار الجار مباشرة، فلا يمكن فتحها على أرض الجار ما لم يكن الحائط الذي يكون فيه وبين تلك الأرض مسافة مترين، أما المطلات المنحرفة فيقصد بها المطلات التي لا تسمح بالنظر إلى عقار الجار إلا إذا انحنى المُطل أو التفت يمينا أو يسارا وهذه المطلات لا يمكن فتحها إلا على بعد متر تفصل الحائط المفتوح فيه المطل والأرض المجاورة.
سادسا: إقامة منشآت مزعجة أو مضرة بالجيران
ورد في الفصل 136 من ظهير19 رجب 1333هـ الملغى بعض الأمثلة عن المنشآت المزعجة أو المضرة بالجيران، كحفر بئر أو مرحاض قرب جدار مشترك أو غير مشترك أو بناء مدخنة أو محل للحدادة أو فرن أو مطبخ أو حظيرة للماشية أو مخزن للملح أو أكداس من المواد الأكالة، ونص على أنه يجب أن يبتعد عن الجدار بالمقدار المقرر بالضوابط والأعراف الخاصة بهذه الأشياء أو أن يقيم المنشآت المقررة بنفس الضوابط والأعراف تفاديا للإضرار بالجيران، والأصل في المذهب المالكي عدم الضرر والقضاء برفع ما من شأنه الضرر؛ وذكر العلامة سيدي خليل في هذا المقام مما يمنع الشريك منه ما لفظه: “وَقُضيَ عَلَى شَرِيكٍ بمنع دُخان كحمامٍ، ورائحةٍ كدباغٍ، وأندرٍ قبل بيتٍ، وَمُضِرٍّ بِجِدَارٍ، وَإِصْطَبْلٍ أَوْ حَانُوتٍ قُبَالَةَ بَابٍ”.
والقاعدة المقررة في مدونة الحقوق العينية أنه لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا، والضرر البليغ يزال (المادة 21)، وعلى هذا الأساس يحق للجيران إذا كانت مثل هذه المنشآت تلحق بهم ضررا تفوق الحد المألوف رغم التقيد بالمسافة القانونية أن يطالبوا قضائيا إما بإزالة هذه المنشآت أو إدخال ما يلزم لتغييرها للقضاء على الأضرار التي يتظلمون منها وذلك عملا بالفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود.
الفرع الثاني: القيود الاتفاقية
يصطلح رجال القانون غالبا على هذه القيود بالقيود الاتفاقية، أما الباحثون في الشريعة الإسلامية فيطلقون عليه القيود الإرادية، وبالرجوع إلى فقهاء الشريعة الإسلامية فيطلقون عليها الشروط المصاحبة للعقد، ويقصد بالقيود الاتفاقية أن يتفق المتعاقدون على ما يقيد حق المالك ويمنعه من التصرف في عقاره على نحو معين، فهل مثل هذا الشرط صحيح وهل يجوز تقييد حرية المالك في التصرف في عقاره عن طريق التعاقد؟ ثم هل يتعين على المالك أن يتقيد بهذا القيد أو يمكنه أن يتحلل منه؟
ونذكر في هذا الفرع القيود الاتفاقية في الفقه المالكي (أولا) ثم القيود الاتفاقية في القانون المغربي (ثانيا).
أولا: القيود الاتفاقية في الفقه المالكي
يرى فقهاء المالكية أن الإرادة هي التي تنشئ العقود وتبرم التصرفات، فكل عقد أو تصرف لا يتم إلا برضا المتعاقدين أو المتصرف وهذه الإرادة لا دخل لها في إنتاج العقد لآثاره، لأن الشارع هو الذي يحدد تلك الآثار ويعين الأحكام التي تترتب على كل عقد وهذا يعني أن الفقهاء يعتبرون أن العقود جعلية، لأن الشارع هو الذي حدد الآثار التي تترتب على كل عقد من العقود، وبذلك يتم التوافق بين المصالح المتعارضة، ولا يتمكن أي شخص من أن يملي ما يشاء من الشروط على من يتعاقد معه ليحقق مصلحته على حساب غيره، لأن ذلك يورث الضغائن والأحقاد، ويؤدي إلى الغبن والغرر، والعقود الناقلة للملكية قد تقع خالية من أي شروط عقدية تقيد آثار العقد وأحكامه فيكون للمالك الجديد مطلق التصرف في ملكه في الحدود التي قررتها الشريعة الإسلامية، وقد تقع تلك العقود مقترنة بشروط يكون بها تقييد للملكية، سواء أكان التقييد بفرض حق معين على الملكية، أم بتقييد حرية المالك في التصرف فيها، وسواء أكان هذا التقييد لمصلحة المتعاقد الذي انتقلت منه الملكية، أم لمصلحة طرف ثالث.
وقد تناول فقهاؤنا بيان حكم هذه الشروط العقدية وما يجوز اشتراطه منها وما لا يجوز، وما يبطل العقد منها وما لا يبطل، وأهم الشروط التي تعرض لها الفقهاء بهذا الصدد هي:
1– اشتراط منفعة محددة من المعقود عليه لمصلحة البائع أو طرف ثالث، وهي متعلقة بعقود المعاوضات، ويدخل فيه اشتراط البائع على المشتري في بيع الدار أن يسكنها البائع أو غيره شهرا، وفي بيع الأرض أن يزرعها سنة، وفي بيع الدابة أن يركبها أياما وفي بيع الثوب أن يلبسه أسبوعا، ومثل هذه الشروط صحيحة سواء أكان الاشتراط لمصلحة البائع أو لشخص ثالث لعموم الآيات والآحاديث التي تأمر بالوفاء بالعقود والعهود مثل قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما”، ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: “أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي، وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه فقلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي”، وفي لفظ: “وشرط ظهره إلى المدينة”، وفيه أيضا: “فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في إثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك”، وهذا نص في صحة اشتراط بعض منافع المبيع إذا كانت معلومة.
هذا وقد ذهب القانون المغربي إلى جواز الاشتراط لمصلحة المتعاقد أو لمصلحة غيره أيا كان نوع هذا الشرط مادام ليس ممنوعا، والقاعدة في ذلك أن العقد شريعة المتعاقدين.
2- اشتراط منع التصرف، سواء أكان التصرف يسيرا أم كثيرا في عقود المعاوضات، ميز الفقهاء في الشروط التي تمنع التصرف في الملكية المنتقلة بين نوعين منها: الأول: الشروط التي تمنع التصرف اليسير في محل العقد، وذلك كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع من فلان، أو من نفر قليل، أو اشتراط البائع إحدى داريه على المشتري ألا يرفع الحائط الفاصل بينهما، مخافة أن يظلم داره، أو يمنع عنها دخول الشمس، أو اشتراط البائع على المشتري ألا يبيع ولا يهب حتى يسدد الثمن إذا كان الثمن مؤجلا. الثاني: الشروط التي تمنع التصرف مطلقا، أو تمنع التصرف غير اليسير، كما لو شرط على المشتري ألا يتصرف في المبيع، أو لا يخرجه من ملكه أولا ينتفع به، فقالوا بجواز اشتراط منع التصرف اليسير لخفته واليسارة مغتفرة في العقود، وعدم جواز اشتراط منع التصرف غير اليسير؛ لأن العقد يقتضي التصرف المطلق في محل العقد، واشتراط المنع من التصرف ينافي موجب العقد ومقتضاه، وتصرف المالك في ملكه ثبت بالشرع، فهذه الشروط تفضي إلى تحريم الحلال.
3- اشتراط معنى من معاني البر على المشتري في عقود المعاوضات، ويدخل في ذلك اشتراط البائع على المشتري أن يجعل الأرض مسجدا للمسلمين، أو مقبرة لهم، أو في الطعام أن يتصدق به، فقد نص فقهاء المالكية على صحتها لأن المشروط من أعمال الخير المستحبة يحث الشارع عليها ويتشوف إليها، وعقد البيع قابل لها، فلذلك إذا اشترطت صحت، ووجب الوفاء بها لعموم النصوص التي تدعو إلى الوفاء بالعقود والشروط.
4- الشروط المقيدة للملكية في عقود التبرع، ويدخل فيها: اشتراط الواهب على الموهوب له أن يتصدق بالعين الموهوبة أو ببعضها، أو يشترط عليه ألا يبيعها أو لا يهبها، واشتراط المتصدق على المتصدق عليه ألا يبيع العين المتصدق بها أو لا يهبها، وما أشبه ذلك، فمذهب المالكية عدم صحة مثل هذه الشروط ، لما فيه من التحجير والمنع من التصرف الثابت شرعا.
ثانيا: القيود الاتفاقية في القانون المغربي
إن القيود الاتفاقية كما سبق القول هي قيود تقيد حرية المالك في التصرف في ملكه كما يشاء، وقبل صدور مدونة الحقوق العينية لم يكن يتعرض القانون المغربي صراحة بخصوص الشرط المانع من التصرف لا في ظهير 19 رجب 1333هـ الملغى ولا في ظهير قانون الالتزامات والعقود، غير أنه يصح الاستناد إلى الفصل 492 من ق.ل.ع للقول بأن المقنن المغربي أقر مبدأ صحة هذه القيود، فقد ورد فيه: {بمجرد تمام البيع، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء، وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه، ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين}، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار عقد البيع المتضمن قيدا يمنع المشتري من التصرف في المبيع قبل انقضاء زمن معين، عقدا صحيحا والقيد معتبرا، كما أنه توجد بعض النصوص القانونية الأخرى والتي يستشف منها أن المقنن المغربي يقر بهذه القيود إذا كان فيها مصلحة لأحد الأطراف أو الغير، ومن هذه النصوص نجد الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 07 ـ 14 والذي ينص على أنه: {يجب على كل شخص يطلب تقييدا أو بيانا أو تقييدا احتياطيا بالرسم العقاري أن يقدم للمحافظ على الأملاك العقارية طلبا، ويجب أن يتضمن هذا الطلب بيان ما يطلب في تقييد الحق الأصلي، من أسباب الفسخ أو قيد على حق التصرف أو أي تقييد آخر خاص …}، كما أن المادة 285 من مدونة الأسرة تنص على مثل هذه الشروط الاتفاقية إذ جاء فيها ما نصه: {يصح تعليق الوصية بشرط وتقييدها به إن كان الشرط صحيحا، والشرط الصحيح ما كان فيه مصلحة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولم يكن مخالفا للمقاصد الشرعية}.
فهذان النصان يدلان على أن المقنن المغربي لا يرى مانعا من اتفاق الأطراف على ما يقيد حق المالك في التصرف في العقار الذي آل إليه، لكن وبصدور مدونة الحقوق العينية الجديدة فإننا نجدها تطرقت إلى هذه المسألة بشكل واضح وصريح، وأخذت بما ذهبت إليه القوانين الأخرى من اعتبار الشرط المانع من التصرف وبذلك تكون قد وضعت حدا لهذا الغموض التشريعي حول صحة القيود الاتفاقية، وهو ما نصت عليه في مادتها 14 والتي جاء فيها: {يخول حق الملكية لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق}، وأكدته مقتضيات المادة 15 وفيها: {ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها إلا إذا نص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك}.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الشرط المانع من التصرف يرد على خلاف الأصل الذي مقتضاه أن للمالك كامل الحرية في التصرف في ملكه، حيث تعتبر سلطة التصرف من أهم السلطات التي يخولها حق الملكية للمالك، فضلا عن أن الأخذ بمبدأ الشرط على إطلاقه يضر بالنشاط الاقتصادي، كما أن مبدأ حرية التصرف في الأموال من أهم المبادئ الاقتصادية التي تساعد على انتشار الائتمان وحرية تبادل الأموال وانتقالها من يد إلى يد.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
خاتمة بأهم الخلاصات والنتائج:
لقد انصبت المعالجة لموضوع هذه الدراسة على القضايا الأساسية الخاصة بالملكية في الفقه المالكي مع المقارنة بما هو مقرر في القانون المغربي، في محاولة لإبراز أهم المبادئ والأصول والقواعد التي تحكم الملكية، وبعد هذه الرحلة في كتب الفقه المالكي وبعض الكتب المتخصصة والقوانين ذات الصلة كمدونة الحقوق العينية فإننا نجد مجموعة من الاستنتاجات القيمة التي يمكن تسجليها بخصوص موضوع حق الملكية والقيود الواردة عليه، نشير إلى أهمها كالآتي:
1)- إن مفهوم الملك عند الفقهاء هو حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك، أو هو استحقاق التصرف في الشيء بكل أمر جائز فعلا أو حكما لا بنيابة.
2)– والملك في القانون المغربي حق عيني أصلي يخول لمالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق.
3)– يتأسس حق الملكية على ثلاثة عناصر وهي: حق الاستعمال والاستغلال والتصرف.
4)– تتمحور خصائص حق الملكية في كونه: حقا جامعا كما أنه حق مانع إضافة إلى أنه حق دائم.
5)- نطاق حق الملكية يشمل علو الشيء وعمقه وما يتفرع عنه، فبالنسبة لعلو الشيء فالقاعدة عند الفقهاء أن من ملك أرضا ملك هواءها إلى ما لانهاية، هذا هو الأصل العام عندهم لكن يملك بقدر الحاجة، ومن حيث العمق فالراجح في المذهب المالكي أنها تملك إلى الحد المفيد في التمتع، وتقضي مدونة الحقوق العينية بأن ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على ما يخالف ذلك، ويمتد نطاق حق الملكية لشيء ما إلى ما يتفرع عنه وينتج منه، فمالك العقار يملك كل ملحقاته وما يدره من ثمار أو منتجات، وما يضم إليه أو يدمج فيه بالالتصاق.
6)- أما حماية حق الملكية فإن الإسلام أقر للملكية ما تتطلبه من حماية وصيانة فشرع الله عز وجل أحكاما للحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من العدوان عليها، والنصوص الدالة على هذا أكثر من أن تحصى، وقد أقر القانون المغربي هذه الحماية من خلال ما جاءت به مدونة الحقوق العينية من مقتضيات، خاصة إذا استحضرنا أنها أتت في غايتها الأساسية لحفظ الملكية العقارية بصفة خاصة والملكية بصفة عامة.
7)- أما ما يتعلق بالقيود الواردة على حق الملكية فإن فقهاءنا قيدوا حق الملكية بقيود يجب أن يقف عندها المالك، وحدوا له حدودا يتعين عليه أن لا يتجاوزها، ليؤدي حق الملكية غايته ويحقق ما هدف إليه الإسلام منه، كما عمل القانون المغربي على ذلك اعتبارا منه أن الملكية مؤسسة حقوقية يراد منها أن تؤدي وظيفة اجتماعية.
8)- القيود التي ترد على حق الملكية متنوعة ومتعددة، وترجع في جملتها إلى قيود لحماية المصلحة الخاصة، وأخرى لحماية المصلحة العامة.
9)- لقد كانت الشريعة الإسلامية سباقة إلى الأخذ بنظرية عدم التعسف في استعمال الحق فالمالك يمنع منعا باتا من التعسف في استعمال حقه في التملك إذا استعمله استعمالا يضر بغيره، وأخذ بها القانون المغربي من خلال مجموعة من النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود ومدونة الحقوق العينية.
10)- إن الشريعة الإسلامية كما أعطت للمالك التصرف في ملكه بجميع التصرفات، ضمنت كذلك للجيران عدم الإضرار بهم من طرف المالك، والنصوص الشرعية التي أقرت الشريعة الإسلامية من خلالها هذا المبدأ كثيرة، وسار القانون المغربي على هذا المنوال، حيث نص على مجموعة من المقتضيات التي تحد من سلطة المالك على ملكه بهدف رفع الضرر الذي يمكن أن يلحقه هذا المالك بجاره.
11)- القيود التي ترد على حق الملكية في سبيل تحقيق النفع العام كثيرة ومتنوعة، وهي قيود تحد إما من سلطة المالك على علو أرضه أو في عمق أرضه، أو قيود تهم نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة، أو قيود خاصة تتعلق بالأفراد يقصد منها رفع مضار الجوار.
12)- يوجد نوع آخر من القيود تتمثل في القيود الاتفاقية أو الإرادية أو المسماة فقها بالشروط المصاحبة للعقد، وقد بين الفقه ما يجوز منها وما لا يجوز سواء في عقود المعاوضات أو التبرعات. والحمد لله رب العالمين.
الإعلان بأحكام البنيان لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي بن الرامي البناء (734هـ)، تحقيق فريد بن سليمان، مركز النشر الجامعي ـ تونس، طبعة 1999م.
الأم لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ)، دار المعرفة ـ بيروت، بدون طبعة، 1410هـ1990م.
أنوار البروق في أنواء الفروق المعروف بالفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان المالكي الشهير بالقرافي (ت684هـ)، وبهامشه إدرار الشروق على أنوار الفروق المعروف بحاشية ابن الشاط (ت723هـ) على الفروق، بدون طبعة وتاريخ الطبع، عالم الكتب ـ مراكش.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد الأندلسي، ابن رشد الحفيد (ت595هـ)، دار الحديث ـ القاهرة ، بدون طبعة، 1425هـ/2004م.
- البهجة في شرح تحفة الحكام لعلي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التسولي (ت1258هـ) تحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ/1998م.
تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر الجوهري الفارابي (ت393هـ)، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة الرابعة 1407هـ/1987م.
التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية في ضوء التشريع المغربي للأستاذ مأمون الكزبري، شركة الهلال العربية للطباعة والنشر ـ القاهرة، الطبعة الثانية 1987م.
الجامع الصحيح للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ)، تحقيق: محمد زهير ناصر الناصر، دار طوق النجاة ـ بيروت، الطبعة الأولى 1422هـ.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت1230هـ)، دار الفكر ـ بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
الحقوق العينية الأصلية أحكامها مصادرها للأستاذ إبراهيم سعد، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية، طبعة 2008م.
الحقوق العينية في الفقه الإسلامي لمحمد ابن معجوز المزغراني (ت1438)، مطبعة النجاح ـ الدار البيضاء، الطبعة الثانية 1419هـ/1999م.
الحقوق العينية وفق القانون 39.08 للدكتور إدريس الفاخوري، منشور مجلة الحقوق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الإصدار الثاني عشر، دار نشر المعرفة ـ الرباط، طبعة 2013م.
- الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت684هـ)، تحقيق: محمد بو خبزة، محمد حجي، وسعيد أعراب، دار الغرب الإسلامي – بيروت، الطبعة الأولى سنة 1994م.
سنن الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (ت275هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
سنن الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، (ت273هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي.
سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، (ت279هـ)، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي ـ بيروت، سنة 1998م.
سنن الإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني (ت385هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الأولى 1424هـ/2004م.
السنن الكبرى للإمام أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت458هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الثالثة 1424هـ/2003م.
صحيح الإمام أبي الحسن القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج (ت261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.
ظهير 9 شعبان 1332هـ الموافق لفاتح يوليوز 1914م بشأن الأملاك العمومية.
ظهير شريف رقم 118.1.91 صادر في 27 رمضان 1412هـ الموافق لفاتح أبريل 1992 بتنفيذ القانون رقم 90ـ21 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربونات واستغلالها.
ظهير شريف رقم 130. 01. 02 صادر في تاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 هـ الموافق لـ 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 81 ـ 01 المتعلق باستغلال المقالع، الجريدة الرسمية بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1423هـ 19 أغسطس 2002م.
ظهير شريف رقم 154. 95 .1 صادر في 18 ربيع الأول 1416 هـ الموافق ل 16 أغسطس 1995م بتنفيذ القانون رقم 95 . 10 المتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 30 شتنبر 1995م.
ظهير شريف رقم 254. 81 .1 صادر في 11 رجب 1402 هـ الموافق لـ 6 ماي 1982 بتنفيذ القانون رقم 81ـ7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 5/6/1983م.
ظهير شريف صادر في رمضان 1331هـ الموافق 12 غشت 1913م بشأن التحفيظ العقاري، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07 ـ 14.
- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة بن مصطفى الزحيلي (ت1436هـ)، دار الفكر ـ دمشق، الطبعة الرابعة.
القانون رقم 80 ـ 22 والذي صدر بمقتضى الظهير الشريف رقم 341. 80. 1 بتاريخ 17 صفر 1401هـ الموافق 25 دجنبر 1980 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3564 بتاريخ 18 يناير 1981م.
القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الغرناطي (ت741هـ)، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى سنة 2013م.
قيود الملكية الخاصة للأستاذ عبد الله بن عبد العزيز المصلح، دار المؤيد للطباعة والنشر ـ الرياض، بدون طبعة وتاريخ الطبع.
لسان العرب لجمال الدين بن منظور الأنصاري (ت711هـ)، دار صادر ـ بيروت، الطبعة الثالثة 1414هـ.
محاضرات في القانون العقاري للأستاذ إدريس الحياني، المطبعة: SO-ME PRINT Agadire، طبعة 2022م.
مختصر العلامة خليل بن إسحاق الجندي المصري المالكي (ت776هـ)، تحقيق: محفوظ بوكراع وعبد الحق بوربيعة، دار المعراج ـ دمشق، الطبعة الأولى 1442هـ/2020م.
المختصر في شرح مدونة الحقوق العينية الجديدة على ضوء التشريع والفقه والقضاء لمحمادي المعكشاوي، دار السلام ـ الرباط، سنة 2012م.
المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون عن الإمام ابن القاسم، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 1415هـ/1994م.
الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية للأستاذ عبد السلام داود العبادي، مؤسسة الرسالة دار البشير، الطبعة الأولى 1421هـ/2000م.
الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتها بالقوانين العربية للأستاذ علي محمد الخفيف (ت1398هـ)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ بيروت، 1990م.
الملكية وأسباب كسبها في القانون المدني لأنور العمروسي، دار محمود للنشر والتوزيع ـ القاهرة، تاريخ النشر 2005م.
الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية لأحمد فراج حسين، دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الإسكندرية، السنة 2005م.
المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي (ت474هـ)، مطبعة السعادة ـ مصر، الطبعة الأولى 1332هـ.
منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (ت1299هـ)، دار الفكر ـ بيروت، بدون طبعة، السنة 1409هـ/1989م.
الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي (ت790هـ)، دار ابن عفان ـ القاهرة، الطبعة الأولى 1417هـ/1997م.
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، لشمس الدين محمد بن محمد المعروف بالحطاب (ت954هـ)، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الثالثة 1412هـ/1992م.
موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي المدني (ت179هـ)، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت، 1406هـ/1985م.
الموطأ لعبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي (ت197هـ)، دار الغرب ـ بيروت، الطبعة الأولى، د.ت.
نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي لفتحي الدريني، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، 1977م.
الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية المعروف بشرح حدود ابن عرفة (ت803هـ) لأبي عبد الله محمد بن القاسم الأنصاري المعروف بالرصاع (ت894هـ)، المكتبة العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى 1350هـ.
الوجيز في الملكية العقارية والضمانات العينية لعبد الخالق أحمدون، طبع طوب بريس ـ الرباط، طبعة 2007م.
الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري (ت1971م)، دار النهضة العربية ـ القاهرة، 1967م.







تعليق واحد