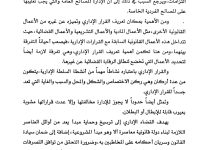منظومة القيم بين الثابت والمتغير في أحكام قانون الأسرة والقانون الجنائي الدكتور : محمد نعناني،
[]
منظومة القيم بين الثابت والمتغير في أحكام قانون الأسرة والقانون الجنائي
The values system between the constant and the variable in family law and criminal law
الدكتور : محمد نعناني،
أستاذ محاضر مؤهل، جامعة الحسن أول، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

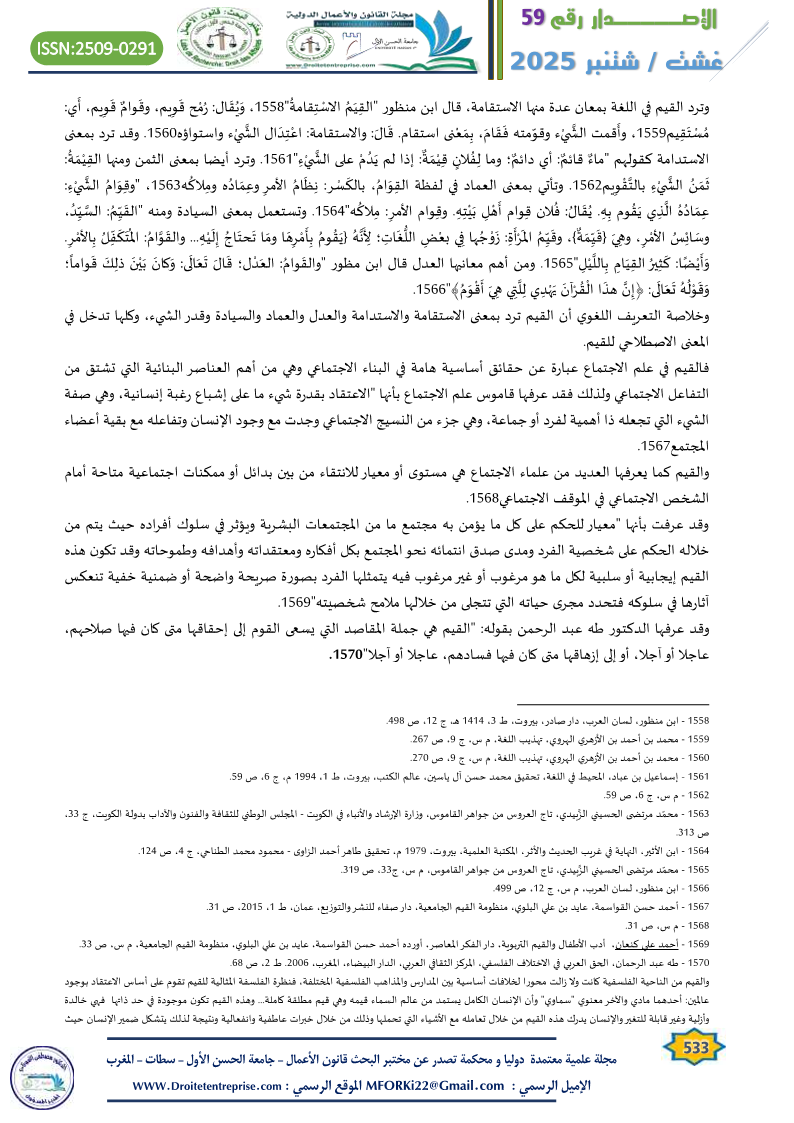
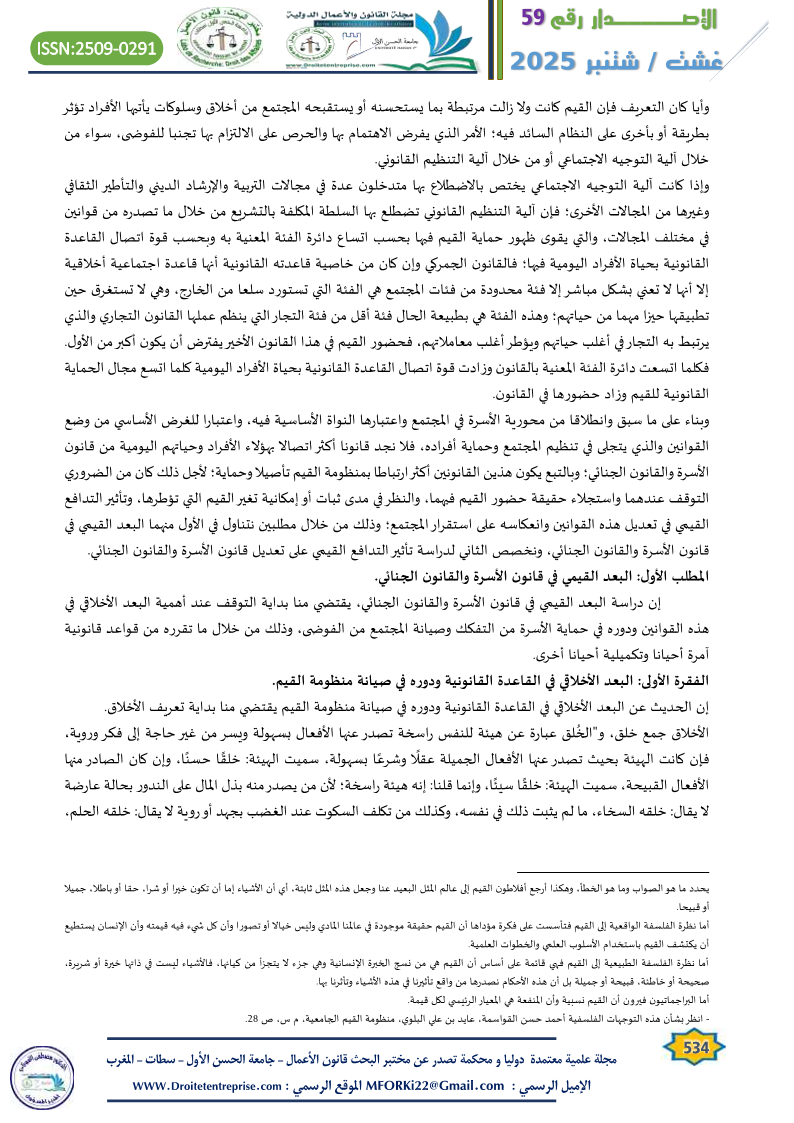
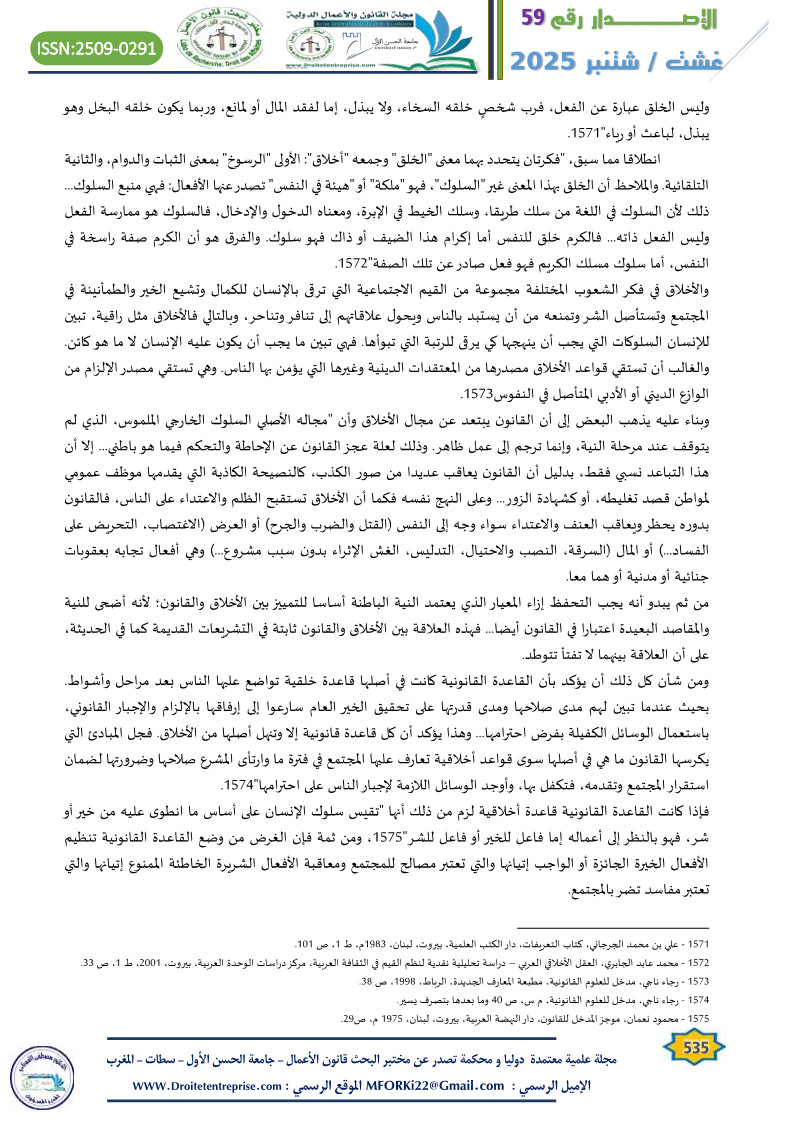
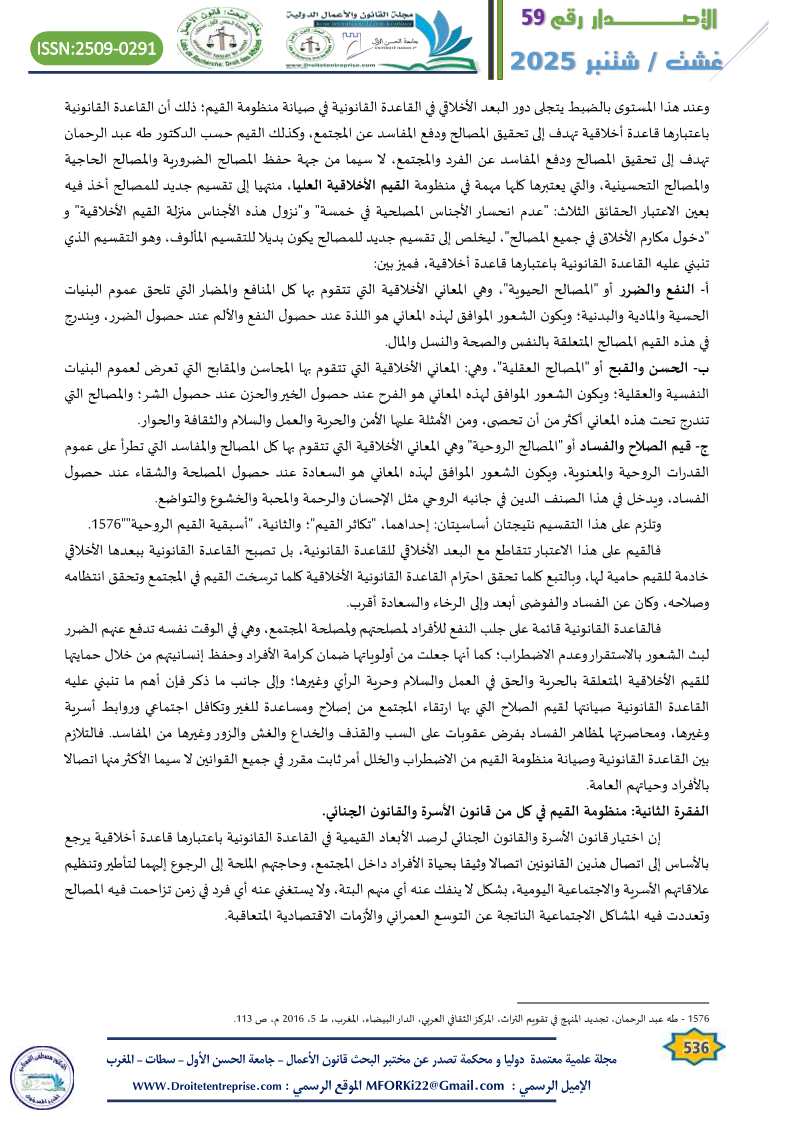
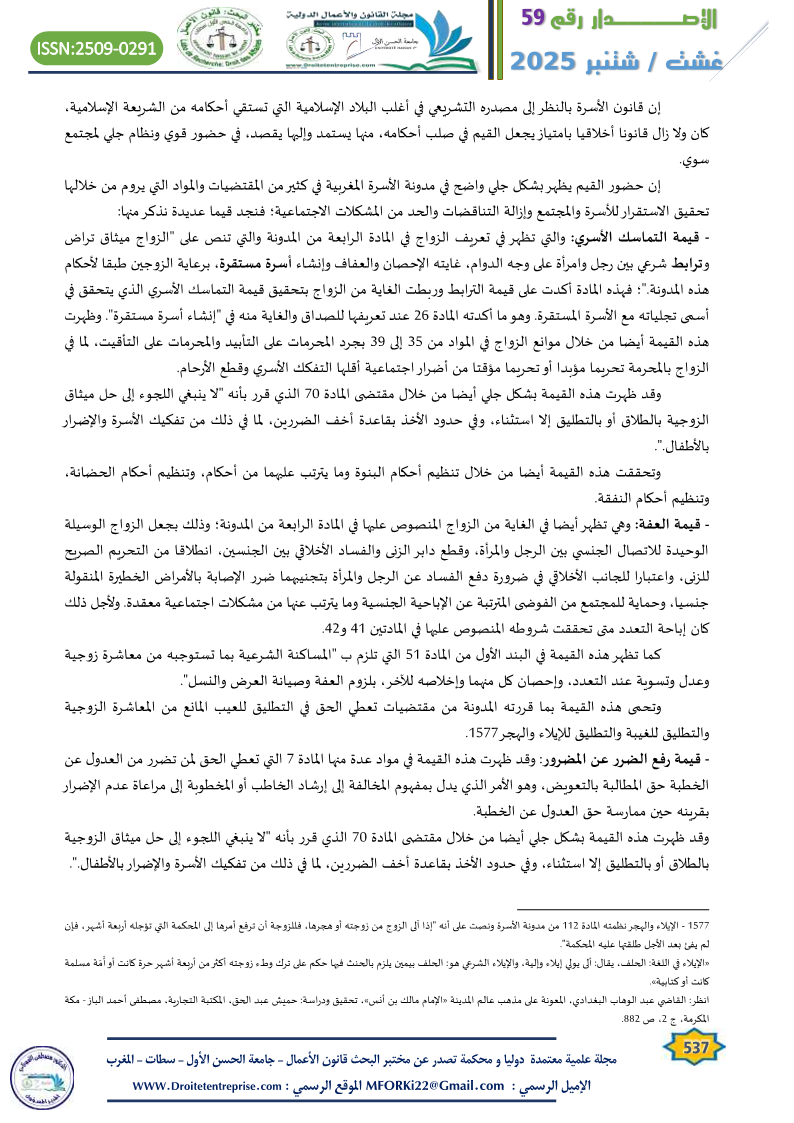
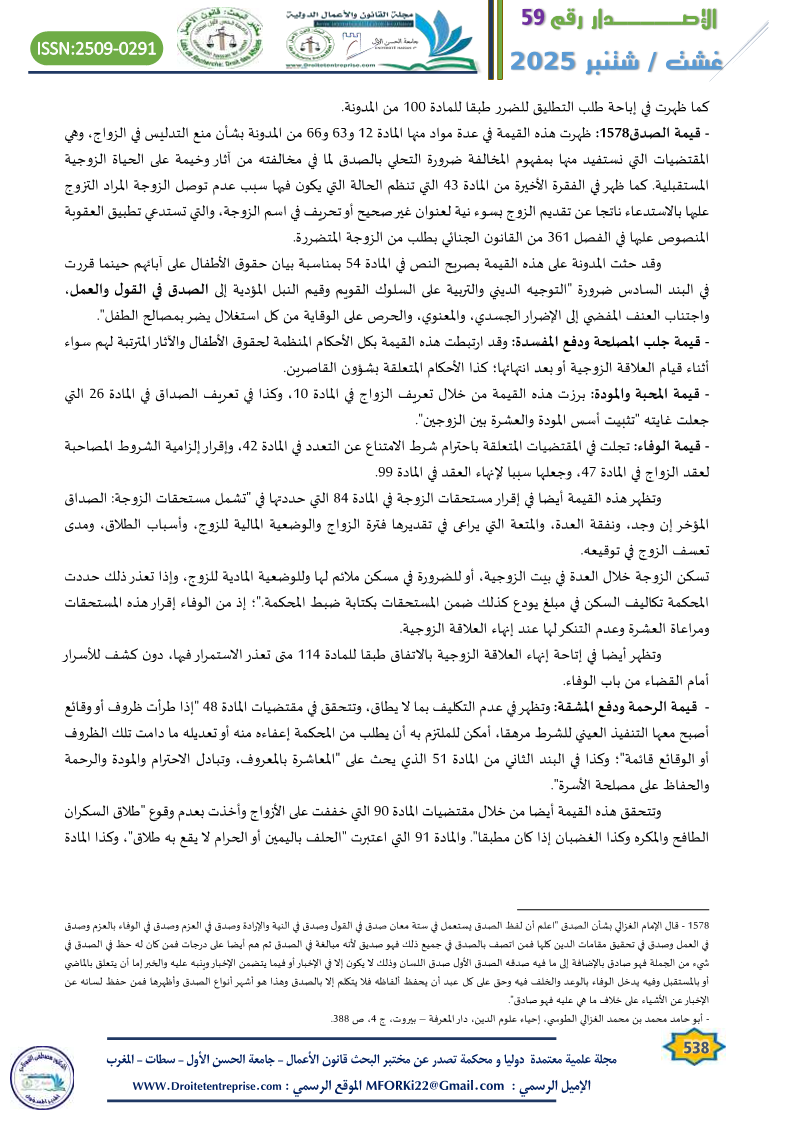
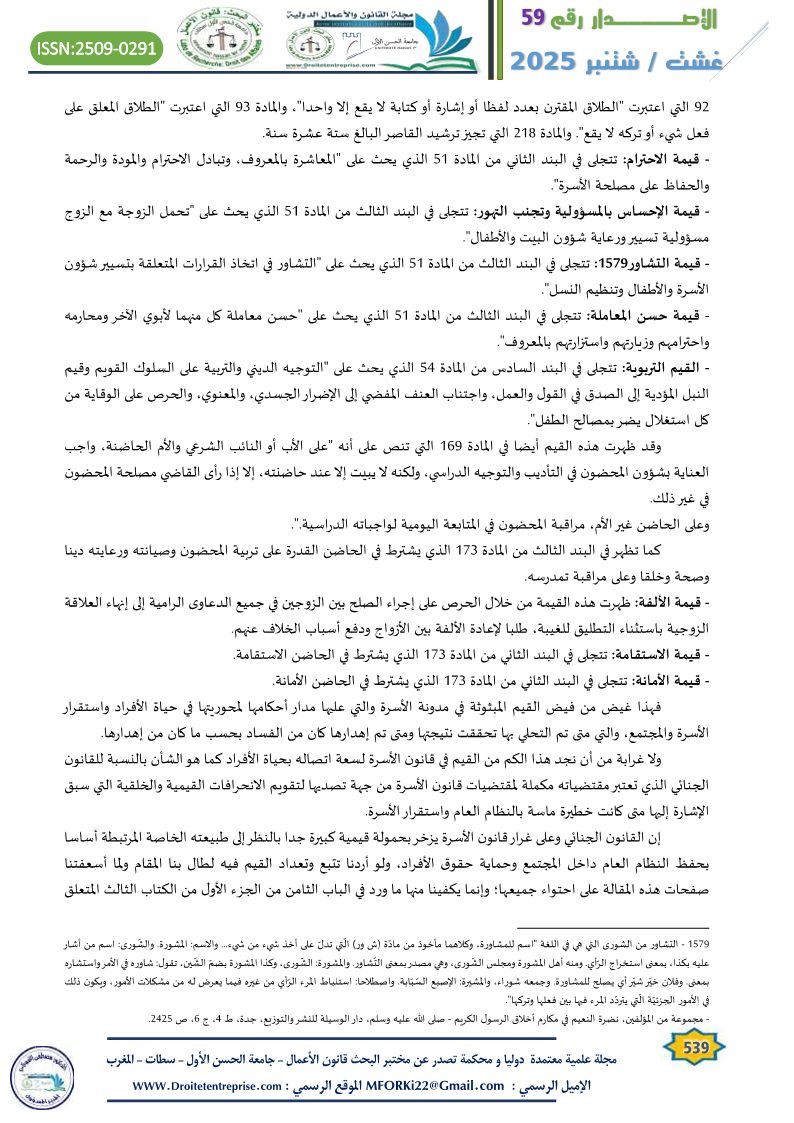
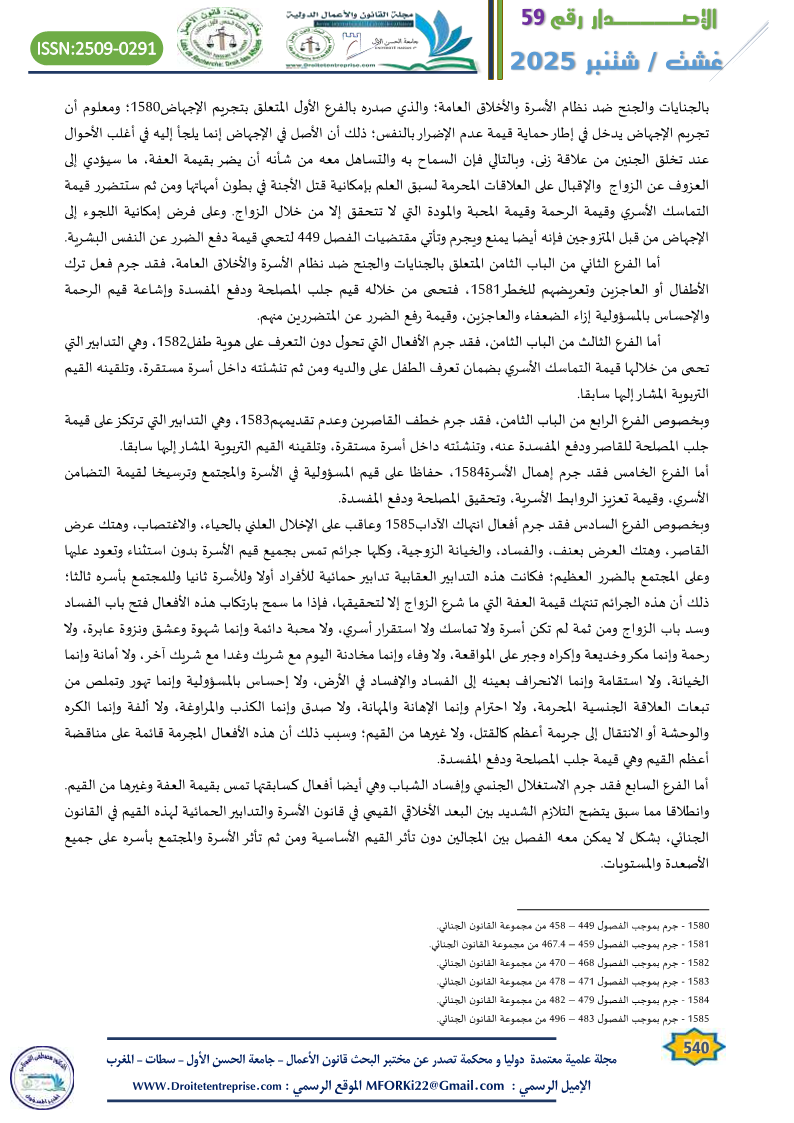
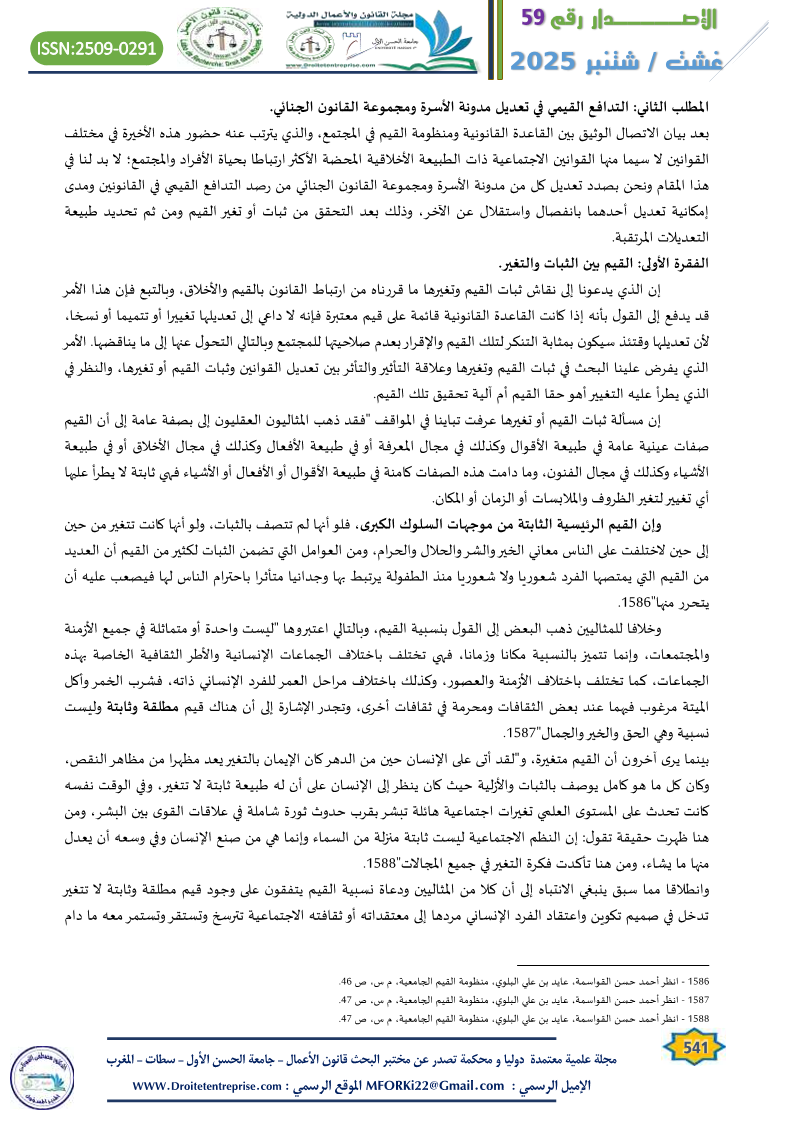
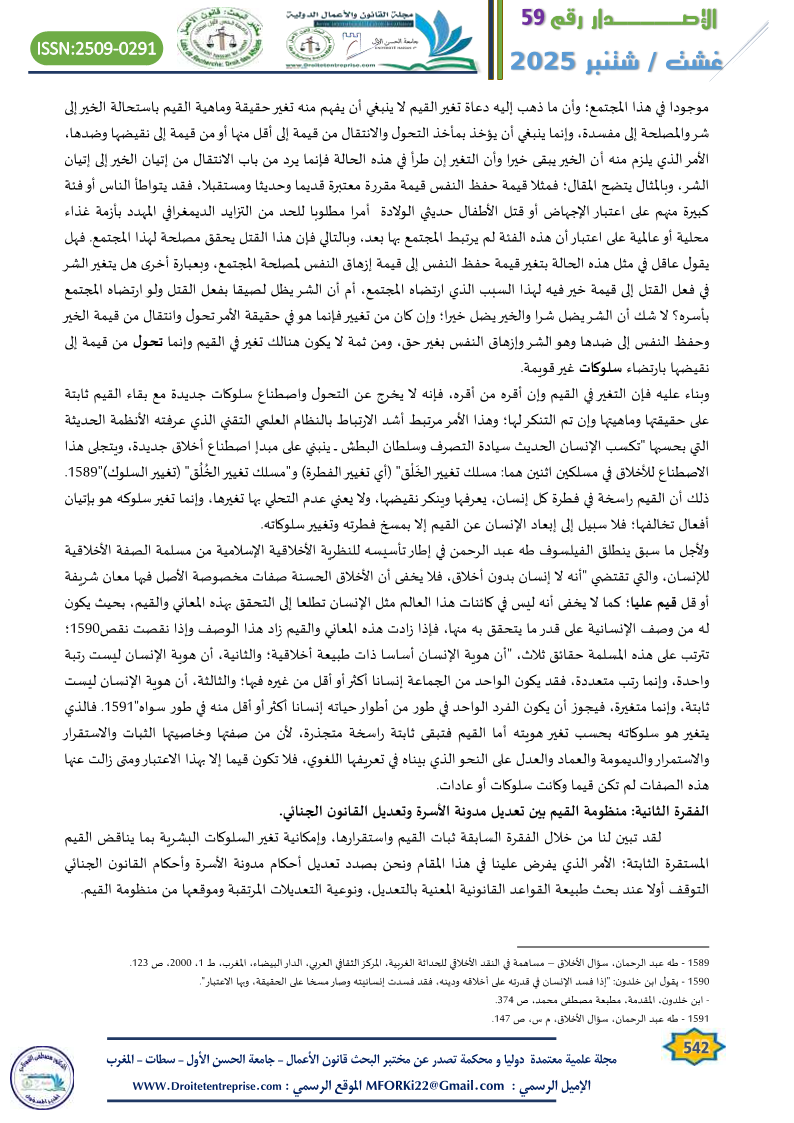
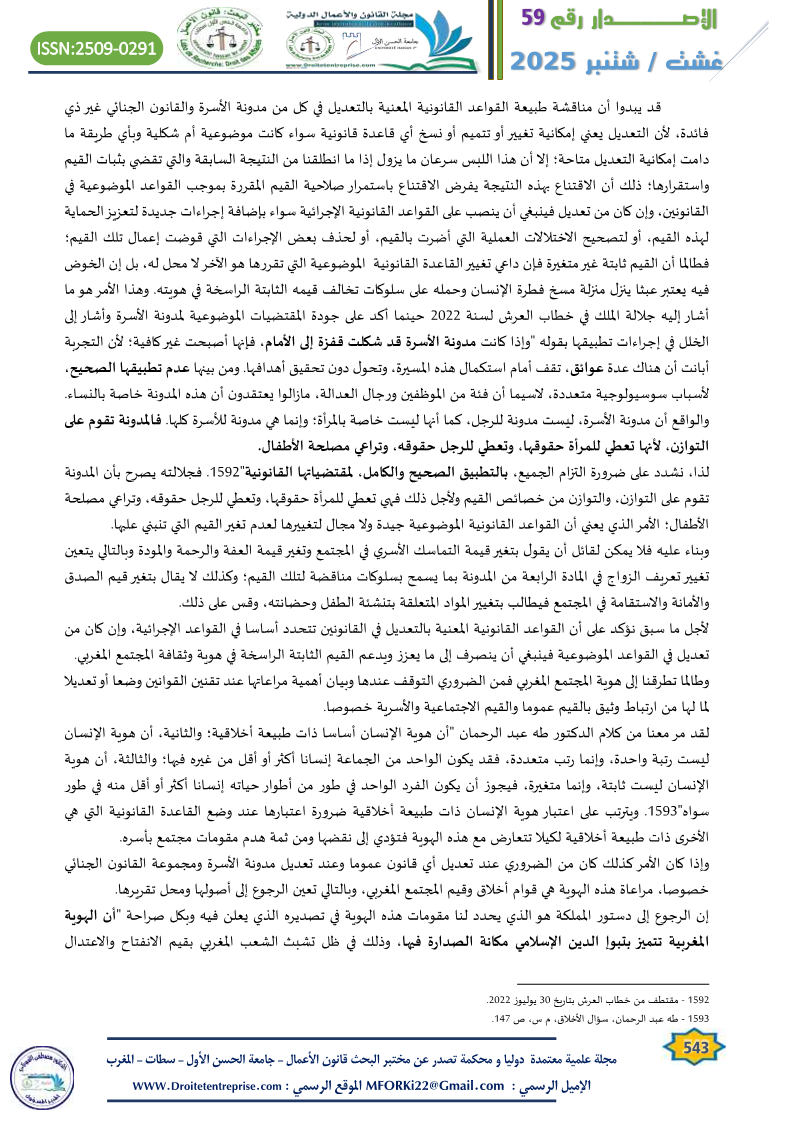
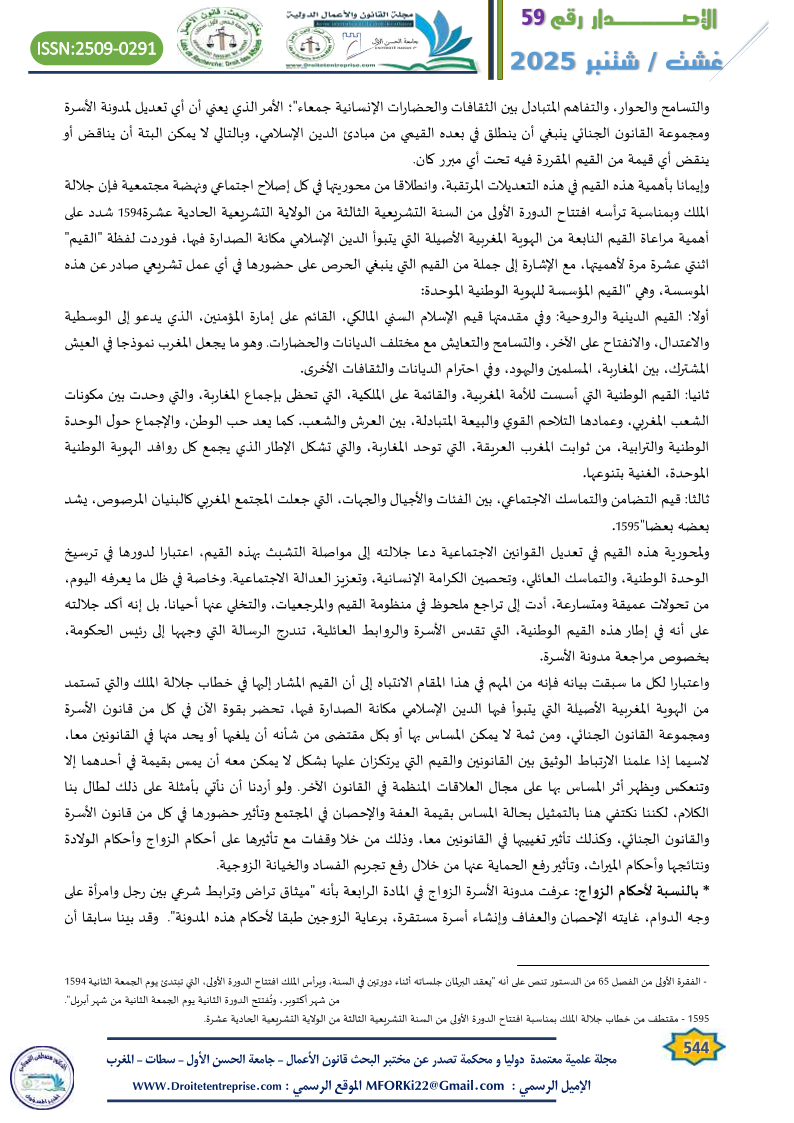
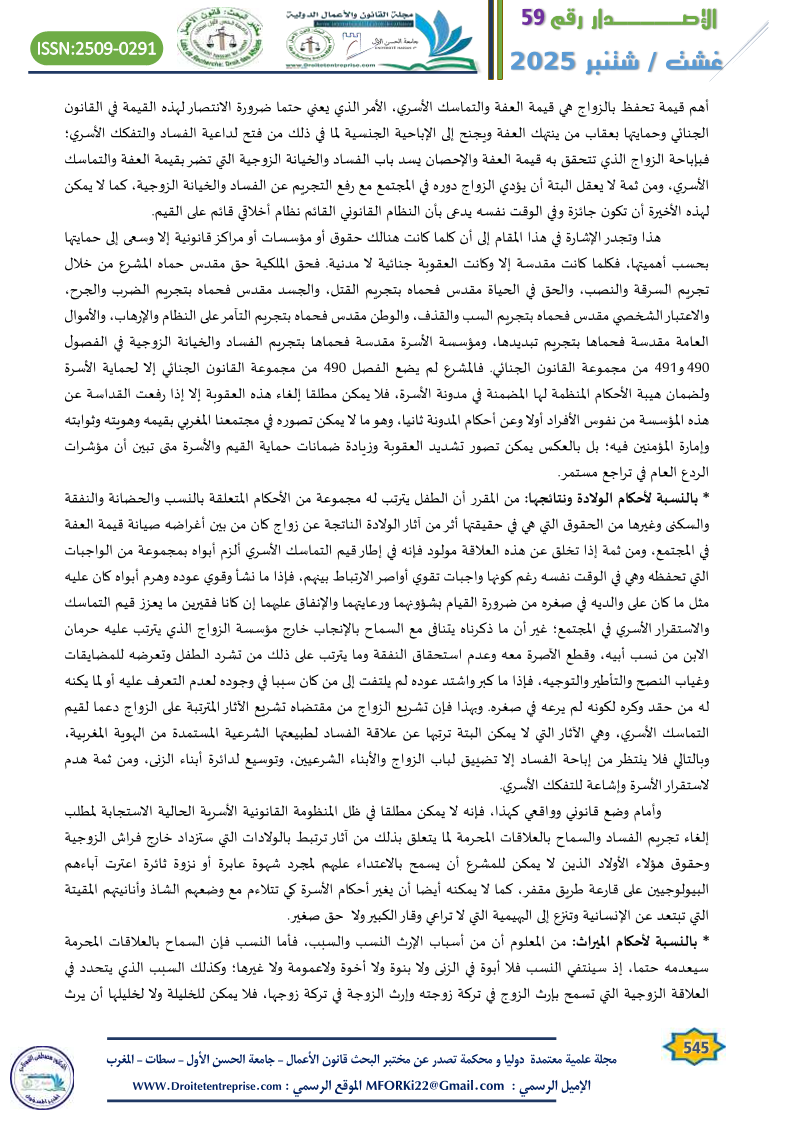
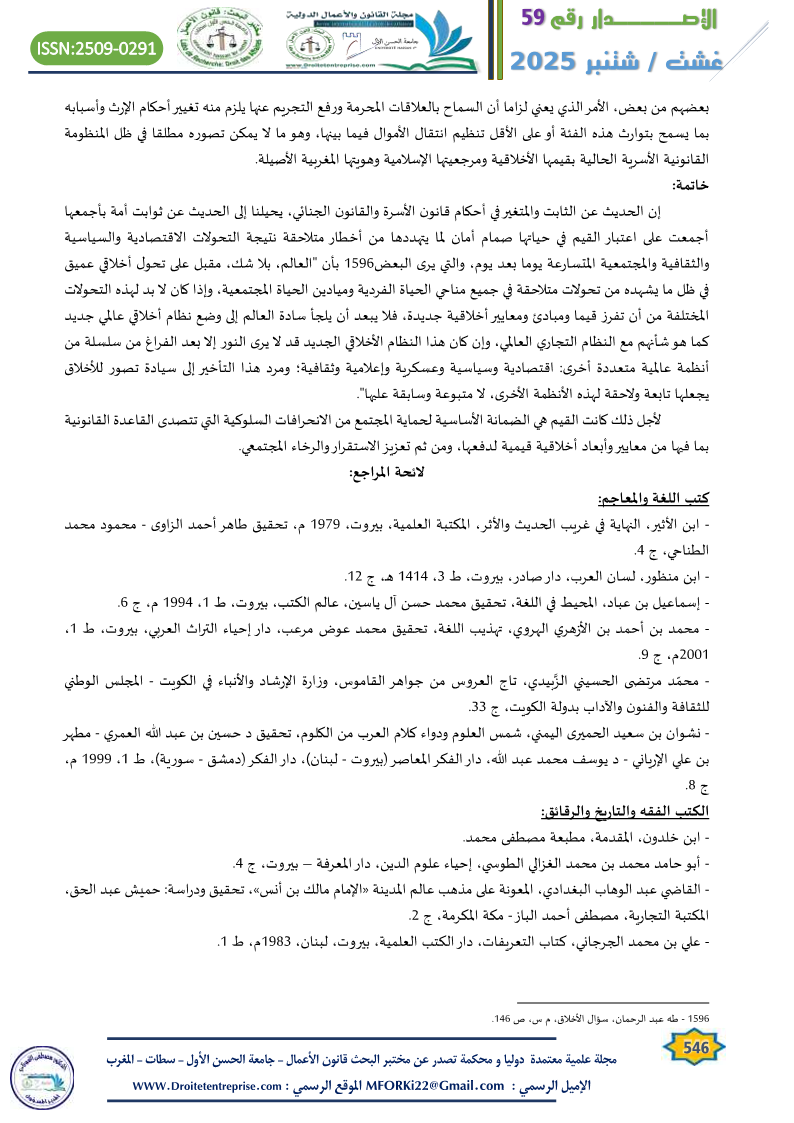
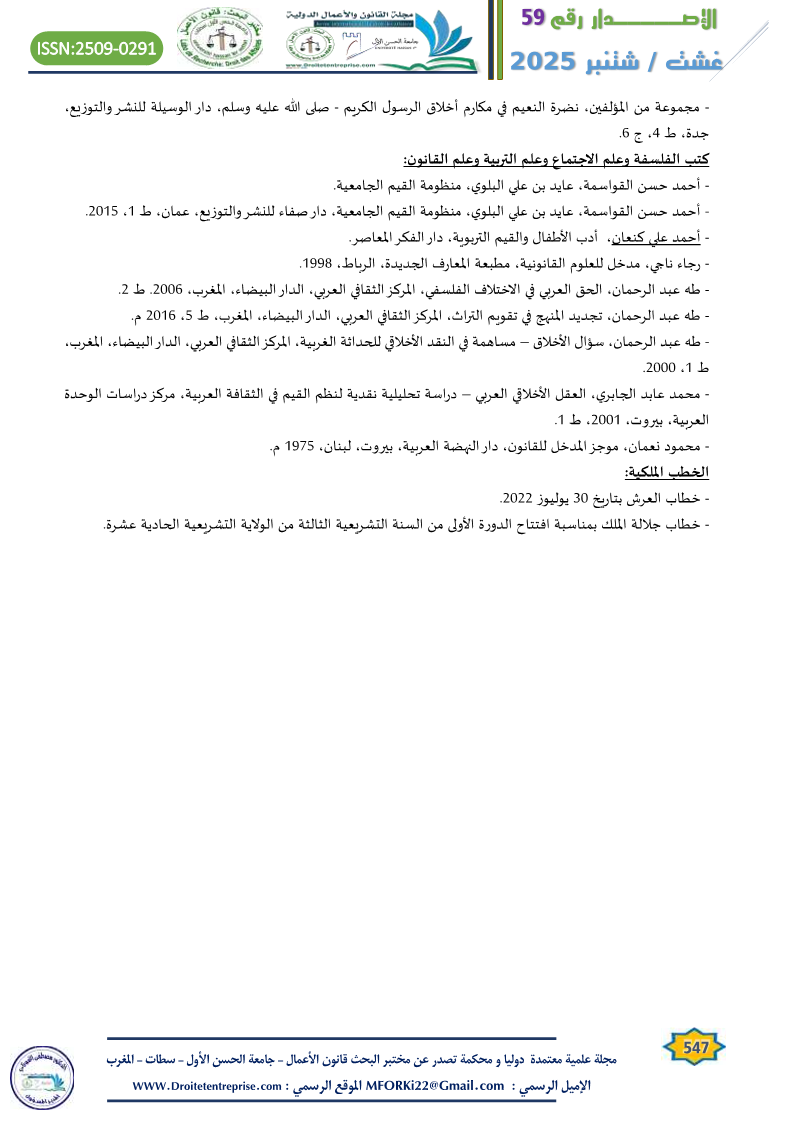
منظومة القيم بين الثابت والمتغير في أحكام قانون الأسرة والقانون الجنائي
The values system between the constant and the variable in family law and criminal law
الدكتور : محمد نعناني،
أستاذ محاضر مؤهل، جامعة الحسن أول، كلية العلوم القانونية والسياسية سطات.
ملخص:
انطلاقا من محورية الأسرة في المجتمع واعتبارها النواة الأساسية، واعتبارا للغرض الأساسي من وضع القوانين والذي يتجلى في تنظيم المجتمع وحماية أفراده، فلا نجد قانونا أكثر اتصالا بهؤلاء الأفراد وحياتهم اليومية من قانون الأسرة والقانون الجنائي؛ وبالتبع يكون هذين القانونين أكثر ارتباطا بمنظومة القيم تأصيلا وحماية؛ لأجل ذلك تتوقف هذه الدراسة عندهما لاستجلاء حقيقة حضور القيم فيهما، والنظر في مدى ثبات أو إمكانية تغير القيم التي تؤطرهما، وتأثير التدافع القيمي في تعديل هذه القوانين وانعكاسه على استقرار المجتمع.
Abstract:
Based on the importance of the family in society, and given that the purpose of establishing laws is to organize society and protect its members, we do not find a law more closely related to these individuals and their daily lives than family law and criminal law. Consequently, these two laws are more closely linked to the system of values, both in terms of foundation and protection. For this reason, this study focuses on them to clarify the reality of the presence of values in them, and to consider the extent of the stability or possibility of change of the values that frame them, and the impact of the value conflict in amending these laws and its reflection on the stability of society.
مقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد؛
يرى علماء الاجتماع أن النظام الاجتماعي عبارة عن نمط متميز من النشاط الاجتماعي والقيم التي تدور حول إحدى الحاجات الإنسانية الأساسية والتي تصاحبها طرق متميزة للتفاعل الاجتماعي؛ الأمر الذي يلزم منه اعتبار القيم أساس بناء المجتمع وانتظامه واستقراره، ما يعكس أهميتها ومحوريتها في كل زمان ومكان.
ونظرا لأهمية القيم وتأثيرها الكبير على البناء الاجتماعي والاستقرار المجتمعي، فمن الضروري التوقف عند تعريفها لغة واصطلاحا.
فأما تعريف القيم لغة، فجمع قيمة، وأصلها من مادة قوم، و”القِيَم مصدر كالصِّغَر وَالْكبر… لأنَّ قِيَماً من قَوْلك: قَامَ قِيَماً، وَقَامَ كَانَ فِي الأَصْل قَوَمَ أَو قَوُمَ فَصَارَ قَامَ، فاعتلّ قِيَم”.
وترد القيم في اللغة بمعان عدة منها الاستقامة، قال ابن منظور “القِيَمُ الاسْتِقامةُ”، وَيُقَال: رُمْح قَوِيم، وقَوامٌ قَوِيم، أَي: مُسْتَقِيم، وأَقمت الشَّيْء وقوّمته فَقَامَ، بِمَعْنى استقام. قَالَ: والاستقامة: اعْتِدَال الشَّيْء واستواؤه. وقد ترد بمعنى الاستدامة كقولهم “ماءٌ قائمٌ: أي دائمٌ؛ وما لِفُلانٍ قِيْمَةٌ: إذا لم يَدُمْ على الشَّيْءِ”. وترد أيضا بمعنى الثمن ومنها القِيْمَةُ: ثَمَنُ الشَّيْءِ بالتَّقْوِيم. وتأتي بمعنى العماد في لفظة القِوَامُ، بالكَسْر: نِظَامُ الأمرِ وعِمَادُه ومِلاكُه، “وقِوَامُ الشَّيْءِ: عِمَادُهُ الَّذِي يَقُوم بِهِ. يُقَالُ: فُلان قِوام أَهْلِ بَيْتِهِ. وقِوام الأمرِ: مِلاكُه”. وتستعمل بمعنى السيادة ومنه “القَيِّمُ: السَّيِّدُ، وسَائِسُ الأمْرِ، وهِيَ {قَيِّمَةٌ}، وقَيِّمُ المَرْأَةِ: زَوْجُها فِي بعْضِ اللُّغَاتِ؛ لِأَنَّهُ {يَقُومُ بِأَمْرِهَا ومَا تَحتَاجُ إِلَيْهِ… والقَوَّامُ: المُتَكَفِّلُ بِالأمْرِ. وَأَيْضًا: كَثِيرُ القِيَامِ بِاللَّيْلِ”. ومن أهم معانيها العدل قال ابن مظور “والقَوامُ: العَدْل؛ قَالَ تَعَالَى: وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾”.
وخلاصة التعريف اللغوي أن القيم ترد بمعنى الاستقامة والاستدامة والعدل والعماد والسيادة وقدر الشيء، وكلها تدخل في المعنى الاصطلاحي للقيم.
فالقيم في علم الاجتماع عبارة عن حقائق أساسية هامة في البناء الاجتماعي وهي من أهم العناصر البنائية التي تشتق من التفاعل الاجتماعي ولذلك فقد عرفها قاموس علم الاجتماع بأنها “الاعتقاد بقدرة شيء ما على إشباع رغبة إنسانية، وهي صفة الشيء التي تجعله ذا أهمية لفرد أو جماعة، وهي جزء من النسيج الاجتماعي وجدت مع وجود الإنسان وتفاعله مع بقية أعضاء المجتمع.
والقيم كما يعرفها العديد من علماء الاجتماع هي مستوى أو معيار للانتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام الشخص الاجتماعي في الموقف الاجتماعي.
وقد عرفت بأنها “معيار للحكم على كل ما يؤمن به مجتمع ما من المجتمعات البشرية ويؤثر في سلوك أفراده حيث يتم من خلاله الحكم على شخصية الفرد ومدى صدق انتمائه نحو المجتمع بكل أفكاره ومعتقداته وأهدافه وطموحاته وقد تكون هذه القيم إيجابية أو سلبية لكل ما هو مرغوب أو غير مرغوب فيه يتمثلها الفرد بصورة صريحة واضحة أو ضمنية خفية تنعكس آثارها في سلوكه فتحدد مجرى حياته التي تتجلى من خلالها ملامح شخصيته”.
وقد عرفها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: “القيم هي جملة المقاصد التي يسعى القوم إلى إحقاقها متى كان فيها صلاحهم، عاجلا أو آجلا، أو إلى إزهاقها متى كان فيها فسادهم، عاجلا أو آجلا”.
وأيا كان التعريف فإن القيم كانت ولا زالت مرتبطة بما يستحسنه أو يستقبحه المجتمع من أخلاق وسلوكات يأتيها الأفراد تؤثر بطريقة أو بأخرى على النظام السائد فيه؛ الأمر الذي يفرض الاهتمام بها والحرص على الالتزام بها تجنبا للفوضى، سواء من خلال آلية التوجيه الاجتماعي أو من خلال آلية التنظيم القانوني.
وإذا كانت آلية التوجيه الاجتماعي يختص بالاضطلاع بها متدخلون عدة في مجالات التربية والإرشاد الديني والتأطير الثقافي وغيرها من المجالات الأخرى؛ فإن آلية التنظيم القانوني تضطلع بها السلطة المكلفة بالتشريع من خلال ما تصدره من قوانين في مختلف المجالات، والتي يقوى ظهور حماية القيم فيها بحسب اتساع دائرة الفئة المعنية به وبحسب قوة اتصال القاعدة القانونية بحياة الأفراد اليومية فيها؛ فالقانون الجمركي وإن كان من خاصية قاعدته القانونية أنها قاعدة اجتماعية أخلاقية إلا أنها لا تعني بشكل مباشر إلا فئة محدودة من فئات المجتمع هي الفئة التي تستورد سلعا من الخارج، وهي لا تستغرق حين تطبيقها حيزا مهما من حياتهم؛ وهذه الفئة هي بطبيعة الحال فئة أقل من فئة التجار التي ينظم عملها القانون التجاري والذي يرتبط به التجار في أغلب حياتهم ويؤطر أغلب معاملاتهم، فحضور القيم في هذا القانون الأخير يفترض أن يكون أكبر من الأول. فكلما اتسعت دائرة الفئة المعنية بالقانون وزادت قوة اتصال القاعدة القانونية بحياة الأفراد اليومية كلما اتسع مجال الحماية القانونية للقيم وزاد حضورها في القانون.
وبناء على ما سبق وانطلاقا من محورية الأسرة في المجتمع واعتبارها النواة الأساسية فيه، واعتبارا للغرض الأساسي من وضع القوانين والذي يتجلى في تنظيم المجتمع وحماية أفراده، فلا نجد قانونا أكثر اتصالا بهؤلاء الأفراد وحياتهم اليومية من قانون الأسرة والقانون الجنائي؛ وبالتبع يكون هذين القانونين أكثر ارتباطا بمنظومة القيم تأصيلا وحماية؛ لأجل ذلك كان من الضروري التوقف عندهما واستجلاء حقيقة حضور القيم فيهما، والنظر في مدى ثبات أو إمكانية تغير القيم التي تؤطرها، وتأثير التدافع القيمي في تعديل هذه القوانين وانعكاسه على استقرار المجتمع؛ وذلك من خلال مطلبين نتناول في الأول منهما البعد القيمي في قانون الأسرة والقانون الجنائي، ونخصص الثاني لدراسة تأثير التدافع القيمي على تعديل قانون الأسرة والقانون الجنائي.
المطلب الأول: البعد القيمي في قانون الأسرة والقانون الجنائي.
إن دراسة البعد القيمي في قانون الأسرة والقانون الجنائي، يقتضي منا بداية التوقف عند أهمية البعد الأخلاقي في هذه القوانين ودوره في حماية الأسرة من التفكك وصيانة المجتمع من الفوضى، وذلك من خلال ما تقرره من قواعد قانونية آمرة أحيانا وتكميلية أحيانا أخرى.
الفقرة الأولى: البعد الأخلاقي في القاعدة القانونية ودوره في صيانة منظومة القيم.
إن الحديث عن البعد الأخلاقي في القاعدة القانونية ودوره في صيانة منظومة القيم يقتضي منا بداية تعريف الأخلاق.
الأخلاق جمع خلق، و”الخُلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلًا وشرعًا بسهولة، سميت الهيئة: خلقًا حسنًا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة، سميت الهيئة: خلقًا سيئًا، وإنما قلنا: إنه هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال على الندور بحالة عارضة لا يقال: خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه، وكذلك من تكلف السكوت عند الغضب بجهد أو روية لا يقال: خلقه الحلم، وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخصٍ خلقه السخاء، ولا يبذل، إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل، لباعث أو رياء”.
انطلاقا مما سبق، “فكرتان يتحدد بهما معنى “الخلق” وجمعه “أخلاق”: الأولى “الرسوخ” بمعنى الثبات والدوام، والثانية التلقائية. والملاحظ أن الخلق بهذا المعنى غير “السلوك”، فهو “ملكة” أو “هيئة في النفس” تصدر عنها الأفعال: فهي منبع السلوك… ذلك لأن السلوك في اللغة من سلك طريقا، وسلك الخيط في الإبرة، ومعناه الدخول والإدخال، فالسلوك هو ممارسة الفعل وليس الفعل ذاته… فالكرم خلق للنفس أما إكرام هذا الضيف أو ذاك فهو سلوك. والفرق هو أن الكرم صفة راسخة في النفس، أما سلوك مسلك الكريم فهو فعل صادر عن تلك الصفة”.
والأخلاق في فكر الشعوب المختلفة مجموعة من القيم الاجتماعية التي ترقى بالإنسان للكمال وتشيع الخير والطمأنينة في المجتمع وتستأصل الشر وتمنعه من أن يستبد بالناس ويحول علاقاتهم إلى تنافر وتناحر، وبالتالي فالأخلاق مثل راقية، تبين للإنسان السلوكات التي يجب أن ينهجها كي يرقى للرتبة التي تبوأها. فهي تبين ما يجب أن يكون عليه الإنسان لا ما هو كائن. والغالب أن تستقي قواعد الأخلاق مصدرها من المعتقدات الدينية وغيرها التي يؤمن بها الناس. وهي تستقي مصدر الإلزام من الوازع الديني أو الأدبي المتأصل في النفوس.
وبناء عليه يذهب البعض إلى أن القانون يبتعد عن مجال الأخلاق وأن “مجاله الأصلي السلوك الخارجي الملموس، الذي لم يتوقف عند مرحلة النية، وإنما ترجم إلى عمل ظاهر. وذلك لعلة عجز القانون عن الإحاطة والتحكم فيما هو باطني… إلا أن هذا التباعد نسبي فقط، بدليل أن القانون يعاقب عديدا من صور الكذب، كالنصيحة الكاذبة التي يقدمها موظف عمومي لمواطن قصد تغليطه، أو كشهادة الزور… وعلى النهج نفسه فكما أن الأخلاق تستقبح الظلم والاعتداء على الناس، فالقانون بدوره يحظر ويعاقب العنف والاعتداء سواء وجه إلى النفس (القتل والضرب والجرح) أو العرض (الاغتصاب، التحريض على الفساد…) أو المال (السرقة، النصب والاحتيال، التدليس، الغش الإثراء بدون سبب مشروع…) وهي أفعال تجابه بعقوبات جنائية أو مدنية أو هما معا.
من ثم يبدو أنه يجب التحفظ إزاء المعيار الذي يعتمد النية الباطنة أساسا للتمييز بين الأخلاق والقانون؛ لأنه أضحى للنية والمقاصد البعيدة اعتبارا في القانون أيضا… فهذه العلاقة بين الأخلاق والقانون ثابتة في التشريعات القديمة كما في الحديثة، على أن العلاقة بينهما لا تفتأ تتوطد.
ومن شأن كل ذلك أن يؤكد بأن القاعدة القانونية كانت في أصلها قاعدة خلقية تواضع عليها الناس بعد مراحل وأشواط. بحيث عندما تبين لهم مدى صلاحها ومدى قدرتها على تحقيق الخير العام سارعوا إلى إرفاقها بالإلزام والإجبار القانوني، باستعمال الوسائل الكفيلة بفرض احترامها… وهذا يؤكد أن كل قاعدة قانونية إلا وتنهل أصلها من الأخلاق. فجل المبادئ التي يكرسها القانون ما هي في أصلها سوى قواعد أخلاقية تعارف عليها المجتمع في فترة ما وارتأى المشرع صلاحها وضرورتها لضمان استقرار المجتمع وتقدمه، فتكفل بها، وأوجد الوسائل اللازمة لإجبار الناس على احترامها”.
فإذا كانت القاعدة القانونية قاعدة أخلاقية لزم من ذلك أنها “تقيس سلوك الإنسان على أساس ما انطوى عليه من خير أو شر، فهو بالنظر إلى أعماله إما فاعل للخير أو فاعل للشر”، ومن ثمة فإن الغرض من وضع القاعدة القانونية تنظيم الأفعال الخيرة الجائزة أو الواجب إتيانها والتي تعتبر مصالح للمجتمع ومعاقبة الأفعال الشريرة الخاطئة الممنوع إتيانها والتي تعتبر مفاسد تضر بالمجتمع.
وعند هذا المستوى بالضبط يتجلى دور البعد الأخلاقي في القاعدة القانونية في صيانة منظومة القيم؛ ذلك أن القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة أخلاقية تهدف إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن المجتمع، وكذلك القيم حسب الدكتور طه عبد الرحمان تهدف إلى تحقيق المصالح ودفع المفاسد عن الفرد والمجتمع، لا سيما من جهة حفظ المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، والتي يعتبرها كلها مهمة في منظومة القيم الأخلاقية العليا، منتهيا إلى تقسيم جديد للمصالح أخذ فيه بعين الاعتبار الحقائق الثلاث: “عدم انحسار الأجناس المصلحية في خمسة” و”نزول هذه الأجناس منزلة القيم الأخلاقية” و “دخول مكارم الأخلاق في جميع المصالح”، ليخلص إلى تقسيم جديد للمصالح يكون بديلا للتقسيم المألوف، وهو التقسيم الذي تنبني عليه القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة أخلاقية، فميز بين:
أ- النفع والضرر أو “المصالح الحيوية”، وهي المعاني الأخلاقية التي تتقوم بها كل المنافع والمضار التي تلحق عموم البنيات الحسية والمادية والبدنية؛ ويكون الشعور الموافق لهذه المعاني هو اللذة عند حصول النفع والألم عند حصول الضرر، ويندرج في هذه القيم المصالح المتعلقة بالنفس والصحة والنسل والمال.
ب- الحسن والقبح أو “المصالح العقلية”، وهي: المعاني الأخلاقية التي تتقوم بها المحاسن والمقابح التي تعرض لعموم البنيات النفسية والعقلية؛ ويكون الشعور الموافق لهذه المعاني هو الفرح عند حصول الخير والحزن عند حصول الشر؛ والمصالح التي تندرج تحت هذه المعاني أكثر من أن تحصى، ومن الأمثلة عليها الأمن والحرية والعمل والسلام والثقافة والحوار.
ج- قيم الصلاح والفساد أو “المصالح الروحية” وهي المعاني الأخلاقية التي تتقوم بها كل المصالح والمفاسد التي تطرأ على عموم القدرات الروحية والمعنوية، ويكون الشعور الموافق لهذه المعاني هو السعادة عند حصول المصلحة والشقاء عند حصول الفساد، ويدخل في هذا الصنف الدين في جانبه الروحي مثل الإحسان والرحمة والمحبة والخشوع والتواضع.
وتلزم على هذا التقسيم نتيجتان أساسيتان: إحداهما، “تكاثر القيم”؛ والثانية، “أسبقية القيم الروحية””.
فالقيم على هذا الاعتبار تتقاطع مع البعد الأخلاقي للقاعدة القانونية، بل تصبح القاعدة القانونية ببعدها الأخلاقي خادمة للقيم حامية لها، وبالتبع كلما تحقق احترام القاعدة القانونية الأخلاقية كلما ترسخت القيم في المجتمع وتحقق انتظامه وصلاحه، وكان عن الفساد والفوضى أبعد وإلى الرخاء والسعادة أقرب.
فالقاعدة القانونية قائمة على جلب النفع للأفراد لمصلحتهم ولمصلحة المجتمع، وهي في الوقت نفسه تدفع عنهم الضرر لبث الشعور بالاستقرار وعدم الاضطراب؛ كما أنها جعلت من أولوياتها ضمان كرامة الأفراد وحفظ إنسانيتهم من خلال حمايتها للقيم الأخلاقية المتعلقة بالحرية والحق في العمل والسلام وحرية الرأي وغيرها؛ وإلى جانب ما ذكر فإن أهم ما تنبني عليه القاعدة القانونية صيانتها لقيم الصلاح التي بها ارتقاء المجتمع من إصلاح ومساعدة للغير وتكافل اجتماعي وروابط أسرية وغيرها، ومحاصرتها لمظاهر الفساد بفرض عقوبات على السب والقذف والخداع والغش والزور وغيرها من المفاسد. فالتلازم بين القاعدة القانونية وصيانة منظومة القيم من الاضطراب والخلل أمر ثابت مقرر في جميع القوانين لا سيما الأكثر منها اتصالا بالأفراد وحياتهم العامة.
الفقرة الثانية: منظومة القيم في كل من قانون الأسرة والقانون الجنائي.
إن اختيار قانون الأسرة والقانون الجنائي لرصد الأبعاد القيمية في القاعدة القانونية باعتبارها قاعدة أخلاقية يرجع بالأساس إلى اتصال هذين القانونين اتصالا وثيقا بحياة الأفراد داخل المجتمع، وحاجتهم الملحة إلى الرجوع إليهما لتأطير وتنظيم علاقاتهم الأسرية والاجتماعية اليومية، بشكل لا ينفك عنه أي منهم البتة، ولا يستغني عنه أي فرد في زمن تزاحمت فيه المصالح وتعددت فيه المشاكل الاجتماعية الناتجة عن التوسع العمراني والأزمات الاقتصادية المتعاقبة.
إن قانون الأسرة بالنظر إلى مصدره التشريعي في أغلب البلاد الإسلامية التي تستقي أحكامه من الشريعة الإسلامية، كان ولا زال قانونا أخلاقيا بامتياز يجعل القيم في صلب أحكامه، منها يستمد وإليها يقصد، في حضور قوي ونظام جلي لمجتمع سوي.
إن حضور القيم يظهر بشكل جلي واضح في مدونة الأسرة المغربية في كثير من المقتضيات والمواد التي يروم من خلالها تحقيق الاستقرار للأسرة والمجتمع وإزالة التناقضات والحد من المشكلات الاجتماعية؛ فنجد قيما عديدة نذكر منها:
– قيمة التماسك الأسري: والتي تظهر في تعريف الزواج في المادة الرابعة من المدونة والتي تنص على “الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.”؛ فهذه المادة أكدت على قيمة الترابط وربطت الغاية من الزواج بتحقيق قيمة التماسك الأسري الذي يتحقق في أسمى تجلياته مع الأسرة المستقرة. وهو ما أكدته المادة 26 عند تعريفها للصداق والغاية منه في “إنشاء أسرة مستقرة”. وظهرت هذه القيمة أيضا من خلال موانع الزواج في المواد من 35 إلى 39 بجرد المحرمات على التأبيد والمحرمات على التأقيت، لما في الزواج بالمحرمة تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا من أضرار اجتماعية أقلها التفكك الأسري وقطع الأرحام.
وقد ظهرت هذه القيمة بشكل جلي أيضا من خلال مقتضى المادة 70 الذي قرر بأنه “لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.”.
وتحققت هذه القيمة أيضا من خلال تنظيم أحكام البنوة وما يترتب عليهما من أحكام، وتنظيم أحكام الحضانة، وتنظيم أحكام النفقة.
– قيمة العفة: وهي تظهر أيضا في الغاية من الزواج المنصوص عليها في المادة الرابعة من المدونة؛ وذلك بجعل الزواج الوسيلة الوحيدة للاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، وقطع دابر الزنى والفساد الأخلاقي بين الجنسين، انطلاقا من التحريم الصريح للزنى، واعتبارا للجانب الأخلاقي في ضرورة دفع الفساد عن الرجل والمرأة بتجنيبهما ضرر الإصابة بالأمراض الخطيرة المنقولة جنسيا، وحماية للمجتمع من الفوضى المترتبة عن الإباحية الجنسية وما يترتب عنها من مشكلات اجتماعية معقدة. ولأجل ذلك كان إباحة التعدد متى تحققت شروطه المنصوص عليها في المادتين 41 و42.
كما تظهر هذه القيمة في البند الأول من المادة 51 التي تلزم ب “المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل”.
وتحمى هذه القيمة بما قررته المدونة من مقتضيات تعطي الحق في التطليق للعيب المانع من المعاشرة الزوجية والتطليق للغيبة والتطليق للإيلاء والهجر.
– قيمة رفع الضرر عن المضرور: وقد ظهرت هذه القيمة في مواد عدة منها المادة 7 التي تعطي الحق لمن تضرر من العدول عن الخطبة حق المطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذي يدل بمفهوم المخالفة إلى إرشاد الخاطب أو المخطوبة إلى مراعاة عدم الإضرار بقرينه حين ممارسة حق العدول عن الخطبة.
وقد ظهرت هذه القيمة بشكل جلي أيضا من خلال مقتضى المادة 70 الذي قرر بأنه “لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.”.
كما ظهرت في إباحة طلب التطليق للضرر طبقا للمادة 100 من المدونة.
– قيمة الصدق: ظهرت هذه القيمة في عدة مواد منها المادة 12 و63 و66 من المدونة بشأن منع التدليس في الزواج، وهي المقتضيات التي نستفيد منها بمفهوم المخالفة ضرورة التحلي بالصدق لما في مخالفته من آثار وخيمة على الحياة الزوجية المستقبلية. كما ظهر في الفقرة الأخيرة من المادة 43 التي تنظم الحالة التي يكون فيها سبب عدم توصل الزوجة المراد التزوج عليها بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والتي تستدعي تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
وقد حثت المدونة على هذه القيمة بصريح النص في المادة 54 بمناسبة بيان حقوق الأطفال على آبائهم حينما قررت في البند السادس ضرورة “التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل”.
– قيمة جلب المصلحة ودفع المفسدة: وقد ارتبطت هذه القيمة بكل الأحكام المنظمة لحقوق الأطفال والآثار المترتبة لهم سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها؛ كذا الأحكام المتعلقة بشؤون القاصرين.
– قيمة المحبة والمودة: برزت هذه القيمة من خلال تعريف الزواج في المادة 10، وكذا في تعريف الصداق في المادة 26 التي جعلت غايته “تثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين”.
– قيمة الوفاء: تجلت في المقتضيات المتعلقة باحترام شرط الامتناع عن التعدد في المادة 42، وإقرار إلزامية الشروط المصاحبة لعقد الزواج في المادة 47، وجعلها سببا لإنهاء العقد في المادة 99.
وتظهر هذه القيمة أيضا في إقرار مستحقات الزوجة في المادة 84 التي حددتها في “تشمل مستحقات الزوجة: الصداق المؤخر إن وجد، ونفقة العدة، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.”؛ إذ من الوفاء إقرار هذه المستحقات ومراعاة العشرة وعدم التنكر لها عند إنهاء العلاقة الزوجية.
وتظهر أيضا في إتاحة إنهاء العلاقة الزوجية بالاتفاق طبقا للمادة 114 متى تعذر الاستمرار فيها، دون كشف للأسرار أمام القضاء من باب الوفاء.
– قيمة الرحمة ودفع المشقة: وتظهر في عدم التكليف بما لا يطاق، وتتحقق في مقتضيات المادة 48 “إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة”؛ وكذا في البند الثاني من المادة 51 الذي يحث على “المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة”.
وتتحقق هذه القيمة أيضا من خلال مقتضيات المادة 90 التي خففت على الأزواج وأخذت بعدم وقوع “طلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا”. والمادة 91 التي اعتبرت “الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق”، وكذا المادة 92 التي اعتبرت “الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا”، والمادة 93 التي اعتبرت “الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع”. والمادة 218 التي تجيز ترشيد القاصر البالغ ستة عشرة سنة.
– قيمة الاحترام: تتجلى في البند الثاني من المادة 51 الذي يحث على “المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة”.
– قيمة الإحساس بالمسؤولية وتجنب التهور: تتجلى في البند الثالث من المادة 51 الذي يحث على “تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال”.
– قيمة التشاور: تتجلى في البند الثالث من المادة 51 الذي يحث على “التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل”.
– قيمة حسن المعاملة: تتجلى في البند الثالث من المادة 51 الذي يحث على “حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف”.
– القيم التربوية: تتجلى في البند السادس من المادة 54 الذي يحث على “التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي، والمعنوي، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل”.
وقد ظهرت هذه القيم أيضا في المادة 169 التي تنص على أنه “على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.”.
كما تظهر في البند الثالث من المادة 173 الذي يشترط في الحاضن القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه.
– قيمة الألفة: ظهرت هذه القيمة من خلال الحرص على إجراء الصلح بين الزوجين في جميع الدعاوى الرامية إلى إنهاء العلاقة الزوجية باستثناء التطليق للغيبة، طلبا لإعادة الألفة بين الأزواج ودفع أسباب الخلاف عنهم.
– قيمة الاستقامة: تتجلى في البند الثاني من المادة 173 الذي يشترط في الحاضن الاستقامة.
– قيمة الأمانة: تتجلى في البند الثاني من المادة 173 الذي يشترط في الحاضن الأمانة.
فهذا غيض من فيض القيم المبثوثة في مدونة الأسرة والتي عليها مدار أحكامها لمحوريتها في حياة الأفراد واستقرار الأسرة والمجتمع، والتي متى تم التحلي بها تحققت نتيجتها ومتى تم إهدارها كان من الفساد بحسب ما كان من إهدارها.
ولا غرابة من أن نجد هذا الكم من القيم في قانون الأسرة لسعة اتصاله بحياة الأفراد كما هو الشأن بالنسبة للقانون الجنائي الذي تعتبر مقتضياته مكملة لمقتضيات قانون الأسرة من جهة تصديها لتقويم الانحرافات القيمية والخلقية التي سبق الإشارة إليها متى كانت خطيرة ماسة بالنظام العام واستقرار الأسرة.
إن القانون الجنائي وعلى غرار قانون الأسرة يزخر بحمولة قيمية كبيرة جدا بالنظر إلى طبيعته الخاصة المرتبطة أساسا بحفظ النظام العام داخل المجتمع وحماية حقوق الأفراد، ولو أردنا تتبع وتعداد القيم فيه لطال بنا المقام ولما أسعفتنا صفحات هذه المقالة على احتواء جميعها؛ وإنما يكفينا منها ما ورد في الباب الثامن من الجزء الأول من الكتاب الثالث المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة؛ والذي صدره بالفرع الأول المتعلق بتجريم الإجهاض؛ ومعلوم أن تجريم الإجهاض يدخل في إطار حماية قيمة عدم الإضرار بالنفس؛ ذلك أن الأصل في الإجهاض إنما يلجأ إليه في أغلب الأحوال عند تخلق الجنين من علاقة زنى، وبالتالي فإن السماح به والتساهل معه من شأنه أن يضر بقيمة العفة، ما سيؤدي إلى العزوف عن الزواج والإقبال على العلاقات المحرمة لسبق العلم بإمكانية قتل الأجنة في بطون أمهاتها ومن ثم ستتضرر قيمة التماسك الأسري وقيمة الرحمة وقيمة المحبة والمودة التي لا تتحقق إلا من خلال الزواج. وعلى فرض إمكانية اللجوء إلى الإجهاض من قبل المتزوجين فإنه أيضا يمنع ويجرم وتأتي مقتضيات الفصل 449 لتحمي قيمة دفع الضرر عن النفس البشرية.
أما الفرع الثاني من الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة، فقد جرم فعل ترك الأطفال أو العاجزين وتعريضهم للخطر، فتحمى من خلاله قيم جلب المصلحة ودفع المفسدة وإشاعة قيم الرحمة والإحساس بالمسؤولية إزاء الضعفاء والعاجزين، وقيمة رفع الضرر عن المتضررين منهم.
أما الفرع الثالث من الباب الثامن، فقد جرم الأفعال التي تحول دون التعرف على هوية طفل، وهي التدابير التي تحمى من خلالها قيمة التماسك الأسري بضمان تعرف الطفل على والديه ومن ثم تنشئته داخل أسرة مستقرة، وتلقينه القيم التربوية المشار إليها سابقا.
وبخصوص الفرع الرابع من الباب الثامن، فقد جرم خطف القاصرين وعدم تقديمهم، وهي التدابير التي ترتكز على قيمة جلب المصلحة للقاصر ودفع المفسدة عنه، وتنشئته داخل أسرة مستقرة، وتلقينه القيم التربوية المشار إليها سابقا.
أما الفرع الخامس فقد جرم إهمال الأسرة، حفاظا على قيم المسؤولية في الأسرة والمجتمع وترسيخا لقيمة التضامن الأسري، وقيمة تعزيز الروابط الأسرية، وتحقيق المصلحة ودفع المفسدة.
وبخصوص الفرع السادس فقد جرم أفعال انتهاك الآداب وعاقب على الإخلال العلني بالحياء، والاغتصاب، وهتك عرض القاصر، وهتك العرض بعنف، والفساد، والخيانة الزوجية، وكلها جرائم تمس بجميع قيم الأسرة بدون استثناء وتعود عليها وعلى المجتمع بالضرر العظيم؛ فكانت هذه التدابير العقابية تدابير حمائية للأفراد أولا وللأسرة ثانيا وللمجتمع بأسره ثالثا؛ ذلك أن هذه الجرائم تنتهك قيمة العفة التي ما شرع الزواج إلا لتحقيقها، فإذا ما سمح بارتكاب هذه الأفعال فتح باب الفساد وسد باب الزواج ومن ثمة لم تكن أسرة ولا تماسك ولا استقرار أسري، ولا محبة دائمة وإنما شهوة وعشق ونزوة عابرة، ولا رحمة وإنما مكر وخديعة وإكراه وجبر على المواقعة، ولا وفاء وإنما مخادنة اليوم مع شريك وغدا مع شريك آخر، ولا أمانة وإنما الخيانة، ولا استقامة وإنما الانحراف بعينه إلى الفساد والإفساد في الأرض، ولا إحساس بالمسؤولية وإنما تهور وتملص من تبعات العلاقة الجنسية المحرمة، ولا احترام وإنما الإهانة والمهانة، ولا صدق وإنما الكذب والمراوغة، ولا ألفة وإنما الكره والوحشة أو الانتقال إلى جريمة أعظم كالقتل، ولا غيرها من القيم؛ وسبب ذلك أن هذه الأفعال المجرمة قائمة على مناقضة أعظم القيم وهي قيمة جلب المصلحة ودفع المفسدة.
أما الفرع السابع فقد جرم الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب وهي أيضا أفعال كسابقتها تمس بقيمة العفة وغيرها من القيم.
وانطلاقا مما سبق يتضح التلازم الشديد بين البعد الأخلاقي القيمي في قانون الأسرة والتدابير الحمائية لهذه القيم في القانون الجنائي، بشكل لا يمكن معه الفصل بين المجالين دون تأثر القيم الأساسية ومن ثم تأثر الأسرة والمجتمع بأسره على جميع الأصعدة والمستويات.
المطلب الثاني: التدافع القيمي في تعديل مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي.
بعد بيان الاتصال الوثيق بين القاعدة القانونية ومنظومة القيم في المجتمع، والذي يترتب عنه حضور هذه الأخيرة في مختلف القوانين لا سيما منها القوانين الاجتماعية ذات الطبيعة الأخلاقية المحضة الأكثر ارتباطا بحياة الأفراد والمجتمع؛ لا بد لنا في هذا المقام ونحن بصدد تعديل كل من مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي من رصد التدافع القيمي في القانونين ومدى إمكانية تعديل أحدهما بانفصال واستقلال عن الآخر، وذلك بعد التحقق من ثبات أو تغير القيم ومن ثم تحديد طبيعة التعديلات المرتقبة.
الفقرة الأولى: القيم بين الثبات والتغير.
إن الذي يدعونا إلى نقاش ثبات القيم وتغيرها ما قررناه من ارتباط القانون بالقيم والأخلاق، وبالتبع فإن هذا الأمر قد يدفع إلى القول بأنه إذا كانت القاعدة القانونية قائمة على قيم معتبرة فإنه لا داعي إلى تعديلها تغييرا أو تتميما أو نسخا، لأن تعديلها وقتئذ سيكون بمثابة التنكر لتلك القيم والإقرار بعدم صلاحيتها للمجتمع وبالتالي التحول عنها إلى ما يناقضها. الأمر الذي يفرض علينا البحث في ثبات القيم وتغيرها وعلاقة التأثير والتأثر بين تعديل القوانين وثبات القيم أو تغيرها، والنظر في الذي يطرأ عليه التغيير أهو حقا القيم أم آلية تحقيق تلك القيم.
إن مسألة ثبات القيم أو تغيرها عرفت تباينا في المواقف “فقد ذهب المثاليون العقليون إلى بصفة عامة إلى أن القيم صفات عينية عامة في طبيعة الأقوال وكذلك في مجال المعرفة أو في طبيعة الأفعال وكذلك في مجال الأخلاق أو في طبيعة الأشياء وكذلك في مجال الفنون، وما دامت هذه الصفات كامنة في طبيعة الأقوال أو الأفعال أو الأشياء فهي ثابتة لا يطرأ عليها أي تغيير لتغير الظروف والملابسات أو الزمان أو المكان.
وإن القيم الرئيسية الثابتة من موجهات السلوك الكبرى، فلو أنها لم تتصف بالثبات، ولو أنها كانت تتغير من حين إلى حين لاختلفت على الناس معاني الخير والشر والحلال والحرام، ومن العوامل التي تضمن الثبات لكثير من القيم أن العديد من القيم التي يمتصها الفرد شعوريا ولا شعوريا منذ الطفولة يرتبط بها وجدانيا متأثرا باحترام الناس لها فيصعب عليه أن يتحرر منها”.
وخلافا للمثاليين ذهب البعض إلى القول بنسبية القيم، وبالتالي اعتبروها “ليست واحدة أو متماثلة في جميع الأزمنة والمجتمعات، وإنما تتميز بالنسبية مكانا وزمانا، فهي تختلف باختلاف الجماعات الإنسانية والأطر الثقافية الخاصة بهذه الجماعات، كما تختلف باختلاف الأزمنة والعصور، وكذلك باختلاف مراحل العمر للفرد الإنساني ذاته، فشرب الخمر وأكل الميتة مرغوب فيهما عند بعض الثقافات ومحرمة في ثقافات أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن هناك قيم مطلقة وثابتة وليست نسبية وهي الحق والخير والجمال”.
بينما يرى آخرون أن القيم متغيرة، و”لقد أتى على الإنسان حين من الدهر كان الإيمان بالتغير يعد مظهرا من مظاهر النقص، وكان كل ما هو كامل يوصف بالثبات والأزلية حيث كان ينظر إلى الإنسان على أن له طبيعة ثابتة لا تتغير، وفي الوقت نفسه كانت تحدث على المستوى العلمي تغيرات اجتماعية هائلة تبشر بقرب حدوث ثورة شاملة في علاقات القوى بين البشر، ومن هنا ظهرت حقيقة تقول: إن النظم الاجتماعية ليست ثابتة منزلة من السماء وإنما هي من صنع الإنسان وفي وسعه أن يعدل منها ما يشاء، ومن هنا تأكدت فكرة التغير في جميع المجالات”.
وانطلاقا مما سبق ينبغي الانتباه إلى أن كلا من المثاليين ودعاة نسبية القيم يتفقون على وجود قيم مطلقة وثابتة لا تتغير تدخل في صميم تكوين واعتقاد الفرد الإنساني مردها إلى معتقداته أو ثقافته الاجتماعية تترسخ وتستقر وتستمر معه ما دام موجودا في هذا المجتمع؛ وأن ما ذهب إليه دعاة تغير القيم لا ينبغي أن يفهم منه تغير حقيقة وماهية القيم باستحالة الخير إلى شر والمصلحة إلى مفسدة، وإنما ينبغي أن يؤخذ بمأخذ التحول والانتقال من قيمة إلى أقل منها أو من قيمة إلى نقيضها وضدها، الأمر الذي يلزم منه أن الخير يبقى خيرا وأن التغير إن طرأ في هذه الحالة فإنما يرد من باب الانتقال من إتيان الخير إلى إتيان الشر، وبالمثال يتضح المقال؛ فمثلا قيمة حفظ النفس قيمة مقررة معتبرة قديما وحديثا ومستقبلا، فقد يتواطأ الناس أو فئة كبيرة منهم على اعتبار الإجهاض أو قتل الأطفال حديثي الولادة أمرا مطلوبا للحد من التزايد الديمغرافي المهدد بأزمة غذاء محلية أو عالمية على اعتبار أن هذه الفئة لم يرتبط المجتمع بها بعد، وبالتالي فإن هذا القتل يحقق مصلحة لهذا المجتمع. فهل يقول عاقل في مثل هذه الحالة بتغير قيمة حفظ النفس إلى قيمة إزهاق النفس لمصلحة المجتمع، وبعبارة أخرى هل يتغير الشر في فعل القتل إلى قيمة خير فيه لهذا السبب الذي ارتضاه المجتمع، أم أن الشر يظل لصيقا بفعل القتل ولو ارتضاه المجتمع بأسره؟ لا شك أن الشر يضل شرا والخير يضل خيرا؛ وإن كان من تغيير فإنما هو في حقيقة الأمر تحول وانتقال من قيمة الخير وحفظ النفس إلى ضدها وهو الشر وإزهاق النفس بغير حق، ومن ثمة لا يكون هنالك تغير في القيم وإنما تحول من قيمة إلى نقيضها بارتضاء سلوكات غير قويمة.
وبناء عليه فإن التغير في القيم وإن أقره من أقره، فإنه لا يخرج عن التحول واصطناع سلوكات جديدة مع بقاء القيم ثابتة على حقيقتها وماهيتها وإن تم التنكر لها؛ وهذا الأمر مرتبط أشد الارتباط بالنظام العلمي التقني الذي عرفته الأنظمة الحديثة التي بحسبها “تكسب الإنسان الحديث سيادة التصرف وسلطان البطش ــــ ينبني على مبدإ اصطناع أخلاق جديدة، ويتجلى هذا الاصطناع للأخلاق في مسلكين اثنين هما: مسلك تغيير الخَلْق” (أي تغيير الفطرة) و”مسلك تغيير الخُلُق” (تغيير السلوك)”. ذلك أن القيم راسخة في فطرة كل إنسان، يعرفها وينكر نقيضها، ولا يعني عدم التحلي بها تغيرها، وإنما تغير سلوكه هو بإتيان أفعال تخالفها؛ فلا سبيل إلى إبعاد الإنسان عن القيم إلا بمسخ فطرته وتغيير سلوكاته.
ولأجل ما سبق ينطلق الفيلسوف طه عبد الرحمن في إطار تأسيسه للنظرية الأخلاقية الإسلامية من مسلمة الصفة الأخلاقية للإنسان، والتي تقتضي “أنه لا إنسان بدون أخلاق، فلا يخفى أن الأخلاق الحسنة صفات مخصوصة الأصل فيها معان شريفة أو قل قيم عليا؛ كما لا يخفى أنه ليس في كائنات هذا العالم مثل الإنسان تطلعا إلى التحقق بهذه المعاني والقيم، بحيث يكون له من وصف الإنسانية على قدر ما يتحقق به منها، فإذا زادت هذه المعاني والقيم زاد هذا الوصف وإذا نقصت نقص؛ تترتب على هذه المسلمة حقائق ثلاث، “أن هوية الإنسان أساسا ذات طبيعة أخلاقية؛ والثانية، أن هوية الإنسان ليست رتبة واحدة، وإنما رتب متعددة، فقد يكون الواحد من الجماعة إنسانا أكثر أو أقل من غيره فيها؛ والثالثة، أن هوية الإنسان ليست ثابتة، وإنما متغيرة، فيجوز أن يكون الفرد الواحد في طور من أطوار حياته إنسانا أكثر أو أقل منه في طور سواه”. فالذي يتغير هو سلوكاته بحسب تغير هويته أما القيم فتبقى ثابتة راسخة متجذرة، لأن من صفتها وخاصيتها الثبات والاستقرار والاستمرار والديمومة والعماد والعدل على النحو الذي بيناه في تعريفها اللغوي، فلا تكون قيما إلا بهذا الاعتبار ومتى زالت عنها هذه الصفات لم تكن قيما وكانت سلوكات أو عادات.
الفقرة الثانية: منظومة القيم بين تعديل مدونة الأسرة وتعديل القانون الجنائي.
لقد تبين لنا من خلال الفقرة السابقة ثبات القيم واستقرارها، وإمكانية تغير السلوكات البشرية بما يناقض القيم المستقرة الثابتة؛ الأمر الذي يفرض علينا في هذا المقام ونحن بصدد تعديل أحكام مدونة الأسرة وأحكام القانون الجنائي التوقف أولا عند بحث طبيعة القواعد القانونية المعنية بالتعديل، ونوعية التعديلات المرتقبة وموقعها من منظومة القيم.
قد يبدوا أن مناقشة طبيعة القواعد القانونية المعنية بالتعديل في كل من مدونة الأسرة والقانون الجنائي غير ذي فائدة، لأن التعديل يعني إمكانية تغيير أو تتميم أو نسخ أي قاعدة قانونية سواء كانت موضوعية أم شكلية وبأي طريقة ما دامت إمكانية التعديل متاحة؛ إلا أن هذا اللبس سرعان ما يزول إذا ما انطلقنا من النتيجة السابقة والتي تقضي بثبات القيم واستقرارها؛ ذلك أن الاقتناع بهذه النتيجة يفرض الاقتناع باستمرار صلاحية القيم المقررة بموجب القواعد الموضوعية في القانونين، وإن كان من تعديل فينبغي أن ينصب على القواعد القانونية الإجرائية سواء بإضافة إجراءات جديدة لتعزيز الحماية لهذه القيم، أو لتصحيح الاختلالات العملية التي أضرت بالقيم، أو لحذف بعض الإجراءات التي قوضت إعمال تلك القيم؛ فطالما أن القيم ثابتة غير متغيرة فإن داعي تغيير القاعدة القانونية الموضوعية التي تقررها هو الآخر لا محل له، بل إن الخوض فيه يعتبر عبثا ينزل منزلة مسخ فطرة الإنسان وحمله على سلوكات تخالف قيمه الثابتة الراسخة في هويته. وهذا الأمر هو ما أشار إليه جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2022 حينما أكد على جودة المقتضيات الموضوعية لمدونة الأسرة وأشار إلى الخلل في إجراءات تطبيقها بقوله “وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها. ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.
لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية“. فجلالته يصرح بأن المدونة تقوم على التوازن، والتوازن من خصائص القيم ولأجل ذلك فهي تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال؛ الأمر الذي يعني أن القواعد القانونية الموضوعية جيدة ولا مجال لتغييرها لعدم تغير القيم التي تنبني عليها.
وبناء عليه فلا يمكن لقائل أن يقول بتغير قيمة التماسك الأسري في المجتمع وتغير قيمة العفة والرحمة والمودة وبالتالي يتعين تغيير تعريف الزواج في المادة الرابعة من المدونة بما يسمح بسلوكات مناقضة لتلك القيم؛ وكذلك لا يقال بتغير قيم الصدق والأمانة والاستقامة في المجتمع فيطالب بتغيير المواد المتعلقة بتنشئة الطفل وحضانته، وقس على ذلك.
لأجل ما سبق نؤكد على أن القواعد القانونية المعنية بالتعديل في القانونين تتحدد أساسا في القواعد الإجرائية، وإن كان من تعديل في القواعد الموضوعية فينبغي أن ينصرف إلى ما يعزز ويدعم القيم الثابتة الراسخة في هوية وثقافة المجتمع المغربي.
وطالما تطرقنا إلى هوية المجتمع المغربي فمن الضروري التوقف عندها وبيان أهمية مراعاتها عند تقنين القوانين وضعا أو تعديلا لما لها من ارتباط وثيق بالقيم عموما والقيم الاجتماعية والأسرية خصوصا.
لقد مر معنا من كلام الدكتور طه عبد الرحمان “أن هوية الإنسان أساسا ذات طبيعة أخلاقية؛ والثانية، أن هوية الإنسان ليست رتبة واحدة، وإنما رتب متعددة، فقد يكون الواحد من الجماعة إنسانا أكثر أو أقل من غيره فيها؛ والثالثة، أن هوية الإنسان ليست ثابتة، وإنما متغيرة، فيجوز أن يكون الفرد الواحد في طور من أطوار حياته إنسانا أكثر أو أقل منه في طور سواه”. ويترتب على اعتبار هوية الإنسان ذات طبيعة أخلاقية ضرورة اعتبارها عند وضع القاعدة القانونية التي هي الأخرى ذات طبيعة أخلاقية لكيلا تتعارض مع هذه الهوية فتؤدي إلى نقضها ومن ثمة هدم مقومات مجتمع بأسره.
وإذا كان الأمر كذلك كان من الضروري عند تعديل أي قانون عموما وعند تعديل مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي خصوصا، مراعاة هذه الهوية هي قوام أخلاق وقيم المجتمع المغربي، وبالتالي تعين الرجوع إلى أصولها ومحل تقريرها.
إن الرجوع إلى دستور المملكة هو الذي يحدد لنا مقومات هذه الهوية في تصديره الذي يعلن فيه وبكل صراحة “أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء”؛ الأمر الذي يعني أن أي تعديل لمدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي ينبغي أن ينطلق في بعده القيمي من مبادئ الدين الإسلامي، وبالتالي لا يمكن البتة أن يناقض أو ينقض أي قيمة من القيم المقررة فيه تحت أي مبرر كان.
وإيمانا بأهمية هذه القيم في هذه التعديلات المرتقبة، وانطلاقا من محوريتها في كل إصلاح اجتماعي ونهضة مجتمعية فإن جلالة الملك وبمناسبة ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة شدد على أهمية مراعاة القيم النابعة من الهوية المغربية الأصيلة التي يتبوأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، فوردت لفظة “القيم” اثنتي عشرة مرة لأهميتها، مع الإشارة إلى جملة من القيم التي ينبغي الحرص على حضورها في أي عمل تشريعي صادر عن هذه الموسسة، وهي “القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة:
أولا: القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب. كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.
ثالثا: قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا”.
ولمحورية هذه القيم في تعديل القوانين الاجتماعية دعا جلالته إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا. بل إنه أكد جلالته على أنه في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
واعتبارا لكل ما سبقت بيانه فإنه من المهم في هذا المقام الانتباه إلى أن القيم المشار إليها في خطاب جلالة الملك والتي تستمد من الهوية المغربية الأصيلة التي يتبوأ فيها الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، تحضر بقوة الآن في كل من قانون الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، ومن ثمة لا يمكن المساس بها أو بكل مقتضى من شأنه أن يلغيها أو يحد منها في القانونين معا، لاسيما إذا علمنا الارتباط الوثيق بين القانونين والقيم التي يرتكزان عليها بشكل لا يمكن معه أن يمس بقيمة في أحدهما إلا وتنعكس ويظهر أثر المساس بها على مجال العلاقات المنظمة في القانون الآخر. ولو أردنا أن نأتي بأمثلة على ذلك لطال بنا الكلام، لكننا نكتفي هنا بالتمثيل بحالة المساس بقيمة العفة والإحصان في المجتمع وتأثير حضورها في كل من قانون الأسرة والقانون الجنائي، وكذلك تأثير تغييبها في القانونين معا، وذلك من خلا وقفات مع تأثيرها على أحكام الزواج وأحكام الولادة ونتائجها وأحكام الميراث، وتأثير رفع الحماية عنها من خلال رفع تجريم الفساد والخيانة الزوجية.
* بالنسبة لأحكام الزواج: عرفت مدونة الأسرة الزواج في المادة الرابعة بأنه “ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة”. وقد بينا سابقا أن أهم قيمة تحفظ بالزواج هي قيمة العفة والتماسك الأسري، الأمر الذي يعني حتما ضرورة الانتصار لهذه القيمة في القانون الجنائي وحمايتها بعقاب من ينتهك العفة ويجنح إلى الإباحية الجنسية لما في ذلك من فتح لداعية الفساد والتفكك الأسري؛ فبإباحة الزواج الذي تتحقق به قيمة العفة والإحصان يسد باب الفساد والخيانة الزوجية التي تضر بقيمة العفة والتماسك الأسري، ومن ثمة لا يعقل البتة أن يؤدي الزواج دوره في المجتمع مع رفع التجريم عن الفساد والخيانة الزوجية، كما لا يمكن لهذه الأخيرة أن تكون جائزة وفي الوقت نفسه يدعى بأن النظام القانوني القائم نظام أخلاقي قائم على القيم.
هذا وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن كلما كانت هنالك حقوق أو مؤسسات أو مراكز قانونية إلا وسعى إلى حمايتها بحسب أهميتها، فكلما كانت مقدسة إلا وكانت العقوبة جنائية لا مدنية. فحق الملكية حق مقدس حماه المشرع من خلال تجريم السرقة والنصب، والحق في الحياة مقدس فحماه بتجريم القتل، والجسد مقدس فحماه بتجريم الضرب والجرح، والاعتبار الشخصي مقدس فحماه بتجريم السب والقذف، والوطن مقدس فحماه بتجريم التآمر على النظام والإرهاب، والأموال العامة مقدسة فحماها بتجريم تبديدها، ومؤسسة الأسرة مقدسة فحماها بتجريم الفساد والخيانة الزوجية في الفصول 490 و491 من مجموعة القانون الجنائي. فالمشرع لم يضع الفصل 490 من مجموعة القانون الجنائي إلا لحماية الأسرة ولضمان هيبة الأحكام المنظمة لها المضمنة في مدونة الأسرة، فلا يمكن مطلقا إلغاء هذه العقوبة إلا إذا رفعت القداسة عن هذه المؤسسة من نفوس الأفراد أولا وعن أحكام المدونة ثانيا، وهو ما لا يمكن تصوره في مجتمعنا المغربي بقيمه وهويته وثوابته وإمارة المؤمنين فيه؛ بل بالعكس يمكن تصور تشديد العقوبة وزيادة ضمانات حماية القيم والأسرة متى تبين أن مؤشرات الردع العام في تراجع مستمر.
* بالنسبة لأحكام الولادة ونتائجها: من المقرر أن الطفل يترتب له مجموعة من الأحكام المتعلقة بالنسب والحضانة والنفقة والسكنى وغيرها من الحقوق التي هي في حقيقتها أثر من آثار الولادة الناتجة عن زواج كان من بين أغراضه صيانة قيمة العفة في المجتمع، ومن ثمة إذا تخلق عن هذه العلاقة مولود فإنه في إطار قيم التماسك الأسري ألزم أبواه بمجموعة من الواجبات التي تحفظه وهي في الوقت نفسه رغم كونها واجبات تقوي أواصر الارتباط بينهم، فإذا ما نشأ وقوي عوده وهرم أبواه كان عليه مثل ما كان على والديه في صغره من ضرورة القيام بشؤونهما ورعايتهما والإنفاق عليهما إن كانا فقيرين ما يعزز قيم التماسك والاستقرار الأسري في المجتمع؛ غير أن ما ذكرناه يتنافى مع السماح بالإنجاب خارج مؤسسة الزواج الذي يترتب عليه حرمان الابن من نسب أبيه، وقطع الآصرة معه وعدم استحقاق النفقة وما يترتب على ذلك من تشرد الطفل وتعرضه للمضايقات وغياب النصح والتأطير والتوجيه، فإذا ما كبر واشتد عوده لم يلتفت إلى من كان سببا في وجوده لعدم التعرف عليه أو لما يكنه له من حقد وكره لكونه لم يرعه في صغره. وبهذا فإن تشريع الزواج من مقتضاه تشريع الآثار المترتبة على الزواج دعما لقيم التماسك الأسري، وهي الآثار التي لا يمكن البتة ترتبها عن علاقة الفساد لطبيعتها الشرعية المستمدة من الهوية المغربية، وبالتالي فلا ينتظر من إباحة الفساد إلا تضييق لباب الزواج والأبناء الشرعيين، وتوسيع لدائرة أبناء الزنى، ومن ثمة هدم لاستقرار الأسرة وإشاعة للتفكك الأسري.
وأمام وضع قانوني وواقعي كهذا، فإنه لا يمكن مطلقا في ظل المنظومة القانونية الأسرية الحالية الاستجابة لمطلب إلغاء تجريم الفساد والسماح بالعلاقات المحرمة لما يتعلق بذلك من آثار ترتبط بالولادات التي ستزداد خارج فراش الزوجية وحقوق هؤلاء الأولاد الذين لا يمكن للمشرع أن يسمح بالاعتداء عليهم لمجرد شهوة عابرة أو نزوة ثائرة اعترت آباءهم البيولوجيين على قارعة طريق مقفر، كما لا يمكنه أيضا أن يغير أحكام الأسرة كي تتلاءم مع وضعهم الشاذ وأنانيتهم المقيتة التي تبتعد عن الإنسانية وتنزع إلى البهيمية التي لا تراعي وقار الكبير ولا حق صغير.
* بالنسبة لأحكام الميراث: من المعلوم أن من أسباب الإرث النسب والسبب، فأما النسب فإن السماح بالعلاقات المحرمة سيعدمه حتما، إذ سينتفي النسب فلا أبوة في الزنى ولا بنوة ولا أخوة ولاعمومة ولا غيرها؛ وكذلك السبب الذي يتحدد في العلاقة الزوجية التي تسمح بإرث الزوج في تركة زوجته وإرث الزوجة في تركة زوجها، فلا يمكن للخليلة ولا لخليلها أن يرث بعضهم من بعض، الأمر الذي يعني لزاما أن السماح بالعلاقات المحرمة ورفع التجريم عنها يلزم منه تغيير أحكام الإرث وأسبابه بما يسمح بتوارث هذه الفئة أو على الأقل تنظيم انتقال الأموال فيما بينها، وهو ما لا يمكن تصوره مطلقا في ظل المنظومة القانونية الأسرية الحالية بقيمها الأخلاقية ومرجعيتها الإسلامية وهويتها المغربية الأصيلة.
خاتمة:
إن الحديث عن الثابت والمتغير في أحكام قانون الأسرة والقانون الجنائي، يحيلنا إلى الحديث عن ثوابت أمة بأجمعها أجمعت على اعتبار القيم في حياتها صمام أمان لما يتهددها من أخطار متلاحقة نتيجة التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية والمجتمعية المتسارعة يوما بعد يوم، والتي يرى البعض بأن “العالم، بلا شك، مقبل على تحول أخلاقي عميق في ظل ما يشهده من تحولات متلاحقة في جميع مناحي الحياة الفردية وميادين الحياة المجتمعية، وإذا كان لا بد لهذه التحولات المختلفة من أن تفرز قيما ومبادئ ومعايير أخلاقية جديدة، فلا يبعد أن يلجأ سادة العالم إلى وضع نظام أخلاقي عالمي جديد كما هو شأنهم مع النظام التجاري العالمي، وإن كان هذا النظام الأخلاقي الجديد قد لا يرى النور إلا بعد الفراغ من سلسلة من أنظمة عالمية متعددة أخرى: اقتصادية وسياسية وعسكرية وإعلامية وثقافية؛ ومرد هذا التأخير إلى سيادة تصور للأخلاق يجعلها تابعة ولاحقة لهذه الأنظمة الأخرى، لا متبوعة وسابقة عليها”.
لأجل ذلك كانت القيم هي الضمانة الأساسية لحماية المجتمع من الانحرافات السلوكية التي تتصدى القاعدة القانونية بما فيها من معايير وأبعاد أخلاقية قيمية لدفعها، ومن ثم تعزيز الاستقرار والرخاء المجتمعي.
لائحة المراجع:
كتب اللغة والمعاجم:
– ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، المكتبة العلمية، بيروت، 1979 م، تحقيق طاهر أحمد الزاوى – محمود محمد الطناحي، ج 4.
– ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ، ج 12.
– إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، ط 1، 1994 م، ج 6.
– محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1، 2001م، ج 9.
– محمّد مرتضى الحسيني الزَّبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، ج 33.
– نشوان بن سعيد الحميرى اليمني، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق د حسين بن عبد الله العمري – مطهر بن علي الإرياني – د يوسف محمد عبد الله، دار الفكر المعاصر (بيروت – لبنان)، دار الفكر (دمشق – سورية)، ط 1، 1999 م، ج 8.
الكتب الفقه والتاريخ والرقائق:
– ابن خلدون، المقدمة، مطبعة مصطفى محمد.
– أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة – بيروت، ج 4.
– القاضي عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة «الإمام مالك بن أنس»، تحقيق ودراسة: حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز – مكة المكرمة، ج 2.
– علي بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1983م، ط 1.
– مجموعة من المؤلفين، نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط 4، ج 6.
كتب الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم التربية وعلم القانون:
– أحمد حسن القواسمة، عايد بن علي البلوي، منظومة القيم الجامعية.
– أحمد حسن القواسمة، عايد بن علي البلوي، منظومة القيم الجامعية، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ط 1، 2015.
– أحمد علي كنعان، أدب الأطفال والقيم التربوية، دار الفكر المعاصر.
– رجاء ناجي، مدخل للعلوم القانونية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1998.
– طه عبد الرحمان، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 2006. ط 2.
– طه عبد الرحمان، تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 5، 2016 م.
– طه عبد الرحمان، سؤال الأخلاق – مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2000.
– محمد عابد الجابري، العقل الأخلاقي العربي – دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2001، ط 1.
– محمود نعمان، موجز المدخل للقانون، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1975 م.
الخطب الملكية:
– خطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2022.
– خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.