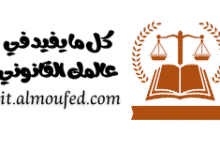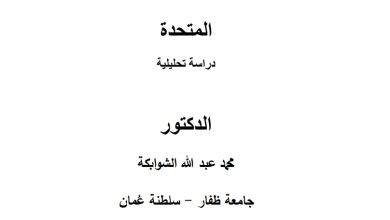التكييف القانوني للتورق المصرفي في ليبيا: بين الحاجة العملية والفراغ التشريعي الأستاذة : وفاء ميلود ساسي الجبالي
[]
التكييف القانوني للتورق المصرفي في ليبيا: بين الحاجة العملية والفراغ التشريعي
The Legal Characterization of Banking Tawarruq in Libya: Between Practical Necessity and Legislative
Vacuum
الأستاذة : وفاء ميلود ساسي الجبالي
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس_ كلية القانون طرابلس_ ليبيا
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665

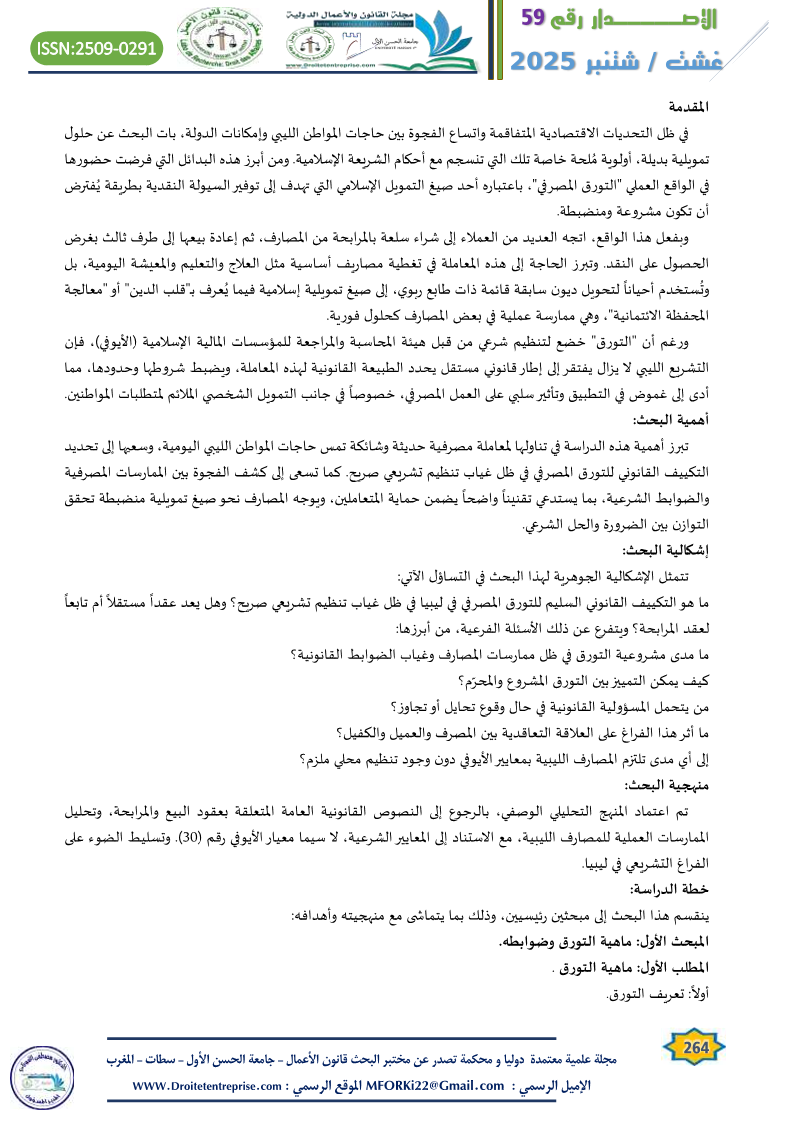
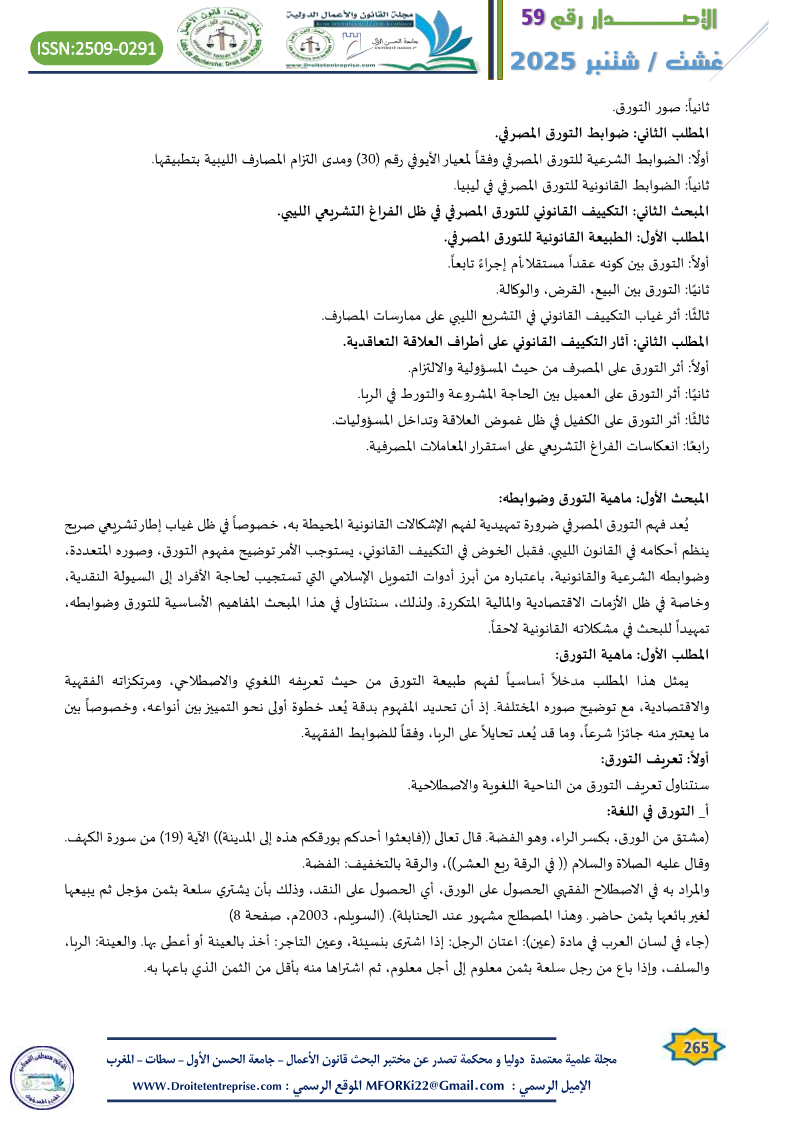
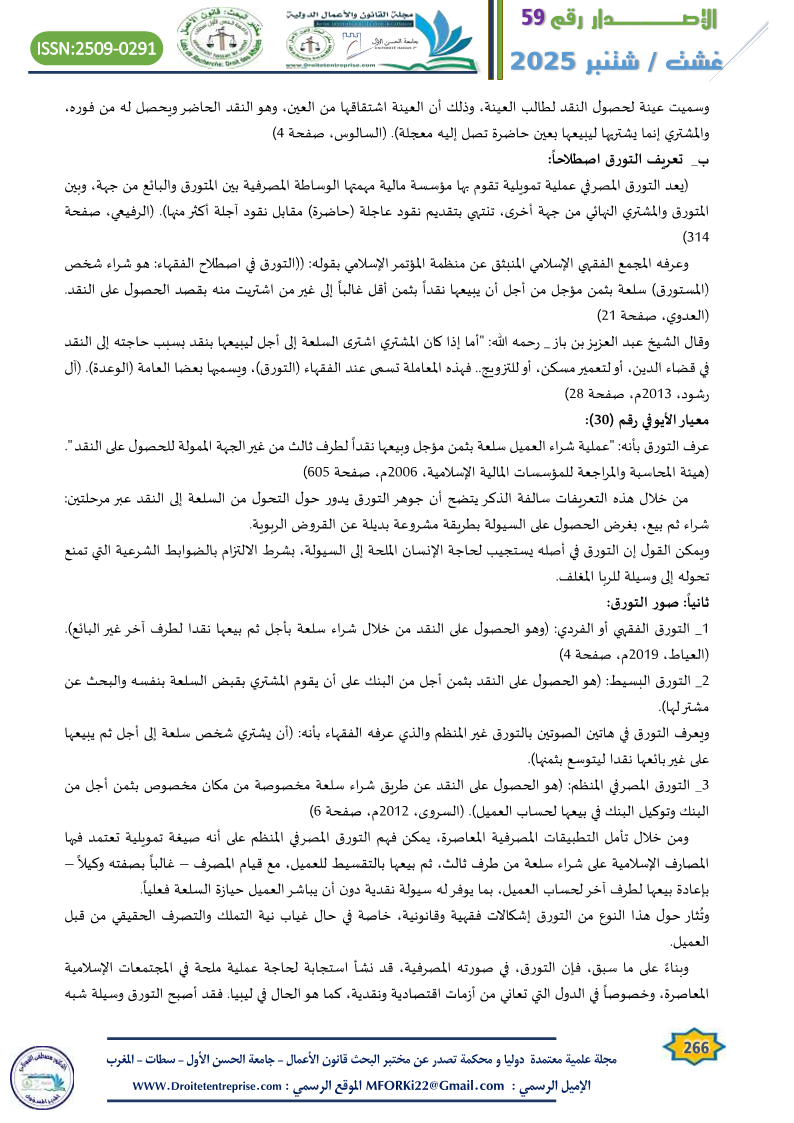
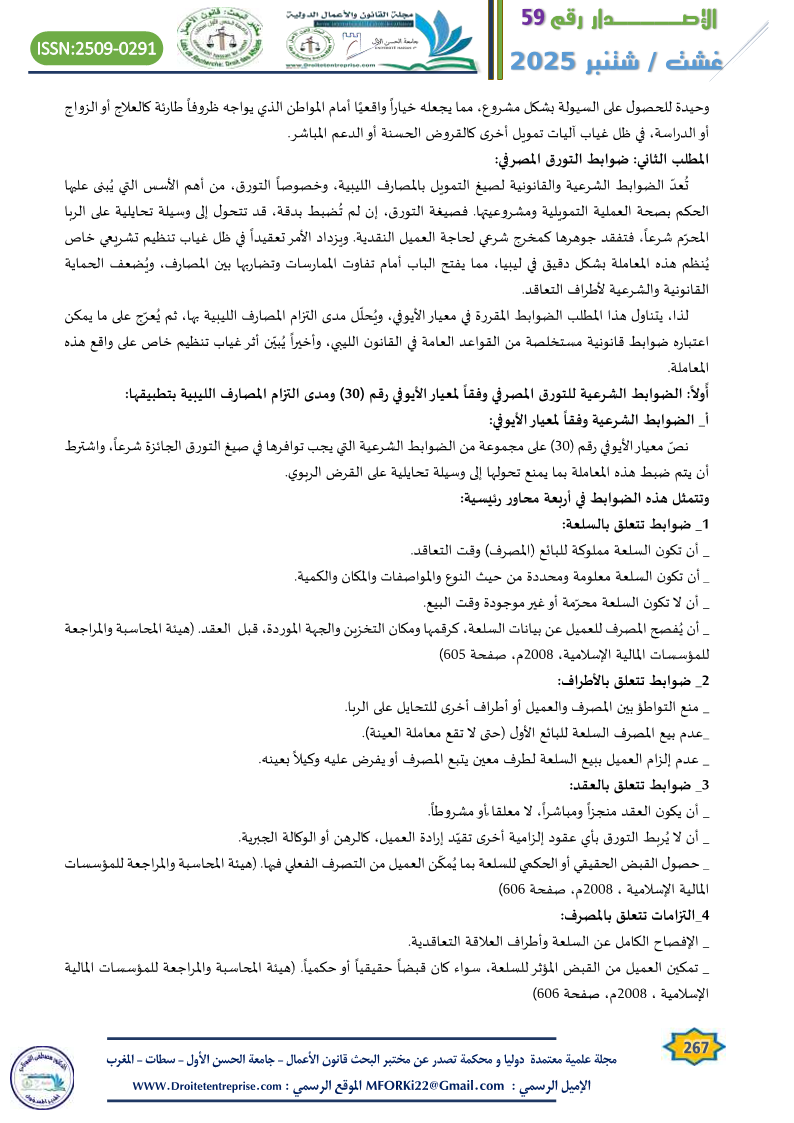


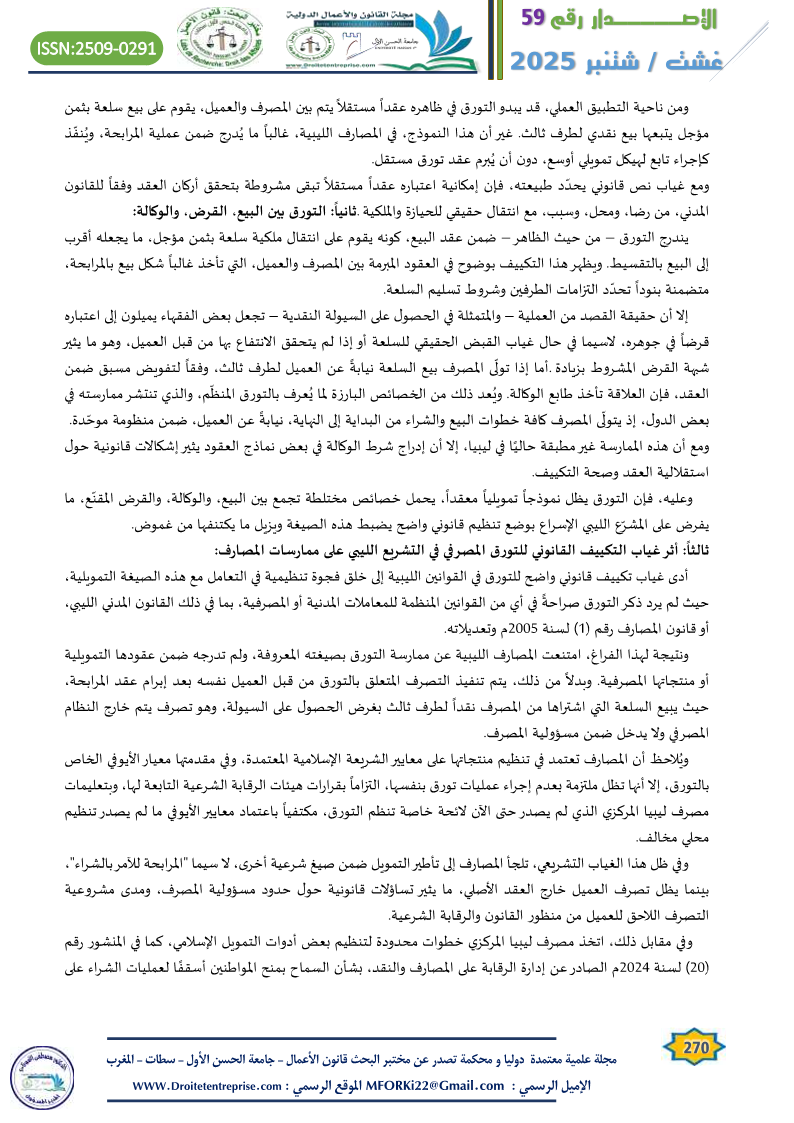
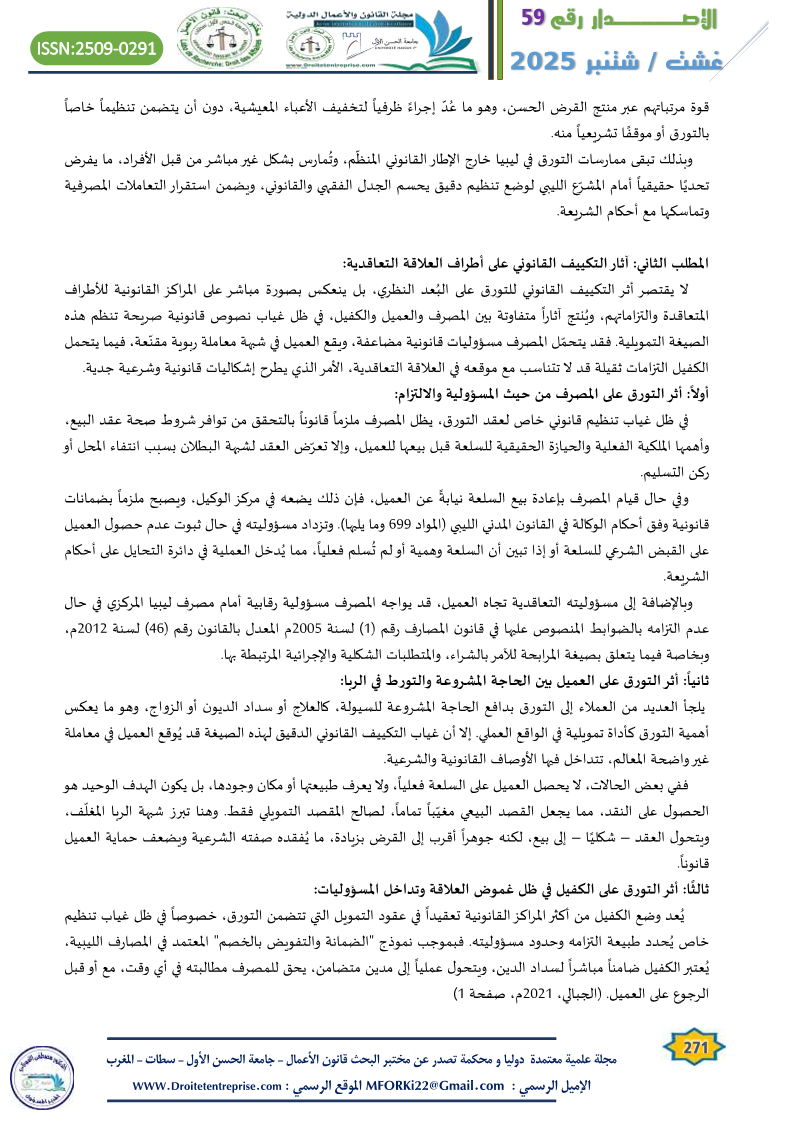
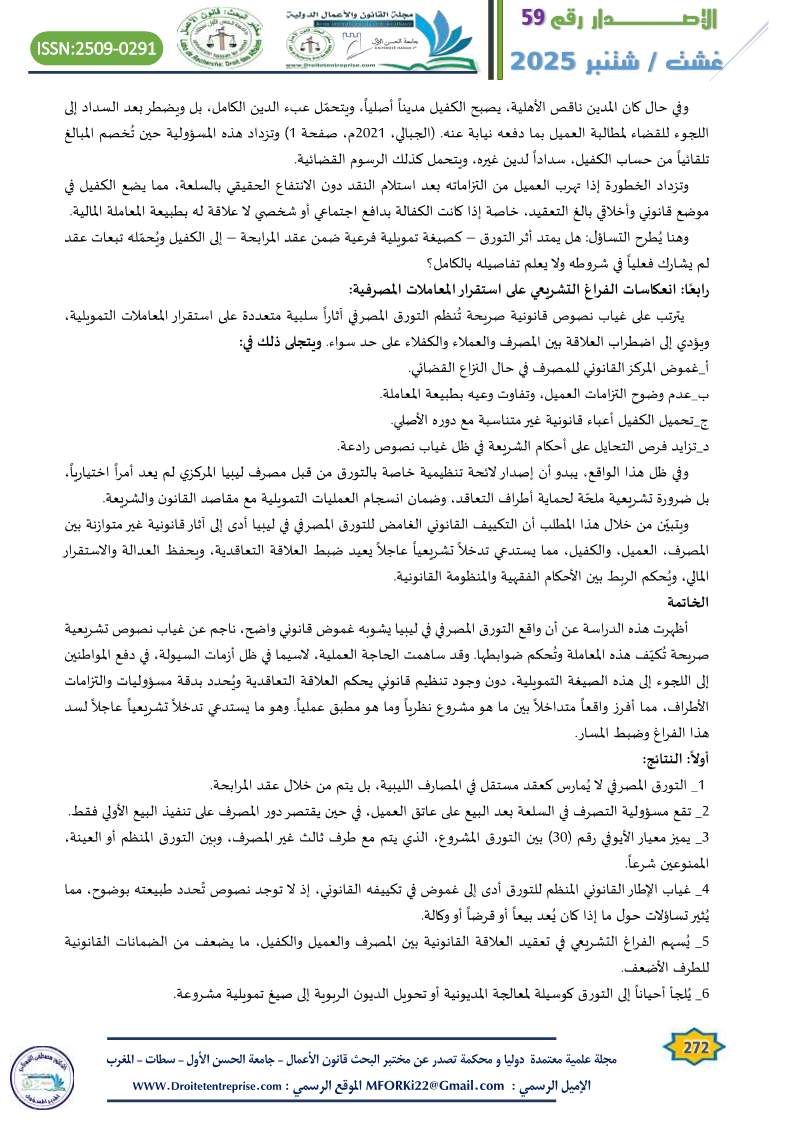

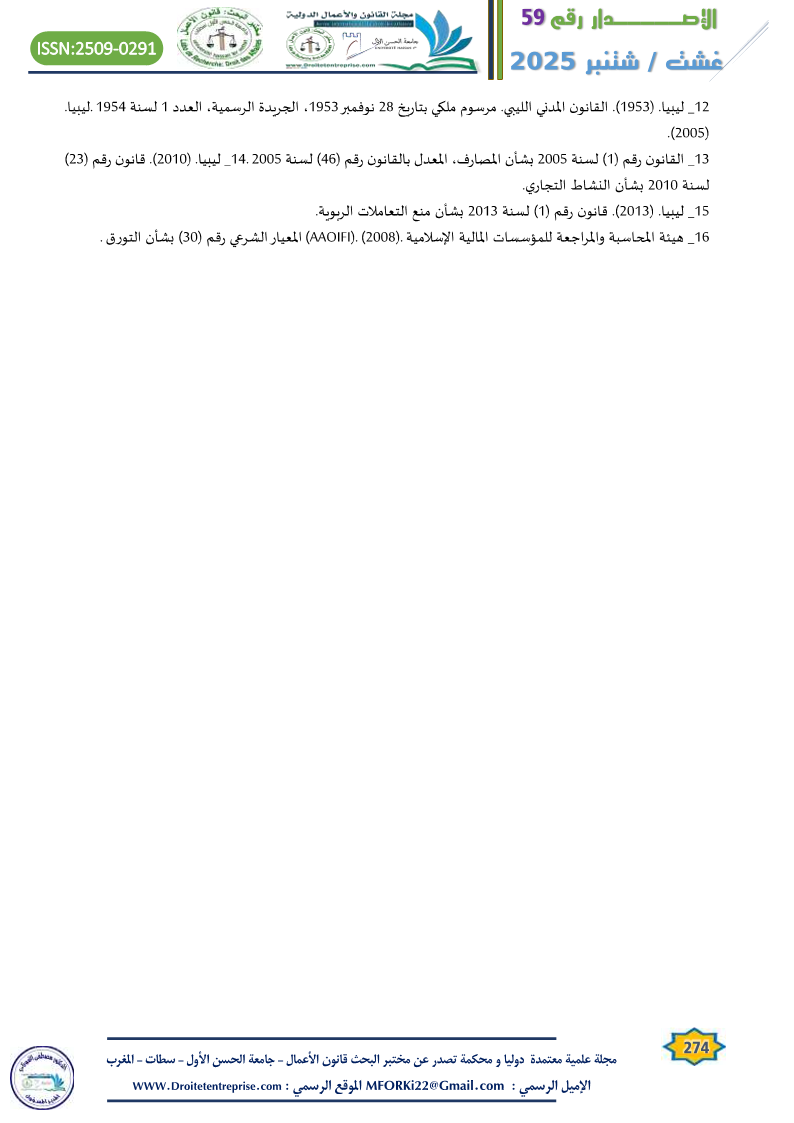
التكييف القانوني للتورق المصرفي في ليبيا: بين الحاجة العملية والفراغ التشريعي
The Legal Characterization of Banking Tawarruq in Libya: Between Practical Necessity and Legislative
Vacuum
الأستاذة : وفاء ميلود ساسي الجبالي
عضو هيئة تدريس بجامعة طرابلس_ كلية القانون طرابلس_ ليبيا
ملخص الدراسة:
شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة تزايدا في الاعتماد على آليات التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها “التورق المصرفي”، كأداة لتوفير السيولة النقدية للمواطن في ظل ضعف السياسات الاقتصادية وتراجع الخدمات الأساسية. إلا أن غياب تنظيم قانوني خاص بهذه الصيغة التمويليـة، خلق حالة من الغموض حول طبيعتها القانونية، خاصة مع ممارسة التورق خارج المصرف من قبل العميل نفسه. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل التكييف القانوني للتورق المصرفي في ليبيا، والكشف عن آثاره القانونية والشرعية في ظل الفراغ التشريعي، مع التركيز على واقع ممارسته في بعض المصارف الليبية، ومدى توافقه مع معايير الهيئة الشرعية للمحاسبة والمراجعة (AAOIFI)، وذلك من خلال منهج تحليلي قانوني يستند إلى النصوص العامة والشواهد الفقهية والتطبيقية. وخلصت الدراسة إلى وجود ضرورة ملحة لتنظيم التورق تشريعياً؛ لضمان المشروعية وحماية حقوق الأطراف، وتقنين الممارسات المصرفية بما يحقق التوازن بين الحاجة التمويلية والضوابط الشرعية والقانونية.
الكلمات المفتاحية: التورق المصرفي، الصيغة التمويلية، الفراغ التشريعي، العميل، المصرف.
Abstract :
In recent years, Libya has witnessed a growing reliance on Islamic financing instruments, most notably “banking Tawarruq,” as a means of providing cash liquidity amid economic hardship and declining public services. However, the absence of a clear legal framework governing this financial mechanism has led to ambiguity regarding its legal nature, particularly as Tawarruq is often practiced by clients outside the bank. This study aims to analyze the legal characterization of banking Tawarruq in Libya and its implications under the current legislative vacuum. It focuses on its practical implementation in some Libyan banks and the extent to which it complies with the standards of the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Using an analytical legal methodology, the study draws upon general legal provisions, Islamic jurisprudence, and real-life banking practices. The findings underscore the urgent need for legislative regulation of Tawarruq to ensure its legitimacy, protect stakeholders’ rights, and align financial practices with both Shariah and legal requirements. Keywords: Banking Tawarruq, financing instrument, legislative vacuum, client, bank.
المقدمة
في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة واتساع الفجوة بين حاجات المواطن الليبي وإمكانات الدولة، بات البحث عن حلول تمويلية بديلة، أولوية مُلحة خاصة تلك التي تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن أبرز هذه البدائل التي فرضت حضورها في الواقع العملي “التورق المصرفي”، باعتباره أحد صيغ التمويل الإسلامي التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية بطريقة يُفترض أن تكون مشروعة ومنضبطة.
وبفعل هذا الواقع، اتجه العديد من العملاء إلى شراء سلعة بالمرابحة من المصارف، ثم إعادة بيعها إلى طرف ثالث بغرض الحصول على النقد. وتبرز الحاجة إلى هذه المعاملة في تغطية مصاريف أساسية مثل العلاج والتعليم والمعيشة اليومية، بل وتُستخدم أحياناً لتحويل ديون سابقة قائمة ذات طابع ربوي، إلى صيغ تمويلية إسلامية فيما يُعرف بـ”قلب الدين” أو “معالجة المحفظة الائتمانية”، وهي ممارسة عملية في بعض المصارف كحلول فورية.
ورغم أن “التورق” خضع لتنظيم شرعي من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي)، فإن التشريع الليبي لا يزال يفتقر إلى إطار قانوني مستقل يحدد الطبيعة القانونية لهذه المعاملة، ويضبط شروطها وحدودها، مما أدى إلى غموض في التطبيق وتأثير سلبي على العمل المصرفي، خصوصاً في جانب التمويل الشخصي الملائم لمتطلبات المواطنين.
أهمية البحث:
تبرز أهمية هذه الدراسة في تناولها لمعاملة مصرفية حديثة وشائكة تمس حاجات المواطن الليبي اليومية، وسعيها إلى تحديد التكييف القانوني للتورق المصرفي في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح. كما تسعى إلى كشف الفجوة بين الممارسات المصرفية والضوابط الشرعية، بما يستدعي تقنيناً واضحاً يضمن حماية المتعاملين، ويوجه المصارف نحو صيغ تمويلية منضبطة تحقق التوازن بين الضرورة والحل الشرعي.
إشكالية البحث:
تتمثل الإشكالية الجوهرية لهذا البحث في التساؤل الآتي:
ما هو التكييف القانوني السليم للتورق المصرفي في ليبيا في ظل غياب تنظيم تشريعي صريح؟ وهل يعد عقداً مستقلاً أم تابعاً لعقد المرابحة؟ ويتفرع عن ذلك الأسئلة الفرعية، من أبرزها:
ما مدى مشروعية التورق في ظل ممارسات المصارف وغياب الضوابط القانونية؟
كيف يمكن التمييز بين التورق المشروع والمحرّم؟
من يتحمل المسؤولية القانونية في حال وقوع تحايل أو تجاوز؟
ما أثر هذا الفراغ على العلاقة التعاقدية بين المصرف والعميل والكفيل؟
إلى أي مدى تلتزم المصارف الليبية بمعايير الأيوفي دون وجود تنظيم محلي ملزم؟
منهجية البحث:
تم اعتماد المنهج التحليلي الوصفي، بالرجوع إلى النصوص القانونية العامة المتعلقة بعقود البيع والمرابحة، وتحليل الممارسات العملية للمصارف الليبية، مع الاستناد إلى المعايير الشرعية، لا سيما معيار الأيوفي رقم (30). وتسليط الضوء على الفراغ التشريعي في ليبيا.
خطة الدراسة:
ينقسم هذا البحث إلى مبحثين رئيسيين، وذلك بما يتماشى مع منهجيته وأهدافه:
المبحث الأول: ماهية التورق وضوابطه.
المطلب الأول: ماهية التورق .
أولاً: تعريف التورق.
ثانياً: صور التورق.
المطلب الثاني: ضوابط التورق المصرفي.
أولًا: الضوابط الشرعية للتورق المصرفي وفقاً لمعيار الأيوفي رقم (30) ومدى التزام المصارف الليبية بتطبيقها.
ثانياً: الضوابط القانونية للتورق المصرفي في ليبيا.
المبحث الثاني: التكييف القانوني للتورق المصرفي في ظل الفراغ التشريعي الليبي.
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للتورق المصرفي.
أولاً: التورق بين كونه عقداً مستقلا ًأم إجراءً تابعاً.
ثانيًا: التورق بين البيع، القرض، والوكالة.
ثالثًا: أثر غياب التكييف القانوني في التشريع الليبي على ممارسات المصارف.
المطلب الثاني: آثار التكييف القانوني على أطراف العلاقة التعاقدية.
أولاً: أثر التورق على المصرف من حيث المسؤولية والالتزام.
ثانيًا: أثر التورق على العميل بين الحاجة المشروعة والتورط في الربا.
ثالثًا: أثر التورق على الكفيل في ظل غموض العلاقة وتداخل المسؤوليات.
رابعًا: انعكاسات الفراغ التشريعي على استقرار المعاملات المصرفية.
المبحث الأول: ماهية التورق وضوابطه:
يُعد فهم التورق المصرفي ضرورة تمهيدية لفهم الإشكالات القانونية المحيطة به، خصوصاً في ظل غياب إطار تشريعي صريح ينظم أحكامه في القانون الليبي. فقبل الخوض في التكييف القانوني، يستوجب الأمر توضيح مفهوم التورق، وصوره المتعددة، وضوابطه الشرعية والقانونية، باعتباره من أبرز أدوات التمويل الإسلامي التي تستجيب لحاجة الأفراد إلى السيولة النقدية، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية المتكررة. ولذلك، سنتناول في هذا المبحث المفاهيم الأساسية للتورق وضوابطه، تمهيداً للبحث في مشكلاته القانونية لاحقاً.
المطلب الأول: ماهية التورق:
يمثل هذا المطلب مدخلاً أساسياً لفهم طبيعة التورق من حيث تعريفه اللغوي والاصطلاحي، ومرتكزاته الفقهية والاقتصادية، مع توضيح صوره المختلفة. إذ أن تحديد المفهوم بدقة يُعد خطوة أولى نحو التمييز بين أنواعه، وخصوصاً بين ما يعتبر منه جائزا شرعاً، وما قد يُعد تحايلاً على الربا، وفقاً للضوابط الفقهية.
أولاً: تعريف التورق:
سنتناول تعريف التورق من الناحية اللغوية والاصطلاحية.
أ_ التورق في اللغة:
(مشتق من الورق، بكسر الراء، وهو الفضة. قال تعالى ((فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة)) الآية (19) من سورة الكهف.
وقال عليه الصلاة والسلام (( في الرقة ربع العشر))، والرقة بالتخفيف: الفضة.
والمراد به في الاصطلاح الفقهي الحصول على الورق، أي الحصول على النقد، وذلك بأن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لغير بائعها بثمن حاضر. وهذا المصطلح مشهور عند الحنابلة). (السويلم، 2003م، صفحة 8)
(جاء في لسان العرب في مادة (عين): اعتان الرجل: إذا اشترى بنسيئة، وعين التاجر: أخذ بالعينة أو أعطى بها. والعينة: الربا، والسلف، وإذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به.
وسميت عينة لحصول النقد لطالب العينة، وذلك أن العينة اشتقاقها من العين، وهو النقد الحاضر ويحصل له من فوره، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة). (السالوس، صفحة 4)
ب_ تعريف التورق اصطلاحاً:
(يعد التورق المصرفي عملية تمويلية تقوم بها مؤسسة مالية مهمتها الوساطة المصرفية بين المتورق والبائع من جهة، وبين المتورق والمشتري النهائي من جهة أخرى، تنتهي بتقديم نقود عاجلة (حاضرة) مقابل نقود آجلة أكثر منها). (الرفيعي، صفحة 314)
وعرفه المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي بقوله: ((التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء شخص (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إلى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على النقد. (العدوي، صفحة 21)
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز _ رحمه الله: “أما إذا كان المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد بسبب حاجته إلى النقد في قضاء الدين، أو لتعمير مسكن، أو للتزويج.. فهذه المعاملة تسمى عند الفقهاء (التورق)، ويسميها بعضا العامة (الوعدة). (آل رشود، 2013م، صفحة 28)
معيار الأيوفي رقم (30):
عرف التورق بأنه: “عملية شراء العميل سلعة بثمن مؤجل وبيعها نقداً لطرف ثالث من غير الجهة الممولة للحصول على النقد.” (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 2006م، صفحة 605)
من خلال هذه التعريفات سالفة الذكر يتضح أن جوهر التورق يدور حول التحول من السلعة إلى النقد عبر مرحلتين: شراء ثم بيع، بغرض الحصول على السيولة بطريقة مشروعة بديلة عن القروض الربوية.
ويمكن القول إن التورق في أصله يستجيب لحاجة الإنسان الملحة إلى السيولة، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية التي تمنع تحوله إلى وسيلة للربا المغلف.
ثانياً: صور التورق:
1_ التورق الفقهي أو الفردي: (وهو الحصول على النقد من خلال شراء سلعة بأجل ثم بيعها نقدا لطرف آخر غير البائع). (العياط، 2019م، صفحة 4)
2_ التورق البسيط: (هو الحصول على النقد بثمن أجل من البنك على أن يقوم المشتري بقبض السلعة بنفسه والبحث عن مشتر لها).
ويعرف التورق في هاتين الصوتين بالتورق غير المنظم والذي عرفه الفقهاء بأنه: (أن يشتري شخص سلعة إلى أجل ثم يبيعها على غير بائعها نقدا ليتوسع بثمنها).
3_ التورق المصرفي المنظم: (هو الحصول على النقد عن طريق شراء سلعة مخصوصة من مكان مخصوص بثمن أجل من البنك وتوكيل البنك في بيعها لحساب العميل). (السروى، 2012م، صفحة 6)
ومن خلال تأمل التطبيقات المصرفية المعاصرة، يمكن فهم التورق المصرفي المنظم على أنه صيغة تمويلية تعتمد فيها المصارف الإسلامية على شراء سلعة من طرف ثالث، ثم بيعها بالتقسيط للعميل، مع قيام المصرف – غالباً بصفته وكيلاً – بإعادة بيعها لطرف آخر لحساب العميل، بما يوفر له سيولة نقدية دون أن يباشر العميل حيازة السلعة فعلياً.
وتُثار حول هذا النوع من التورق إشكالات فقهية وقانونية، خاصة في حال غياب نية التملك والتصرف الحقيقي من قبل العميل.
وبناءً على ما سبق، فإن التورق، في صورته المصرفية، قد نشأ استجابة لحاجة عملية ملحة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وخصوصاً في الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية ونقدية، كما هو الحال في ليبيا. فقد أصبح التورق وسيلة شبه وحيدة للحصول على السيولة بشكل مشروع، مما يجعله خياراً واقعيًا أمام المواطن الذي يواجه ظروفاً طارئة كالعلاج أو الزواج أو الدراسة، في ظل غياب آليات تمويل أخرى كالقروض الحسنة أو الدعم المباشر.
المطلب الثاني: ضوابط التورق المصرفي:
تُعدّ الضوابط الشرعية والقانونية لصيغ التمويل بالمصارف الليبية، وخصوصاً التورق، من أهم الأسس التي يُبنى عليها الحكم بصحة العملية التمويلية ومشروعيتها. فصيغة التورق، إن لم تُضبط بدقة، قد تتحول إلى وسيلة تحايلية على الربا المحرّم شرعاً، فتفقد جوهرها كمخرج شرعي لحاجة العميل النقدية. ويزداد الأمر تعقيداً في ظل غياب تنظيم تشريعي خاص يُنظم هذه المعاملة بشكل دقيق في ليبيا، مما يفتح الباب أمام تفاوت الممارسات وتضاربها بين المصارف، ويُضعف الحماية القانونية والشرعية لأطراف التعاقد.
لذا، يتناول هذا المطلب الضوابط المقررة في معيار الأيوفي، ويُحلّل مدى التزام المصارف الليبية بها، ثم يُعرّج على ما يمكن اعتباره ضوابط قانونية مستخلصة من القواعد العامة في القانون الليبي، وأخيراً يُبيّن أثر غياب تنظيم خاص على واقع هذه المعاملة.
أًولاً: الضوابط الشرعية للتورق المصرفي وفقاً لمعيار الأيوفي رقم (30) ومدى التزام المصارف الليبية بتطبيقها:
أ_ الضوابط الشرعية وفقاً لمعيار الأيوفي:
نصّ معيار الأيوفي رقم (30) على مجموعة من الضوابط الشرعية التي يجب توافرها في صيغ التورق الجائزة شرعاً، واشترط أن يتم ضبط هذه المعاملة بما يمنع تحولها إلى وسيلة تحايلية على القرض الربوي.
وتتمثل هذه الضوابط في أربعة محاور رئيسية:
1_ ضوابط تتعلق بالسلعة:
_ أن تكون السلعة مملوكة للبائع (المصرف) وقت التعاقد.
_ أن تكون السلعة معلومة ومحددة من حيث النوع والمواصفات والمكان والكمية.
_ أن لا تكون السلعة محرّمة أو غير موجودة وقت البيع.
_ أن يُفصح المصرف للعميل عن بيانات السلعة، كرقمها ومكان التخزين والجهة الموردة، قبل العقد. (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 2008م، صفحة 605)
2_ ضوابط تتعلق بالأطراف:
_ منع التواطؤ بين المصرف والعميل أو أطراف أخرى للتحايل على الربا.
_عدم بيع المصرف السلعة للبائع الأول (حتى لا تقع معاملة العينة).
_ عدم إلزام العميل ببيع السلعة لطرف معين يتبع المصرف أو يفرض عليه وكيلاً بعينه.
3_ ضوابط تتعلق بالعقد:
_ أن يكون العقد منجزاً ومباشراً، لا معلقا ًأو مشروطاً.
_ أن لا يُربط التورق بأي عقود إلزامية أخرى تقيّد إرادة العميل، كالرهن أو الوكالة الجبرية.
_ حصول القبض الحقيقي أو الحكمي للسلعة بما يُمكّن العميل من التصرف الفعلي فيها. (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 2008م، صفحة 606)
4_التزامات تتعلق بالمصرف:
_ الإفصاح الكامل عن السلعة وأطراف العلاقة التعاقدية.
_ تمكين العميل من القبض المؤثر للسلعة، سواء كان قبضاً حقيقياً أو حكمياً. (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، 2008م، صفحة 606)
ب_مدى التزام المصارف الليبية بالضوابط الشرعية الصادرة عن هيئة الأيوفي:
من خلال الواقع العملي للمصارف الليبية، سواء التجارية أو الإسلامية، ومن خلال الاطلاع على بعض نماذج العقود، يتبيّن أن أغلب المصارف تلتزم – شكلياً – بالمعايير الصادرة عن هيئة الأيوفي. ومن أمثلة ذلك:
_ ما ورد في المادة الأولى من عقد بيع سلعة بالمرابحة لأحد المصارف التجارية في ليبيا. حيث نصت على أن “الطرف الأول (المصرف) يبيع للطرف الثاني (العميل) سلعة بمواصفات متمثلة في نوع السلعة، الكمية، سنة الصنع، بلد الصنع، الرقم التسلسلي، مستندات الملكية، وغيرها، إضافة إلى تحديد المبلغ وموعد تسليم السلعة”.
وهذا يُعد التزاماً صريحاً من المصرف ببيان مواصفات السلعة وتمكين العميل من العلم بها قبل التعاقد، وفق معيار الأيوفي رقم (30).
كما تنص التشريعات المنظمة للعمل المصرفي في ليبيا، وعلى رأسها القانون رقم (1) لسنة 2005م، بشأن المصارف والمُعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، على التزام المصارف الإسلامية بالصيغ التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على نحو ما ورد في المادة (100مكررة 7) منه، وكذلك نص المادة (100 مكررة 8) التي تقضي ” بضرورة مراجعة يومية للأعمال المصرفية وفقاً للمعايير الدولية المُقررة في شأن تدقيق العمليات المصرفية الإسلامية، من قبل إدارة المراجعة والتدقيق الشرعي في كل مصرف”
وقد اتضح من خلال الدراسة الميدانية لواقع المصارف الليبية (سواء التجارية أو الإسلامية)، أنها تُمارس نشاطها وفق صيغ التمويل الإسلامي، مما يجعل هذا الالتزام مُطبقاً فعلياً على مُجمل القطاع المصرفي في ليبيا.
أما من حيث التطبيق العملي، فتؤكد الهيئة المركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا المركزي على منع صور التورق التي تُخفي الربا أو تتحايل عليه، مثل:
_ غياب السلعة أو البائع الحقيقي.
_ العقود الصورية أو التواطؤ بين المصرف والعميل.
_ البيع للمالك الأول (العينة).
لكن الهيئة لا تمنع التورق المشروع، الذي يُستكمل فيه انتقال الملكية للعميل، وتُستوفى فيه شروط القبض، ويقوم فيه العميل بالبيع لطرف أجنبي، بعد انتهاء دور المصرف في التمليك وانتقال ملكية السلعة للعميل.
ثانياً: الضوابط القانونية للتورق المصرفي في ليبيا:
رغم استخدام التورق المصرفي كأحد أدوات التمويل في أغلب المصارف الليبية، إلا أنه لا يوجد تنظيم قانوني خاص بهذه الصيغة في المنظومة التشريعية الليبية، كما لا يُعد “عقد التورق” عقداً مستقلاً من عقود المعاملات المدنية أو التجارية المعروفة قانوناً.
أ_ غياب ضوابط قانونية خاصة:
لا يوجد نص قانوني يحدّد طبيعة التورق أو شروطه أو تنظيمه كصيغة تمويل مستقلة. غير أن بعض النصوص العامة يُمكن الاستناد إليها، وفي مقدمتها:
المادة رقم (1) من قانون منع المعاملات الربوية لسنة 2013م، والتي تنص على أن: “يمنع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية و التجارية التي تجرى بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، ويبطل بطلاناً مطلقاً كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة”.
كذلك نصت المادة (100 مكررة 5) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، والتي تنص على أن: على أنه “للمصرف المركزي إصدار الضوابط والتعليمات المنظمة لعمل المصارف الإسلامية، بما يضمن توافق أنشطتها مع الشريعة الإسلامية”.
ونصت المادة (100 مكررة 5/4) من نفس القانون، على أن: “يجوز للمصارف المُرخص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية، القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، وغيرها من صيغ العقود التكميلية”
ورغم وجود هذه النصوص، إلا أنها لا توفر إطاراً قانونياً دقيقاً يُمكن الرجوع إليه عند نشوء نزاع يتعلق بصحة معاملة التورق، أو عند وقوع إخلال بضوابطها الشرعية من أي طرف. ويختلف الأمر بالنسبة لعقد المرابحة بالمصارف الليبية، إذ يخضع لتنظيم واضح وفقاً للمعيار رقم (1) الصادر عن لجنة المعايير ونُظم الصيرفة الإسلامية، بمصرف ليبيا المركزي والذي تم اعتماده بقرار رسمي، ويضم مجموعة من المتطلبات القانونية والضوابط المصرفية المنظمة لبيع المرابحة للآمر بالشراء.
المبحث الثاني: التكييف القانوني للتورق المصرفي في ظل الفراغ التشريعي الليبي:
يمثل التكييف القانوني للتورق المصرفي إحدى القضايا المحورية التي تُثير جدلاً فقهياً وقانونياً واسعاً، ولا سيما في ظل غياب تشريع صريح يُنظم هذه الصيغة التمويلية في القطاع المصرفي الليبي. وتتجلى أهمية هذا التكييف في ما يترتب عليه من آثار قانونية على أطراف العلاقة التعاقدية، لا سيما في ظل تزايد الاعتماد على التورق كوسيلة للتمويل من قبل الأفراد والجهات الاعتبارية.
ويُثيرغياب التنظيم التشريعي جملة من الإشكاليات القانونية، تتعلق بتحديد الطبيعة العقدية للتورق، وانعكاسها على التزامات المصرف والعميل، ومدى مشروعيته من منظور قانوني.
المطلب الأول: الطبيعة القانونية للتورق المصرفي:
يعد تحديد الطبيعة القانونية للتورق الخطوة الأولى لفهم العلاقة التعاقدية الناشئة عنه.
فهل يُعد التورق عقداً مالياً قائماً بذاته أم مجرد إجراء تابع لعقد آخر كعقد المرابحة؟ وهل يُصنف قانوناً ضمن عقود البيع، أم القرض، أم الوكالة؟
إن الإجابة على هذه التساؤلات تستوجب الرجوع إلى المبادئ العامة للقانون المدني الليبي، واستقراء الواقع العملي داخل المصارف، إلى جانب المُقارنة بالمعايير الدولية المتعمدة مثل معيار الأيوفي، مما يُفسح المجال لدراسة مركبة تُقارن بين ما هو معمول به وبين ما يجب أن يكون عليه الوضع من الناحية القانونية.
أولًا: التورق بين كونه عقدًا مستقلاً أم إجراءً تابعاً:
لم يُصنّف المشرّع الليبي “التورق” ضمن العقود المسماة في القانون المدني الصادر سنة 1953م، كما لم يرد له تنظيم خاص في قانون النشاط التجاري رقم (23) لسنة 2010م، أو في لوائحه التنفيذية.ولا في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته. وهو ما أفسح المجال لاجتهادات فقهية وقانونية بشأن طبيعته القانونية.
ورغم هذا الفراغ التشريعي، فإن بعض النصوص القانونية توحي ضمناً بأن التورق ليس عقداً قائماً بذاته، بل “صيغة تمويلية”، كما ورد في المادة (100 مكرر 7) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف، المُعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، والتي تنص على أن: “تتولى هيئة الرقابة الشرعية في كل مصرف اعتماد صيغ العقود اللازمة لأنشطة المصرف الإسلامي وأعماله.” كما نصت المادة (100 مكرر3) من القانون نفسه على أن: “يجوز للمصارف المُرخّص لها بممارسة أنشطة الصيرفة الإسلامية القيام بعمليات التمويل للأنشطة الاقتصادية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام العقود الشرعية، وغيرها من صيغ العقود التكميلية.” ويُفهم من ذلك أن المشرّع اعتبر التورق “صيغة” لا “عقداً”، وهو تكييف له دلالته القانونية؛ إذ يُبقي التورق خارج التصنيف الصريح للعقود المنصوص عليها قانوناً، الأمر الذي يعكس بوضوح الفجوة التشريعية حيال هذه الأداة التمويلية.
ومن ناحية التطبيق العملي، قد يبدو التورق في ظاهره عقداً مستقلاً يتم بين المصرف والعميل، يقوم على بيع سلعة بثمن مؤجل يتبعها بيع نقدي لطرف ثالث. غير أن هذا النموذج، في المصارف الليبية، غالباً ما يُدرج ضمن عملية المرابحة، ويُنفّذ كإجراء تابع لهيكل تمويلي أوسع، دون أن يُبرم عقد تورق مستقل.
ومع غياب نص قانوني يحدّد طبيعته، فإن إمكانية اعتباره عقداً مستقلاً تبقى مشروطة بتحقق أركان العقد وفقاً للقانون المدني، من رضا، ومحل، وسبب، مع انتقال حقيقي للحيازة والملكية. ثانياً: التورق بين البيع، القرض، والوكالة:
يندرج التورق – من حيث الظاهر – ضمن عقد البيع، كونه يقوم على انتقال ملكية سلعة بثمن مؤجل، ما يجعله أقرب إلى البيع بالتقسيط. ويظهر هذا التكييف بوضوح في العقود المبرمة بين المصرف والعميل، التي تأخذ غالباً شكل بيع بالمرابحة، متضمنة بنوداً تحدّد التزامات الطرفين وشروط تسليم السلعة.
إلا أن حقيقة القصد من العملية – والمتمثلة في الحصول على السيولة النقدية – تجعل بعض الفقهاء يميلون إلى اعتباره قرضاً في جوهره، لاسيما في حال غياب القبض الحقيقي للسلعة أو إذا لم يتحقق الانتفاع بها من قبل العميل، وهو ما يثير شبهة القرض المشروط بزيادة. أما إذا تولّى المصرف بيع السلعة نيابةً عن العميل لطرف ثالث، وفقاً لتفويض مسبق ضمن العقد، فإن العلاقة تأخذ طابع الوكالة. ويُعد ذلك من الخصائص البارزة لما يُعرف بالتورق المنظّم، والذي تنتشر ممارسته في بعض الدول، إذ يتولّى المصرف كافة خطوات البيع والشراء من البداية إلى النهاية، نيابةً عن العميل، ضمن منظومة موحّدة.
ومع أن هذه الممارسة غير مطبقة حاليًا في ليبيا، إلا أن إدراج شرط الوكالة في بعض نماذج العقود يثير إشكالات قانونية حول استقلالية العقد وصحة التكييف.
وعليه، فإن التورق يظل نموذجاً تمويلياً معقداً، يحمل خصائص مختلطة تجمع بين البيع، والوكالة، والقرض المقنّع، ما يفرض على المشرّع الليبي الإسراع بوضع تنظيم قانوني واضح يضبط هذه الصيغة ويزيل ما يكتنفها من غموض.
ثالثاً: أثر غياب التكييف القانوني للتورق المصرفي في التشريع الليبي على ممارسات المصارف:
أدى غياب تكييف قانوني واضح للتورق في القوانين الليبية إلى خلق فجوة تنظيمية في التعامل مع هذه الصيغة التمويلية، حيث لم يرد ذكر التورق صراحةً في أي من القوانين المنظمة للمعاملات المدنية أو المصرفية، بما في ذلك القانون المدني الليبي، أو قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته.
ونتيجة لهذا الفراغ، امتنعت المصارف الليبية عن ممارسة التورق بصيغته المعروفة، ولم تدرجه ضمن عقودها التمويلية أو منتجاتها المصرفية. وبدلاً من ذلك، يتم تنفيذ التصرف المتعلق بالتورق من قبل العميل نفسه بعد إبرام عقد المرابحة، حيث يبيع السلعة التي اشتراها من المصرف نقداً لطرف ثالث بغرض الحصول على السيولة، وهو تصرف يتم خارج النظام المصرفي ولا يدخل ضمن مسؤولية المصرف.
ويُلاحظ أن المصارف تعتمد في تنظيم منتجاتها على معايير الشريعة الإسلامية المعتمدة، وفي مقدمتها معيار الأيوفي الخاص بالتورق، إلا أنها تظل ملتزمة بعدم إجراء عمليات تورق بنفسها، التزاماً بقرارات هيئات الرقابة الشرعية التابعة لها، وبتعليمات مصرف ليبيا المركزي الذي لم يصدر حتى الآن لائحة خاصة تنظم التورق، مكتفياً باعتماد معايير الأيوفي ما لم يصدر تنظيم محلي مخالف.
وفي ظل هذا الغياب التشريعي، تلجأ المصارف إلى تأطير التمويل ضمن صيغ شرعية أخرى، لا سيما “المرابحة للآمر بالشراء”، بينما يظل تصرف العميل خارج العقد الأصلي، ما يثير تساؤلات قانونية حول حدود مسؤولية المصرف، ومدى مشروعية التصرف اللاحق للعميل من منظور القانون والرقابة الشرعية.
وفي مقابل ذلك، اتخذ مصرف ليبيا المركزي خطوات محدودة لتنظيم بعض أدوات التمويل الإسلامي، كما في المنشور رقم (20) لسنة 2024م الصادر عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بشأن السماح بمنح المواطنين أسقفًا لعمليات الشراء على قوة مرتباتهم عبر منتج القرض الحسن، وهو ما عُدّ إجراءً ظرفياً لتخفيف الأعباء المعيشية، دون أن يتضمن تنظيماً خاصاً بالتورق أو موقفًا تشريعياً منه.
وبذلك تبقى ممارسات التورق في ليبيا خارج الإطار القانوني المنظّم، وتُمارس بشكل غير مباشر من قبل الأفراد، ما يفرض تحديًا حقيقياً أمام المشرّع الليبي لوضع تنظيم دقيق يحسم الجدل الفقهي والقانوني، ويضمن استقرار التعاملات المصرفية وتماسكها مع أحكام الشريعة.
المطلب الثاني: آثار التكييف القانوني على أطراف العلاقة التعاقدية:
لا يقتصر أثر التكييف القانوني للتورق على البُعد النظري، بل ينعكس بصورة مباشر على المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة والتزاماتهم، ويُنتج آثاراً متفاوتة بين المصرف والعميل والكفيل، في ظل غياب نصوص قانونية صريحة تنظم هذه الصيغة التمويلية. فقد يتحمّل المصرف مسؤوليات قانونية مضاعفة، ويقع العميل في شبهة معاملة ربوية مقنّعة، فيما يتحمل الكفيل التزامات ثقيلة قد لا تتناسب مع موقعه في العلاقة التعاقدية، الأمر الذي يطرح إشكاليات قانونية وشرعية جدية.
أولاً: أثر التورق على المصرف من حيث المسؤولية والالتزام:
في ظل غياب تنظيم قانوني خاص لعقد التورق، يظل المصرف ملزماً قانوناً بالتحقق من توافر شروط صحة عقد البيع، وأهمها الملكية الفعلية والحيازة الحقيقية للسلعة قبل بيعها للعميل، وإلا تعرّض العقد لشبهة البطلان بسبب انتفاء المحل أو ركن التسليم.
وفي حال قيام المصرف بإعادة بيع السلعة نيابةً عن العميل، فإن ذلك يضعه في مركز الوكيل، ويصبح ملزماً بضمانات قانونية وفق أحكام الوكالة في القانون المدني الليبي (المواد 699 وما يليها). وتزداد مسؤوليته في حال ثبوت عدم حصول العميل على القبض الشرعي للسلعة أو إذا تبين أن السلعة وهمية أو لم تُسلم فعلياً، مما يُدخل العملية في دائرة التحايل على أحكام الشريعة.
وبالإضافة إلى مسؤوليته التعاقدية تجاه العميل، قد يواجه المصرف مسؤولية رقابية أمام مصرف ليبيا المركزي في حال عدم التزامه بالضوابط المنصوص عليها في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2012م، وبخاصة فيما يتعلق بصيغة المرابحة للآمر بالشراء، والمتطلبات الشكلية والإجرائية المرتبطة بها.
ثانياً: أثر التورق على العميل بين الحاجة المشروعة والتورط في الربا:
يلجأ العديد من العملاء إلى التورق بدافع الحاجة المشروعة للسيولة، كالعلاج أو سداد الديون أو الزواج، وهو ما يعكس أهمية التورق كأداة تمويلية في الواقع العملي. إلا أن غياب التكييف القانوني الدقيق لهذه الصيغة قد يُوقع العميل في معاملة غير واضحة المعالم، تتداخل فيها الأوصاف القانونية والشرعية.
ففي بعض الحالات، لا يحصل العميل على السلعة فعلياً، ولا يعرف طبيعتها أو مكان وجودها، بل يكون الهدف الوحيد هو الحصول على النقد، مما يجعل القصد البيعي مغيّباً تماماً، لصالح المقصد التمويلي فقط. وهنا تبرز شبهة الربا المغلّف، ويتحول العقد – شكليًا – إلى بيع، لكنه جوهراً أقرب إلى القرض بزيادة، ما يُفقده صفته الشرعية ويضعف حماية العميل قانوناً.
ثالثًا: أثر التورق على الكفيل في ظل غموض العلاقة وتداخل المسؤوليات:
يُعد وضع الكفيل من أكثر المراكز القانونية تعقيداً في عقود التمويل التي تتضمن التورق، خصوصاً في ظل غياب تنظيم خاص يُحدد طبيعة التزامه وحدود مسؤوليته. فبموجب نموذج “الضمانة والتفويض بالخصم” المعتمد في المصارف الليبية، يُعتبر الكفيل ضامناً مباشراً لسداد الدين، ويتحول عملياً إلى مدين متضامن، يحق للمصرف مطالبته في أي وقت، مع أو قبل الرجوع على العميل. (الجبالي، 2021م، صفحة 1)
وفي حال كان المدين ناقص الأهلية، يصبح الكفيل مديناً أصلياً، ويتحمّل عبء الدين الكامل، بل ويضطر بعد السداد إلى اللجوء للقضاء لمطالبة العميل بما دفعه نيابة عنه. (الجبالي، 2021م، صفحة 1) وتزداد هذه المسؤولية حين تُخصم المبالغ تلقائياً من حساب الكفيل، سداداً لدين غيره، ويتحمل كذلك الرسوم القضائية.
وتزداد الخطورة إذا تهرب العميل من التزاماته بعد استلام النقد دون الانتفاع الحقيقي بالسلعة، مما يضع الكفيل في موضع قانوني وأخلاقي بالغ التعقيد، خاصة إذا كانت الكفالة بدافع اجتماعي أو شخصي لا علاقة له بطبيعة المعاملة المالية.
وهنا يُطرح التساؤل: هل يمتد أثر التورق – كصيغة تمويلية فرعية ضمن عقد المرابحة – إلى الكفيل ويُحمّله تبعات عقد لم يشارك فعلياً في شروطه ولا يعلم تفاصيله بالكامل؟
رابعًا: انعكاسات الفراغ التشريعي على استقرار المعاملات المصرفية:
يترتب على غياب نصوص قانونية صريحة تُنظم التورق المصرفي آثاراً سلبية متعددة على استقرار المعاملات التمويلية، ويؤدي إلى اضطراب العلاقة بين المصرف والعملاء والكفلاء على حد سواء. ويتجلى ذلك في:
أ_غموض المركز القانوني للمصرف في حال النزاع القضائي.
ب_عدم وضوح التزامات العميل، وتفاوت وعيه بطبيعة المعاملة.
ج_تحميل الكفيل أعباء قانونية غير متناسبة مع دوره الأصلي.
د_تزايد فرص التحايل على أحكام الشريعة في ظل غياب نصوص رادعة.
وفي ظل هذا الواقع، يبدو أن إصدار لائحة تنظيمية خاصة بالتورق من قبل مصرف ليبيا المركزي لم يعد أمراً اختيارياً، بل ضرورة تشريعية ملحّة لحماية أطراف التعاقد، وضمان انسجام العمليات التمويلية مع مقاصد القانون والشريعة.
ويتبيّن من خلال هذا المطلب أن التكييف القانوني الغامض للتورق المصرفي في ليبيا أدى إلى آثار قانونية غير متوازنة بين المصرف، العميل، والكفيل، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً يعيد ضبط العلاقة التعاقدية، ويحفظ العدالة والاستقرار المالي، ويُحكم الربط بين الأحكام الفقهية والمنظومة القانونية.
الخاتمة
أظهرت هذه الدراسة عن أن واقع التورق المصرفي في ليبيا يشوبه غموض قانوني واضح، ناجم عن غياب نصوص تشريعية صريحة تُكيّف هذه المعاملة وتُحكم ضوابطها. وقد ساهمت الحاجة العملية، لاسيما في ظل أزمات السيولة، في دفع المواطنين إلى اللجوء إلى هذه الصيغة التمويلية، دون وجود تنظيم قانوني يحكم العلاقة التعاقدية ويُحدد بدقة مسؤوليات والتزامات الأطراف، مما أفرز واقعاً متداخلاً بين ما هو مشروع نظرياً وما هو مطبق عملياً. وهو ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً لسد هذا الفراغ وضبط المسار.
أولاً: النتائج:
1_ التورق المصرفي لا يُمارس كعقد مستقل في المصارف الليبية، بل يتم من خلال عقد المرابحة.
2_ تقع مسؤولية التصرف في السلعة بعد البيع على عاتق العميل، في حين يقتصر دور المصرف على تنفيذ البيع الأولي فقط.
3_ يميز معيار الأيوفي رقم (30) بين التورق المشروع، الذي يتم مع طرف ثالث غير المصرف، وبين التورق المنظم أو العينة، الممنوعين شرعاً.
4_ غياب الإطار القانوني المنظم للتورق أدى إلى غموض في تكييفه القانوني، إذ لا توجد نصوص تًحدد طبيعته بوضوح، مما يُثير تساؤلات حول ما إذا كان يُعد بيعاً أو قرضاً أو وكالة.
5_ يُسهم الفراغ التشريعي في تعقيد العلاقة القانونية بين المصرف والعميل والكفيل، ما يضعف من الضمانات القانونية للطرف الأضعف.
6_ يُلجأ أحياناً إلى التورق كوسيلة لمعالجة المديونية أو تحويل الديون الربوية إلى صيغ تمويلية مشروعة.
7_ تعتمد المصارف الليبية على معيار الأيوفي في ظل غياب تنظيم محلي مُلزم، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تشريع وطني متكامل ومنضبط.
ثانياً: التوصيات:
1_ يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (سورة البقرة:275).
ومن هنا نبرز أهمية تكثيف جهود التوعية المجتمعية عبر وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، لبيان خطورة التعامل بالربا وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.
2_ نهيب بالمشرع الليبي سد الفراغ التشريعي من خلال إصدار قانون شامل للمعاملات المالية المدنية والتجارية، يتضمن تنظيماً دقيقاً لعقود التمويل الإسلامي، وفي مقدمتها التورق.
3_ نقترح تضمين تعريف دقيق للتورق ضمن نصوص القوانين المصرفية، مع بيان طبيعته القانونية، وتحديد صور التعاقد المسموح بها، لضمان استقرار المعاملات وتقليص فرص التحايل.
4_ نقترح على الجهــات التنفيذيــة المختصـة إصدار لائحة تنظيميـة خاصة بالتورق المصرفي، تُحدّد شروطه وضوابطه وآثاره القانونية، مع التمييز بوضوح بين التورق المشروع، والتورق المنظم أو العينة المحظورين شرعاً، بما يضمن الحماية القانونية للأطراف المتعاقدة.
5_ نقترح دعـم الجهود العلمية من خــلال عقــد نــدوات وورش عمـــل ومؤتمرات متخصصة، لتبادل الخبرات بين الفقهاء والقانونيين والخبراء المصرفيين حول صيغ التمويل الإسلامي، مع التركيز على التورق المشروع، بما يتناسب مع خصوصية الاقتصاد الليبي.
6_ نقترح توفير بدائل تمويلية مشروعة تلبي حاجة المواطن، كالقرض الحسن، وتحسين الخدمات المصرفية.
قائمة المراجع
1_ آل رشود، رياض بن راشد عبد الله. (2013). التورق المصرفي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – دولة قطر.
2_ الجبالي، وفاء ميلود ساسي. (2021). الحماية القانونية للكفيل الشخصي (رسالة ماجستير، جامعة طرابلس، كلية القانون).
3_ الرفيعي، افتخار محمد مناحي. (د.ت). التورق المصرفي وآثاره الاقتصادية السلبية. مجلة كلية الشريعة، الجامعة العراقية – كلية الإدارة والاقتصاد(3)، 314.
4_ السالوس، علي أحمد. (د.ت). التورق: حقيقته وأنواعه. الدورة التاسعة عشرة – إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
5_ السروى، عبد الكريم محمد. (2012، أبريل). التورق المصرفي: التكييف الشرعي والحكم الفقهي. بحث مقدم لمؤتمر “التورق المصرفي والحيل الربوية”، جامعة عجلون، المملكة الأردنية الهاشمية.
6_ السويلم، سامي بن إبراهيم. (2003، أغسطس). التورق..والتورق المنظم: دراسة تأصيلية. بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة.
7_ العياط، رانيا بسام. (2019). التورق: دراسة شرعية تطبيقية (مشروع تخرج لنيل درجة البكالوريوس في المصارف الإسلامية، الجامعة الأردنية – كلية الشريعة).
8_ العدوي، محمد شكري الجميل. (د.ت). التورق وتطبيقاته المعاصرة في المصارف الإسلامية: دراسة فقهية مقارنة.
9_ المصرف المتحد للتجارة والاستثمار. (د.ت). نموذج عقد بيع سلعة بالمرابحة (نافذة فرع إسلامي).
10_ مصرف الجمهورية. (د.ت). نموذج ضمانة تفويض بالخصم للمرابحة الشرعية، الصيرفة الإسلامية.
11_ مصرف ليبيا المركزي – لجنة المعايير ونظم الصيرفة الإسلامية. (د.ت). المعيار المصرفي رقم (1)، الإصدار (1)، المنظم لعملية بيع المرابحة للآمر بالشراء.
12_ ليبيا. (1953). القانون المدني الليبي. مرسوم ملكي بتاريخ 28 نوفمبر 1953، الجريدة الرسمية، العدد 1 لسنة 1954. ليبيا. (2005).
13_ القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، المعدل بالقانون رقم (46) لسنة 2005. 14_ ليبيا. (2010). قانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
15_ ليبيا. (2013). قانون رقم (1) لسنة 2013 بشأن منع التعاملات الربوية.
16_ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). (2008). المعيار الشرعي رقم (30) بشأن التورق.