مواءمة الأطر والقواعد القانونية في منظمة التجارة العالمية مع حماية البيئة: التحديات وسبل الإصلاح – الدكتور : محمد البقجه جي
[]
مواءمة الأطر والقواعد القانونية في منظمة التجارة العالمية مع حماية البيئة: التحديات وسبل الإصلاح
Aligning World Trade Organization’s Legal Frameworks and Rules with Environmental Protection: Challenges and Ways for Reform
كلية القانون. جامعة الأمير سلطان. المملكة العربية السعودية
هذا البحث منشور في مجلة القانون والأعمال الدولية الإصدار رقم 59 الخاص بشهر غشت / شتنبر 2025
رابط تسجيل الاصدار في DOI
https://doi.org/10.63585/KWIZ8576
للنشر و الاستعلام
mforki22@gmail.com
الواتساب 00212687407665
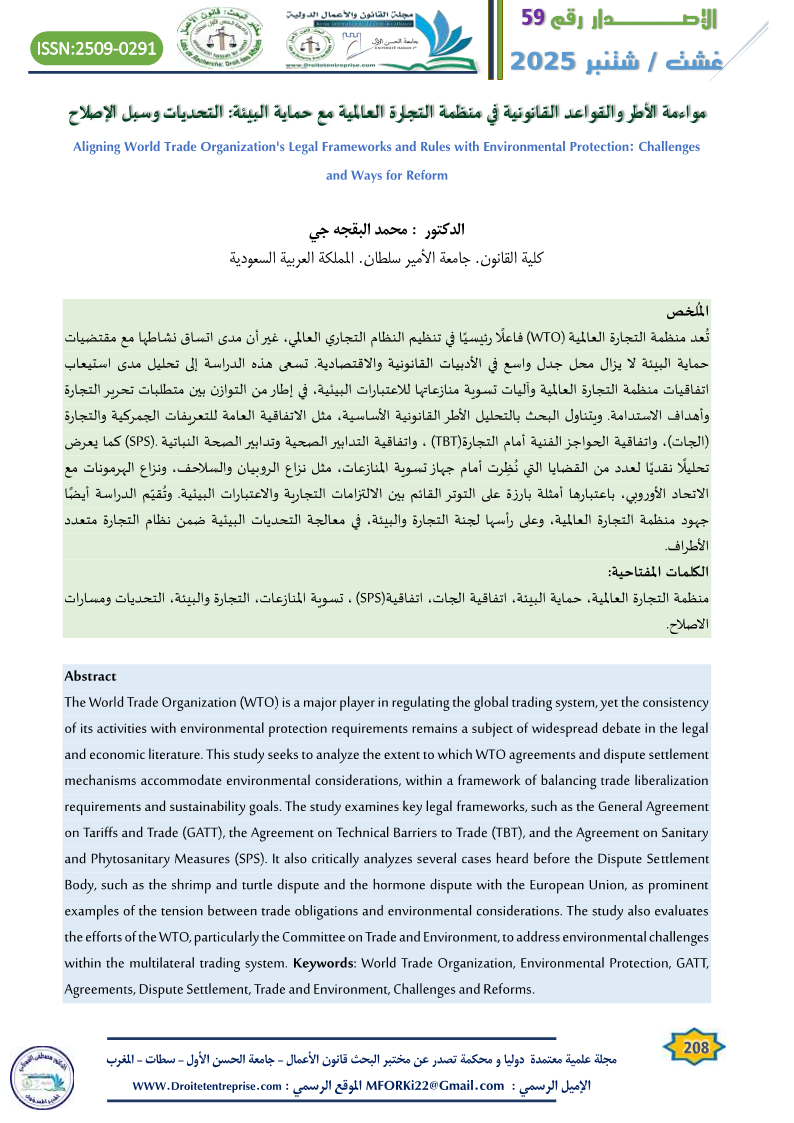
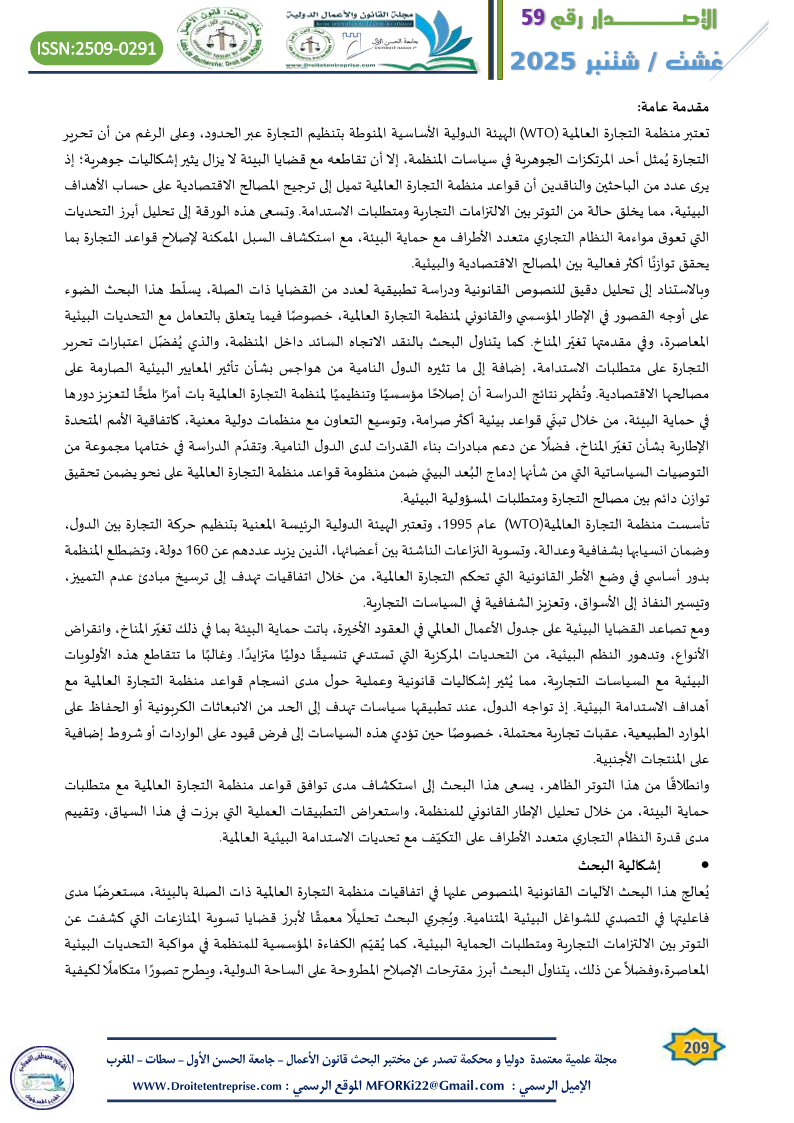
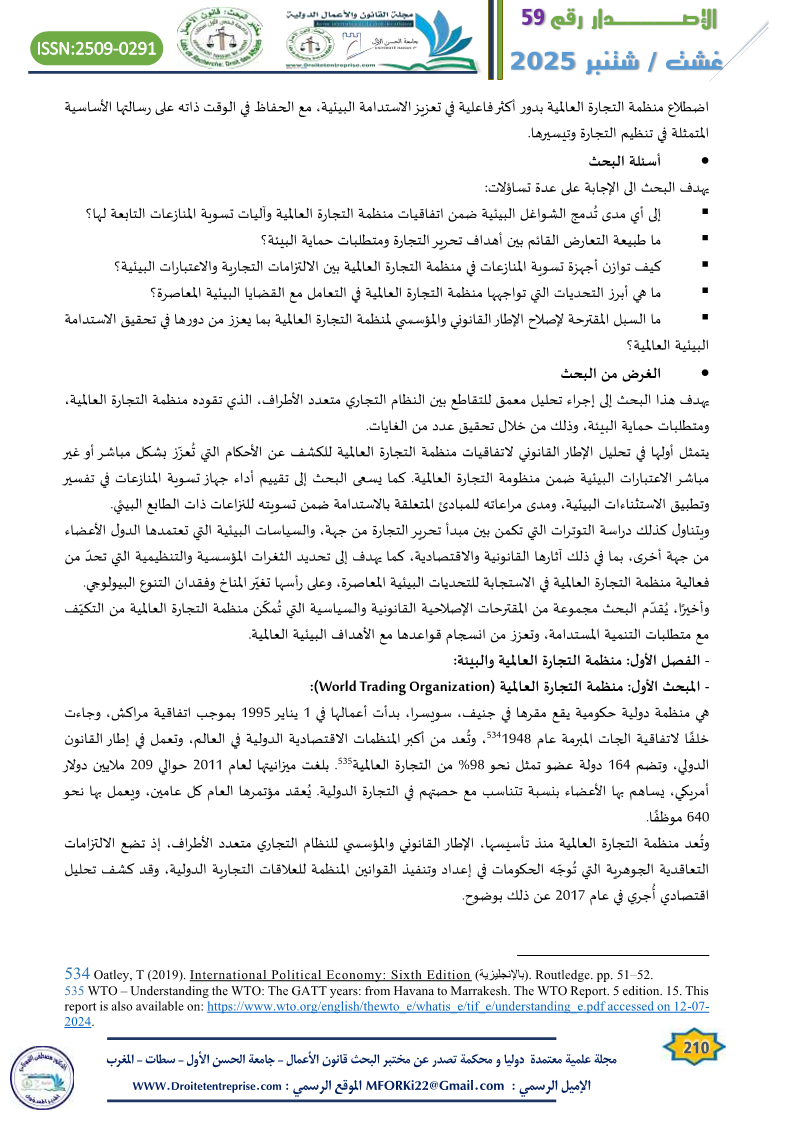
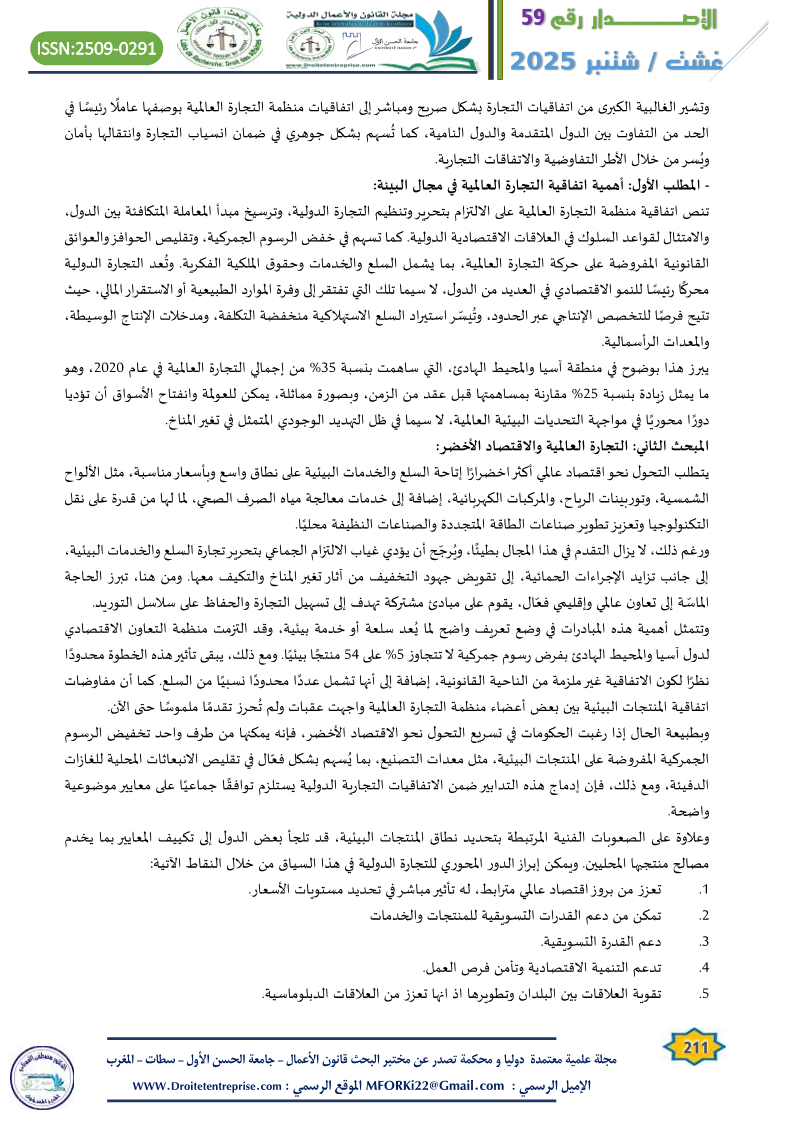
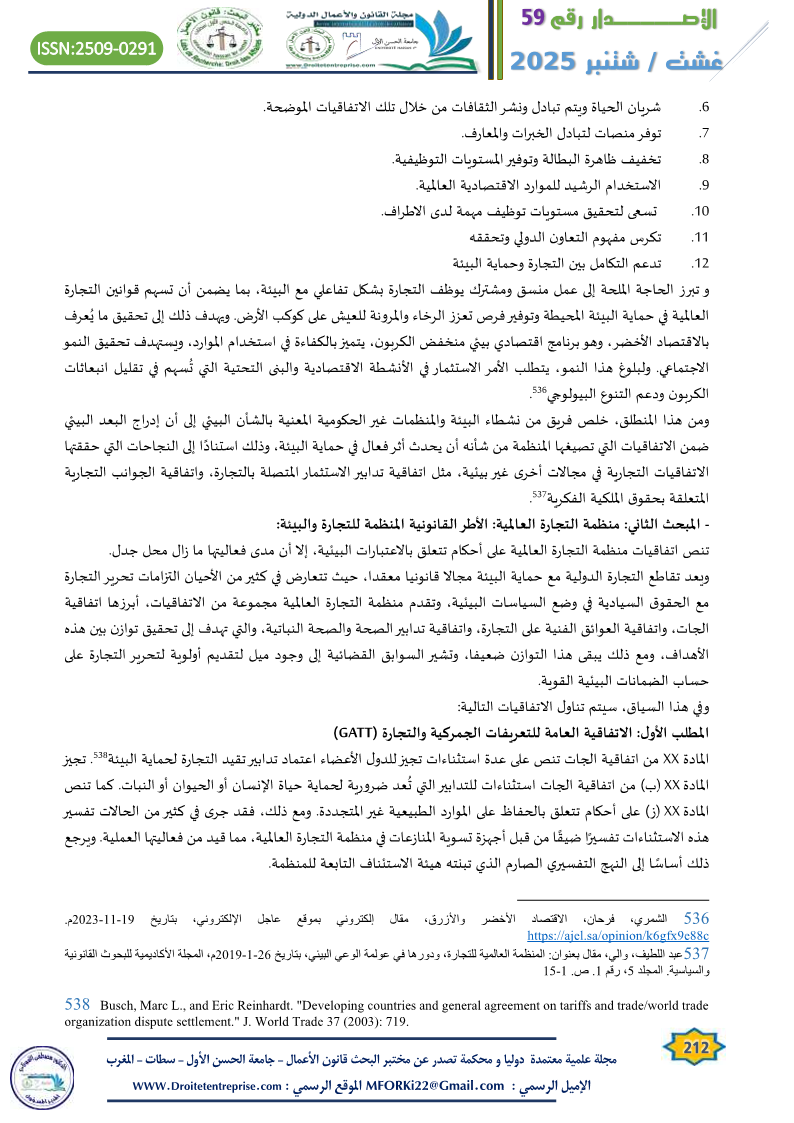
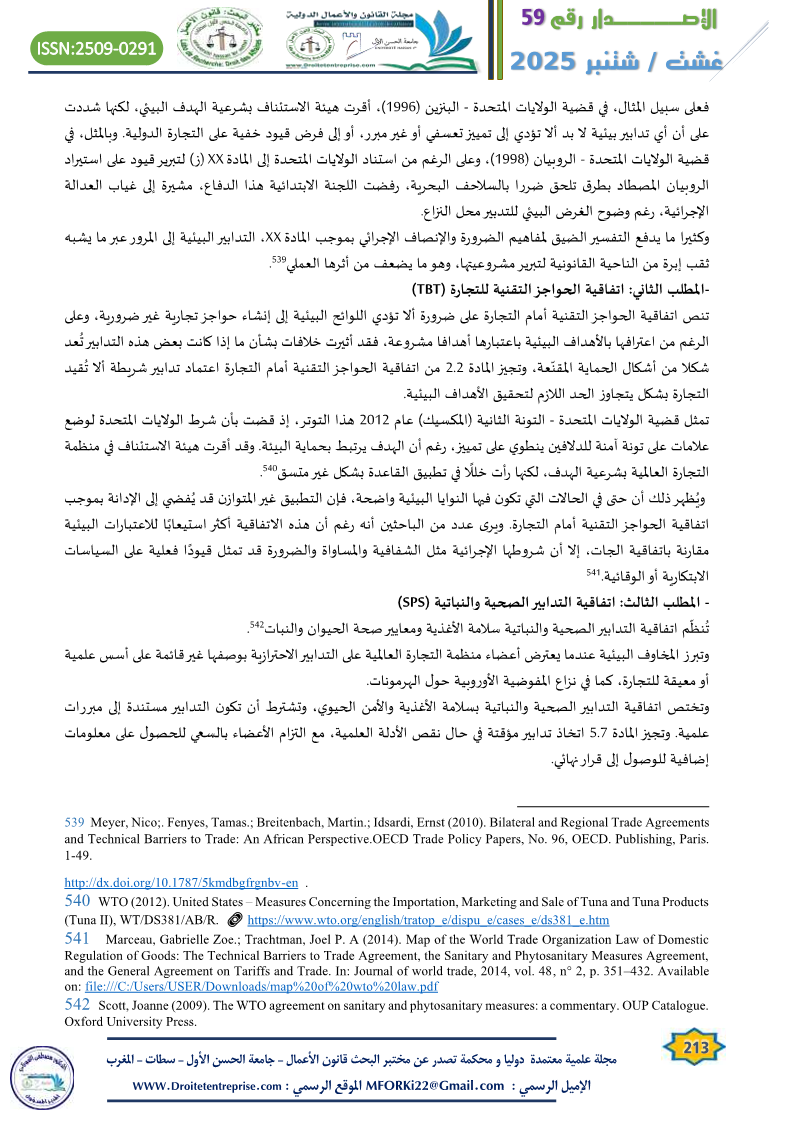
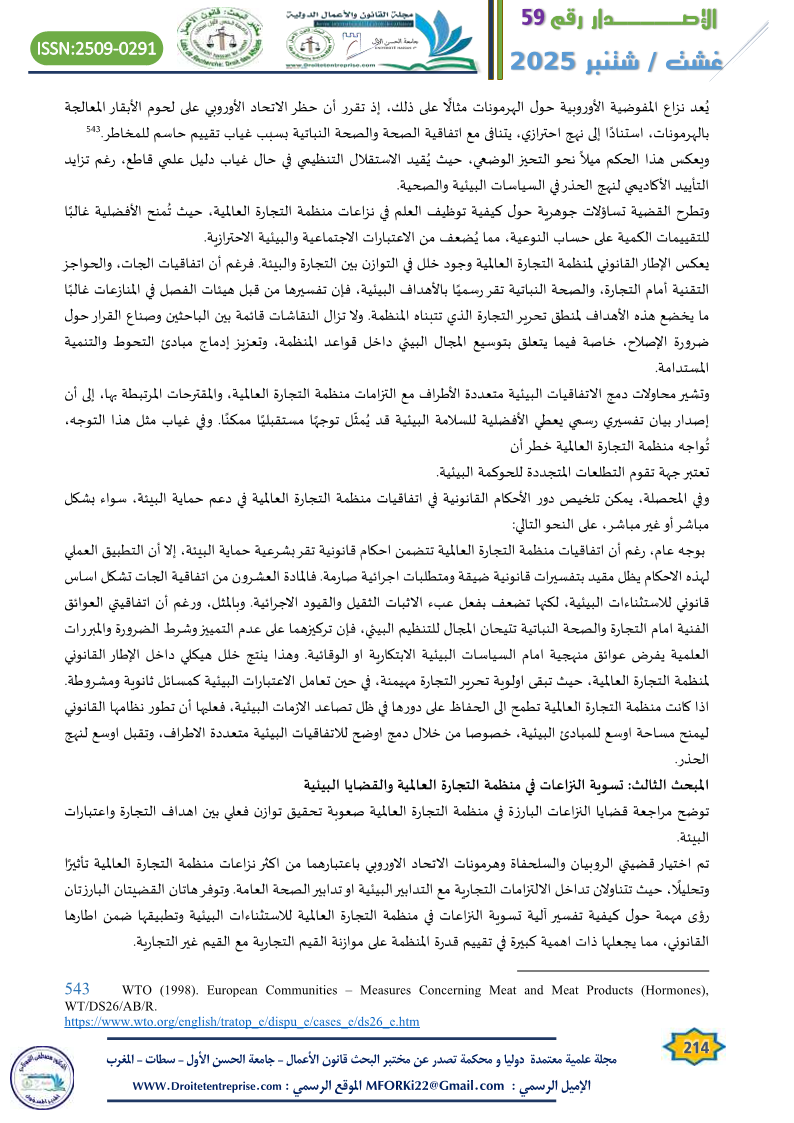
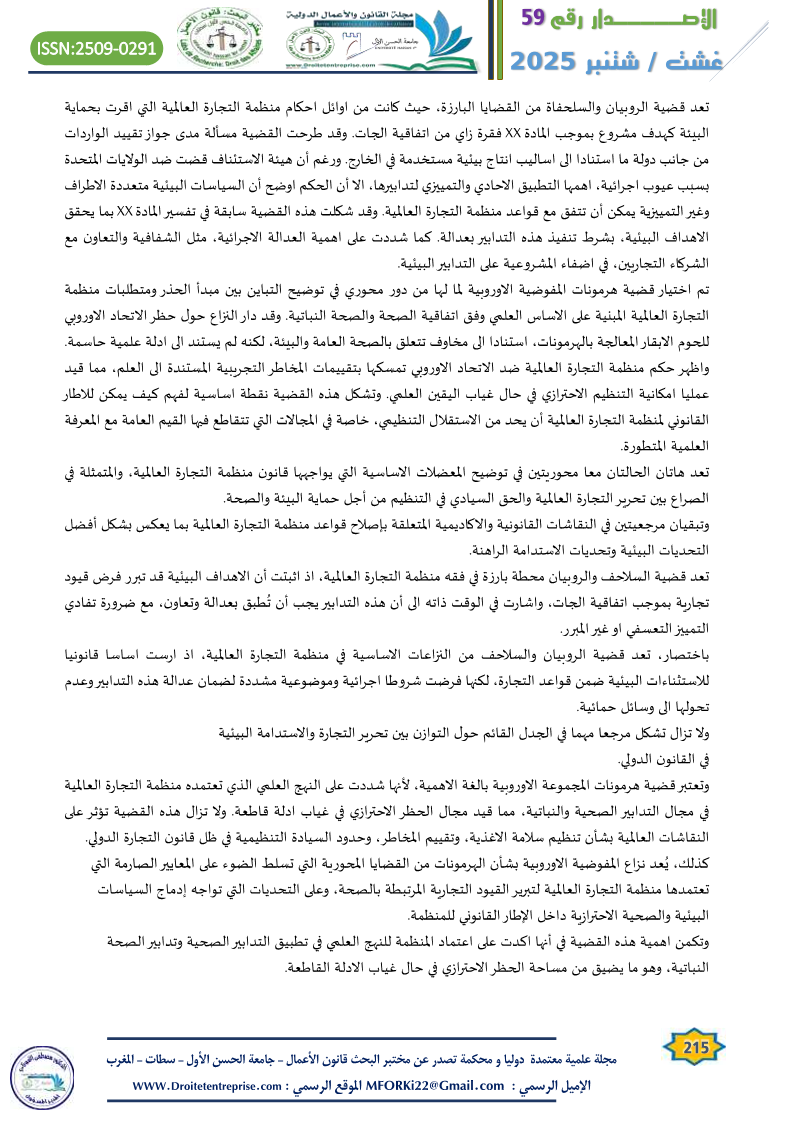
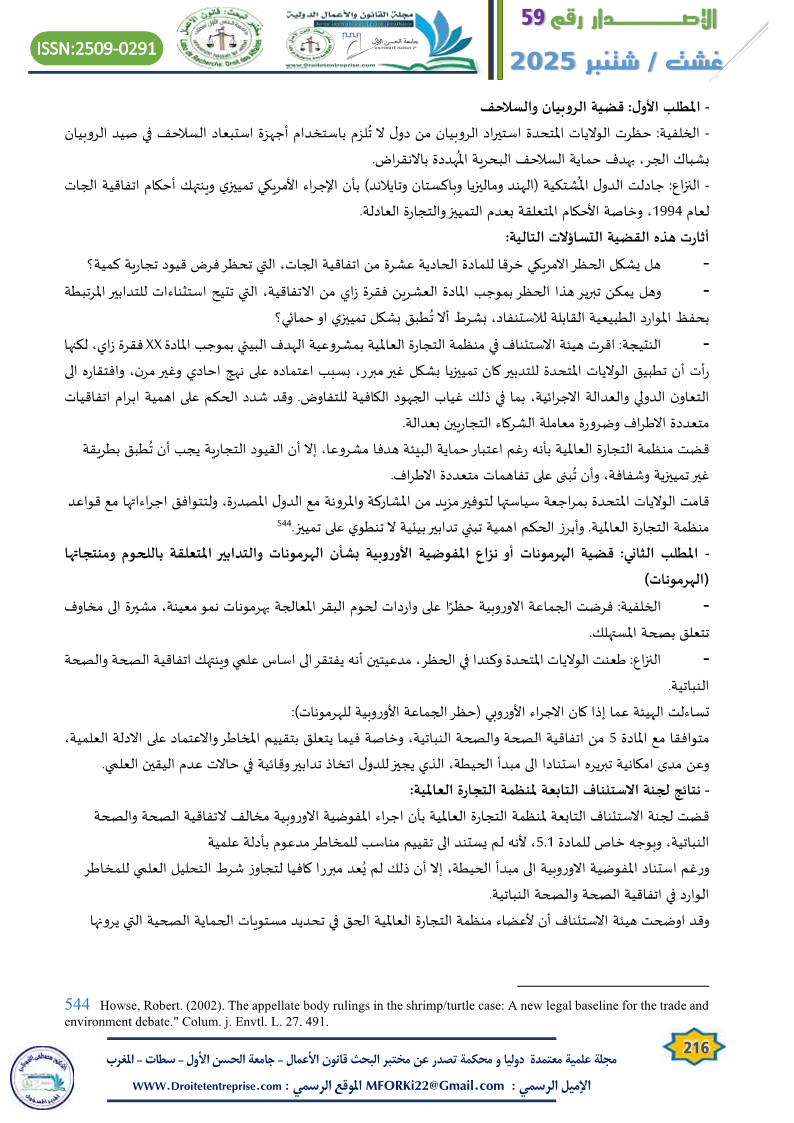
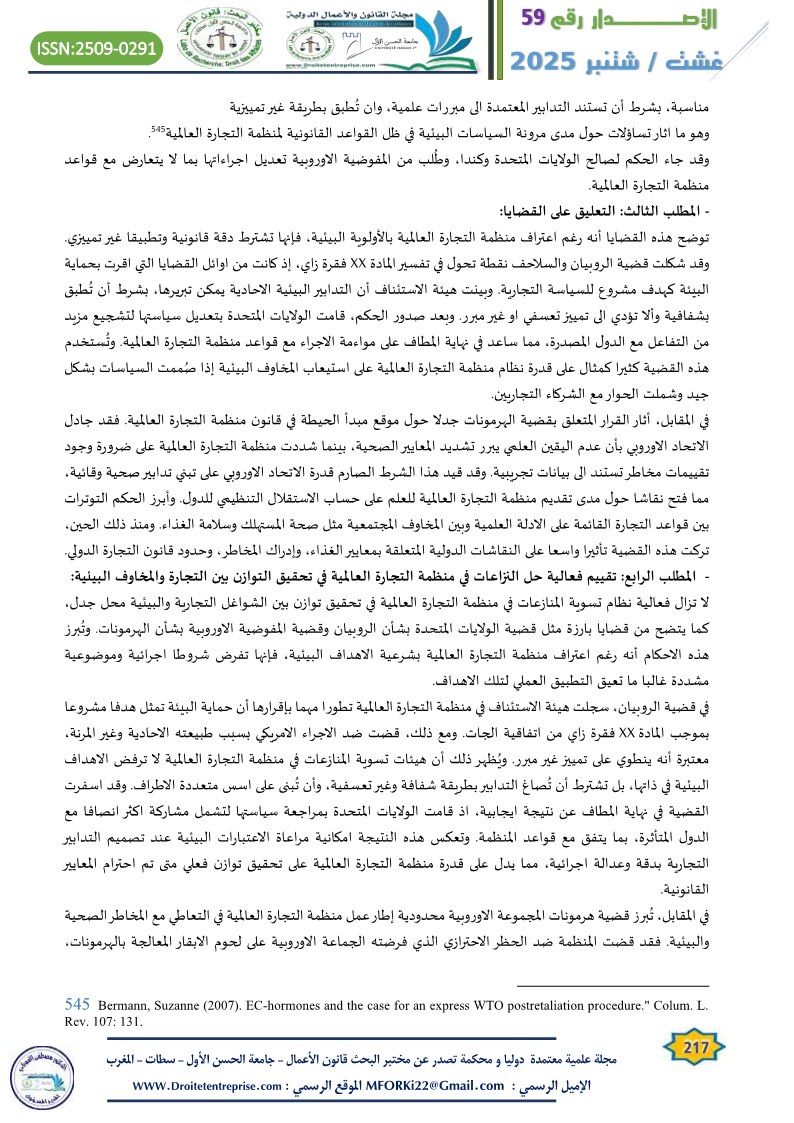
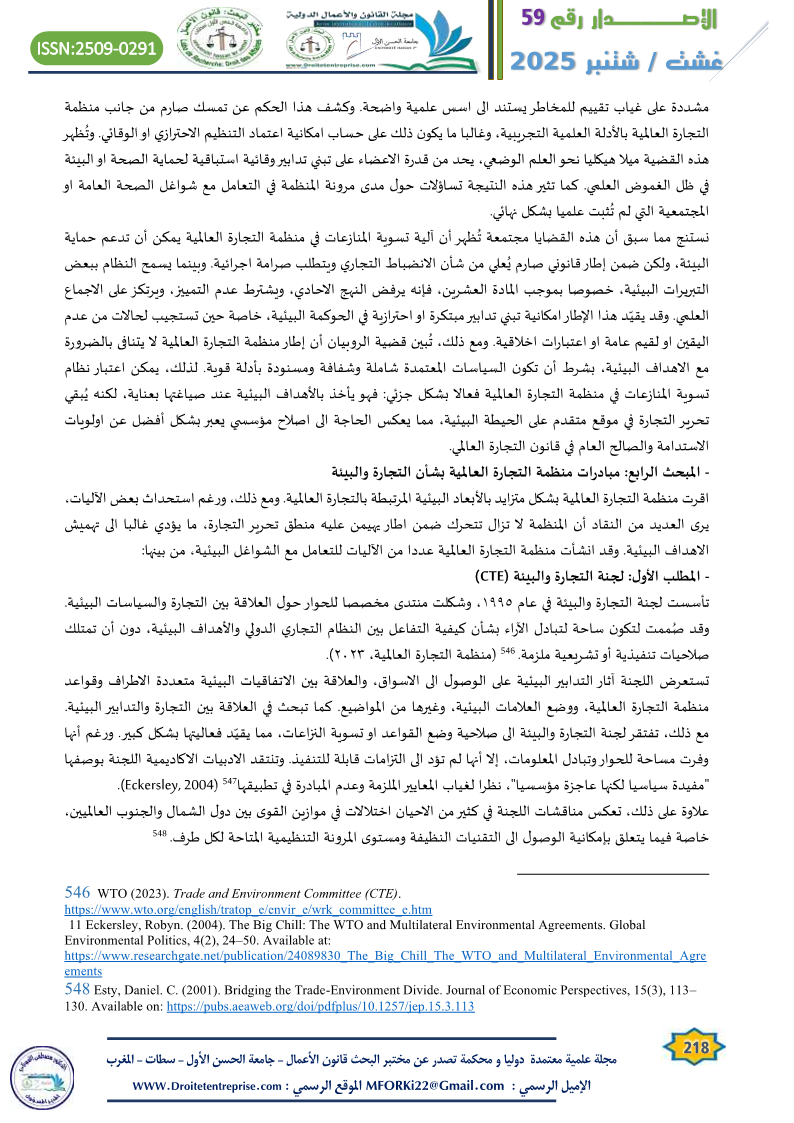
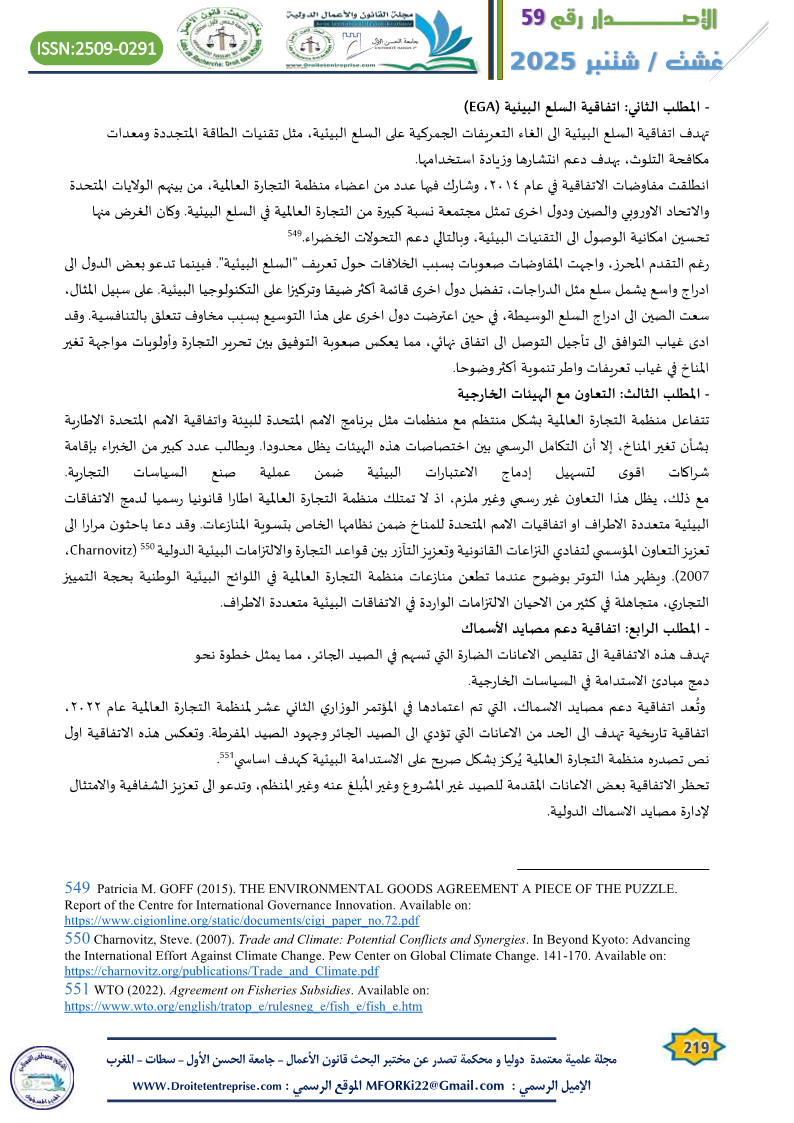
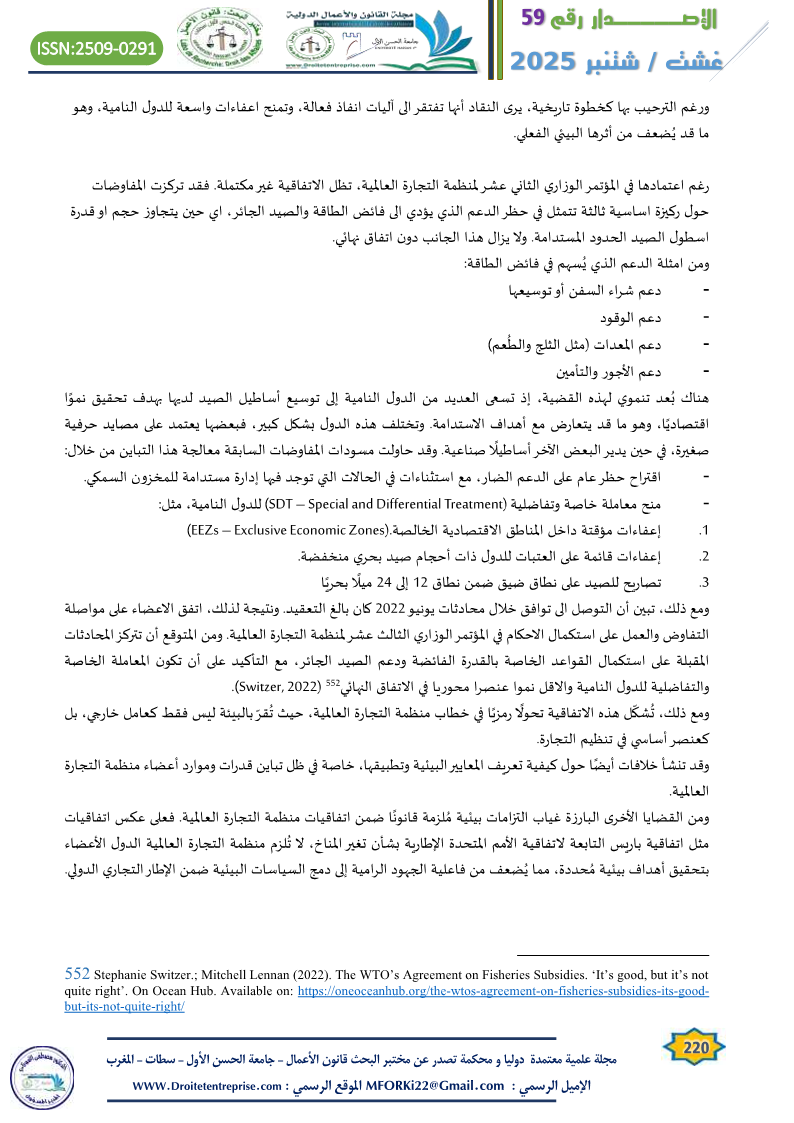
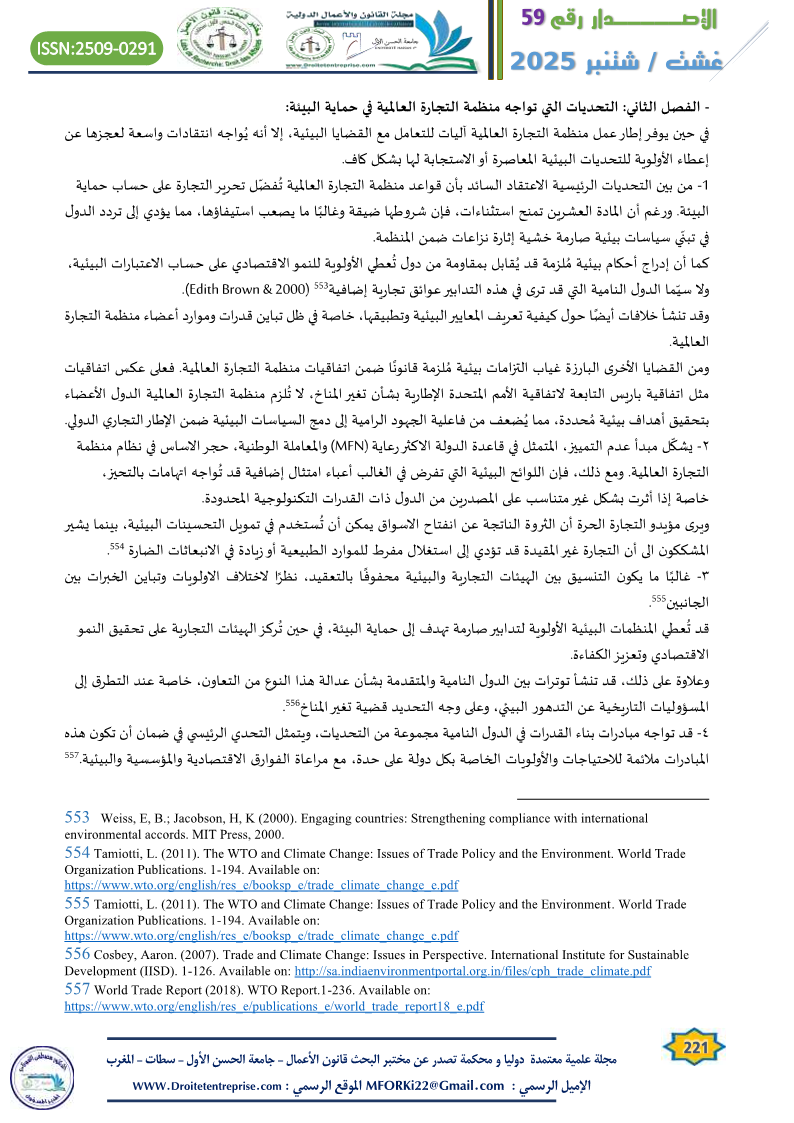
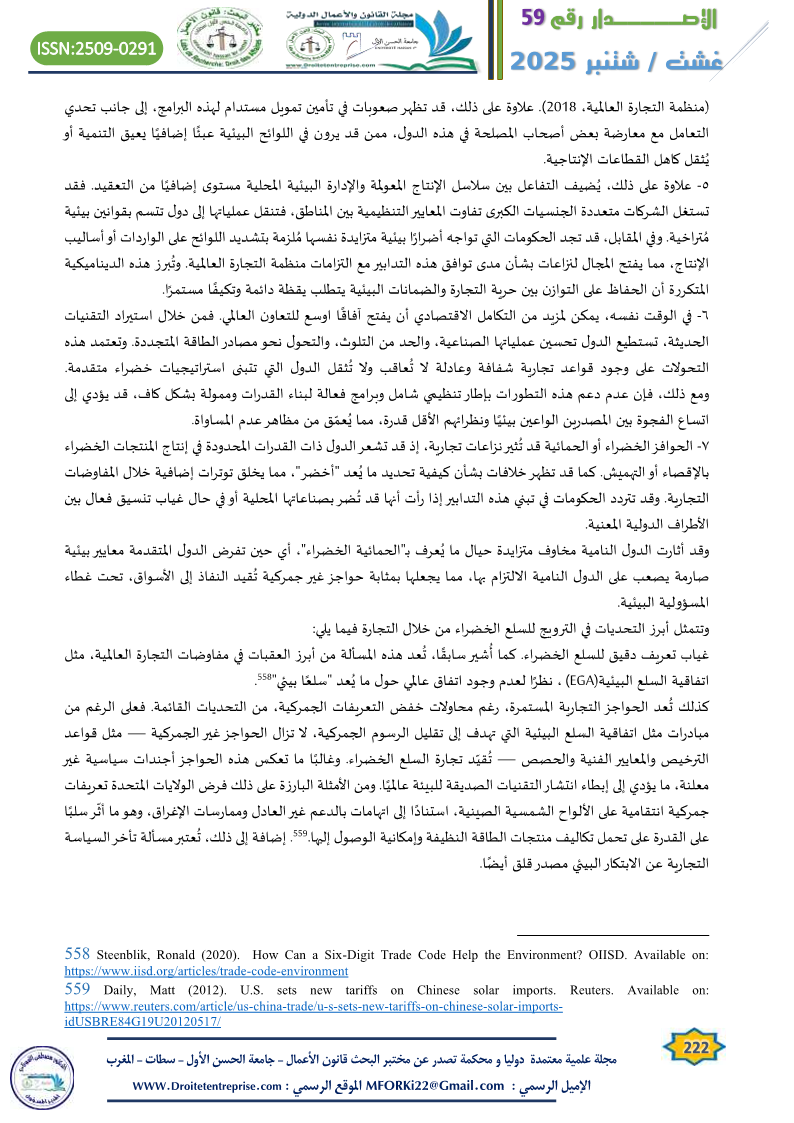
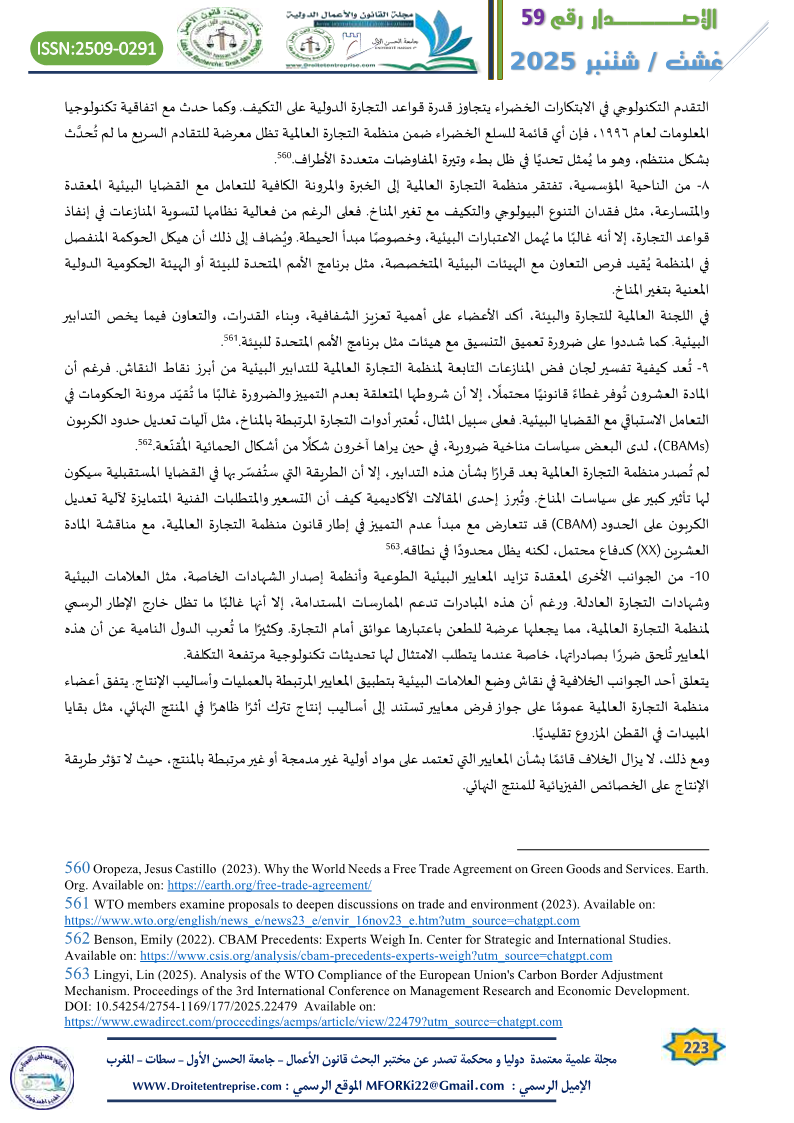
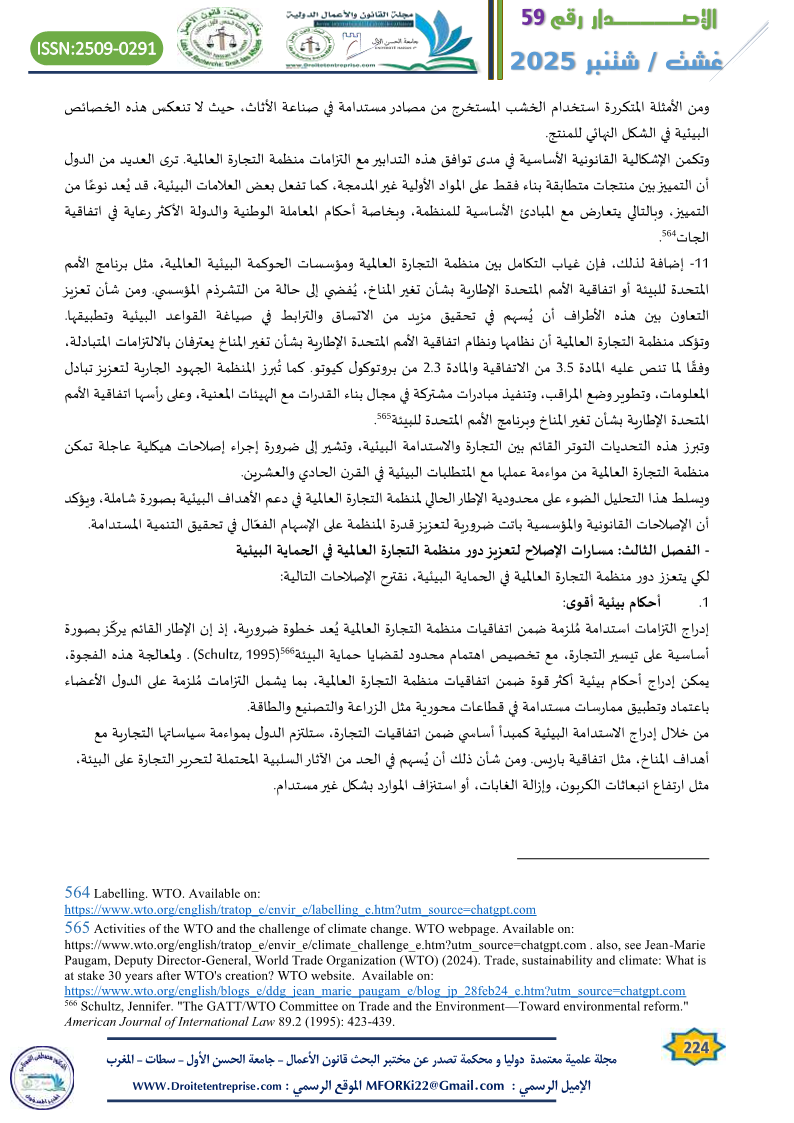
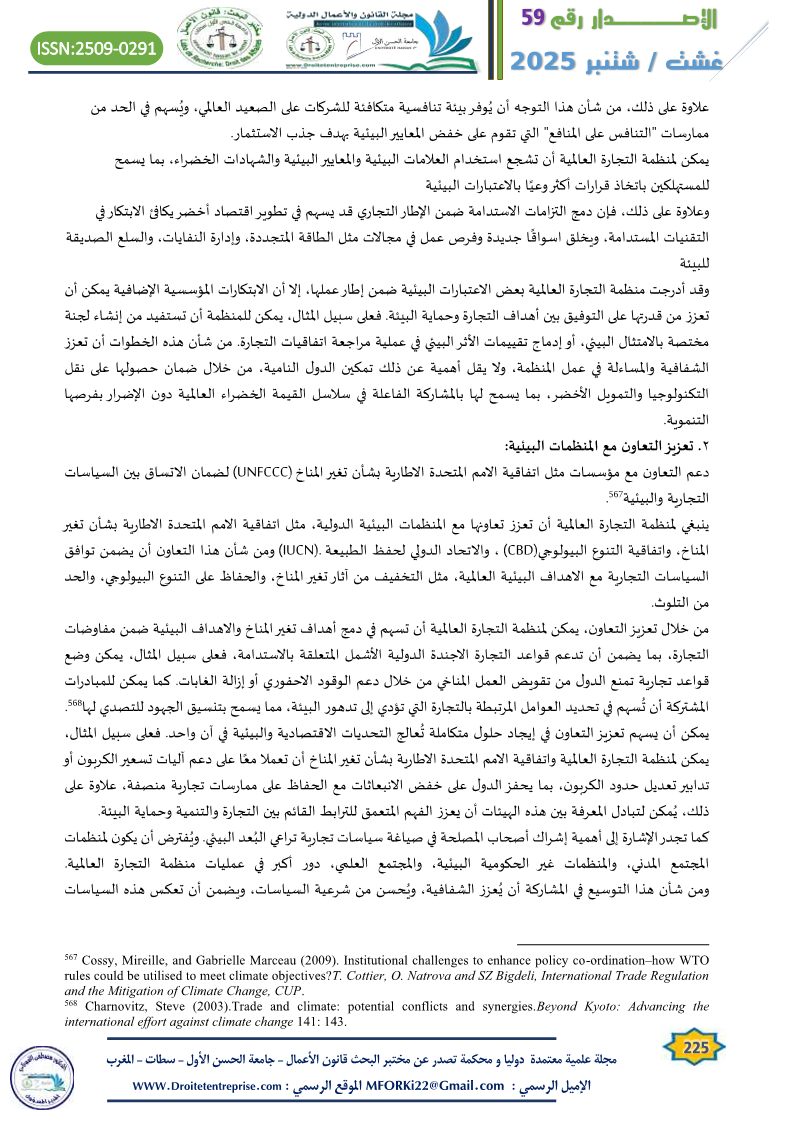
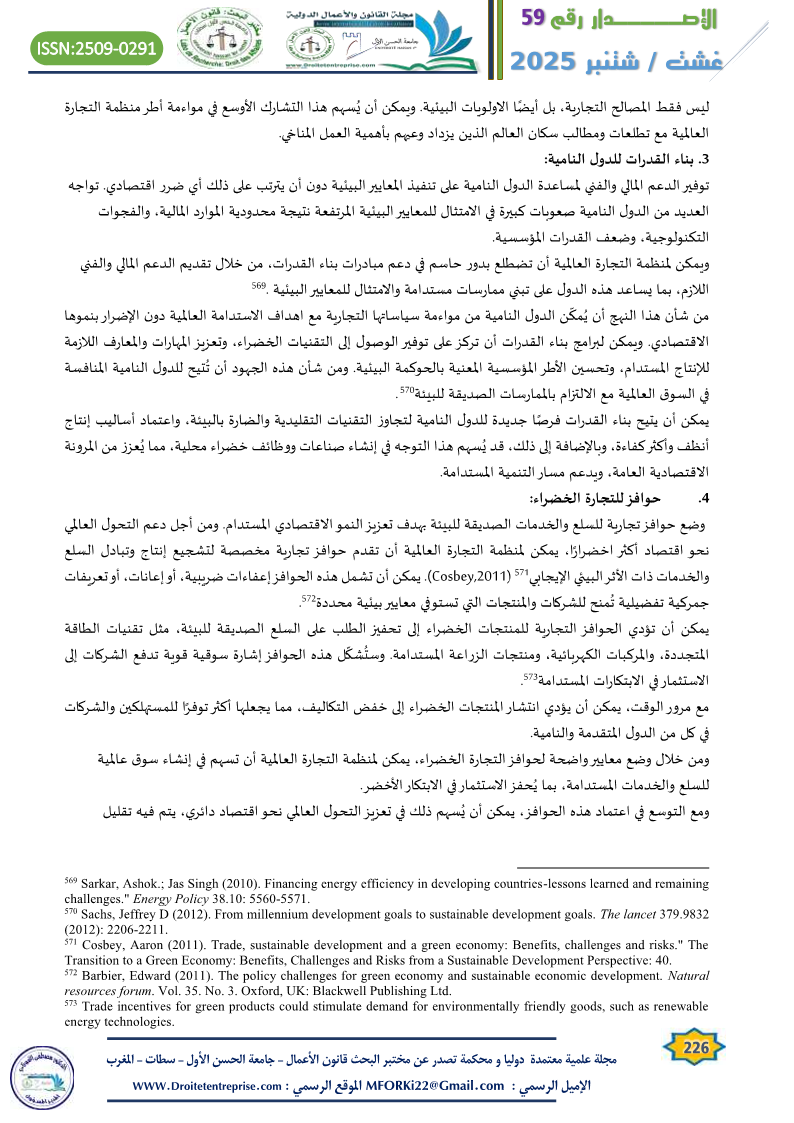
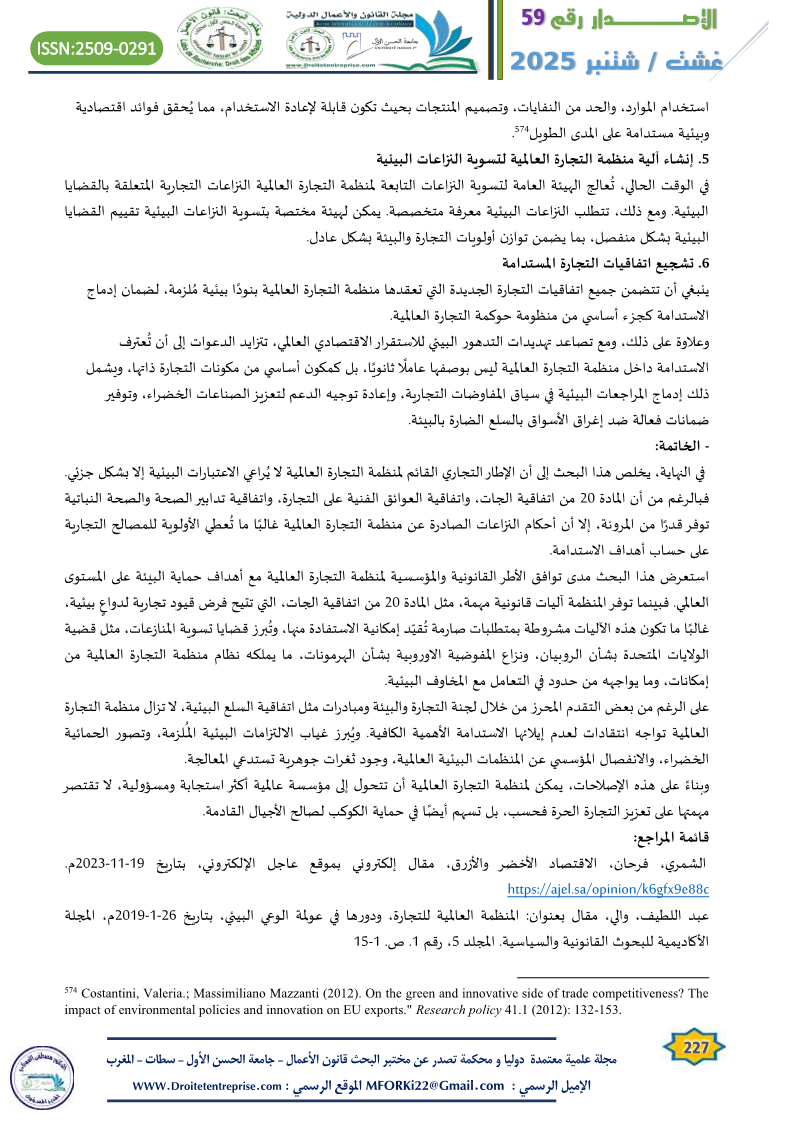
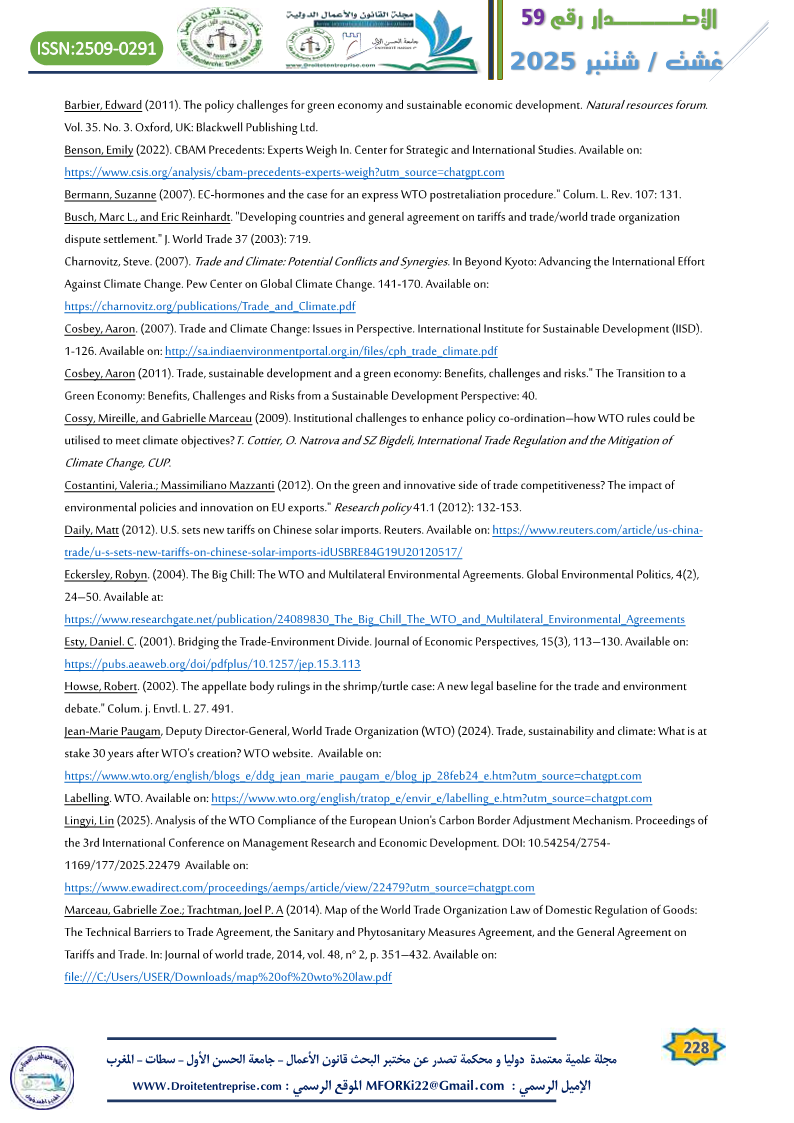
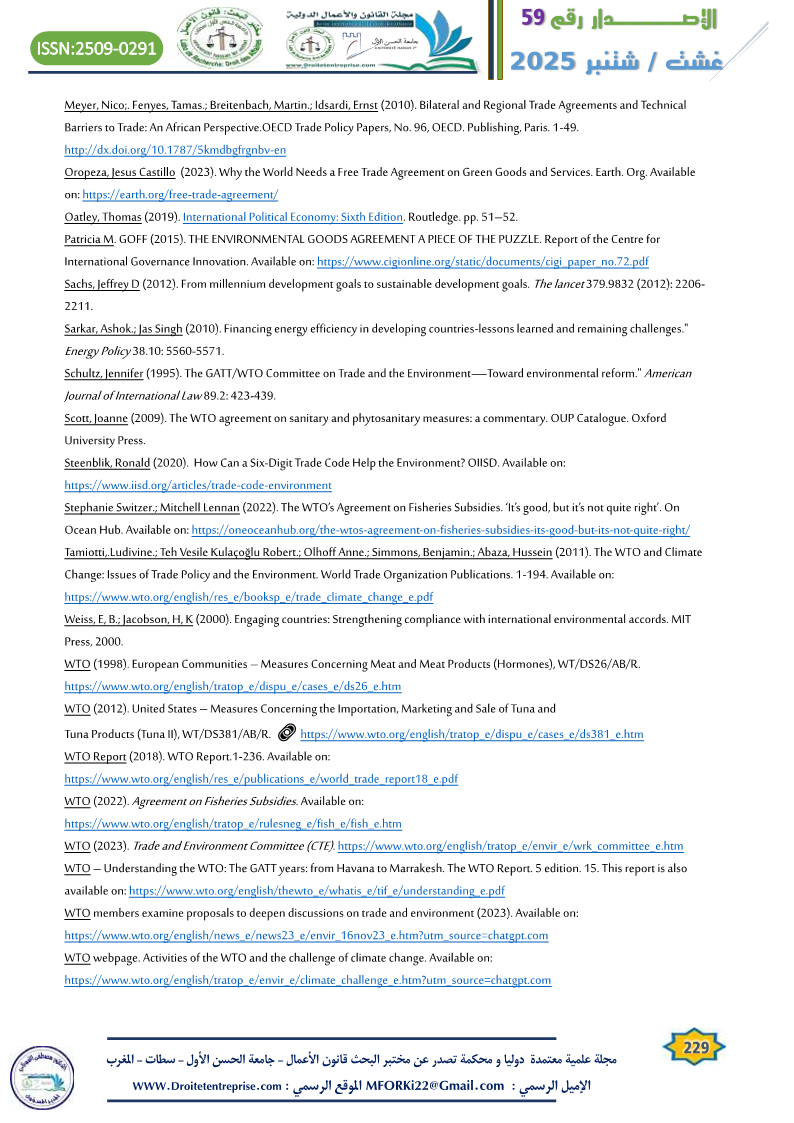
مواءمة الأطر والقواعد القانونية في منظمة التجارة العالمية مع حماية البيئة: التحديات وسبل الإصلاح
Aligning World Trade Organization’s Legal Frameworks and Rules with Environmental Protection: Challenges and Ways for Reform
كلية القانون. جامعة الأمير سلطان. المملكة العربية السعودية
المُلخص
تُعد منظمة التجارة العالمية (WTO) فاعلًا رئيسيًا في تنظيم النظام التجاري العالمي، غير أن مدى اتساق نشاطها مع مقتضيات حماية البيئة لا يزال محل جدل واسع في الأدبيات القانونية والاقتصادية. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل مدى استيعاب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وآليات تسوية منازعاتها للاعتبارات البيئية، في إطار من التوازن بين متطلبات تحرير التجارة وأهداف الاستدامة. ويتناول البحث بالتحليل الأطر القانونية الأساسية، مثل الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة (TBT)، واتفاقية التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية (SPS). كما يعرض تحليلًا نقديًا لعدد من القضايا التي نُظِرت أمام جهاز تسوية المنازعات، مثل نزاع الروبيان والسلاحف، ونزاع الهرمونات مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها أمثلة بارزة على التوتر القائم بين الالتزامات التجارية والاعتبارات البيئية. وتُقيّم الدراسة أيضًا جهود منظمة التجارة العالمية، وعلى رأسها لجنة التجارة والبيئة، في معالجة التحديات البيئية ضمن نظام التجارة متعدد الأطراف.
الكلمات المفتاحية:
منظمة التجارة العالمية، حماية البيئة، اتفاقية الجات، اتفاقية (SPS)، تسوية المنازعات، التجارة والبيئة، التحديات ومسارات الاصلاح.
Abstract
The World Trade Organization (WTO) is a major player in regulating the global trading system, yet the consistency of its activities with environmental protection requirements remains a subject of widespread debate in the legal and economic literature. This study seeks to analyze the extent to which WTO agreements and dispute settlement mechanisms accommodate environmental considerations, within a framework of balancing trade liberalization requirements and sustainability goals. The study examines key legal frameworks, such as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), and the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). It also critically analyzes several cases heard before the Dispute Settlement Body, such as the shrimp and turtle dispute and the hormone dispute with the European Union, as prominent examples of the tension between trade obligations and environmental considerations. The study also evaluates the efforts of the WTO, particularly the Committee on Trade and Environment, to address environmental challenges within the multilateral trading system. Keywords: World Trade Organization, Environmental Protection, GATT, Agreements, Dispute Settlement, Trade and Environment, Challenges and Reforms.
مقدمة عامة:
تعتبر منظمة التجارة العالمية (WTO) الهيئة الدولية الأساسية المنوطة بتنظيم التجارة عبر الحدود، وعلى الرغم من أن تحرير التجارة يُمثل أحد المرتكزات الجوهرية في سياسات المنظمة، إلا أن تقاطعه مع قضايا البيئة لا يزال يثير إشكاليات جوهرية؛ إذ يرى عدد من الباحثين والناقدين أن قواعد منظمة التجارة العالمية تميل إلى ترجيح المصالح الاقتصادية على حساب الأهداف البيئية، مما يخلق حالة من التوتر بين الالتزامات التجارية ومتطلبات الاستدامة. وتسعى هذه الورقة إلى تحليل أبرز التحديات التي تعوق مواءمة النظام التجاري متعدد الأطراف مع حماية البيئة، مع استكشاف السبل الممكنة لإصلاح قواعد التجارة بما يحقق توازنًا أكثر فعالية بين المصالح الاقتصادية والبيئية.
وبالاستناد إلى تحليل دقيق للنصوص القانونية ودراسة تطبيقية لعدد من القضايا ذات الصلة، يسلّط هذا البحث الضوء على أوجه القصور في الإطار المؤسسي والقانوني لمنظمة التجارة العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات البيئية المعاصرة، وفي مقدمتها تغيّر المناخ. كما يتناول البحث بالنقد الاتجاه السائد داخل المنظمة، والذي يُفضّل اعتبارات تحرير التجارة على متطلبات الاستدامة، إضافة إلى ما تثيره الدول النامية من هواجس بشأن تأثير المعايير البيئية الصارمة على مصالحها الاقتصادية. وتُظهر نتائج الدراسة أن إصلاحًا مؤسسيًا وتنظيميًا لمنظمة التجارة العالمية بات أمرًا ملحًّا لتعزيز دورها في حماية البيئة، من خلال تبنّي قواعد بيئية أكثر صرامة، وتوسيع التعاون مع منظمات دولية معنية، كاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، فضلًا عن دعم مبادرات بناء القدرات لدى الدول النامية. وتقدّم الدراسة في ختامها مجموعة من التوصيات السياساتية التي من شأنها إدماج البُعد البيئي ضمن منظومة قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو يضمن تحقيق توازن دائم بين مصالح التجارة ومتطلبات المسؤولية البيئية.
تأسست منظمة التجارة العالمية (WTO) عام 1995، وتعتبر الهيئة الدولية الرئيسة المعنية بتنظيم حركة التجارة بين الدول، وضمان انسيابها بشفافية وعدالة، وتسوية النزاعات الناشئة بين أعضائها، الذين يزيد عددهم عن 160 دولة، وتضطلع المنظمة بدور أساسي في وضع الأطر القانونية التي تحكم التجارة العالمية، من خلال اتفاقيات تهدف إلى ترسيخ مبادئ عدم التمييز، وتيسير النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز الشفافية في السياسات التجارية.
ومع تصاعد القضايا البيئية على جدول الأعمال العالمي في العقود الأخيرة، باتت حماية البيئة بما في ذلك تغيّر المناخ، وانقراض الأنواع، وتدهور النظم البيئية، من التحديات المركزية التي تستدعي تنسيقًا دوليًا متزايدًا. وغالبًا ما تتقاطع هذه الأولويات البيئية مع السياسات التجارية، مما يُثير إشكاليات قانونية وعملية حول مدى انسجام قواعد منظمة التجارة العالمية مع أهداف الاستدامة البيئية. إذ تواجه الدول، عند تطبيقها سياسات تهدف إلى الحد من الانبعاثات الكربونية أو الحفاظ على الموارد الطبيعية، عقبات تجارية محتملة، خصوصًا حين تؤدي هذه السياسات إلى فرض قيود على الواردات أو شروط إضافية على المنتجات الأجنبية.
وانطلاقًا من هذا التوتر الظاهر، يسعى هذا البحث إلى استكشاف مدى توافق قواعد منظمة التجارة العالمية مع متطلبات حماية البيئة، من خلال تحليل الإطار القانوني للمنظمة، واستعراض التطبيقات العملية التي برزت في هذا السياق، وتقييم مدى قدرة النظام التجاري متعدد الأطراف على التكيّف مع تحديات الاستدامة البيئية العالمية.
- إشكالية البحث
يُعالج هذا البحث الآليات القانونية المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بالبيئة، مستعرضًا مدى فاعليتها في التصدي للشواغل البيئية المتنامية. ويُجري البحث تحليلًا معمقًا لأبرز قضايا تسوية المنازعات التي كشفت عن التوتر بين الالتزامات التجارية ومتطلبات الحماية البيئية، كما يُقيّم الكفاءة المؤسسية للمنظمة في مواكبة التحديات البيئية المعاصرة،وفضلاً عن ذلك، يتناول البحث أبرز مقترحات الإصلاح المطروحة على الساحة الدولية، ويطرح تصورًا متكاملًا لكيفية اضطلاع منظمة التجارة العالمية بدور أكثر فاعلية في تعزيز الاستدامة البيئية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على رسالتها الأساسية المتمثلة في تنظيم التجارة وتيسيرها.
يهدف البحث الى الإجابة على عدة تساؤلات:
- إلى أي مدى تُدمج الشواغل البيئية ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وآليات تسوية المنازعات التابعة لها؟
- ما طبيعة التعارض القائم بين أهداف تحرير التجارة ومتطلبات حماية البيئة؟
- كيف توازن أجهزة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية بين الالتزامات التجارية والاعتبارات البيئية؟
- ما هي أبرز التحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية في التعامل مع القضايا البيئية المعاصرة؟
- ما السبل المقترحة لإصلاح الإطار القانوني والمؤسسي لمنظمة التجارة العالمية بما يعزز من دورها في تحقيق الاستدامة البيئية العالمية؟
- الغرض من البحث
يهدف هذا البحث إلى إجراء تحليل معمق للتقاطع بين النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، ومتطلبات حماية البيئة، وذلك من خلال تحقيق عدد من الغايات.
يتمثل أولها في تحليل الإطار القانوني لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية للكشف عن الأحكام التي تُعزّز بشكل مباشر أو غير مباشر الاعتبارات البيئية ضمن منظومة التجارة العالمية. كما يسعى البحث إلى تقييم أداء جهاز تسوية المنازعات في تفسير وتطبيق الاستثناءات البيئية، ومدى مراعاته للمبادئ المتعلقة بالاستدامة ضمن تسويته للنزاعات ذات الطابع البيئي.
ويتناول كذلك دراسة التوترات التي تكمن بين مبدأ تحرير التجارة من جهة، والسياسات البيئية التي تعتمدها الدول الأعضاء من جهة أخرى، بما في ذلك آثارها القانونية والاقتصادية، كما يهدف إلى تحديد الثغرات المؤسسية والتنظيمية التي تحدّ من فعالية منظمة التجارة العالمية في الاستجابة للتحديات البيئية المعاصرة، وعلى رأسها تغيّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.
وأخيرًا، يُقدّم البحث مجموعة من المقترحات الإصلاحية القانونية والسياسية التي تُمكّن منظمة التجارة العالمية من التكيّف مع متطلبات التنمية المستدامة، وتعزز من انسجام قواعدها مع الأهداف البيئية العالمية.
– الفصل الأول: منظمة التجارة العالمية والبيئة:
– المبحث الأول: منظمة التجارة العالمية (World Trading Organization):
هي منظمة دولية حكومية يقع مقرها في جنيف، سويسرا، بدأت أعمالها في 1 يناير 1995 بموجب اتفاقية مراكش، وجاءت خلفًا لاتفاقية الجات المبرمة عام 1948، وتُعد من أكبر المنظمات الاقتصادية الدولية في العالم، وتعمل في إطار القانون الدولي، وتضم 164 دولة عضو تمثل نحو 98% من التجارة العالمية. بلغت ميزانيتها لعام 2011 حوالي 209 ملايين دولار أمريكي، يساهم بها الأعضاء بنسبة تتناسب مع حصتهم في التجارة الدولية. يُعقد مؤتمرها العام كل عامين، ويعمل بها نحو 640 موظفًا.
وتُعد منظمة التجارة العالمية منذ تأسيسها، الإطار القانوني والمؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف، إذ تضع الالتزامات التعاقدية الجوهرية التي تُوجّه الحكومات في إعداد وتنفيذ القوانين المنظمة للعلاقات التجارية الدولية، وقد كشف تحليل اقتصادي أُجري في عام 2017 عن ذلك بوضوح.
وتشير الغالبية الكبرى من اتفاقيات التجارة بشكل صريح ومباشر إلى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بوصفها عاملًا رئيسًا في الحد من التفاوت بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما تُسهم بشكل جوهري في ضمان انسياب التجارة وانتقالها بأمان ويُسر من خلال الأطر التفاوضية والاتفاقات التجارية.
– المطلب الأول: أهمية اتفاقية التجارة العالمية في مجال البيئة:
تنص اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الالتزام بتحرير وتنظيم التجارة الدولية، وترسيخ مبدأ المعاملة المتكافئة بين الدول، والامتثال لقواعد السلوك في العلاقات الاقتصادية الدولية. كما تسهم في خفض الرسوم الجمركية، وتقليص الحوافز والعوائق القانونية المفروضة على حركة التجارة العالمية، بما يشمل السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية. وتُعد التجارة الدولية محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي في العديد من الدول، لا سيما تلك التي تفتقر إلى وفرة الموارد الطبيعية أو الاستقرار المالي، حيث تتيح فرصًا للتخصص الإنتاجي عبر الحدود، وتُيسّر استيراد السلع الاستهلاكية منخفضة التكلفة، ومدخلات الإنتاج الوسيطة، والمعدات الرأسمالية.
يبرز هذا بوضوح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التي ساهمت بنسبة 35% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بمساهمتها قبل عقد من الزمن، وبصورة مماثلة، يمكن للعولمة وانفتاح الأسواق أن تؤديا دورًا محوريًا في مواجهة التحديات البيئية العالمية، لا سيما في ظل التهديد الوجودي المتمثل في تغير المناخ.
المبحث الثاني: التجارة العالمية والاقتصاد الأخضر:
يتطلب التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا إتاحة السلع والخدمات البيئية على نطاق واسع وبأسعار مناسبة، مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والمركبات الكهربائية، إضافة إلى خدمات معالجة مياه الصرف الصحي، لما لها من قدرة على نقل التكنولوجيا وتعزيز تطوير صناعات الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة محليًا.
ورغم ذلك، لا يزال التقدم في هذا المجال بطيئًا، ويُرجّح أن يؤدي غياب الالتزام الجماعي بتحرير تجارة السلع والخدمات البيئية، إلى جانب تزايد الإجراءات الحمائية، إلى تقويض جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسّة إلى تعاون عالمي وإقليمي فعّال، يقوم على مبادئ مشتركة تهدف إلى تسهيل التجارة والحفاظ على سلاسل التوريد.
وتتمثل أهمية هذه المبادرات في وضع تعريف واضح لما يُعد سلعة أو خدمة بيئية، وقد التزمت منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ بفرض رسوم جمركية لا تتجاوز 5% على 54 منتجًا بيئيًا. ومع ذلك، يبقى تأثير هذه الخطوة محدودًا نظرًا لكون الاتفاقية غير ملزمة من الناحية القانونية، إضافة إلى أنها تشمل عددًا محدودًا نسبيًا من السلع. كما أن مفاوضات اتفاقية المنتجات البيئية بين بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية واجهت عقبات ولم تُحرز تقدمًا ملموسًا حتى الآن.
وبطبيعة الحال إذا رغبت الحكومات في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإنه يمكنها من طرف واحد تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات البيئية، مثل معدات التصنيع، بما يُسهم بشكل فعّال في تقليص الانبعاثات المحلية للغازات الدفيئة، ومع ذلك، فإن إدماج هذه التدابير ضمن الاتفاقيات التجارية الدولية يستلزم توافقًا جماعيًا على معايير موضوعية واضحة.
وعلاوة على الصعوبات الفنية المرتبطة بتحديد نطاق المنتجات البيئية، قد تلجأ بعض الدول إلى تكييف المعايير بما يخدم مصالح منتجيها المحليين. ويمكن إبراز الدور المحوري للتجارة الدولية في هذا السياق من خلال النقاط الآتية:
- تعزز من بروز اقتصاد عالمي مترابط، له تأثير مباشر في تحديد مستويات الأسعار.
- تمكن من دعم القدرات التسويقية للمنتجات والخدمات
- دعم القدرة التسويقية.
- تدعم التنمية الاقتصادية وتأمن فرص العمل.
- تقوية العلاقات بين البلدان وتطويرها اذ انها تعزز من العلاقات الدبلوماسية.
- شريان الحياة ويتم تبادل ونشر الثقافات من خلال تلك الاتفاقيات الموضحة.
- توفر منصات لتبادل الخبرات والمعارف.
- تخفيف ظاهرة البطالة وتوفير المستويات التوظيفية.
- الاستخدام الرشيد للموارد الاقتصادية العالمية.
- تسعى لتحقيق مستويات توظيف مهمة لدى الاطراف.
- تكرس مفهوم التعاون الدولي وتحققه
- تدعم التكامل بين التجارة وحماية البيئة
و تبرز الحاجة الملحة إلى عمل منسق ومشترك يوظف التجارة بشكل تفاعلي مع البيئة، بما يضمن أن تسهم قوانين التجارة العالمية في حماية البيئة المحيطة وتوفير فرص تعزز الرخاء والمرونة للعيش على كوكب الأرض. ويهدف ذلك إلى تحقيق ما يُعرف بالاقتصاد الأخضر، وهو برنامج اقتصادي بيئي منخفض الكربون، يتميز بالكفاءة في استخدام الموارد، ويستهدف تحقيق النمو الاجتماعي. ولبلوغ هذا النمو، يتطلب الأمر الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية والبنى التحتية التي تُسهم في تقليل انبعاثات الكربون ودعم التنوع البيولوجي.
ومن هذا المنطلق، خلص فريق من نشطاء البيئة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالشأن البيئي إلى أن إدراج البعد البيئي ضمن الاتفاقيات التي تصيغها المنظمة من شأنه أن يحدث أثر فعال في حماية البيئة، وذلك استنادًا إلى النجاحات التي حققتها الاتفاقيات التجارية في مجالات أخرى غير بيئية، مثل اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، واتفاقية الجوانب التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.
– المبحث الثاني: منظمة التجارة العالمية: الأطر القانونية المنظمة للتجارة والبيئة:
تنص اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على أحكام تتعلق بالاعتبارات البيئية، إلا أن مدى فعاليتها ما زال محل جدل.
ويعد تقاطع التجارة الدولية مع حماية البيئة مجالا قانونيا معقدا، حيث تتعارض في كثير من الأحيان التزامات تحرير التجارة مع الحقوق السيادية في وضع السياسات البيئية، وتقدم منظمة التجارة العالمية مجموعة من الاتفاقيات، أبرزها اتفاقية الجات، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين هذه الأهداف، ومع ذلك يبقى هذا التوازن ضعيفا، وتشير السوابق القضائية إلى وجود ميل لتقديم أولوية لتحرير التجارة على حساب الضمانات البيئية القوية.
وفي هذا السياق، سيتم تناول الاتفاقيات التالية:
المطلب الأول: الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT)
المادة XX من اتفاقية الجات تنص على عدة استثناءات تجيز للدول الأعضاء اعتماد تدابير تقيد التجارة لحماية البيئة. تجيز المادة XX (ب) من اتفاقية الجات استثناءات للتدابير التي تُعد ضرورية لحماية حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات. كما تنص المادة XX (ز) على أحكام تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة. ومع ذلك، فقد جرى في كثير من الحالات تفسير هذه الاستثناءات تفسيرًا ضيقًا من قبل أجهزة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، مما قيد من فعاليتها العملية. ويرجع ذلك أساسًا إلى النهج التفسيري الصارم الذي تبنته هيئة الاستئناف التابعة للمنظمة.
فعلى سبيل المثال، في قضية الولايات المتحدة – البنزين (1996)، أقرت هيئة الاستئناف بشرعية الهدف البيئي، لكنها شددت على أن أي تدابير بيئية لا بد ألا تؤدي إلى تمييز تعسفي أو غير مبرر، أو إلى فرض قيود خفية على التجارة الدولية. وبالمثل، في قضية الولايات المتحدة – الروبيان (1998)، وعلى الرغم من استناد الولايات المتحدة إلى المادة XX (ز) لتبرير قيود على استيراد الروبيان المصطاد بطرق تلحق ضررا بالسلاحف البحرية، رفضت اللجنة الابتدائية هذا الدفاع، مشيرة إلى غياب العدالة الإجرائية، رغم وضوح الغرض البيئي للتدبير محل النزاع.
وكثيرا ما يدفع التفسير الضيق لمفاهيم الضرورة والإنصاف الإجرائي بموجب المادةXX ، التدابير البيئية إلى المرور عبر ما يشبه ثقب إبرة من الناحية القانونية لتبرير مشروعيتها، وهو ما يضعف من أثرها العملي.
-المطلب الثاني: اتفاقية الحواجز التقنية للتجارة (TBT)
تنص اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة على ضرورة ألا تؤدي اللوائح البيئية إلى إنشاء حواجز تجارية غير ضرورية، وعلى الرغم من اعترافها بالأهداف البيئية باعتبارها أهدافا مشروعة، فقد أثيرت خلافات بشأن ما إذا كانت بعض هذه التدابير تُعد شكلا من أشكال الحماية المقنّعة، وتجيز المادة 2.2 من اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة اعتماد تدابير شريطة ألا تُقيد التجارة بشكل يتجاوز الحد اللازم لتحقيق الأهداف البيئية.
تمثل قضية الولايات المتحدة – التونة الثانية (المكسيك) عام 2012 هذا التوتر، إذ قضت بأن شرط الولايات المتحدة لوضع علامات على تونة آمنة للدلافين ينطوي على تمييز، رغم أن الهدف يرتبط بحماية البيئة. وقد أقرت هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية بشرعية الهدف، لكنها رأت خللًا في تطبيق القاعدة بشكل غير متسق.
ويُظهر ذلك أن حتى في الحالات التي تكون فيها النوايا البيئية واضحة، فإن التطبيق غير المتوازن قد يُفضي إلى الإدانة بموجب اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة. ويرى عدد من الباحثين أنه رغم أن هذه الاتفاقية أكثر استيعابًا للاعتبارات البيئية مقارنة باتفاقية الجات، إلا أن شروطها الإجرائية مثل الشفافية والمساواة والضرورة قد تمثل قيودًا فعلية على السياسات الابتكارية أو الوقائية.
– المطلب الثالث: اتفاقية التدابير الصحية والنباتية (SPS)
تُنظّم اتفاقية التدابير الصحية والنباتية سلامة الأغذية ومعايير صحة الحيوان والنبات.
وتبرز المخاوف البيئية عندما يعترض أعضاء منظمة التجارة العالمية على التدابير الاحترازية بوصفها غير قائمة على أسس علمية أو معيقة للتجارة، كما في نزاع المفوضية الأوروبية حول الهرمونات.
وتختص اتفاقية التدابير الصحية والنباتية بسلامة الأغذية والأمن الحيوي، وتشترط أن تكون التدابير مستندة إلى مبررات علمية. وتجيز المادة 5.7 اتخاذ تدابير مؤقتة في حال نقص الأدلة العلمية، مع التزام الأعضاء بالسعي للحصول على معلومات إضافية للوصول إلى قرار نهائي.
يُعد نزاع المفوضية الأوروبية حول الهرمونات مثالًا على ذلك، إذ تقرر أن حظر الاتحاد الأوروبي على لحوم الأبقار المعالجة بالهرمونات، استنادًا إلى نهج احترازي، يتنافى مع اتفاقية الصحة والصحة النباتية بسبب غياب تقييم حاسم للمخاطر.
ويعكس هذا الحكم ميلاً نحو التحيز الوضعي، حيث يُقيد الاستقلال التنظيمي في حال غياب دليل علمي قاطع، رغم تزايد التأييد الأكاديمي لنهج الحذر في السياسات البيئية والصحية.
وتطرح القضية تساؤلات جوهرية حول كيفية توظيف العلم في نزاعات منظمة التجارة العالمية، حيث تُمنح الأفضلية غالبًا للتقييمات الكمية على حساب النوعية، مما يُضعف من الاعتبارات الاجتماعية والبيئية الاحترازية.
يعكس الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية وجود خلل في التوازن بين التجارة والبيئة. فرغم أن اتفاقيات الجات، والحواجز التقنية أمام التجارة، والصحة النباتية تقر رسميًا بالأهداف البيئية، فإن تفسيرها من قبل هيئات الفصل في المنازعات غالبًا ما يخضع هذه الأهداف لمنطق تحرير التجارة الذي تتبناه المنظمة. ولا تزال النقاشات قائمة بين الباحثين وصناع القرار حول ضرورة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق بتوسيع المجال البيئي داخل قواعد المنظمة، وتعزيز إدماج مبادئ التحوط والتنمية المستدامة.
وتشير محاولات دمج الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف مع التزامات منظمة التجارة العالمية، والمقترحات المرتبطة بها، إلى أن إصدار بيان تفسيري رسمي يعطي الأفضلية للسلامة البيئية قد يُمثّل توجهًا مستقبليًا ممكنًا. وفي غياب مثل هذا التوجه، تُواجه منظمة التجارة العالمية خطر أن
تعتبر جهة تقوم التطلعات المتجددة للحوكمة البيئية.
وفي المحصلة، يمكن تلخيص دور الأحكام القانونية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في دعم حماية البيئة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على النحو التالي:
بوجه عام، رغم أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تتضمن احكام قانونية تقر بشرعية حماية البيئة، إلا أن التطبيق العملي لهذه الاحكام يظل مقيد بتفسيرات قانونية ضيقة ومتطلبات اجرائية صارمة. فالمادة العشرون من اتفاقية الجات تشكل اساس قانوني للاستثناءات البيئية، لكنها تضعف بفعل عبء الاثبات الثقيل والقيود الاجرائية. وبالمثل، ورغم أن اتفاقيتي العوائق الفنية امام التجارة والصحة النباتية تتيحان المجال للتنظيم البيئي، فإن تركيزهما على عدم التمييز وشرط الضرورة والمبررات العلمية يفرض عوائق منهجية امام السياسات البيئية الابتكارية او الوقائية. وهذا ينتج خلل هيكلي داخل الإطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية، حيث تبقى اولوية تحرير التجارة مهيمنة، في حين تعامل الاعتبارات البيئية كمسائل ثانوية ومشروطة. اذا كانت منظمة التجارة العالمية تطمح الى الحفاظ على دورها في ظل تصاعد الازمات البيئية، فعليها أن تطور نظامها القانوني ليمنح مساحة اوسع للمبادئ البيئية، خصوصا من خلال دمج اوضح للاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف، وتقبل اوسع لنهج الحذر.
المبحث الثالث: تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية والقضايا البيئية
توضح مراجعة قضايا النزاعات البارزة في منظمة التجارة العالمية صعوبة تحقيق توازن فعلي بين اهداف التجارة واعتبارات البيئة.
تم اختيار قضيتي الروبيان والسلحفاة وهرمونات الاتحاد الاوروبي باعتبارهما من اكثر نزاعات منظمة التجارة العالمية تأثيرًا وتحليلًا، حيث تتناولان تداخل الالتزامات التجارية مع التدابير البيئية او تدابير الصحة العامة. وتوفر هاتان القضيتان البارزتان رؤى مهمة حول كيفية تفسير آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للاستثناءات البيئية وتطبيقها ضمن اطارها القانوني، مما يجعلها ذات اهمية كبيرة في تقييم قدرة المنظمة على موازنة القيم التجارية مع القيم غير التجارية.
تعد قضية الروبيان والسلحفاة من القضايا البارزة، حيث كانت من اوائل احكام منظمة التجارة العالمية التي اقرت بحماية البيئة كهدف مشروع بموجب المادة XX فقرة زاي من اتفاقية الجات. وقد طرحت القضية مسألة مدى جواز تقييد الواردات من جانب دولة ما استنادا الى اساليب انتاج بيئية مستخدمة في الخارج. ورغم أن هيئة الاستئناف قضت ضد الولايات المتحدة بسبب عيوب اجرائية، اهمها التطبيق الاحادي والتمييزي لتدابيرها، الا أن الحكم اوضح أن السياسات البيئية متعددة الاطراف وغير التمييزية يمكن أن تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقد شكلت هذه القضية سابقة في تفسير المادة XX بما يحقق الاهداف البيئية، بشرط تنفيذ هذه التدابير بعدالة. كما شددت على اهمية العدالة الاجرائية، مثل الشفافية والتعاون مع الشركاء التجاريين، في اضفاء المشروعية على التدابير البيئية.
تم اختيار قضية هرمونات المفوضية الاوروبية لما لها من دور محوري في توضيح التباين بين مبدأ الحذر ومتطلبات منظمة التجارة العالمية المبنية على الاساس العلمي وفق اتفاقية الصحة والصحة النباتية. وقد دار النزاع حول حظر الاتحاد الاوروبي للحوم الابقار المعالجة بالهرمونات، استنادا الى مخاوف تتعلق بالصحة العامة والبيئة، لكنه لم يستند الى ادلة علمية حاسمة. واظهر حكم منظمة التجارة العالمية ضد الاتحاد الاوروبي تمسكها بتقييمات المخاطر التجريبية المستندة الى العلم، مما قيد عمليا امكانية التنظيم الاحترازي في حال غياب اليقين العلمي. وتشكل هذه القضية نقطة اساسية لفهم كيف يمكن للاطار القانوني لمنظمة التجارة العالمية أن يحد من الاستقلال التنظيمي، خاصة في المجالات التي تتقاطع فيها القيم العامة مع المعرفة العلمية المتطورة.
تعد هاتان الحالتان معا محوريتين في توضيح المعضلات الاساسية التي يواجهها قانون منظمة التجارة العالمية، والمتمثلة في الصراع بين تحرير التجارة العالمية والحق السيادي في التنظيم من أجل حماية البيئة والصحة.
وتبقيان مرجعيتين في النقاشات القانونية والاكاديمية المتعلقة بإصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية بما يعكس بشكل أفضل التحديات البيئية وتحديات الاستدامة الراهنة.
تعد قضية السلاحف والروبيان محطة بارزة في فقه منظمة التجارة العالمية، اذ اثبتت أن الاهداف البيئية قد تبرر فرض قيود تجارية بموجب اتفاقية الجات، واشارت في الوقت ذاته الى أن هذه التدابير يجب أن تُطبق بعدالة وتعاون، مع ضرورة تفادي التمييز التعسفي او غير المبرر.
باختصار، تعد قضية الروبيان والسلاحف من النزاعات الاساسية في منظمة التجارة العالمية، اذ ارست اساسا قانونيا للاستثناءات البيئية ضمن قواعد التجارة، لكنها فرضت شروطا اجرائية وموضوعية مشددة لضمان عدالة هذه التدابير وعدم تحولها الى وسائل حمائية.
ولا تزال تشكل مرجعا مهما في الجدل القائم حول التوازن بين تحرير التجارة والاستدامة البيئية
في القانون الدولي.
وتعتبر قضية هرمونات المجموعة الاوروبية بالغة الاهمية، لأنها شددت على النهج العلمي الذي تعتمده منظمة التجارة العالمية في مجال التدابير الصحية والنباتية، مما قيد مجال الحظر الاحترازي في غياب ادلة قاطعة. ولا تزال هذه القضية تؤثر على النقاشات العالمية بشأن تنظيم سلامة الاغذية، وتقييم المخاطر، وحدود السيادة التنظيمية في ظل قانون التجارة الدولي.
كذلك، يُعد نزاع المفوضية الاوروبية بشأن الهرمونات من القضايا المحورية التي تسلط الضوء على المعايير الصارمة التي تعتمدها منظمة التجارة العالمية لتبرير القيود التجارية المرتبطة بالصحة، وعلى التحديات التي تواجه إدماج السياسات البيئية والصحية الاحترازية داخل الإطار القانوني للمنظمة.
وتكمن اهمية هذه القضية في أنها اكدت على اعتماد المنظمة للنهج العلمي في تطبيق التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، وهو ما يضيق من مساحة الحظر الاحترازي في حال غياب الادلة القاطعة.
– المطلب الأول: قضية الروبيان والسلاحف
– الخلفية: حظرت الولايات المتحدة استيراد الروبيان من دول لا تُلزم باستخدام أجهزة استبعاد السلاحف في صيد الروبيان بشباك الجر، بهدف حماية السلاحف البحرية المُهددة بالانقراض.
– النزاع: جادلت الدول المُشتكية (الهند وماليزيا وباكستان وتايلاند) بأن الإجراء الأمريكي تمييزي وينتهك أحكام اتفاقية الجات لعام 1994، وخاصة الأحكام المتعلقة بعدم التمييز والتجارة العادلة.
أثارت هذه القضية التساؤلات التالية:
- هل يشكل الحظر الامريكي خرقا للمادة الحادية عشرة من اتفاقية الجات، التي تحظر فرض قيود تجارية كمية؟
- وهل يمكن تبرير هذا الحظر بموجب المادة العشرين فقرة زاي من الاتفاقية، التي تتيح استثناءات للتدابير المرتبطة بحفظ الموارد الطبيعية القابلة للاستنفاد، بشرط ألا تُطبق بشكل تمييزي او حمائي؟
- النتيجة: اقرت هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية بمشروعية الهدف البيئي بموجب المادة XX فقرة زاي، لكنها رأت أن تطبيق الولايات المتحدة للتدبير كان تمييزيا بشكل غير مبرر، بسبب اعتماده على نهج احادي وغير مرن، وافتقاره الى التعاون الدولي والعدالة الاجرائية، بما في ذلك غياب الجهود الكافية للتفاوض. وقد شدد الحكم على اهمية ابرام اتفاقيات متعددة الاطراف وضرورة معاملة الشركاء التجاريين بعدالة.
قضت منظمة التجارة العالمية بأنه رغم اعتبار حماية البيئة هدفا مشروعا، إلا أن القيود التجارية يجب أن تُطبق بطريقة غير تمييزية وشفافة، وأن تُبنى على تفاهمات متعددة الاطراف.
قامت الولايات المتحدة بمراجعة سياستها لتوفير مزيد من المشاركة والمرونة مع الدول المصدرة، ولتتوافق اجراءاتها مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأبرز الحكم اهمية تبني تدابير بيئية لا تنطوي على تمييز.
– المطلب الثاني: قضية الهرمونات أو نزاع المفوضية الأوروبية بشأن الهرمونات والتدابير المتعلقة باللحوم ومنتجاتها (الهرمونات)
- الخلفية: فرضت الجماعة الاوروبية حظرًا على واردات لحوم البقر المعالجة بهرمونات نمو معينة، مشيرة الى مخاوف تتعلق بصحة المستهلك.
- النزاع: طعنت الولايات المتحدة وكندا في الحظر، مدعيتين أنه يفتقر الى اساس علمي وينتهك اتفاقية الصحة والصحة النباتية.
تساءلت الهيئة عما إذا كان الاجراء الأوروبي (حظر الجماعة الأوروبية للهرمونات):
متوافقا مع المادة 5 من اتفاقية الصحة والصحة النباتية، وخاصة فيما يتعلق بتقييم المخاطر والاعتماد على الادلة العلمية، وعن مدى امكانية تبريره استنادا الى مبدأ الحيطة، الذي يجيز للدول اتخاذ تدابير وقائية في حالات عدم اليقين العلمي.
– نتائج لجنة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية:
قضت لجنة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية بأن اجراء المفوضية الاوروبية مخالف لاتفاقية الصحة والصحة النباتية، وبوجه خاص للمادة 5.1، لأنه لم يستند الى تقييم مناسب للمخاطر مدعوم بأدلة علمية
ورغم استناد المفوضية الاوروبية الى مبدأ الحيطة، إلا أن ذلك لم يُعد مبررا كافيا لتجاوز شرط التحليل العلمي للمخاطر الوارد في اتفاقية الصحة والصحة النباتية.
وقد اوضحت هيئة الاستئناف أن لأعضاء منظمة التجارة العالمية الحق في تحديد مستويات الحماية الصحية التي يرونها مناسبة، بشرط أن تستند التدابير المعتمدة الى مبررات علمية، وان تُطبق بطريقة غير تمييزية
وهو ما اثار تساؤلات حول مدى مرونة السياسات البيئية في ظل القواعد القانونية لمنظمة التجارة العالمية.
وقد جاء الحكم لصالح الولايات المتحدة وكندا، وطُلب من المفوضية الاوروبية تعديل اجراءاتها بما لا يتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
– المطلب الثالث: التعليق على القضايا:
توضح هذه القضايا أنه رغم اعتراف منظمة التجارة العالمية بالأولوية البيئية، فإنها تشترط دقة قانونية وتطبيقا غير تمييزي. وقد شكلت قضية الروبيان والسلاحف نقطة تحول في تفسير المادة XX فقرة زاي، إذ كانت من اوائل القضايا التي اقرت بحماية البيئة كهدف مشروع للسياسة التجارية. وبينت هيئة الاستئناف أن التدابير البيئية الاحادية يمكن تبريرها، بشرط أن تُطبق بشفافية وألا تؤدي الى تمييز تعسفي او غير مبرر. وبعد صدور الحكم، قامت الولايات المتحدة بتعديل سياستها لتشجيع مزيد من التفاعل مع الدول المصدرة، مما ساعد في نهاية المطاف على مواءمة الاجراء مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وتُستخدم هذه القضية كثيرا كمثال على قدرة نظام منظمة التجارة العالمية على استيعاب المخاوف البيئية إذا صُممت السياسات بشكل جيد وشملت الحوار مع الشركاء التجاريين.
في المقابل، أثار القرار المتعلق بقضية الهرمونات جدلا حول موقع مبدأ الحيطة في قانون منظمة التجارة العالمية. فقد جادل الاتحاد الاوروبي بأن عدم اليقين العلمي يبرر تشديد المعايير الصحية، بينما شددت منظمة التجارة العالمية على ضرورة وجود تقييمات مخاطر تستند الى بيانات تجريبية. وقد قيد هذا الشرط الصارم قدرة الاتحاد الاوروبي على تبني تدابير صحية وقائية، مما فتح نقاشا حول مدى تقديم منظمة التجارة العالمية للعلم على حساب الاستقلال التنظيمي للدول. وأبرز الحكم التوترات بين قواعد التجارة القائمة على الادلة العلمية وبين المخاوف المجتمعية مثل صحة المستهلك وسلامة الغذاء. ومنذ ذلك الحين، تركت هذه القضية تأثيرا واسعا على النقاشات الدولية المتعلقة بمعايير الغذاء، وإدراك المخاطر، وحدود قانون التجارة الدولي.
– المطلب الرابع: تقييم فعالية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية في تحقيق التوازن بين التجارة والمخاوف البيئية:
لا تزال فعالية نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية في تحقيق توازن بين الشواغل التجارية والبيئية محل جدل، كما يتضح من قضايا بارزة مثل قضية الولايات المتحدة بشأن الروبيان وقضية المفوضية الاوروبية بشأن الهرمونات. وتُبرز هذه الاحكام أنه رغم اعتراف منظمة التجارة العالمية بشرعية الاهداف البيئية، فإنها تفرض شروطا اجرائية وموضوعية مشددة غالبا ما تعيق التطبيق العملي لتلك الاهداف.
في قضية الروبيان، سجلت هيئة الاستئناف في منظمة التجارة العالمية تطورا مهما بإقرارها أن حماية البيئة تمثل هدفا مشروعا بموجب المادة XX فقرة زاي من اتفاقية الجات. ومع ذلك، قضت ضد الاجراء الامريكي بسبب طبيعته الاحادية وغير المرنة، معتبرة أنه ينطوي على تمييز غير مبرر. ويُظهر ذلك أن هيئات تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية لا ترفض الاهداف البيئية في ذاتها، بل تشترط أن تُصاغ التدابير بطريقة شفافة وغير تعسفية، وأن تُبنى على اسس متعددة الاطراف. وقد اسفرت القضية في نهاية المطاف عن نتيجة ايجابية، اذ قامت الولايات المتحدة بمراجعة سياستها لتشمل مشاركة اكثر انصافا مع الدول المتأثرة، بما يتفق مع قواعد المنظمة. وتعكس هذه النتيجة امكانية مراعاة الاعتبارات البيئية عند تصميم التدابير التجارية بدقة وعدالة اجرائية، مما يدل على قدرة منظمة التجارة العالمية على تحقيق توازن فعلي متى تم احترام المعايير القانونية.
في المقابل، تُبرز قضية هرمونات المجموعة الاوروبية محدودية إطار عمل منظمة التجارة العالمية في التعاطي مع المخاطر الصحية والبيئية. فقد قضت المنظمة ضد الحظر الاحترازي الذي فرضته الجماعة الاوروبية على لحوم الابقار المعالجة بالهرمونات، مشددة على غياب تقييم للمخاطر يستند الى اسس علمية واضحة. وكشف هذا الحكم عن تمسك صارم من جانب منظمة التجارة العالمية بالأدلة العلمية التجريبية، وغالبا ما يكون ذلك على حساب امكانية اعتماد التنظيم الاحترازي او الوقائي. وتُظهر هذه القضية ميلا هيكليا نحو العلم الوضعي، يحد من قدرة الاعضاء على تبني تدابير وقائية استباقية لحماية الصحة او البيئة في ظل الغموض العلمي. كما تثير هذه النتيجة تساؤلات حول مدى مرونة المنظمة في التعامل مع شواغل الصحة العامة او المجتمعية التي لم تُثبت علميا بشكل نهائي.
نستنج مما سبق أن هذه القضايا مجتمعة تُظهر أن آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية يمكن أن تدعم حماية البيئة، ولكن ضمن إطار قانوني صارم يُعلي من شأن الانضباط التجاري ويتطلب صرامة اجرائية. وبينما يسمح النظام ببعض التبريرات البيئية، خصوصا بموجب المادة العشرين، فإنه يرفض النهج الاحادي، ويشترط عدم التمييز، ويرتكز على الاجماع العلمي. وقد يقيّد هذا الإطار امكانية تبني تدابير مبتكرة او احترازية في الحوكمة البيئية، خاصة حين تستجيب لحالات من عدم اليقين او لقيم عامة او اعتبارات اخلاقية. ومع ذلك، تُبين قضية الروبيان أن إطار منظمة التجارة العالمية لا يتنافى بالضرورة مع الاهداف البيئية، بشرط أن تكون السياسات المعتمدة شاملة وشفافة ومسنودة بأدلة قوية. لذلك، يمكن اعتبار نظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية فعالا بشكل جزئي: فهو يأخذ بالأهداف البيئية عند صياغتها بعناية، لكنه يُبقي تحرير التجارة في موقع متقدم على الحيطة البيئية، مما يعكس الحاجة الى اصلاح مؤسسي يعبر بشكل أفضل عن اولويات الاستدامة والصالح العام في قانون التجارة العالمي.
– المبحث الرابع: مبادرات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة والبيئة
اقرت منظمة التجارة العالمية بشكل متزايد بالأبعاد البيئية المرتبطة بالتجارة العالمية. ومع ذلك، ورغم استحداث بعض الآليات، يرى العديد من النقاد أن المنظمة لا تزال تتحرك ضمن اطار يهيمن عليه منطق تحرير التجارة، ما يؤدي غالبا الى تهميش الاهداف البيئية. وقد انشأت منظمة التجارة العالمية عددا من الآليات للتعامل مع الشواغل البيئية، من بينها:
– المطلب الأول: لجنة التجارة والبيئة (CTE)
تأسست لجنة التجارة والبيئة في عام ١٩٩٥، وشكلت منتدى مخصصا للحوار حول العلاقة بين التجارة والسياسات البيئية. وقد صُممت لتكون ساحة لتبادل الآراء بشأن كيفية التفاعل بين النظام التجاري الدولي والأهداف البيئية، دون أن تمتلك صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ملزمة. (منظمة التجارة العالمية، ٢٠٢٣).
تستعرض اللجنة آثار التدابير البيئية على الوصول الى الاسواق، والعلاقة بين الاتفاقيات البيئية متعددة الاطراف وقواعد منظمة التجارة العالمية، ووضع العلامات البيئية، وغيرها من المواضيع. كما تبحث في العلاقة بين التجارة والتدابير البيئية.
مع ذلك، تفتقر لجنة التجارة والبيئة الى صلاحية وضع القواعد او تسوية النزاعات، مما يقيّد فعاليتها بشكل كبير. ورغم أنها وفرت مساحة للحوار وتبادل المعلومات، إلا أنها لم تؤد الى التزامات قابلة للتنفيذ. وتنتقد الادبيات الاكاديمية اللجنة بوصفها “مفيدة سياسيا لكنها عاجزة مؤسسيا”، نظرا لغياب المعايير الملزمة وعدم المبادرة في تطبيقها (Eckersley, 2004).
علاوة على ذلك، تعكس مناقشات اللجنة في كثير من الاحيان اختلالات في موازين القوى بين دول الشمال والجنوب العالميين، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الوصول الى التقنيات النظيفة ومستوى المرونة التنظيمية المتاحة لكل طرف.
– المطلب الثاني: اتفاقية السلع البيئية (EGA)
تهدف اتفاقية السلع البيئية الى الغاء التعريفات الجمركية على السلع البيئية، مثل تقنيات الطاقة المتجددة ومعدات مكافحة التلوث، بهدف دعم انتشارها وزيادة استخدامها.
انطلقت مفاوضات الاتفاقية في عام ٢٠١٤، وشارك فيها عدد من اعضاء منظمة التجارة العالمية، من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والصين ودول اخرى تمثل مجتمعة نسبة كبيرة من التجارة العالمية في السلع البيئية. وكان الغرض منها تحسين امكانية الوصول الى التقنيات البيئية، وبالتالي دعم التحولات الخضراء.
رغم التقدم المحرز، واجهت المفاوضات صعوبات بسبب الخلافات حول تعريف “السلع البيئية”. فبينما تدعو بعض الدول الى ادراج واسع يشمل سلع مثل الدراجات، تفضل دول اخرى قائمة أكثر ضيقا وتركيزا على التكنولوجيا البيئية. على سبيل المثال، سعت الصين الى ادراج السلع الوسيطة، في حين اعترضت دول اخرى على هذا التوسيع بسبب مخاوف تتعلق بالتنافسية. وقد ادى غياب التوافق الى تأجيل التوصل الى اتفاق نهائي، مما يعكس صعوبة التوفيق بين تحرير التجارة وأولويات مواجهة تغير المناخ في غياب تعريفات واطر تنموية أكثر وضوحا.
– المطلب الثالث: التعاون مع الهيئات الخارجية
تتفاعل منظمة التجارة العالمية بشكل منتظم مع منظمات مثل برنامج الامم المتحدة للبيئة واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، إلا أن التكامل الرسمي بين اختصاصات هذه الهيئات يظل محدودا. ويطالب عدد كبير من الخبراء بإقامة شراكات اقوى لتسهيل إدماج الاعتبارات البيئية ضمن عملية صنع السياسات التجارية.
مع ذلك، يظل هذا التعاون غير رسمي وغير ملزم، اذ لا تمتلك منظمة التجارة العالمية اطارا قانونيا رسميا لدمج الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف او اتفاقيات الامم المتحدة للمناخ ضمن نظامها الخاص بتسوية المنازعات. وقد دعا باحثون مرارا الى تعزيز التعاون المؤسسي لتفادي النزاعات القانونية وتعزيز التآزر بين قواعد التجارة والالتزامات البيئية الدولية (Charnovitz، 2007). ويظهر هذا التوتر بوضوح عندما تطعن منازعات منظمة التجارة العالمية في اللوائح البيئية الوطنية بحجة التمييز التجاري، متجاهلة في كثير من الاحيان الالتزامات الواردة في الاتفاقات البيئية متعددة الاطراف.
– المطلب الرابع: اتفاقية دعم مصايد الأسماك
تهدف هذه الاتفاقية الى تقليص الاعانات الضارة التي تسهم في الصيد الجائر، مما يمثل خطوة نحو
دمج مبادئ الاستدامة في السياسات الخارجية.
وتُعد اتفاقية دعم مصايد الاسماك، التي تم اعتمادها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية عام ٢٠٢٢، اتفاقية تاريخية تهدف الى الحد من الاعانات التي تؤدي الى الصيد الجائر وجهود الصيد المفرطة. وتعكس هذه الاتفاقية اول نص تصدره منظمة التجارة العالمية يُركز بشكل صريح على الاستدامة البيئية كهدف اساسي.
تحظر الاتفاقية بعض الاعانات المقدمة للصيد غير المشروع وغير المُبلغ عنه وغير المنظم، وتدعو الى تعزيز الشفافية والامتثال لإدارة مصايد الاسماك الدولية.
ورغم الترحيب بها كخطوة تاريخية، يرى النقاد أنها تفتقر الى آليات انفاذ فعالة، وتمنح اعفاءات واسعة للدول النامية، وهو ما قد يُضعف من أثرها البيئي الفعلي.
رغم اعتمادها في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، تظل الاتفاقية غير مكتملة. فقد تركزت المفاوضات حول ركيزة اساسية ثالثة تتمثل في حظر الدعم الذي يؤدي الى فائض الطاقة والصيد الجائر، اي حين يتجاوز حجم او قدرة اسطول الصيد الحدود المستدامة. ولا يزال هذا الجانب دون اتفاق نهائي.
ومن امثلة الدعم الذي يُسهم في فائض الطاقة:
- دعم شراء السفن أو توسيعها
- دعم الوقود
- دعم المعدات (مثل الثلج والطُعم)
- دعم الأجور والتأمين
هناك بُعد تنموي لهذه القضية، إذ تسعى العديد من الدول النامية إلى توسيع أساطيل الصيد لديها بهدف تحقيق نموًا اقتصاديًا، وهو ما قد يتعارض مع أهداف الاستدامة. وتختلف هذه الدول بشكل كبير، فبعضها يعتمد على مصايد حرفية صغيرة، في حين يدير البعض الآخر أساطيلًا صناعية. وقد حاولت مسودات المفاوضات السابقة معالجة هذا التباين من خلال:
- اقتراح حظر عام على الدعم الضار، مع استثناءات في الحالات التي توجد فيها إدارة مستدامة للمخزون السمكي.
- منح معاملة خاصة وتفاضلية (SDT – Special and Differential Treatment) للدول النامية، مثل:
- إعفاءات مؤقتة داخل المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZs – Exclusive Economic Zones).
- إعفاءات قائمة على العتبات للدول ذات أحجام صيد بحري منخفضة.
- تصاريح للصيد على نطاق ضيق ضمن نطاق 12 إلى 24 ميلًا بحريًا
ومع ذلك، تبين أن التوصل الى توافق خلال محادثات يونيو 2022 كان بالغ التعقيد. ونتيجة لذلك، اتفق الاعضاء على مواصلة التفاوض والعمل على استكمال الاحكام في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية. ومن المتوقع أن تتركز المحادثات المقبلة على استكمال القواعد الخاصة بالقدرة الفائضة ودعم الصيد الجائر، مع التأكيد على أن تكون المعاملة الخاصة والتفاضلية للدول النامية والاقل نموا عنصرا محوريا في الاتفاق النهائي (Switzer, 2022).
ومع ذلك، تُشكّل هذه الاتفاقية تحولًا رمزيًا في خطاب منظمة التجارة العالمية، حيث تُقرّ بالبيئة ليس فقط كعامل خارجي، بل كعنصر أساسي في تنظيم التجارة.
وقد تنشأ خلافات أيضًا حول كيفية تعريف المعايير البيئية وتطبيقها، خاصة في ظل تباين قدرات وموارد أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ومن القضايا الأخرى البارزة غياب التزامات بيئية مُلزمة قانونًا ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. فعلى عكس اتفاقيات مثل اتفاقية باريس التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا تُلزم منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء بتحقيق أهداف بيئية مُحددة، مما يُضعف من فاعلية الجهود الرامية إلى دمج السياسات البيئية ضمن الإطار التجاري الدولي.
– الفصل الثاني: التحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية في حماية البيئة:
في حين يوفر إطار عمل منظمة التجارة العالمية آليات للتعامل مع القضايا البيئية، إلا أنه يُواجه انتقادات واسعة لعجزها عن إعطاء الأولوية للتحديات البيئية المعاصرة أو الاستجابة لها بشكل كاف.
1- من بين التحديات الرئيسية الاعتقاد السائد بأن قواعد منظمة التجارة العالمية تُفضّل تحرير التجارة على حساب حماية البيئة. ورغم أن المادة العشرين تمنح استثناءات، فإن شروطها ضيقة وغالبًا ما يصعب استيفاؤها، مما يؤدي إلى تردد الدول في تبنّي سياسات بيئية صارمة خشية إثارة نزاعات ضمن المنظمة.
كما أن إدراج أحكام بيئية مُلزمة قد يُقابل بمقاومة من دول تُعطي الأولوية للنمو الاقتصادي على حساب الاعتبارات البيئية، ولا سيّما الدول النامية التي قد ترى في هذه التدابير عوائق تجارية إضافية (Edith Brown & 2000).
وقد تنشأ خلافات أيضًا حول كيفية تعريف المعايير البيئية وتطبيقها، خاصة في ظل تباين قدرات وموارد أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ومن القضايا الأخرى البارزة غياب التزامات بيئية مُلزمة قانونًا ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. فعلى عكس اتفاقيات مثل اتفاقية باريس التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا تُلزم منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء بتحقيق أهداف بيئية مُحددة، مما يُضعف من فاعلية الجهود الرامية إلى دمج السياسات البيئية ضمن الإطار التجاري الدولي.
٢- يشكّل مبدأ عدم التمييز، المتمثل في قاعدة الدولة الاكثر رعاية (MFN) والمعاملة الوطنية، حجر الاساس في نظام منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن اللوائح البيئية التي تفرض في الغالب أعباء امتثال إضافية قد تُواجه اتهامات بالتحيز، خاصة إذا أثرت بشكل غير متناسب على المصدرين من الدول ذات القدرات التكنولوجية المحدودة.
ويرى مؤيدو التجارة الحرة أن الثروة الناتجة عن انفتاح الاسواق يمكن أن تُستخدم في تمويل التحسينات البيئية، بينما يشير المشككون الى أن التجارة غير المقيدة قد تؤدي إلى استغلال مفرط للموارد الطبيعية أو زيادة في الانبعاثات الضارة .
٣- غالبًا ما يكون التنسيق بين الهيئات التجارية والبيئية محفوفًا بالتعقيد، نظرًا لاختلاف الاولويات وتباين الخبرات بين الجانبين.
قد تُعطي المنظمات البيئية الأولوية لتدابير صارمة تهدف إلى حماية البيئة، في حين تُركز الهيئات التجارية على تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة.
وعلاوة على ذلك، قد تنشأ توترات بين الدول النامية والمتقدمة بشأن عدالة هذا النوع من التعاون، خاصة عند التطرق إلى المسؤوليات التاريخية عن التدهور البيئي، وعلى وجه التحديد قضية تغير المناخ.
٤- قد تواجه مبادرات بناء القدرات في الدول النامية مجموعة من التحديات، ويتمثل التحدي الرئيسي في ضمان أن تكون هذه المبادرات ملائمة للاحتياجات والأولويات الخاصة بكل دولة على حدة، مع مراعاة الفوارق الاقتصادية والمؤسسية والبيئية. (منظمة التجارة العالمية، 2018). علاوة على ذلك، قد تظهر صعوبات في تأمين تمويل مستدام لهذه البرامج، إلى جانب تحدي التعامل مع معارضة بعض أصحاب المصلحة في هذه الدول، ممن قد يرون في اللوائح البيئية عبئًا إضافيًا يعيق التنمية أو يُثقل كاهل القطاعات الإنتاجية.
٥- علاوة على ذلك، يُضيف التفاعل بين سلاسل الإنتاج المعولمة والإدارة البيئية المحلية مستوى إضافيًا من التعقيد. فقد تستغل الشركات متعددة الجنسيات الكبرى تفاوت المعايير التنظيمية بين المناطق، فتنقل عملياتها إلى دول تتسم بقوانين بيئية مُتراخية. وفي المقابل، قد تجد الحكومات التي تواجه أضرارًا بيئية متزايدة نفسها مُلزمة بتشديد اللوائح على الواردات أو أساليب الإنتاج، مما يفتح المجال لنزاعات بشأن مدى توافق هذه التدابير مع التزامات منظمة التجارة العالمية. وتُبرز هذه الديناميكية المتكررة أن الحفاظ على التوازن بين حرية التجارة والضمانات البيئية يتطلب يقظة دائمة وتكيفًا مستمرًا.
٦- في الوقت نفسه، يمكن لمزيد من التكامل الاقتصادي أن يفتح آفاقًا اوسع للتعاون العالمي. فمن خلال استيراد التقنيات الحديثة، تستطيع الدول تحسين عملياتها الصناعية، والحد من التلوث، والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. وتعتمد هذه التحولات على وجود قواعد تجارية شفافة وعادلة لا تُعاقب ولا تُثقل الدول التي تتبنى استراتيجيات خضراء متقدمة.
ومع ذلك، فإن عدم دعم هذه التطورات بإطار تنظيمي شامل وبرامج فعالة لبناء القدرات وممولة بشكل كاف، قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين المصدرين الواعين بيئيًا ونظرائهم الأقل قدرة، مما يُعمّق من مظاهر عدم المساواة.
٧- الحوافز الخضراء أو الحمائية قد تُثير نزاعات تجارية، إذ قد تشعر الدول ذات القدرات المحدودة في إنتاج المنتجات الخضراء بالإقصاء أو التهميش. كما قد تظهر خلافات بشأن كيفية تحديد ما يُعد “أخضر”، مما يخلق توترات إضافية خلال المفاوضات التجارية. وقد تتردد الحكومات في تبني هذه التدابير إذا رأت أنها قد تُضر بصناعاتها المحلية أو في حال غياب تنسيق فعال بين الأطراف الدولية المعنية.
وقد أثارت الدول النامية مخاوف متزايدة حيال ما يُعرف بـ”الحمائية الخضراء”، أي حين تفرض الدول المتقدمة معايير بيئية صارمة يصعب على الدول النامية الالتزام بها، مما يجعلها بمثابة حواجز غير جمركية تُقيد النفاذ إلى الأسواق، تحت غطاء المسؤولية البيئية.
وتتمثل أبرز التحديات في الترويج للسلع الخضراء من خلال التجارة فيما يلي:
غياب تعريف دقيق للسلع الخضراء. كما أُشير سابقًا، تُعد هذه المسألة من أبرز العقبات في مفاوضات التجارة العالمية، مثل اتفاقية السلع البيئية (EGA)، نظرًا لعدم وجود اتفاق عالمي حول ما يُعد “سلعًا بيئي”.
كذلك تُعد الحواجز التجارية المستمرة، رغم محاولات خفض التعريفات الجمركية، من التحديات القائمة. فعلى الرغم من مبادرات مثل اتفاقية السلع البيئية التي تهدف إلى تقليل الرسوم الجمركية، لا تزال الحواجز غير الجمركية — مثل قواعد الترخيص والمعايير الفنية والحصص — تُقيّد تجارة السلع الخضراء. وغالبًا ما تعكس هذه الحواجز أجندات سياسية غير معلنة، ما يؤدي إلى إبطاء انتشار التقنيات الصديقة للبيئة عالميًا. ومن الأمثلة البارزة على ذلك فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية انتقامية على الألواح الشمسية الصينية، استنادًا إلى اتهامات بالدعم غير العادل وممارسات الإغراق، وهو ما أثّر سلبًا على القدرة على تحمل تكاليف منتجات الطاقة النظيفة وإمكانية الوصول إليها.. إضافة إلى ذلك، تُعتبر مسألة تأخر السياسة التجارية عن الابتكار البيئي مصدر قلق أيضًا.
التقدم التكنولوجي في الابتكارات الخضراء يتجاوز قدرة قواعد التجارة الدولية على التكيف. وكما حدث مع اتفاقية تكنولوجيا المعلومات لعام ١٩٩٦، فإن أي قائمة للسلع الخضراء ضمن منظمة التجارة العالمية تظل معرضة للتقادم السريع ما لم تُحدَّث بشكل منتظم، وهو ما يُمثل تحديًا في ظل بطء وتيرة المفاوضات متعددة الأطراف..
٨- من الناحية المؤسسية، تفتقر منظمة التجارة العالمية إلى الخبرة والمرونة الكافية للتعامل مع القضايا البيئية المعقدة والمتسارعة، مثل فقدان التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ. فعلى الرغم من فعالية نظامها لتسوية المنازعات في إنفاذ قواعد التجارة، إلا أنه غالبًا ما يُهمل الاعتبارات البيئية، وخصوصًا مبدأ الحيطة. ويُضاف إلى ذلك أن هيكل الحوكمة المنفصل في المنظمة يُقيد فرص التعاون مع الهيئات البيئية المتخصصة، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
في اللجنة العالمية للتجارة والبيئة، أكد الأعضاء على أهمية تعزيز الشفافية، وبناء القدرات، والتعاون فيما يخص التدابير البيئية. كما شددوا على ضرورة تعميق التنسيق مع هيئات مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة..
٩- تُعد كيفية تفسير لجان فض المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية للتدابير البيئية من أبرز نقاط النقاش. فرغم أن المادة العشرون تُوفر غطاءً قانونيًا محتملًا، إلا أن شروطها المتعلقة بعدم التمييز والضرورة غالبًا ما تُقيّد مرونة الحكومات في التعامل الاستباقي مع القضايا البيئية. فعلى سبيل المثال، تُعتبر أدوات التجارة المرتبطة بالمناخ، مثل آليات تعديل حدود الكربون (CBAMs)، لدى البعض سياسات مناخية ضرورية، في حين يراها آخرون شكلًا من أشكال الحمائية المُقنّعة..
لم تُصدر منظمة التجارة العالمية بعد قرارًا بشأن هذه التدابير، إلا أن الطريقة التي ستُفسّر بها في القضايا المستقبلية سيكون لها تأثير كبير على سياسات المناخ. وتُبرز إحدى المقالات الأكاديمية كيف أن التسعير والمتطلبات الفنية المتمايزة لآلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) قد تتعارض مع مبدأ عدم التمييز في إطار قانون منظمة التجارة العالمية، مع مناقشة المادة العشرين (XX) كدفاع محتمل، لكنه يظل محدودًا في نطاقه.
10- من الجوانب الأخرى المعقدة تزايد المعايير البيئية الطوعية وأنظمة إصدار الشهادات الخاصة، مثل العلامات البيئية وشهادات التجارة العادلة. ورغم أن هذه المبادرات تدعم الممارسات المستدامة، إلا أنها غالبًا ما تظل خارج الإطار الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، مما يجعلها عرضة للطعن باعتبارها عوائق أمام التجارة. وكثيرًا ما تُعرب الدول النامية عن أن هذه المعايير تُلحق ضررًا بصادراتها، خاصة عندما يتطلب الامتثال لها تحديثات تكنولوجية مرتفعة التكلفة.
يتعلق أحد الجوانب الخلافية في نقاش وضع العلامات البيئية بتطبيق المعايير المرتبطة بالعمليات وأساليب الإنتاج. يتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية عمومًا على جواز فرض معايير تستند إلى أساليب إنتاج تترك أثرًا ظاهرًا في المنتج النهائي، مثل بقايا المبيدات في القطن المزروع تقليديًا.
ومع ذلك، لا يزال الخلاف قائمًا بشأن المعايير التي تعتمد على مواد أولية غير مدمجة أو غير مرتبطة بالمنتج، حيث لا تؤثر طريقة الإنتاج على الخصائص الفيزيائية للمنتج النهائي.
ومن الأمثلة المتكررة استخدام الخشب المستخرج من مصادر مستدامة في صناعة الأثاث، حيث لا تنعكس هذه الخصائص البيئية في الشكل النهائي للمنتج.
وتكمن الإشكالية القانونية الأساسية في مدى توافق هذه التدابير مع التزامات منظمة التجارة العالمية. ترى العديد من الدول أن التمييز بين منتجات متطابقة بناء فقط على المواد الأولية غير المدمجة، كما تفعل بعض العلامات البيئية، قد يُعد نوعًا من التمييز، وبالتالي يتعارض مع المبادئ الأساسية للمنظمة، وبخاصة أحكام المعاملة الوطنية والدولة الأكثر رعاية في اتفاقية الجات.
11- إضافة لذلك، فإن غياب التكامل بين منظمة التجارة العالمية ومؤسسات الحوكمة البيئية العالمية، مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة أو اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يُفضي إلى حالة من التشرذم المؤسسي. ومن شأن تعزيز التعاون بين هذه الأطراف أن يُسهم في تحقيق مزيد من الاتساق والترابط في صياغة القواعد البيئية وتطبيقها.
وتؤكد منظمة التجارة العالمية أن نظامها ونظام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يعترفان بالالتزامات المتبادلة، وفقًا لما تنص عليه المادة 3.5 من الاتفاقية والمادة 2.3 من بروتوكول كيوتو. كما تُبرز المنظمة الجهود الجارية لتعزيز تبادل المعلومات، وتطوير وضع المراقب، وتنفيذ مبادرات مشتركة في مجال بناء القدرات مع الهيئات المعنية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتبرز هذه التحديات التوتر القائم بين التجارة والاستدامة البيئية، وتشير إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة تمكن منظمة التجارة العالمية من مواءمة عملها مع المتطلبات البيئية في القرن الحادي والعشرين.
ويسلط هذا التحليل الضوء على محدودية الإطار الحالي لمنظمة التجارة العالمية في دعم الأهداف البيئية بصورة شاملة، ويؤكد أن الإصلاحات القانونية والمؤسسية باتت ضرورية لتعزيز قدرة المنظمة على الإسهام الفعّال في تحقيق التنمية المستدامة.
– الفصل الثالث: مسارات الإصلاح لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية في الحماية البيئية
لكي يتعزز دور منظمة التجارة العالمية في الحماية البيئية، نقترح الإصلاحات التالية:
- أحكام بيئية أقوى:
إدراج التزامات استدامة مُلزمة ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة ضرورية، إذ إن الإطار القائم يركّز بصورة أساسية على تيسير التجارة، مع تخصيص اهتمام محدود لقضايا حماية البيئة. (Schultz, 1995) ولمعالجة هذه الفجوة، يمكن إدراج أحكام بيئية أكثر قوة ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بما يشمل التزامات مُلزمة على الدول الأعضاء باعتماد وتطبيق ممارسات مستدامة في قطاعات محورية مثل الزراعة والتصنيع والطاقة.
من خلال إدراج الاستدامة البيئية كمبدأ أساسي ضمن اتفاقيات التجارة، ستلتزم الدول بمواءمة سياساتها التجارية مع أهداف المناخ، مثل اتفاقية باريس. ومن شأن ذلك أن يُسهم في الحد من الآثار السلبية المحتملة لتحرير التجارة على البيئة، مثل ارتفاع انبعاثات الكربون، وإزالة الغابات، أو استنزاف الموارد بشكل غير مستدام.
علاوة على ذلك، من شأن هذا التوجه أن يُوفر بيئة تنافسية متكافئة للشركات على الصعيد العالمي، ويُسهم في الحد من ممارسات “التنافس على المنافع” التي تقوم على خفض المعايير البيئية بهدف جذب الاستثمار.
يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تشجع استخدام العلامات البيئية والمعايير البيئية والشهادات الخضراء، بما يسمح للمستهلكين باتخاذ قرارات أكثر وعيًا بالاعتبارات البيئية
وعلاوة على ذلك، فإن دمج التزامات الاستدامة ضمن الإطار التجاري قد يسهم في تطوير اقتصاد أخضر يكافئ الابتكار في التقنيات المستدامة، ويخلق اسواقًا جديدة وفرص عمل في مجالات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والسلع الصديقة للبيئة
وقد أدرجت منظمة التجارة العالمية بعض الاعتبارات البيئية ضمن إطار عملها، إلا أن الابتكارات المؤسسية الإضافية يمكن أن تعزز من قدرتها على التوفيق بين أهداف التجارة وحماية البيئة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمنظمة أن تستفيد من إنشاء لجنة مختصة بالامتثال البيئي، أو إدماج تقييمات الأثر البيئي في عملية مراجعة اتفاقيات التجارة. من شأن هذه الخطوات أن تعزز الشفافية والمساءلة في عمل المنظمة، ولا يقل أهمية عن ذلك تمكين الدول النامية، من خلال ضمان حصولها على نقل التكنولوجيا والتمويل الأخضر، بما يسمح لها بالمشاركة الفاعلة في سلاسل القيمة الخضراء العالمية دون الإضرار بفرصها التنموية.
٢. تعزيز التعاون مع المنظمات البيئية:
دعم التعاون مع مؤسسات مثل اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لضمان الاتساق بين السياسات التجارية والبيئية.
ينبغي لمنظمة التجارة العالمية أن تعزز تعاونها مع المنظمات البيئية الدولية، مثل اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). ومن شأن هذا التعاون أن يضمن توافق السياسات التجارية مع الاهداف البيئية العالمية، مثل التخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحد من التلوث.
من خلال تعزيز التعاون، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تسهم في دمج أهداف تغير المناخ والاهداف البيئية ضمن مفاوضات التجارة، بما يضمن أن تدعم قواعد التجارة الاجندة الدولية الأشمل المتعلقة بالاستدامة، فعلى سبيل المثال، يمكن وضع قواعد تجارية تمنع الدول من تقويض العمل المناخي من خلال دعم الوقود الاحفوري أو إزالة الغابات. كما يمكن للمبادرات المشتركة أن تُسهم في تحديد العوامل المرتبطة بالتجارة التي تؤدي إلى تدهور البيئة، مما يسمح بتنسيق الجهود للتصدي لها.
يمكن أن يسهم تعزيز التعاون في إيجاد حلول متكاملة تُعالج التحديات الاقتصادية والبيئية في آن واحد. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنظمة التجارة العالمية واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ أن تعملا معًا على دعم آليات تسعير الكربون أو تدابير تعديل حدود الكربون، بما يحفز الدول على خفض الانبعاثات مع الحفاظ على ممارسات تجارية منصفة، علاوة على ذلك، يُمكن لتبادل المعرفة بين هذه الهيئات أن يعزز الفهم المتعمق للترابط القائم بين التجارة والتنمية وحماية البيئة.
كما تجدر الإشارة إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة في صياغة سياسات تجارية تراعي البُعد البيئي. ويُفترض أن يكون لمنظمات المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية البيئية، والمجتمع العلمي، دور أكبر في عمليات منظمة التجارة العالمية.
ومن شأن هذا التوسيع في المشاركة أن يُعزز الشفافية، ويُحسن من شرعية السياسات، ويضمن أن تعكس هذه السياسات ليس فقط المصالح التجارية، بل أيضًا الاولويات البيئية. ويمكن أن يُسهم هذا التشارك الأوسع في مواءمة أطر منظمة التجارة العالمية مع تطلعات ومطالب سكان العالم الذين يزداد وعيهم بأهمية العمل المناخي.
3. بناء القدرات للدول النامية:
توفير الدعم المالي والفني لمساعدة الدول النامية على تنفيذ المعايير البيئية دون أن يترتب على ذلك أي ضرر اقتصادي. تواجه العديد من الدول النامية صعوبات كبيرة في الامتثال للمعايير البيئية المرتفعة نتيجة محدودية الموارد المالية، والفجوات التكنولوجية، وضعف القدرات المؤسسية.
ويمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تضطلع بدور حاسم في دعم مبادرات بناء القدرات، من خلال تقديم الدعم المالي والفني اللازم، بما يساعد هذه الدول على تبني ممارسات مستدامة والامتثال للمعايير البيئية .
من شأن هذا النهج أن يُمكّن الدول النامية من مواءمة سياساتها التجارية مع اهداف الاستدامة العالمية دون الإضرار بنموها الاقتصادي. ويمكن لبرامج بناء القدرات أن تركز على توفير الوصول إلى التقنيات الخضراء، وتعزيز المهارات والمعارف اللازمة للإنتاج المستدام، وتحسين الأطر المؤسسية المعنية بالحوكمة البيئية. ومن شأن هذه الجهود أن تُتيح للدول النامية المنافسة في السوق العالمية مع الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة .
يمكن أن يتيح بناء القدرات فرصًا جديدة للدول النامية لتجاوز التقنيات التقليدية والضارة بالبيئة، واعتماد أساليب إنتاج أنظف وأكثر كفاءة، وبالإضافة إلى ذلك، قد يُسهم هذا التوجه في إنشاء صناعات ووظائف خضراء محلية، مما يُعزز من المرونة الاقتصادية العامة، ويدعم مسار التنمية المستدامة.
- حوافز للتجارة الخضراء:
وضع حوافز تجارية للسلع والخدمات الصديقة للبيئة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام. ومن أجل دعم التحول العالمي نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تقدم حوافز تجارية مخصصة لتشجيع إنتاج وتبادل السلع والخدمات ذات الأثر البيئي الإيجابي (Cosbey,2011). يمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية، أو إعانات، أو تعريفات جمركية تفضيلية تُمنح للشركات والمنتجات التي تستوفي معايير بيئية محددة.
يمكن أن تؤدي الحوافز التجارية للمنتجات الخضراء إلى تحفيز الطلب على السلع الصديقة للبيئة، مثل تقنيات الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية، ومنتجات الزراعة المستدامة. وستُشكّل هذه الحوافز إشارة سوقية قوية تدفع الشركات إلى الاستثمار في الابتكارات المستدامة.
مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي انتشار المنتجات الخضراء إلى خفض التكاليف، مما يجعلها أكثر توفرًا للمستهلكين والشركات في كل من الدول المتقدمة والنامية.
ومن خلال وضع معايير واضحة لحوافز التجارة الخضراء، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تسهم في إنشاء سوق عالمية للسلع والخدمات المستدامة، بما يُحفز الاستثمار في الابتكار الأخضر.
ومع التوسع في اعتماد هذه الحوافز، يمكن أن يُسهم ذلك في تعزيز التحول العالمي نحو اقتصاد دائري، يتم فيه تقليل استخدام الموارد، والحد من النفايات، وتصميم المنتجات بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام، مما يُحقق فوائد اقتصادية وبيئية مستدامة على المدى الطويل.
5. إنشاء آلية منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاعات البيئية
في الوقت الحالي، تُعالج الهيئة العامة لتسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية النزاعات التجارية المتعلقة بالقضايا البيئية. ومع ذلك، تتطلب النزاعات البيئية معرفة متخصصة. يمكن لهيئة مختصة بتسوية النزاعات البيئية تقييم القضايا البيئية بشكل منفصل، بما يضمن توازن أولويات التجارة والبيئة بشكل عادل.
6. تشجيع اتفاقيات التجارة المستدامة
ينبغي أن تتضمن جميع اتفاقيات التجارة الجديدة التي تعقدها منظمة التجارة العالمية بنودًا بيئية مُلزمة، لضمان إدماج الاستدامة كجزء أساسي من منظومة حوكمة التجارة العالمية.
وعلاوة على ذلك، ومع تصاعد تهديدات التدهور البيئي للاستقرار الاقتصادي العالمي، تتزايد الدعوات إلى أن تُعترف الاستدامة داخل منظمة التجارة العالمية ليس بوصفها عاملًا ثانويًا، بل كمكون أساسي من مكونات التجارة ذاتها، ويشمل ذلك إدماج المراجعات البيئية في سياق المفاوضات التجارية، وإعادة توجيه الدعم لتعزيز الصناعات الخضراء، وتوفير ضمانات فعالة ضد إغراق الأسواق بالسلع الضارة بالبيئة.
– الخاتمة:
في النهاية، يخلص هذا البحث إلى أن الإطار التجاري القائم لمنظمة التجارة العالمية لا يُراعي الاعتبارات البيئية إلا بشكل جزئي. فبالرغم من أن المادة 20 من اتفاقية الجات، واتفاقية العوائق الفنية على التجارة، واتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية توفر قدرًا من المرونة، إلا أن أحكام النزاعات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية غالبًا ما تُعطي الأولوية للمصالح التجارية على حساب أهداف الاستدامة.
استعرض هذا البحث مدى توافق الأطر القانونية والمؤسسية لمنظمة التجارة العالمية مع أهداف حماية البيئة على المستوى العالمي. فبينما توفر المنظمة آليات قانونية مهمة، مثل المادة 20 من اتفاقية الجات، التي تتيح فرض قيود تجارية لدواعٍ بيئية، غالبًا ما تكون هذه الآليات مشروطة بمتطلبات صارمة تُقيّد إمكانية الاستفادة منها، وتُبرز قضايا تسوية المنازعات، مثل قضية الولايات المتحدة بشأن الروبيان، ونزاع المفوضية الاوروبية بشأن الهرمونات، ما يملكه نظام منظمة التجارة العالمية من إمكانات، وما يواجهه من حدود في التعامل مع المخاوف البيئية.
على الرغم من بعض التقدم المحرز من خلال لجنة التجارة والبيئة ومبادرات مثل اتفاقية السلع البيئية، لا تزال منظمة التجارة العالمية تواجه انتقادات لعدم إيلائها الاستدامة الأهمية الكافية. ويُبرز غياب الالتزامات البيئية المُلزمة، وتصور الحمائية الخضراء، والانفصال المؤسسي عن المنظمات البيئية العالمية، وجود ثغرات جوهرية تستدعي المعالجة.
وبناءً على هذه الإصلاحات، يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تتحول إلى مؤسسة عالمية أكثر استجابة ومسؤولية، لا تقتصر مهمتها على تعزيز التجارة الحرة فحسب، بل تسهم أيضًا في حماية الكوكب لصالح الأجيال القادمة.
قائمة المراجع:
الشمري، فرحان، الاقتصاد الأخضر والأزرق، مقال إلكتروني بموقع عاجل الإلكتروني، بتاريخ 19-11-2023م. https://ajel.sa/opinion/k6gfx9e88c
عبد اللطيف، والي، مقال بعنوان: المنظمة العالمية للتجارة، ودورها في عولمة الوعي البيئي، بتاريخ 26-1-2019م، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية. المجلد 5، رقم 1. ص. 1-15
Barbier, Edward (2011). The policy challenges for green economy and sustainable economic development. Natural resources forum. Vol. 35. No. 3. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd.
Benson, Emily (2022). CBAM Precedents: Experts Weigh In. Center for Strategic and International Studies. Available on: https://www.csis.org/analysis/cbam-precedents-experts-weigh?utm_source=chatgpt.com
Bermann, Suzanne (2007). EC-hormones and the case for an express WTO postretaliation procedure.” Colum. L. Rev. 107: 131.
Busch, Marc L., and Eric Reinhardt. “Developing countries and general agreement on tariffs and trade/world trade organization dispute settlement.” J. World Trade 37 (2003): 719.
Charnovitz, Steve. (2007). Trade and Climate: Potential Conflicts and Synergies. In Beyond Kyoto: Advancing the International Effort Against Climate Change. Pew Center on Global Climate Change. 141-170. Available on: https://charnovitz.org/publications/Trade_and_Climate.pdf
Cosbey, Aaron. (2007). Trade and Climate Change: Issues in Perspective. International Institute for Sustainable Development (IISD). 1-126. Available on: http://sa.indiaenvironmentportal.org.in/files/cph_trade_climate.pdf
Cosbey, Aaron (2011). Trade, sustainable development and a green economy: Benefits, challenges and risks.” The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective: 40.
Cossy, Mireille, and Gabrielle Marceau (2009). Institutional challenges to enhance policy co-ordination–how WTO rules could be utilised to meet climate objectives?T. Cottier, O. Natrova and SZ Bigdeli, International Trade Regulation and the Mitigation of Climate Change, CUP.
Costantini, Valeria.; Massimiliano Mazzanti (2012). On the green and innovative side of trade competitiveness? The impact of environmental policies and innovation on EU exports.” Research policy 41.1 (2012): 132-153.
Daily, Matt (2012). U.S. sets new tariffs on Chinese solar imports. Reuters. Available on: https://www.reuters.com/article/us-china-trade/u-s-sets-new-tariffs-on-chinese-solar-imports-idUSBRE84G19U20120517/
Eckersley, Robyn. (2004). The Big Chill: The WTO and Multilateral Environmental Agreements. Global Environmental Politics, 4(2), 24–50. Available at: https://www.researchgate.net/publication/24089830_The_Big_Chill_The_WTO_and_Multilateral_Environmental_Agreements
Esty, Daniel. C. (2001). Bridging the Trade-Environment Divide. Journal of Economic Perspectives, 15(3), 113–130. Available on: https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jep.15.3.113
Howse, Robert. (2002). The appellate body rulings in the shrimp/turtle case: A new legal baseline for the trade and environment debate.” Colum. j. Envtl. L. 27. 491.
Jean-Marie Paugam, Deputy Director-General, World Trade Organization (WTO) (2024). Trade, sustainability and climate: What is at stake 30 years after WTO’s creation? WTO website. Available on: https://www.wto.org/english/blogs_e/ddg_jean_marie_paugam_e/blog_jp_28feb24_e.htm?utm_source=chatgpt.com
Labelling. WTO. Available on: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/labelling_e.htm?utm_source=chatgpt.com
Lingyi, Lin (2025). Analysis of the WTO Compliance of the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism. Proceedings of the 3rd International Conference on Management Research and Economic Development. DOI: 10.54254/2754-1169/177/2025.22479 Available on: https://www.ewadirect.com/proceedings/aemps/article/view/22479?utm_source=chatgpt.com
Marceau, Gabrielle Zoe.; Trachtman, Joel P. A (2014). Map of the World Trade Organization Law of Domestic Regulation of Goods: The Technical Barriers to Trade Agreement, the Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement, and the General Agreement on Tariffs and Trade. In: Journal of world trade, 2014, vol. 48, n° 2, p. 351–432. Available on: file:///C:/Users/USER/Downloads/map%20of%20wto%20law.pdf
Meyer, Nico;. Fenyes, Tamas.; Breitenbach, Martin.; Idsardi, Ernst (2010). Bilateral and Regional Trade Agreements and Technical Barriers to Trade: An African Perspective.OECD Trade Policy Papers, No. 96, OECD. Publishing, Paris. 1-49.
http://dx.doi.org/10.1787/5kmdbgfrgnbv-en
Oropeza, Jesus Castillo (2023). Why the World Needs a Free Trade Agreement on Green Goods and Services. Earth. Org. Available on: https://earth.org/free-trade-agreement/
Oatley, Thomas (2019). International Political Economy: Sixth Edition. Routledge. pp. 51–52.
Patricia M. GOFF (2015). THE ENVIRONMENTAL GOODS AGREEMENT A PIECE OF THE PUZZLE. Report of the Centre for International Governance Innovation. Available on: https://www.cigionline.org/static/documents/cigi_paper_no.72.pdf
Sachs, Jeffrey D (2012). From millennium development goals to sustainable development goals. The lancet 379.9832 (2012): 2206-2211.
Sarkar, Ashok.; Jas Singh (2010). Financing energy efficiency in developing countries-lessons learned and remaining challenges.” Energy Policy 38.10: 5560-5571.
Schultz, Jennifer (1995). The GATT/WTO Committee on Trade and the Environment—Toward environmental reform.” American Journal of International Law 89.2: 423-439.
Scott, Joanne (2009). The WTO agreement on sanitary and phytosanitary measures: a commentary. OUP Catalogue. Oxford University Press.
Steenblik, Ronald (2020). How Can a Six-Digit Trade Code Help the Environment? OIISD. Available on: https://www.iisd.org/articles/trade-code-environment
Stephanie Switzer.; Mitchell Lennan (2022). The WTO’s Agreement on Fisheries Subsidies. ‘It’s good, but it’s not quite right’. On Ocean Hub. Available on: https://oneoceanhub.org/the-wtos-agreement-on-fisheries-subsidies-its-good-but-its-not-quite-right/
Tamiotti,.Ludivine.; Teh Vesile Kulaçoğlu Robert.; Olhoff Anne.; Simmons, Benjamin.; Abaza, Hussein (2011). The WTO and Climate Change: Issues of Trade Policy and the Environment. World Trade Organization Publications. 1-194. Available on: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/trade_climate_change_e.pdf
Weiss, E, B.; Jacobson, H, K (2000). Engaging countries: Strengthening compliance with international environmental accords. MIT Press, 2000.
WTO (1998). European Communities – Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/AB/R. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm
WTO (2012). United States – Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and
Tuna Products (Tuna II), WT/DS381/AB/R. 🔗 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds381_e.htm
WTO Report (2018). WTO Report.1-236. Available on: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/world_trade_report18_e.pdf
WTO (2022). Agreement on Fisheries Subsidies. Available on:
https://www.wto.org/english/tratop_e/rulesneg_e/fish_e/fish_e.htm
WTO (2023). Trade and Environment Committee (CTE). https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/wrk_committee_e.htm
WTO – Understanding the WTO: The GATT years: from Havana to Marrakesh. The WTO Report. 5 edition. 15. This report is also available on: https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/understanding_e.pdf
WTO members examine proposals to deepen discussions on trade and environment (2023). Available on: https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/envir_16nov23_e.htm?utm_source=chatgpt.com
WTO webpage. Activities of the WTO and the challenge of climate change. Available on: https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/climate_challenge_e.htm?utm_source=chatgpt.com


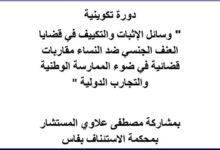


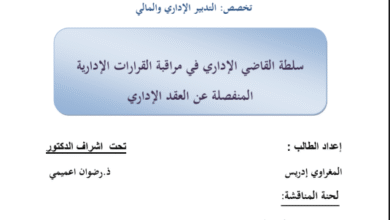

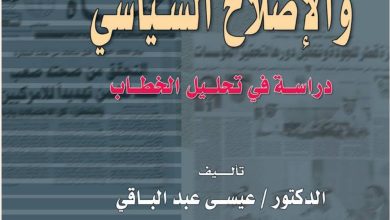
تعليق واحد